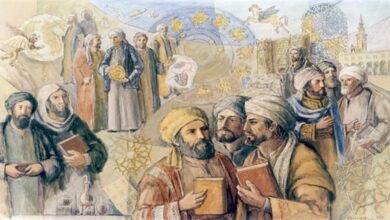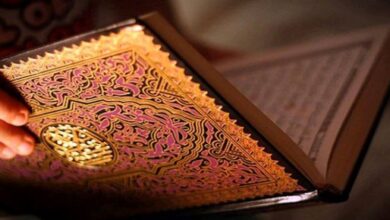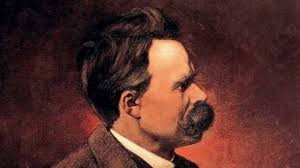تأمُّلات في كلاسيكيات علم الاجتماع
تأملات في كلاسيكيات علم الاجتماع
تأمُّلات في كلاسيكيات علم الاجتماع
أشرف حسن منصور
رئيس قسم الفلسفة بكليَّة الآداب في جامعة الإسكندرية – مصر
مقدمة
لاشك في أن نشأة علم الاجتماع كانت مصاحبة بإحساس باكتشاف علم جديد، لم يفكر فيه أحد من الفلاسفة أو المفكرين السابقين، علم يدرس “المجتمع”، لا السياسة ولا الاقتصاد ولا القانون. قد نأخذ هذا العلم الذي يدرس “المجتمع” الآن على أنه شيء مُسَلَّم به، بوصفه عاديًا معتادًا وطبيعيًا، إذ يقول الحس الشائع الآن إنه يجب أن يكون للمجتمع علم يدرسه. هذا هو ما يقوله وعينا الحالي البسيط، الذي اعتاد سماع كلمة “مجتمع”، وكلمة “علم اجتماع“، من مصادر مختلفة، سواء من المجال الثقافي العام أو من وسائل الإعلام، أو من المناهج الدراسية.
لكن إذا كان الأمر بديهيًا على هذا النحو، فلماذا لم يظهر علم الاجتماع قبل مائتي سنة؟ ولماذا ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحديدًا، وهو عصر متأخر بالنسبة إلى تواريخ نشأة العلوم الاجتماعية الأخرى الأسبق ظهورًا مثل علم النفس وعلم السياسة وعلم القانون والأنثروبولوجيا؟ ومن ثم فإن نشأة علم الاجتماع تتطلب دراسة مستقلة، توضح أسباب ظهوره والعوامل التي ساعدت على اكتشافه من قِبَل علماء عديدين موزعين على دول كثيرة. في تلك الفترة، ظهر وعي بإمكان دراسة المجتمع بمنظور ورؤية ومناهج مختلفة عن تلك السائدة في العلوم الاجتماعية الأخرى، ووعي بشيء يسمى “المجتمع”، لا يمكن أن يُرَدُّ إلى شيء آخر أعم منه يستوعبه، ولا يمكن تفسير ظواهره خارجه بل يشكل هو نفسه أساس تفسير ظواهره. فلأول مرة، يظهر اكتشاف جديد، لمجال لا يمكن رده إلى الاقتصاد أو السياسة أو القانون أو الحالات النفسية للفرد، وهو المجال الاجتماعي الذي أدى إلى زيادة الوعي بالاحتياج إلى علم خاص يدرسه. ومن هنا تأتي أهمية دراسة كلاسيكيات هذا العلم، فهي التي تمثل لحظة التأسيس الأولى ونقطة الانطلاق الأصلية التي سوف تحدد هوية ومعالم علم الاجتماع طوال مراحل تطوره التالية.
أولًا – الرواد والكلاسيكيات
1) لحظة التأسيس الأولى
يتصف علم الاجتماع بكونه على صلة وثيقة بلحظة تأسيسه الأولى طوال مراحل تطوره؛ فعلماء الاجتماع لا ينسون هذه اللحظة، ودائمًا ما يبني كل عالم اجتماع جديد على من سبقوه وبالعودة إلى نقطة الانطلاق الأولى، فهو يأخذ من الرواد ويستوحي منهم أفكارًا ويطورها أو يتجاوزها. كما أن مهمة تجاوز الأعمال التأسيسية الأولى تحتاج إلى معرفة وثيقة بها ودراسة متأنية كي يتم تجاوزها. ومن ثم شكلت أعمال رواد علم الاجتماع “كلاسيكيات”، أي أعمالًا تأسيسية مرجعية ونموذجية، تتم قراءتها وإعادة قراءتها باستمرار. والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من تعليم علم الاجتماع يتمثل في قراءة ودراسة كلاسيكيات هذا العلم، فقراءة هذه الكلاسيكيات تمثل إعدادًا ذهنيًا وتهيئة عقلية وتدريبًا لكل متعلم ولكل باحث ناشئ في هذا العلم. إذا أردت أن تعرف ما هو علم الاجتماع، فعليك قراءة أعمال علماء الاجتماع، خاصة الرواد منهم، وهي المسماة “كلاسيكيات” Classics.
وتعد إعادة قراءة ودراسة وتفسير كلاسيكيات علم الاجتماع من أهم عوامل استمراره وتطوره في المستقبل، وعليها تعتمد إمكانات وفرص نجاحه ونقله إلى كل جيل جديد، وهي حالة نادرة من الارتباط بالتراث الفكري للعلم لا نجد لها شبيهًا إلا في الفلسفة، التي تعتمد هي أيضًا على أعمال الفلاسفة الكبار. وليست كلاسيكيات علم الاجتماع مثل الأعمال الفنية في المتاحف، حيث يشاهدها الزوار ويستمتعون بها لما فيها من طرافة ولما تثيره في نفوسهم من فضول وحب استطلاع. فليست هذه الأعمال الكلاسيكية متقادمة مثل مطبعة جوتنبرج التي كانت تشغل مساحة غرفة كبيرة مقارنة بالطابعة الليزر التي يمكن أن تحملها باليد الواحدة، وليست هذه الأعمال مثل التجول في متحف القطارات لمشاهدة القطارات الأولى في القرن التاسع عشر؛ إنها بالأحرى النصوص التأسيسية التي تعطي لعلم الاجتماع هويته وتشكل فرص استمراره في المستقبل.
وتمثل لحظة التأسيس الأولى لعلم الاجتماع مرحلة محورية فارقة، لا لأنها هي لحظة التدشين وتحديد هوية العلم وحسب، بل لأن الرواد كانوا منشغلين بقضايا ظلت هي قضايا البحث السوسيولوجي طوال تاريخ العلم، مثل: اختلاف علم الاجتماع عن العلوم الاجتماعية الأخرى، والسعي إلى تمييزه عنها بموضوع خاص به ومنهج مستقل؛ والتمييز بين المنظور السوسيولوجي والمنظورات السيكولوجية والبيولوجية والاقتصادية؛ وتحديد مستوى خاص للتفسير السوسيولوجي يختلف عن مستويات التفسير النفسية والاقتصادية؛ والتشديد على درجة استقلال المجتمع عن السلطة الحاكمة وأجهزة الدولة والقانون، وهي الأشياء التي تتخصص في دراستها علوم أخرى مثل علم السياسة والاقتصاد والقانون؛ والأسباب الاجتماعية للمشكلات الفردية (وهو الموضوع الذي لفت النظر إليه رايت ميلز في كتابه “الخيال السوسيولوجي“)؛ والعلاقة بين الفرد والمجتمع وأيهما يشكل الآخر، والعلاقة بين الفعل الاجتماعي والنسق الاجتماعي، وما يندرج تحت هذه العلاقة من إشكاليات الحرية والحتمية.
2) ما هي “الكلاسيكيات”؟
عند تناولنا كلاسيكيات علم الاجتماع، فيجب أن نحدد ما الذي نقصده بعلم الاجتماع ونفصله عن العلوم الاجتماعية القريبة منه. في التراث الفكري الاجتماعي نستطيع أن نميز بين: الفكر الاجتماعي أو الفلسفة الاجتماعية، والفكر السياسي، والنظرية السياسية، والنظرية الاجتماعية، والنظرية السوسيولوجية، والفكر السوسيولوجي. والكلاسيكيات التي أقصدها هي الخاصة بالنظرية السوسيولوجية والفكر السوسيولوجي. فلكل فرع من الفروع السابق ذكرها كلاسيكياته. على سبيل المثال، “محاورة الجمهورية” لأفلاطون تنتمي إلى الفكر السياسي والفلسفة الاجتماعية، و”كتاب السياسة” لأرسطو ينتمي إلى النظرية السياسية والفكر السياسي، وبالتحديد “نظم الحكم”؛ وكذلك مؤلفات شيشرون إذ تنتمي إلى نفس المجال. وفي العصر الحديث، لدينا كتاب هوبز “اللفياثان“ Leviathan وكتاب “المواطن“، وكتاب جون لوك “بحثان في الحكومة المدنية“، وكتاب مونتسيكو “روح القوانين“، وكتاب روسو “العقد الاجتماعي“، وكتاب هيجل “أصول فلسفة الحق“، وكل هذه كلاسيكيات، تنتمي إلى الفكر السياسي والفلسفة السياسية والاجتماعية. وكتاب توكفيل “النظام القديم والثورة الفرنسية” هو عمل كلاسيكي يقارن بين العهد القديم وعصر الثورة الفرنسية في نظم الحكم والإدارة، وكتاب “في الحرية” لجون ستيوارت ميل في الفكر السياسي، فهو لا يقدم نظرية في الحكم ولا في أنواع النظم الحاكمة، بل يقدم فلسفة في الحكم.
أما الكلاسيكيات التي أقصدها فهي الخاصة بعلم الاجتماع تحديدًا، أي التي ألفها علماء اجتماع، كانوا على وعي بهذا العلم وبأنهم يكتبون فيه، وهي على سبيل المثال مؤلفات دوركايم وفيبر وزيمل، بالإضافة إلى تونيز وباريتو ومانهايم وبارسونز، وطائفة أخرى من السوسيولوجيين سنتعرض لهم في سياق الدراسة. ولا أقتصر في دراستي للكلاسيكيات على الأعمال النظرية، مثل كتاب بارسونز “النسق الاجتماعي” The Social System، بل تضم الكلاسيكيات أيضًا، تلك الأعمال التي قدمت تحليلات سوسيولوجية عينية، مثل كتاب ريزمان “الحشد الوحيد” The Lonely Crowd وكتابي رايت ميلز “ذوو الياقات البيضاء” White Collar، و”صفوة القوة” The Power Elite.
3) أعمال الرواد
هذا بالإضافة إلى أن أعمال الرواد تتصف ببراءة ولحظة صفاء ذهني صاحبت البداية الأولى لعلم الاجتماع عند مرحلة تأسيسه. تتمثل هذه “البراءة” في نية صافية مخلصة لتأسيس العلم الجديد بوصفه علمًا، قبل أن يصير علم الاجتماع أداة للحصول على امتيازات ومكاسب، وقبل أن تستغله النظم السياسية في التخطيط الاجتماعي والهندسة الاجتماعية ولخدمة مصالح سياسية أو حزبية معينة أو لخدمة الدولة الرأسمالية أو الدولة الاشتراكية، وقبل أن يصير لدى بعض علماء الاجتماع اللاحقين أيديولوجيا مبررة للمصالح الرأسمالية أو الحزبية. وإذا كان علماء الاجتماع اللاحقين قد ارتبطوا بحكومات وبرامج حكومية باعوا لها العلم بغرض السيطرة على المجتمع أو البروباجاندا، إلا أن هذه الأغراض لم تكن من أهداف الرواد، إذ أردوا تأسيس علم جديد وضمان اعتراف أكاديمي به والوصول به إلى هوية وشخصية مختلفة عن العلوم الاجتماعية الأخرى، وهي كلها أهداف علمية وأكاديمية خالصة.
على الرغم من أن عُمْر علم الاجتماع ليس كبيرًا، بل هو قصير إذ يبلغ حوالي 150 سنة، إلا أننا نشعر مع رواد هذا العلم بأنهم كانوا ينتمون إلى عصرٍ ماضٍ سحيق موغل في القدم. فالجيل الحالي من شباب الباحثين ينظر إلى ماركس ودوركايم وفيبر وزيمل على أنهم كما لو كانوا ينتمون إلى عصر قديم وأشبه بفلاسفة اليونان القدماء. لكن هذا الإحساس هو مجرد انطباع غير حقيقي، وقد ارتبطت الكثير من الانطباعات غير الحقيقية بتاريخ وأعلام علم الاجتماع.
إقرأ أيضا: التعاقب الدوري في فكر فيكو.. مقاربة ومقارنة مع الواقع اليوم
وقد أصاب بيتر باير عندما ذهب إلى أن أثر رواد علم الاجتماع قد صار جزءًا عضويًا أساسيًا من هذا العلم؛ إذ صارت المفاهيم التي صاغوها من المقولات السوسيولوجية المعتمدة ومن الجهاز التفسيري السائد في هذا العلم، والعامل في مجالي التنظير والبحث التجريبي معًا[1]. إذ لا يزال علم الاجتماع يشتغل بمفاهيم “التساند الآلي mechanical solidarity والتساند العضوي” organic solidarity و”اللامعيارية” anomy، و”الوعي الجمعي” conscience collective، وهي المفاهيم التي أدخلها دوركايم، وصارت مرتبطة باسمه بحيث يتذكره المرء كلما قرأها في أي عمل سوسيولوجي ؛ وكذلك الحال بالنسبة لمفاهيم أخرى مثل “النموذج المثالي” ideal type و”الفعل الاجتماعي” و”القفص الحديدي” Iron Cage و”الكاريزما”، التي أدخلها ماكس فيبر، ومفاهيم “صفوة القوة” و”الخيال السوسيولوجي” و”اللامسئولية المُمَأسسة” institutionalized irresponsibility التي أدخلها رايت ميلز[2]، ويمكن أن يستعين الباحث بهذه المفاهيم لشهرتها الذائعة دون ذكر اسم صاحبها، لأن الجماعة العلمية تعرفه جيدًا؛ وكذلك الحال مع مفاهيم مثل “الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة” manifest and latent functions التي أدخلها روبرت ميرتون[3]، و”العنف الرمزي” و”رأس المال الرمزي” و”رأس المال الاجتماعي” و”الطبع الاجتماعي” habitus التي أدخلها بيير بورديو[4]. إن الذي يجعل مفكرًا ما من الرواد والمؤسسين هو قدرته على إبداع مفاهيم تساعد في فهم وتصنيف الحياة الاجتماعية وتفسيرها وتكون جزءًا من الممارسة السوسيولوجية، ومن التفكير التلقائي والاعتيادي للسوسيولوجي. هذه المفاهيم هي مقولات الفهم السوسيولوجي وتعبر عن أنماط وجود وأشكال فاعلية الظواهر الاجتماعية. إنها مقولات إبستيمولوجية وأنطولوجية في وقت واحد. فهي طريقة في الفهم التصوري والتنظير العقلي للظواهر الاجتماعية (وهذا هو جانبها الإبستيمولوجي أو المعرفي)، وهي في الوقت نفسه الأنماط أو الصور التي توجد عليها الحياة الاجتماعية وتترتب وتنتظم فيها النظم الاجتماعية وأفعال الأفراد، أي أنها مقولات أنطولوجية أيضًا، أو بالأحرى أنطو – سوسيولوجية.
ولعل القارئ قد لاحظ أنني ضممت بيير بورديو إلى فئة الكلاسيكيين والرواد، في حين أنه متأخر ومن علماء الاجتماع المعاصرين (توفى 2002)، وهذا ملمح آخر عجيب من ملامح علم الاجتماع، فرواده وعلماءه “الكلاسيكيون” لا ينحصرون في بدايته ولحظة نشأته الأولى وحسب، بل تستمر معه فئة الرواد ملازمة لكل مراحل تطوره، إذ يظهر في كل عصر وكل فترة رائد جديد يضع عملًا كلاسيكيًا جديدًا. وهذه مفارقة أخرى، إذ نشهد في هذا العلم أعمالًا كلاسيكية متأخرة وحديثة للغاية، تعطيك شعورًا بأنها مكتوبة عند لحظة تأسيس العلم رغم أنها حديثة؛ وهذا هو حال مؤلفات بورديو. فهي “كلاسيكية” بمعنى أنها أصيلة وتأسيسية وتحمل البصمة الشخصية لصاحبها، في عصر اعتقدنا معه في نهاية الكلاسيكيات.
4) العوامل “الاجتماعية” لنشأة علم الاجتماع
وتتمثل أحد عناصر القوة في علم الاجتماع في أنه كان نتاجًا لظهور المجتمع الحديث، فهو قد نشأ بوصفه النظرية المفسرة لظهور هذا المجتمع من داخل المجتمع التقليدي، ودراسة لطبيعته وتفاعلاته وأزماته. وبذلك أخذ علم الاجتماع شرعيته كعلم من المجتمع ذاته، أي من موضوع دراسته، قبل أن يأخذ شرعية أكاديمية باعتراف جامعي به في أوائل القرن العشرين. وبذلك اتصف علم الاجتماع ببداهة زادته قوة، جعلته يبدو أنه بديهي وعادي ومُسلَّم به، وهو ما يظهر في أبسط تعريف له وهو التعريف ذائع الانتشار بين العامة: “علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس المجتمع“، هكذا ببساطة ومباشرة. لكن ألم يكن هناك مجتمع طوال تاريخ الإنسانية؟ إذا كان علم الاجتماع هو “العلم الذي يدرس المجتمع”، فلماذا تأخر في ظهوره إلى أواخر القرن التاسع عشر وكان من أواخر العلوم الاجتماعية في الظهور؟ السبب هو أن الوعي بالمجتمع هو الذي تأخر في الظهور، فقد كانت المجتمعات البشرية قائمة منذ فجر التاريخ البشري، لكن الوعي بشيء اسمه “المجتمع” وبأنه يصلح موضوعًا للدراسة العلمية هو الذي تأخر، حتى ظهور المجتمع الحديث. عندئذ استقل المجتمع عن السياسة والمؤسسة الدينية والاقتصاد، وصار من الممكن أن يدرسه علم مستقل. ظهور العلم المستقل يأتي نتيجة لظهور موضوع مستقل له. وربما يرجع السبب في الاضمحلال الحالي لعلم الاجتماع إلى اضمحلال المجتمع نفسه حول العالم كله؛ فعندما يكون المجتمع فريسة للاقتصاد الرأسمالي وللأطماع الربحية وللتوجيهات والتلاعبات السلطوية وللسيطرة الإمبريالية، يفقد استقلاله بذاته ومن ثم يفقد أول شرط يجعله موضوعًا مستقلًا لعلم متخصص.
هذا بالإضافة إلى أن علم الاجتماع قد نشأ في اللحظة التي اكتملت فيها عمليات التحديث في المجتمعات الغربية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واتضحت فيها معالم الحداثة، وظهر فيها العلم والتكنولوجيا والعصر الصناعي، فكانت أعين رواد علم الاجتماع مُرَكِّزة على دراسة عمليات الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، والكشف عما إذا كانت هناك أنماط ثابتة مشتركة بين كل هذه العمليات، والكشف عن الاعتلالات الاجتماعية المصاحبة لعمليات التحديث، أو المصاحبة للحداثة نفسها، فيما يُعرف بالباثولوجيا الاجتماعية social pathology ، حتى قيل عن علم الاجتماع إنه هو علم التحديث والحداثة. وكان رواد علم الاجتماع هم الذين افتتحوا طرح كل تلك الموضوعات والمسائل، وكانت مركز أعمالهم، وظلت ملازمة لعلم الاجتماع طوال تاريخه وحتى الآن. ومن ثم فإن دراسة كلاسيكيات علم الاجتماع تطلعنا على لحظة الالتقاء الأولى مع هذه المشكلات، ومع أولى طرق التعامل السوسيولوجي معها. إن الكلاسيكيات هي جزء أصيل من تاريخ علم الاجتماع، ومن هوية علم الاجتماع نفسه.
ولنا أن نتساءل بناء على تلك الأهمية القصوى لأعمال الرواد: هل ظهر علم الاجتماع جاهزًا مكتملًا ودفعة واحدة على يد هؤلاء الرواد بحيث لم يبق أمام اللاحقين سوى الإضافات والتعديلات والتوظيفات؟ هل تناظر أعمال الرواد أعمال الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون وأرسطو والتي صارت من بعدهم النصوص التأسيسية التي لم يكن أمام ألفي عام من تاريخ الفلسفة سوى شرحها والتعليق عليها وتوظيفها؟ لا نستطيع الجزم بإجابة بالإثبات أو النفي على هذه التساؤلات، لكن كل ما يمكن قوله حولها هو أن علم الاجتماع على يد الرواد قد اتضحت معالمه وهويته وبها اتخذ مساراته اللاحقة وبدأت في التشكل إمكاناته البحثية التجريبية، مع النظريات والمناهج التي ستميزه لاحقًا. وهذه الحالة ليست نادرة في تاريخ العلم وتطوراته، ذلك لأن حالة النصوص التأسيسية التي تظل موجهة لكل تطورات العلم اللاحقة وحاكمة لكل الإنتاج اللاحق فيه نظريًا وتجريبيًا هي ما عبر عنه توماس كون بمصطلح “النموذج الإرشادي” paradigm. فلكل علم حسب كون مجموعة من المؤلفات التأسيسية، بها يأخذ شكله كعلم ويحصل على شرعيته العلمية، وهي التي تحتوي على النموذج الذي سوف يسير عليه هذا العلم ويرشد كل العاملين فيه لاحقًا. ويتصف هذا النموذج بثبات نسبي عبر مراحل تاريخ العلم، حتى يأتي نموذج آخر جديد يتحداه ثم تحدث الثورة العلمية بانهيار النموذج القديم وحلول النموذج الجديد محله . وتمثل أعمال رواد علم الاجتماع نموذجًا إرشاديًا بالمعنى الذي قصده توماس كون. ولعل هذا هو السبب في أنه كلما مر علم الاجتماع بأزمة، عاد علماء الاجتماع يفتحون مؤلفات الرواد، باحثين فيها عن حلول أو بصائر جديدة أو دفعة فكرية تفتح مجالًا للخروج من الأزمة. وخير مثال على ذلك، رايت ميلز في كتابه “الخيال السوسيولوجي”؛ إذ بعد أن رصد الحالة المزرية لعلم الاجتماع الأمريكي في عصره والتي تمثلت حسب تحليله في سيادة نزعة تجريبية مجتزأة وضيقة الأفق، ونزعة تنظيرية مثالية تمثلت في “النظرية المتضخمة” لتالكوت بارسونز grand theory والتي سخر منها رايت ميلز وأوضح أنها رطانة فارغة، عاد ميلز مرة أخرى إلى الرواد: دوركايم وفيبر ومانهايم، ليستقي منهم طرق ربط علم الاجتماع بمهمته الأصلية التي تمثلت في نظره في الوعد بالعقلانية والحرية.
ملمح آخر لعلم الاجتماع لدى رواده، هو أنهم فهموه دومًا على أنه وريث لشيء ما، يرث تراثًا سابقًا ويتجاوزه ويحقق ما لم يحققه هذا التراث. هكذا نظر دوركايم إلى علم الاجتماع على أنه وريث العلم الاجتماعي لعصر التنوير، خاصة لدى مونتسكيو وروسو، ويتجاوز الاقتصاد السياسي بنظرته الاقتصادوية الضيقة، ونظر فيبر إلى إسهامه في علم الاجتماع على أنه وريث المدرسة التاريخية الألمانية في الاقتصاد السياسي وفي القانون ويتجاوزهما، ووريث المثالية الألمانية والكانطية الجديدة، ويبني على المدرسة الحدية في الاقتصاد السياسي marginal economics، في حين نظر فبلن إلى علمه الاجتماعي على أنه البديل عن هذه المدرسة الحدية بالذات.
5) الفرق بين الرواد الأصلاء والرواد بالتبني
كي نستطيع تقييم أعمال رواد علم الاجتماع يجب أن نحدد هويتهم تحديدًا دقيقًا. هناك نوعان من الرواد في علم الاجتماع؛
- النوع الأول أصيل، بمعنى أن المفكر قد أعلن تبنيه لعلم الاجتماع وفهم نفسه على أنه عالم اجتماع وقدم نفسه لجمهوره بوصفه كذلك وكتب أعماله بوصفها أعمالًا في علم الاجتماع، أو ساهم في مأسسة علم الاجتماع في صورة قسم أكاديمي أو مركز بحثي أو دورية علمية. وينطبق هذا التوصيف على عدد قليل من الذين ننظر إليهم على أنهم رواد، مثل كونت ودوركايم ومانهايم وسوروكين وبارسونز.
- أما النوع الثاني فهو الرواد بالتبني، أي الذين اعتبرناهم نحن علماء اجتماع وهم لم يفهموا أنفسهم على أنهم كذلك، ولم يكتبوا أعمالهم بوصفها تنتمي إلى هذا العلم، وهم طائفة كبيرة، منها ماركس وفبلن وماكس فيبر نفسه. والذي يجعلنا نعتبر هؤلاء منتمين إلى علم الاجتماع أنهم قدموا تحليلات سوسيولوجية وبصائر سوسيولوجية عديدة يستحقون معها أن ينضموا إلى فئة الرواد، لكنهم في الحقيقة مفكرون اجتماعيون، وهذه الفئة أوسع من فئة السوسيولوجيين، لكنها لا تستبعدهم بل تشملهم.
ثانيًا – خصائص كلاسيكيات علم الاجتماع
1) الكلاسيكيات تحدد هوية علم الاجتماع
ومع رواد علم الاجتماع الذين كتبوا كلاسيكيات هذا العلم ونصوصه التأسيسية، نرى ظاهرة أخرى عجيبة، وهي أن علم الاجتماع يمكن اعتباره يتمثل في مجموع مؤلفات هؤلاء حصرًا. فلا نبالغ إذا حاولنا تحديد علم الاجتماع وتعريفه إجرائيًا وعمليًا بأنه ذلك العلم الذي يوجد في مؤلفات دوركايم (“تقسيم العمل الاجتماعي”؛ “قواعد المنهج السوسيولوجي”؛ “الانتحار”، الأشكال الأولية للحياة الدينية“)، وفرديناند تونيز (“الجماعة والمجتمع” Gemeinschaft und Gesellschaft) وماكس فيبر (“الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”[5]، “الاقتصاد والمجتمع”[6]، “علم الاجتماع الديني”)؛ وبارسونز (“بنية الفعل الاجتماعي”، “النسق الاجتماعي”) وروبرت ميرتون (“النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي”) ورايت ميلز (“الخيال السوسيولوجي”[7]، “ذوو الياقات البيضاء”[8]، صفوة القوة”[9]). إن هناك نوعًا من التماهي والتطابق التام بين علم الاجتماع ذاته ومؤلفات رواده. إنه هو هذه المؤلفات بعينها.
هناك علوم اجتماعية كثيرة، كما أن هناك الكثير من النظريات الاجتماعية والفلسفات الاجتماعية، لكن الذي يعطي لعلم الاجتماع هويته ويميزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى هو كلاسيكياته، والتي تمثل ما يجب أن يكون عليه علم الاجتماع، وتعمل بوصفها نقاطًا مرجعية لكل الأجيال اللاحقة والتي تذكرهم دومًا بما يجب أن تكون عليه السوسيولوجيا كي لا تطغى عليهم العلوم الاجتماعية الأخرى أو يتوهوا فيها. وقد ذهب روبرت نيسبت في تقييمه لتراث الكلاسيكيات في علم الاجتماع إلى أن هذا العلم يعتمد على بعض الأفكار التأسيسية والمحورية unit ideas والتي شكلت هويته وصاغت كل اتجاهات البحث فيه، مثل “الجماعة المحلية” community والسلطة authority والمكانة status والطبقة class، والمقدس sacred والاغتراب alienation، والتقدم، وأن كل هذه الأفكار كانت حاضرة بقوة في كلاسيكيات العلم.
وبناء على هذه الأفكار الأساسية تناولت الكلاسيكيات ثنائيات متناقضة لا تزال تحكم عالمنا المعاصر، مثل: المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث، الجماعة المحلية والمجتمع الكبير، الفرد والمجتمع، الفعل الفردي والنظام الاجتماعي، المقدس والعلماني. ولا تزال الكلاسيكيات تخاطبنا حتى الآن ولا تزال لها دلالة بالنسبة إلينا لأنها طرحت هذه الثنائيات وتناولتها من وجهة النظر السوسيولوجية. وليس هناك أبلغ في التعبير عن أهمية الكلاسيكيات لعلم الاجتماع من قول نيسبت:
“لو حذفنا من علم الاجتماع الذي نعرفه اليوم المنظورات والإطارات الفكرية التي وضعها علماء مثل فيبر ودوركايم، فلن يتبقى لدينا سوى حشد مبعثر من البيانات وبعض الفروض المشتتة”[10]؛
دليلًا على أن الأعمال الكلاسيكية تشكل أطرًا نظرية وتصورية وتفسيرية لكل العلم، طوال مراحل تاريخه.
2) الكلاسيكيات من أهم مجالات البحث السوسيولوجي
ومع رواد علم الاجتماع نجد ظاهرة أخرى لا نعثر عليها واضحة وبارزة إلا في أعمال الفلاسفة، وهي أن أعمال الرواد “الكلاسيكية” كانت على الدوام موضوعًا للبحث والتفسير والتأويل والتوظيف، وكأنها نصوص فلسفية. فمثلما كانت أعمال الفلاسفة الكبار موضوعًا للشروح والتفسيرات والتلخيصات، كذلك كانت أعمال رواد علم الاجتماع؛ بل قد وجدنا دارسين تخصصوا في عرض وبسط وشرح وتفسير أعمال مفكر سوسيولوجي بعينه، مثل ستيفن لوكس الذي خصص عددًا من دراساته لدوركايم[11]، وفولفجانج مومسن الذي ألف ثلاثة كتب في سوسيولوجيا ماكس فيبر[12]، وإرفنج هوروفيتز الذي خصص دراسات عديدة عن رايت ميلز.
ولا يخلو الإنتاج العلمي لمتخصص في علم الاجتماع من عمل أو أكثر، يخصصه لدراسة أحد الرواد أو عمل من أعمالهم. بل إن البعض من علماء الاجتماع ذائعي الصيت قد بنى شهرته على نقد علماء اجتماع آخرين، مثل جولدنر الذي اشتهر بكتابه “الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي”[13]، والذي يركز على نقد نظرية بارسونز السوسيولوجية، وخصص لبارسونز وحده ما يقرب من نصف عدد صفحات الكتاب. وكان هذا الكتاب هو سبب شهرة جولدنر، أكثر من كتابه الآخر الذي يعد دراسة سوسيولوجية تجريبية لكنه لم يشتهر وهو “أنماط البيروقراطية الصناعية”[14]. إن ما نتعلمه من جولدنر هو أن الباحث السوسيولوجي يمكنه أن يدرس موضوعًا تجريبيًا حيًا مثل البيروقراطية الصناعية دون أن يعود عليه بأي شهرة أو انتشار، في حين يحقق كل الشهرة والانتشار بنقد غيره من علماء الاجتماع، خاصة إذا كان هذا النقد منصبًا على رائد كلاسيكي ومؤسس مدرسة سوسيولوجية مثل تالكوت بارسونز.
ملمح آخر هام من ملامح أعمال الرواد والذي يعد من أسباب جاذبيتها، هو أن هؤلاء الرواد كانوا على وعي بأنهم رواد، وبأن ما يكتبونه هو كلاسيكيات، أي نصوص تأسيسية مُحَدِّدة لهوية ومستقبل العلم. ومن ثم فهذه الأعمال ليست كلاسيكية مصادفةً أو على نحو عارض، أو لأن اللاحقين قرروا أنها كذلك أو اعترفوا بها بوصفها كلاسيكيات رائدة، بل لأنها كانت مكتوبة من الأصل بوصفها كذلك، بوعي كامل من كُتَّابها وبتخطيط مقصود منهم. انظر مثلًا عنوان كتاب دوركايم “قواعد المنهج السوسيولوجي“؛ لا يمكن لكاتب أن يضع هذا العنوان لكتابه إلا لكونه على وعي بأنه يؤسس لعلم جديد ويضع له منهجه، ولا يمكن أن يظهر هذا العنوان إلا في المرحلة التأسيسية. لقد كان رواد علم الاجتماع يعرفون أنهم رواد وكانوا يكتبون أعمالهم بقصد أن تكون كلاسيكية، وهذا هو أحد أسباب جاذبية نصوصهم، التي نشعر فيها بمغامرة البدايات الأولى التي تشبه العلاقة الغرامية في بداياتها، ونشعر فيها كذلك بإحساس الكاتب وهو يفتح فتحًا علميًا جديدًا ويكتشف لأول مرة مجالًا بحثيًا جديدًا.
3) ارتباط الكلاسيكيات بأشخاص مؤلفيها
كما تتصف أعمال الرواد بارتباطها بأشخاصهم وبتطورهم الفكري وتكوينهم العقلي، تمامًا مثل أعمال الفلاسفة؛ فلكل عمل كلاسيكي طابع شخصي يحمل بصمة صاحبه. كان دوركايم متفائلًا منفتحًا، فخصص فصلًا عن السعادة في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي“، وكان فيبر كئيبًا مكتئبًا فأخذ يتكلم عن “القفص الحديدي” الذي يحبس الإنسان الحديث (أي العقلانية الإدارية “البيروقراطية” والعقلانية الصناعية “الرأسمالية”). وجاء دوركايم بخلفية فرنسية تُعلي من شأن الفردية والقيم الليبرالية، وعلى العكس منها درس “الوعي الجمعي” الذي يخضع له الأفراد، ودرس أثر النزعة الفردية في ارتفاع نسبة الانتحار، ودافع عن القيم الجماعية؛ أما فيبر الذي كان يحمل في خلفية تفكيره التراث الألماني الذي تضعف فيه الفردية والذي تغيب فيه القيم الليبرالية والحريات الفردية والنظم الديمقراطية وتسيطر عليه الدولة البروسية السلطوية والنزعة العسكرية، فقد تمسك في نظريته السوسيولوجية بالمنظور الفردي وبالفردية المنهجية وعرَّف الفعل الاجتماعي بأنه فعل الفرد الموجه بغرض اجتماعي، وهنا المفارقة:
- الفعل الاجتماعي عند فيبر ليس اجتماعيًا، ليس هو فعل المجتمع،بل هو فعل الفرد، ويوصف بأنه اجتماعي إذا كان موجهًا بمقاصد اجتماعية؛ وبذلك جاءت سوسيولوجيا فيبر الفردية تعويضًا عن افتقاد الفردية في المجتمع الألماني.
- وكان بارسونز أستاذًا جامعيًا تقليديًا وقويًا مسيطرًا داخل الأكاديميا الأمريكية، فجاءت نظريته السوسيولوجية كليانة وتصورية وذات ملمح مثالي واضح وأصيبت بالنزعة القَبْلية apriorism، أي التحديد القبلي، أي العقلي التصوري، لخصائص المجتمع، أي مجتمع وكل مجتمع في كل مكان وزمان، وشروط استقراره وتوازنه، وهي الرؤية الوظيفية التي اشتهر بها، والتي كانت نابعة من موقعه المسيطر داخل جامعة هارفارد.
- كما ارتبطت الأعمال التأسيسية الكلاسيكية بالأسلوب الشخصي في الكتابة لدى كل عالم اجتماع؛ أسلوب دوركايم بسيط وواضح ومباشر مثل أسلوب الفلاسفة الفرنسيين من ديكارت ومرورًا بمونتسكيو وروسو إلى رينان وفيكتور كوزان المعاصرين له؛ أما نصوص فيبر فكثيفة ودسمة ومركبة مثل نصوص الفلاسفة الألمان.
- علم الاجتماع الفرنسي مرتبط بالفلسفة الفرنسية ويعتمد عليها في أسلوب الكتابة، وعلم الاجتماع الألماني مرتبط بالفلسفة الألمانية ويقوم على أكتافها وهو وريثها الفعلي.
4) الظهور المتزامن لكلاسيكيات علم الاجتماع وفي وقت واحد قصير
كما يتمثل أحد الملامح الهامة لعلم الاجتماع في أن رواده قد ظهروا في وقت واحد في بلدان غربية عديدة، فقد ظهروا في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن العشرين. في هذه الأربعين من السنين ظهر
- تونيز وزيمل وفيبر في ألمانيا
- وظهر جوستاف لوبون (1841 – 1931)
- وجابرييل تارد (1843 – 1904)
- ودوركايم (1858 – 1917) في فرنسا
- وهربرت سبنسر (1820 – 1903) في إنجلترا
- وباريتو (1848 – 1923)
- وميتشلز (1876 – 1936) في إيطاليا
- ووليام جراهام سمنر (1840 – 1910)
- وجورج هيربرت ميد (1863 – 1931)
- وفبلن (1857 – 1929) في الولايات المتحدة.
أربعة عقود فقط هي الفترة التي ضمت كل رواد علم الاجتماع المؤسسين للعلم، وتوزعوا على خمس دول، وكأن وعيًا تاريخيًا واحدًا ظهر فجأة متجاوزًا الحدود القومية، يمثل شعورًا قويًا بضرورة تأسيس هذا العلم الجديد، وهو وعي تاريخي – اجتماعي يشبه الكشف العلمي أو الكشف العرفاني أو الاهتداء إلى حقيقة أو عقيدة جديدة. وهنا نرى كيف أن نشأة علم الاجتماع كانت بناءً على وعي سوسيولوجي انتشر في وقت واحد في الغرب، مما يجعلنا نقول إن السوسيولوجيا كانت نتاجًا لوعي سوسيولوجي جديد.
5) الكلاسيكي الأول – أفلاطون هو أول مفكر اجتماعي
لكن انظروا إلى هذه المفارقة: لقد كان أول من فكر في المجتمع تفكيرًا عقلانيًا منهجيًا ومنضبطًا هو أفلاطون في محاورة “الجمهورية”!!! وكان يهدف في هذه المحاورة البحث عن أفضل السبل في تنظيم مجتمع المدينة وفي حكم المدينة؛ لقد كان أفلاطون رائد الهندسة الاجتماعية، فلم يكتف بدراسة طبيعة المجتمع الإنساني أو الاجتماع المدني، بل بحث عن الاجتماع المدني الكامل والفاضل، وكان في ذلك أول مخطط اجتماعي، وربما لهذا السبب اتهمه البعض ومنهم كارل بوبر بأنه شمولي، يفرض رؤية مسبقة على المجتمع ويريد تخطيط المجتمع كله وفق هذه الرؤية[15]. لكن لا تهمنا اتهامات بوبر لأفلاطون، بقدر ما يهمنا لفت الانتباه إلى أن أفلاطون كان أول من فكر في المجتمع؛ وقد انتبه جولدنر إلى ذلك، وخصص لأفلاطون كتابًا من أهم الكتب في تاريخ علم الاجتماع وإن لم يحظ بالاهتمام الكافي وهو “داخل أفلاطون: اليونان القديمة ونشأة النظرية الاجتماعية“[16]؛ وفيه يعالج جولدنر فلسفة أفلاطون وخاصة في محاورة “الجمهورية” بوصفها أول نظرية اجتماعية، تركز على البناء الاجتماعي وكيفية إحداث التوازن فيه بين الطبقات وكيفية الحفاظ على استقراره وتكامله؛ لاحظ العناصر التي اهتم بها أفلاطون: “بناء اجتماعي“، “توازن“، “استقرار”، “تكامل”؛ هذه هي العناصر التي ظهرت واضحة في سوسيولوجيا بارسونز في القرن العشرين، سبق ظهورها في محاورة الجمهورية لأفلاطون، مما جعل جولدنر يقول عن أفلاطون إنه هو الأصل الأول للفكر الاجتماعي، والأب الروحي لعلم الاجتماع الحديث. والمفارقة هنا تأتي من أننا كلما بحثنا عن أسلاف لعلم الاجتماع، سنجد أنفسنا نرجع إلى الوراء على نحو مستمر، ليس إلى روسو ومونتسكيو، وليس إلى ابن خلدون، بل إلى أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، فهو أبعد وأقدم نقطة وصل إليها المفكرون الاجتماعيون بحثًا عن أصول العلم الاجتماعي القديمة.
6) الانقسام إلى تيارات ومدارس مثل الفلسفة
كما يتشابه علم الاجتماع في الجانب النظري والمنهجي منه مع الفلسفة، في أنه ينقسم ويتوزع على تيارات ومدارس ومذاهب مثلما كانت الفلسفة طوال تاريخها. إذ توزعت الفلسفة على المدارس الفيثاغورية والأفلاطونية والأرسطية والأبيقورية والرواقية والشكية والديكارتية والتجريبية والكانطية والهيجلية والوجودية… إلخ. وكذلك تَوَزَّع علم الاجتماع على مدارس وتيارات تتخذ الشكل المذهبي: السان سيمونية، الكونتية، الدوركايميون، الفيبريون، الوظيفية، البنائية التاريخية، التفاعلية الرمزية، مدرسة فرانكفورت، التيار الإثنوميثودولوجي، التيار الفينوميولوجي، مدرسة شيكاغو، مدرسة برمنجهام...إلخ. وقد ارتبط كل تيار بأشخاص مؤسسيه كما يتربط التيار أو المذهب الفلسفي بالفيلسوف الذي أسسه؛ والذي يخلق التيار أو المدرسة هو التوجه النظري والمنهجي الذي يؤسسه المؤسس وتتكون حوله مدرسة من المشاركين فيه والتلاميذ والورثة، وكثيرًا ما يرتبط التلاميذ بالأستاذ داخل المدرسة السوسيولوجية إما بعلاقة شخصية مباشرة وإما بعلاقة مؤسسية. والسبب في اشتراك علم الاجتماع والفلسفة في الانقسام إلى مذاهب ومدارس وتيارات، هو أن المذهب أو التيار سواء في الفلسفة أو في علم الاجتماع يمثل رؤية للمجتمع وللحياة الاجتماعية، ومنظورًا يتم به النظر إلى المجتمع والعلاقة بينه وبين الأفراد وتفاعلاتهم فيه.
7) الكلاسيكيات نقاط مرجعية دائمة
وتتضح أهمية أعمال الرواد الكلاسيكية في أنها لا تزال حتى الآن نقاطًا مرجعية تبدأ بها الكثير من الأبحاث الإمبيريقة بوصفها أصولًا للعلم وتستقي منها إطارات نظرية وأدوات تفسيرية. فكثيرًا ما نجد الباحث، وقبل أن يدخل في موضوع بحثه، يستعرض التراث النظري في هذا الموضوع، وغالبًا ما يرجع به التراث النظري إلى أعمال الرواد. وغالبًا ما يكون الإطار النظري لدراسته خليطًا من توجهات نظرية ومقولات تفسيرية عديدة ومفاهيم موجودة في أعمال الرواد. ومن ثم فلا نرى دراسة في البيروقراطية والتنظيمات إلا وترجع إلى ماكس فيبر (بالإضافة إلى نيكلاس لومان من المحدثين “الكلاسيكيين”[17])، ولا نجد دراسة في سوسيولوجيا الدين إلا وترجع إلى كتاب دوركايم “الأشكال الأولية للحياة الدينية”، ولا نجد دراسة عن التحضر إلا وترجع إلى جورج زيمل، ولا نجد دراسة تبحث في العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع إلا وترجع إلى ماركس، أو إلى دوركايم في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي“، ولا نجد دراسة عن السلطة والقوة إلا وترجع إلى باريتو ورايت ميلز وبوتومور[18]، ولا نجد دراسة تتناول الصراع الاجتماعي إلا وترجع إلى كتاب رالف دارندورف “الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي“[19].
لكن ما الذي يجعل عملًا ما كلاسيكيًا ومؤسسًا لعلم أو لتيار فكري أو لمدرسة داخل هذا العلم؟ الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال ستجعلنا نتحول إلى سوسيولوجيا المعرفة، أي إلى البحث في الشروط الاجتماعية لنشأة وتطور علم ما، وفي حالتنا هذه فإن موضوعنا هو البحث السوسيولوجي في نشأة السوسيولوجيا، أي سوسيولوجيا السوسيولوجيا، أو التحليل السوسيولوجي لإمكان المعرفة السوسيولوجية. وقد كان التحليل السوسيولوجي لظهور علم الاجتماع موضوعًا لدراسات عديدة، منها دراسات رايت ميلز (الخيال السوسيولوجي)، وإرفنج زايتلن (الأيديولوجيا وتطور النظرية السوسيولوجية)[20]، وجولدنر (الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي)، وجوران ثربورن (العلم والطبقة والمجتمع: في تكوين علم الاجتماع والمادية التاريخية)[21].
ومن جهة أخرى يمكننا التركيز على دراسة كيفية تحول أعمال بعينها إلى نصوص كلاسيكية. إذ يمكننا أن نبحث في هذا الموضوع اعتمادً على ثلاثة مفكرين سبق لهم تناوله، وهم حسب الترتيب الزمني: توماس كون في كتابه “بنية الثورات العلمية” كما قلنا، ومفهومه عن النموذج الإرشادي وكيفية تكونه وتشكيله لعلم ما، ينفعنا في دراسة أعمال رواد علم الاجتماع بوصفها نماذج إرشادية؛ وفوكو في دراسته الشهيرة “من هو المؤلف؟“[22]، إذ يبحث في مؤسسي العلوم الاجتماعية بوصفهم مؤسسي خطابات discourses يتم انتشارها من بعدهم، وعلم الاجتماع إذا ما نظرنا إليه وفق هذه النظرية سيكون “خطابًا” علميًا وفكريًا تم تأسيسه من قبل مجموعة من المفكرين؛ وأخيرًا بيير بورديو ونظريته حول تشكل الحقول المعرفية والعلمية والتي وظف فيها نظريته في المجال field وفي الطبع habitus في دراسة الوضع الأكاديمي للعلوم الاجتماعية في عصره، وفي عمل هام له بعنوان “الإنسان الأكاديمي“[23] Homo Academicus.
8) نقد الكلاسيكيات المستمر وإدماجها باستمرار في الأعمال اللاحقة
ملمح آخر لأعمال الرواد، وهو أنها مثل الأعمال الفلسفية تبني نفسها بنقد أعمال سابقة أو إدماجها بوصفها إرهاصات لها، وهي آلية الضم والدمج والاستبعاد. وكأن لسان حال عالم الاجتماع هو: موقفي هو نهاية سلسلة تطور كان يجري من قبلي، تمامًا كما يفعل الفلاسفة. العمل النظري في علم الاجتماع يتقدم بتحليل أعمال نظرية سابقة، وأبرز مثال على ذلك هو كتاب بارسونز “بناء الفعل الاجتماعي“[24]، إذ يُنظَر إليه على أنه عمل تركيبي وتوليفي، وأحيانًا ما ينظر إليه على أنه تلفيقي أيضًا.
9) اعتماد علم الاجتماع على أعمال فكرية خارج مجاله الاختصاصي
كثيرًا ما يظهر مفكر أو تيار فكري خارج علم الاجتماع، ويُحدث فتحًا علميًا جديدًا، وتتوالى الدراسات السوسيولوجية التي تستوحي أفكار ذلك المفكر أو التيار، وتستلهمه، مثل فوكو أو تيار ما بعد الحداثة، أو فلاسفة مثل ريكور وأجامبن ودريدا وبودريار وألتوسير وكاستوريادس وكالينيكوس. وعلم الاجتماع منفتح دائمًا على هذه المؤثرات الخارجية وهي أحيانًا ما تؤثر فيه أكثر من تياراته هو. ونظرًا لهذه الغزوات الخارجية لعلم الاجتماع وباستمرار، فإنني أراه هو نفسه علمًا بينيًا، إذ هو يقع بين العلوم الاجتماعية، وهو ليس وحده المتصف بالبينية، فكل العلوم الاجتماعية بينية.
10) العودة المستمرة إلى الكلاسيكيات طوال مسيرة العلم
ويتمثل أحد معاني الكلاسيكيات في أنها نقطة مرجعية، يتم الرجوع إليها دومًا كلما مر العلم بأزمة أو بصعوبات تستدعي استعادة نقطة بدايته الأولى. وحدث هذا في تاريخ علم الاجتماع، عندما كان رايت ميلز ينقد حال علم الاجتماع الأمريكي في عصره، والذي انقسم إلى نظرية متضخمة grand theory وتجريبية مجتزأة abstracted empiricism[25]، وعاد إلى التشديد على أعمال الرواد مثل فيبر ودوركايم ومانهايم لمعرفة الطبيعة الحقيقية لعلم الاجتماع من أعمال هؤلاء، والتي لا هي بالنظرية المجردة ولا هي بالتجريبية ذات النظرة الجزئية المحدودة، بل التي توسطت بين الجانبين واستطاعت وضع يدها على طبيعة المجتمع المعاصر ودرست العلاقة بين الفرد ومجتمعه المتغير. وقد تحضر الأعمال الكلاسيكية للعلم لدى علماء اجتماع محدثين إذا أردوا الانطلاق في تأسيس توجه نظري جديد، مثل الحضور الكثيف لرواد العلم في أعمال بورديو، قاصدًا استعادة المعنى الأصيل والأصلي للعلم وإعادة النظر في بعض عناصره، أثناء إنشائه لنظريته السوسيولوجية[26]. وهذا هو نفسه حال هابرماس في كتابه “نظرية الفعل التواصلي“، الذي هو في حقيقته ليس نظرية في الفعل التواصلي، إذ لم يدخل في إقامة مثل هذه النظرية، ولم يدرس طبيعة هذا الفعل أو بنائه، بل درس النظريات السوسيولوجية السابقة عليه بحثًا فيها عما يمكن أن يصلح كخيط هادٍ يؤسس به مشروعية القول بوجود شيء يسمى الفعل التواصلي من الأصل.
والرجوع إلى كلاسيكيات العلم وقت الأزمة بوصفها نقاط مرجعية، شبيه بما كان يحدث في تاريخ الفلسفة، من رجوع الفلاسفة إلى أعمال أرسطو عندما كانت الأرسطية محل هجوم، وأقصد بذلك شرح ابن رشد لأعمال أرسطو مجددًا بعد الهجوم الذي تعرضت له الفلسفة في العالم الإسلامي، وبعد إساءة فهم ابن سينا لمذهب أرسطو وتوظيفه له في خدمة رؤية فيضية أفلاطونية محدثة غريبة عن المذهب الأرسطي. فكان على ابن رشد العودة إلى مؤلفات أرسطو لشرحها شرحًا جديدًا يخلصها مما علق بها من تأويلات وتوظيفات أفلاطونية محدثة، وكي ينهي مشروع الجمع بين رأيي الحكيمين، السائد في الفلسفة منذ العصر الهلينستي وطوال العصر الإسلامي. وحدث شيء شبيه بذلك في الفكر الغربي مع ماركس، إذ تمت العودة إلى أعماله مرارًا لإعادة تفسيرها، بحثًا عن “ماركس الحقيقي“، بعيدًا عن التوظيفات السياسية والحزبية له على يد اتحاد الاشتراكية الدولية الثانية، ثم على يد الروس على مختلف توجهاتهم: بوخارين ولينين وستالين. فظهرت قراءات متجددة باستمرار لأعمال ماركس، على يد لوكاتش (1885 – 1971)، ثم مدرسة فرانكفورت، وهنري لوفيفر (1901 – 1991)، وألتوسير (1918 – 1990) ومدرسته، ولا تزال قراءات أعمال ماركس حية وتظهر من حين لآخر في الفكر الغربي إلى الآن، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية التي ادعت تطبيق الماركسية، في حين أن هذا الانهيار أدى إلى تحرير ماركس من التوظيفات الأيديولوجية والسياسية التي خضع لها فكره طوال القرن العشرين. ونجد مقررات جامعية تدرس ماركس، مثل الكورس الذي يخصصه الجغرافي الماركسي ديفيد هارفي (م. 1935) لشرح كتاب “رأس المال“[27] والمستمر منذ سنوات عديدة.
11) إمكان اختزال أفكار كل مفكر في قضية واحدة
ملمح آخر في أعمال الرواد، وهو إمكان اختزال نظرية كل واحد منهم في قضية واحدة، بسيطة ومباشرة وواضحة للغاية، تَثْبُت في الذهن وفي الذاكرة وتتناقلها الألسنة وتُكتب كجملة مفتاحية، وهي الأثر الذي تتركه في الذاكرة الجمعية للعلم. فمن الممكن التعبير عن مركز ومحور كل نظرية فيما يلي:
- دوركايم (ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء؛ الوعي الجمعي هو الذي يشكل الوعي الفردي؛ الدين نتاج المجتمع ويلبي احتياجات اجتماعية؛ تقسيم العمل غير المخطط يؤدي إلى اللامعيارية؛ الانتحار هو نتيجة فقدان الراوابط الاجتماعية التي تترك الفرد منعزلًا وضحية لمصيره الشخصي)؛
- ماكس فيبر (للدين دور أساسي في التغير الاجتماعي، وفي إعاقة هذا التغير أيضًا؛ للبروتستانتية دور في نشأة الرأسمالية؛ الذي يميز الحداثة الأوروبية هو العقلنة الإدارية (البيروقراطية وجهاز الدولة الحديثة) والعقلنة الاقتصادية (الرأسمالية والسوق الرأسمالي) والعقلنة الدينية (البروتستانتية)؛ أديان الشرق أعاقت ظهور الرأسمالية هناك؛ الزعامات الكارزمية هي محركة التاريخ والتغير الاجتماعي)؛
- كارل ماركس: (المجتمع ينقسم إلى بناء تحتي اقتصادي وبناء فوقي سياسي وقانوني وأخلاقي وديني؛ هناك تناقض بين قوى الإنتاج المتطورة باستمرار وعلاقات الإنتاج الثابتة التي لا تتطور بنفس الوتيرة؛ الرأسمالية تُحدث استقطابًا بين الرأسماليين والعمال، وتركيزًا للثروة والسلطة في يد القلة المسيطرة؛ الدولة أداة في يد الطبقات المهيمنة لإدارة الصراع الطبقي؛ التنظيم الرأسمالي للصناعة الحديثة يؤدي إلى الإفقار والاغتراب.
- تالكوت بارسونز: (كل مجتمع فيه وظائف تعمل على تكامله وتوازنه وإدماج الناس فيه).
- فرويد: (اللاوعي يتحكم في الحياة الواعية للفرد والجماعة؛ النفس الإنسانية تتكون من الهو والأنا والأنا الأعلى؛ الحياة الاجتماعية والحضارة البشرية كلها إعلاء للغرائز وسمو بمبدأ الواقع؛
- توكفيل (الشكل الإداري للدولة الحديثة ثابت ومستقل عن التغيرات السياسية وتحولات أنظمة الحكم).
ثالثًا – مفارقات في تاريخ الرواد
نظرة عامة
من هذه المفارقات، أن ماركس لم ير في حياته مصنعًا وهو يعمل، ولم يراقب عمالًا في مصنع، وإن كان قد احتك بهم عن قرب ووجهًا لوجه في اجتماعات الاتحاد الاشتراكي الدولي. وكان يعتمد في دراساته على تقارير البرلمان الإنجليزي عن المصانع الإنجليزية، خاصة مصانع الغزل والنسيج التي كانت تعاني من الإضرابات. ودوركايم لم يزر أستراليا ولم ير قبائلها البدائية التي حلل شعائرها الدينية في كتابه “الأشكال الأولية للحياة الدينية“، بل اعتمد على الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية لعلماء إنجليز ورحالة اختلطوا بهذه القبائل. ولم يكن هو الذي أعد الإحصائيات والجداول الموجودة في كتابه “الانتحار”، فالإحصائيات زوده بها جابرييل تارد، عالم الاجتماع الفرنسي الشهير، بوصفه رئيس مكتب الإحصاء القانوني ؛ والجداول أعدها تلميذه وابن أخته مارسيل موس، الحاصل على شهادة التبريز في الفلسفة، والذي قام بتصنيف 26 ألف حالة انتحار على أساس السن والجنس والحالة الاجتماعية والأبناء إن وجدوا. أي أن الذي انشغل في العمل الإحصائي والدراسة الإمبيريقية لكتاب “الانتحار” ليس دوركايم بل تلميذه الحاصل على شهادة في الفلسفة!!. ولم يكن فيبر قد ذهب إلى منطقة شرق نهر إلبا عندما كتب عن حالة العمالة الزراعية بها في تسعينيات القرن التاسع عشر، ولم تكن استمارة المقابلة التي أعدها فيبر تُوَزَّع على العمال الزراعيين، بل على رجال الدين البروتستانت في كنائس شرق ألمانيا، تسألهم فيها عن أحوال العمال وتفاصيل حياتهم وإنفاقهم وأجورهم، خوفًا من أن يثير سؤال العمال الزراعيين عن أحوالهم الصراع الطبقي هناك.
1) موقف ماركس من كونت
في تاريخ علم الاجتماع وفي الذاكرة الجمعية لدارسي العلوم الاجتماعية يوجد ثلاثة أعلام كبار، بوصفهم الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع: ماركس ودوركايم وفيبر. ولا يخلو كتاب في تاريخ علم الاجتماع أو تاريخ النظرية السوسيولوجية من تناول هؤلاء الثلاثة، وقد خصص لهم أنتوني جيدنز كتابًا شهيرًا هو “الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة“[28]. لكن المفارقة هنا هي أن ماركس لم يكن ينظر إلى أعماله على أنها تنتمي إلى علم الاجتماع، ولم يذكر كلمة “سوسيولوجيا” في أي من مؤلفاته، وكان ينظر إلى أوجست كونت باحتقار ويعتبره رجعيًا[29]. ذكر ماركس كونت لمرة واحدة فقط في كتابه “رأس المال”، المجلد الأول، في هامش قصير، يسخر فيه من كونت ومدرسته ويقول إن عليهم أن ينظروا إلى الإقطاعي على أنه ضرورة أزلية مثلما نظروا إلى الرأسمالي على أنه كذلك[30]. هنا يسخر ماركس من كونت و”مدرسته”، أي أتباعه الذين روجوا لنظريته السوسيولوجية، بسبب أنهم ربطوا الرأسمالي بالعصر الصناعي الحديث، ورأوا أنه ضروري لهذا العصر، وأن الصناعة الحديثة لا يمكنها أن تقوم إلا بالرأسمالي، وعلى هذا فمثلما نظروا إلى الرأسمالي على أنه ضرورة أزلية فعليهم أن ينظروا إلى السيد الإقطاعي على أنه ضرورة أزلية أيضًا في حين أنه انتهى من زمن بعيد وكان مرتبطًا بنمط إنتاجي معين؛ فالنظام الاقتصادي عند ماركس ليس من إنتاج أشخاص، ولا يصنعه أفراد بقصد ووعي وتخطيط، فليس الإقطاعي هو الذي ينشئ النظام الإقطاعي، بل نمط الإنتاج الإقطاعي هو الذي يخلق الشخص الإقطاعي، وليس الرأسمالي هو الذي يصنع الرأسمالية، بل الرأسمالية بوصفها نمطًا إنتاجيًا تنشأ نتيجة لتفاعلات اقتصادية عميقة وتاريخ مسبق طويل من التطور الصناعي والتقني، ومن ثم تصنع الرأسمالية الرأسمالي وليس العكس؛ فالأفراد يأتون ليشغلوا مواقع اجتماعية مسبقة، يؤدون فيها أدوارًا تحددها البنية الاقتصادية العامة.
ولم يكن رأي ماركس في كونت انطباعًا شخصيًا متسرعًا، ولا كان حِدَّة في طبع ماركس المشهور به، بل كان نتيجة دراسة لأعماله أثناء كتابته “رأس المال” الذي صدر سنة 1867. فقبل نشر الكتاب بسنة، وبتاريخ 7 يوليو 1866، كتب ماركس لإنجلز قائلًا:
“لقد بدأت في دراسة كونت الآن فقط، كعمل جانبي، لأن الإنجليز والفرنسيين يصنعون ضجة حوله. والذي خدعهم فيه هو موسوعيته وتركيبيته. لكنه فقير بالنسبة إلى هيجل (رغم أنه يتفوق على هيجل بوصفه رياضيًا وفيزيائيًا من حيث التخصص؛ أي أنه متفوق في التفاصيل، لكن لا يزال هيجل أعلى منه بكثير في النظرة الكلية). والغريب أن هذا المذهب الوضعي الحقير ظهر سنة 1832!”[31]؛ أي في وقت مبكر بالنسبة إلى شهرته اللاحقة.
ماركس يطلق على سوسيولوجيا كونت “المذهب الوضعي الحقير“!!، أثناء كتابته “رأس المال“. كان ماركس حادًا وقاسيًا على خصومه، وكان يأخذ حريته في مراسلاته مع إنجلز حيث وردت هذه العبارة. إذ كنا سننظر إلى أوجست كونت وكارل ماركس على أنهما من رواد علم الاجتماع، فيجب ألا تفوتنا هذه الاختلافات الجوهرية بينهما.
2) ماركس بوصفه سوسيولوجيًا
ولأن علم الاجتماع قد نشأ في الأساس بوصفه استجابة لصعود المجتمع البورجوازي الرأسمالي الحديث ولدراسة تبعات هذا النمط الاجتماعي كما يقول جيدنز، فلا يمكن تجاهل ماركس أو حذفه من فئة مؤسسي علم الاجتماع، أو بالأدق، مؤسسي علم المجتمع . وإلى نفس هذا الرأي ذهب توم بوتومور وماكسيميليان روبل، في مقدمتهما لمختارات من مؤلفات ماركس، وضعا له عنوانًا ملفتًا للنظر: “كارل ماركس: أعمال مختارة في السوسيولوجيا والفلسفة الاجتماعية Selected Writings in Sociology and Social Philosophy”. الغريب وضع كلمة “سوسيولوجيا” في عنوان لكتاب يجمع بعض أعمال ماركس، لكن يبرر المحرران هذا العنوان بتشديدهما على الدلالات السوسيولوجية لفكر ماركس، وبقولهما إن العلم الاجتماعي الذي وضعه ماركس أقرب إلى الاهتمامات الحالية لعلم الاجتماع من الاتجاهات النظرية التي ربطت نفسها بهذا العلم ، وربما كانا يقصدان اتجاه تالكوت بارسونز، الذي تتصف نظريته السوسيولوجية بالتجريد العالي المبالغ فيه إلى درجة الكتابة بلغة معقدة ومقعرة للغاية سخر منها رايت ميلز وجولدنر.
3) الوضع الإشكالي لفيبر بوصفه عالم اجتماع
أما فيبر فلا يعد كتابه “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” كتابًا في السوسيولوجيا، فهو لا يحتوي على تحليلات سوسيولوجية، بل ينحصر في توضيع علاقة أخلاق العمل في البروتستانتية النُسُكية في جانبها اللوثري بصعود الروح الرأسمالية الناشئة في مطلع العصر الحديث؛ ولما كان هذا الكتاب يتناول “أخلاق” و”روح”، فهو في حقيقته ينتمي إلى الدراسات الثقافية وتاريخ الأفكار وليس إلى علم الاجتماع. هذا علاوة على أن فيبر لم يكن ينظر إلى نفسه على أنه عالم اجتماع، بل على أنه باحث في الاقتصاد السياسي، ولم يبدأ في النظر إلى نفسه على أنه سوسيولوجي إلا سنة 1910 ثم تراجع عن تسمية نفسه “عالم اجتماع“، وعاد إلى وصف نفسه بأنه “عالم اقتصاد سياسي” في سنواته الأخيرة. دوركايم هو الوحيد الذي ينطبق عليه وصف “عالم اجتماع”، فهو الوحيد من بين هؤلاء الثلاثة الذي سعى إلى تأسيس هذا العلم وظل متمسكًا به طوال حياته. وإذا تناولنا زيمل فسوف نفاجأ بأنه لم يكن ينظر إلى نفسه على أنه عالم اجتماع بل على أنه فيلسوف. لدينا إذن حالة في منتهى النقائضية: علماء يؤخذون على أنهم علماء اجتماع لكن أحدهم ينكر هذا الوصف (زيمل)، والآخر لم ينظر إلى إسهامه على أنه ينتمي إلى شيء يسمى “علم الاجتماع”، وهو ماركس، إذ نظر إلى نفسه على أنه اقتصادي سياسي، ونظر إلى إسهامه في الاقتصاد السياسي على أنه “مادية تاريخية“؛ وثالث كان تبنيه لعلم الاجتماع متأخرًا للغاية (فيبر) ولم يتمسك بعلم الاجتماع عبر كل أعماله.
وتأكيدًا على رأينا بأن علاقة فيبر بعلم الاجتماع لم تكن ثابتة ولا واضحة، قول أنطوني جيدنز:
“لم يكن فيبر في حياته ينظر إلى نفسه ولا كان المحيطون به ينظرون إليه على أنه عالم اجتماع، بل كان ينظر إلى نفسه على أنه مؤرخ وعالم اقتصاد ومُنَظِّر للفقه القانوني”[32].
معنى هذا أن شهرة فيبر بوصفه عالم اجتماع، ومؤسسًا لهذا العلم، وأحد رواده، وأحد كاتبي الكلاسيكيات فيه، ليست صحيحة وفي حاجة إلى إعادة نظر. وليست تلك الشهرة وحدها هي التي تحتاج إلى إعادة نظر، فأعماله نفسها ووصفها التقليدي باعتبارها “سوسيولوجيا” في حاجة إلى إعادة نظر، إذ ربما لا تكون منتمية إلى السوسيولوجيا.
4) الوضع المُحَيِّر لثورشتاين فبلن
يؤخذ فبلن على أنه اقتصادي سياسي وعلى أنه عالم اجتماع أو مفكر اجتماعي في الوقت نفسه، وأحيانًا ما تعود التسمية القديمة في حالته بالذات ويسمونه “عالم اجتماعي” social scientist. وهو أحيانًا ما يحضر في كتب تاريخ علم الاجتماع، وأحيانًا ما يحضر في كتب تاريخ الفكر الاقتصادي والنظريات الاقتصادية. أما هو نفسه فلم يكن مهتمًا بتعريف نفسه أو بتصنيف ما يقدمه من أعمال. ووضْع فبلن مُحَيِّر، إذ ليس هناك إجماع على اعتباره عالم اجتماع. أما إذا اتخذنا معيار الحكم على مفكر ما بما ينتجه من تحليلات سوسيولوجية، فسوف نفاجأ بأن فبلن يستحق أن يُصنَّف على أنه عالم اجتماع أكثر من ماكس فيبر نفسه. ذلك لأن أشهر أعمال فبلن هو كتابه “نظرية الطبقة المترفة”[33]، وفيه تحليلات سوسيولوجية حقيقية لا نجدها في كتاب فيبر “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية“. والطريف في أمر فبلن وفيبر، أن الطبقة التي انتشرت فيها “الأخلاق البروتستانتية” وظهرت فيها “روح الرأسمالية” في مرحلة نشأة الرأسمالية، هي البورجوازية التي صارت في عصر فبلن “الطبقة المترفة“. كل ما في الأمر أن دراسة فيبر ركزت على المرحلة المبكرة الأولى من ظهور الرأسمالية في أوروبا، على يد طبقة كانت توجهها “أخلاق” و”روح”، أما فبلن فقد كان يدرس نفس هذه الطبقة بعد أن سيطرت وهيمنت على الاقتصاد وانتصرت على كل منافسيها، فصارت في غير حاجة إلى :أخلاق” و”روح” وأصبحت “الطبقة المترفة“. لقد كانا يدرسان الطبقة نفسها لكن في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين من تطورها. والغريب أن الدراستين مقتربتان زمنيًا، إذ صدر كتاب “نظرية الطبقة المترفة” سنة 1899، وصدر كتاب “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” سنة 1905.
5) مفارقة هابرماس ودارندورف
من يعرف دارندورف الآن؟ القليل. ومن يعرف هابرماس؟ الكثير. المفارقة هنا هي أن إسهام دراندورف في النظرية السوسيولوجية وفي التحليل السوسيولوجي أهم بكثير من إسهام هابرماس ويفوقه بمراحل. لم ينشغل هابرماس بتحليل مجتمعه الألماني، بل توجه إلى الكتابة في النظريات، وكل أعماله نظرية، في حين وضع دارندورف تحليلًا سوسيولوجيًا بارعًا للمجتمع الألماني في كتابه “الديمقراطية والمجتمع في ألمانيا“، وكان إسهامه في النظرية السوسيولوجية في مجال الصراع الاجتماعي في كتابه “الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي”.
ومن الوقائع الغريبة الجديرة بالملاحظة، أن كتاب “نظرية الفعل التواصلي” لهابرماس Theorie des kommunikativen Handelns، قد باع فور صدوره بالألمانية 10 آلاف نسخة في نفس شهر صدوره (ديسمبر 1981) ، وهو كتاب ضخم من مجلدين، وهو كتاب نظري في نظريات علم الاجتماع، وليست به أية تحليلات سوسيولوجية لقضايا اجتماعية بعينها، وكل ما يمكن أن نستخلصه منه هو على الأكثر فلسفة اجتماعية وليس نظرية سوسيولوجية تصلح لتوجيه البحث السوسيولوجي التجريبي. أما العمل الأقل شهرة منه والذي لم يأخذ حقه في القراءة والانتشار مع أنه هو الدراسة السوسيولوجية الحقيقية، فهو كتاب “بؤس العالم“، الذي حرره بيير بورديو مع آخرين وشارك في كتابة بعض فصوله .
6) سوسيولوجيا جالبرايث
وكمثال على عالم اقتصاد سياسي غير محسوب على فئة السوسيولوجيين ولم يعرف عنه أن قدم تحليلًا سوسيولوجيًا أو حتى فلسفة اجتماعية لكنه قدم بالفعل تحليلات سوسيولوجية بارعة، هو جون كينيث جالبرايث، خاصة في كتابه “الدولة الصناعية الحديثة“. في هذا الكتاب يذهب جالبرايث إلى أن ما يميز المجتمعات الحديثة أنها صناعية، وأنه لا فرق بين الدولة في الشرق أو الغرب لأن الاثنتين دولتان صناعيتان، وأن الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية هو فرق في تنظيم الصناعة وعلاقة الدولة بالهيكل الصناعي السائد، وهو أمر ثانوي بالنسبة إلى تنظيم عملية الصناعة ذاتها. ويدخل جالبرايث في تحليل للداوفع الاجتماعية التي تعمل على دمج الناس في الأنظمة السائدة في مجتمعاتها وفي التكيف مع العصر الصناعي ومتطلباته، وهو ما يذكرنا بسوسيولوجيا بارسونز. ورغم هذا الإطار السوسيولوجي الذي درس به جالبرايث العصر الصناعي، إلا أننا لا نجد جالبرايث مذكورًا في كتب تاريخ النظريات السوسيولوجية، على حد علمي، رغم أن تحليله للدولة الصناعية الحديثة في الشرق والغرب هو تحليل سوسيولوجي بجدارة.
7) التجاهل المتبادل بين ريزمان وبارسونز
في سنة 1950 أصدر عالم الاجتماع الأمريكي ديفيد ريزمان كتابه الهام والشهير “الحشد الوحيد: دراسة في الشخصية الأمريكية المتغيرة” The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character[34]، وفيه وضع نموذجًا تصوريًا يحلل به ويفسر التحولات التي حدثت للمجتمع الأمريكي والشخصية الأمريكية وفق أنماط ثلاثة من الشخصية، الفردية والاجتماعية، تحدد الشخصية وفق توجهاتها: التوجه التقليدي/ التراثي tradition directed، والتوجه الداخليInner directed، والتوجه الخارجي other-directed. تشرط هذه التوجهات الأنماط الاجتماعية، من شخصية فردية إلى شخصية اجتماعية. التوجه التقليدي التراثي يسود في المجتمعات التقليدية السابقة على الرأسمالية وكان هو التوجه السائد في المجتمع الأمريكي حتى القرن التاسع عشر، والتوجه الداخلي يسود لدى الشعوب الحديثة التي اكتشفت إمكاناتها الذاتية وحصلت على الحريات الفردية وتوجهت في الحياة بمعايير ذاتية من صنعها (وهي تشبه الأخلاق الكانطية، أخلاق الضمير والواجب والإلزام الذاتي). وفي سنة 1951، أي بعد سنة واحدة فقط، صدر كتاب بارسونز “النسق الاجتماعي”، وفيه جزء هام للغاية حول أنماط التوجهات القيمية للفعل الاجتماعي، شبيهة للغاية وقريبة من توجهات الفعل لدى ريزمان، وأطلق عليها بارسونز “المتغيرات النمطية للفعل” pattern variables. وعلى الرغم من القرب الشديد بين “أنماط توجهات الشخصية” عند ريزمان، و”المتغيرات النمطية للفعل الاجتماعي” عند بارسونز، إلا أن بارسونز لم يذكر ريزمان، وريزمان لم يذكر بارسونز، إلا في صفحة واحدة فقط في هامش (ص 281، حيث ذكر دراسة لبارسونز حول أثر العمر والجنس في البناء الاجتماعي للولايات المتحدة، وهي دراسة ليس لها أي أثر في حجة ريزمان الأساسية في كتابه). وإذا كان ريزمان معذورًا في عدم ذكره لبارسونز لكون كتابه قد صدر قبل كتاب بارسونز بسنة، إلا أنه لم يكن معذورًا في تجاهله للمتغيرات النمطية لبارسونز في مقدماته للطبعات التالية للكتاب، الصادرة سنة 1961 وسنة 1969. كل واحد منهما تجاهل الآخر، رغم أن الاثنين ألفا الكتابين في نفس الفترة، وكان بارسونز أستاذًا في هارفارد، وكان ريزمان أستاذًا في جامعة شيكاغو. ورغم ذلك، فإن بارسونز شارك بمقال في حلقة دراسية حول كتاب ريزمان، نُشِرَت في كتاب سنة 1961. وفي المقال سعى بارسونز إلى استيعاب وهضم نظرية ريزمان في نظريته هو في المتغيرات النمطية[35]. وما نتوصل إليه من ذلك، هو أن عملين كلاسيكيين يمكنهما تجاهل بعضهما البعض تمامًا، حتى ولو تم تأليفهما في نفس الفترة وبالقرب من بعضهما البعض (هارفارد وشيكاغو). تمامًا كما تجاهل دوركايم وفيبر بعضهما البعض.
رابعًا – الوعي الذاتي السوسيولوجي
1) تحليل دوركايم لنفسه سوسيولوجيًا
الغريب في أمر دوركايم أن بصيرته السوسيولوجية قد وصلت به إلى مدى بعيد، إذ حلل إنتاجه السوسيولوجي تحليلًا سوسيولوجيًا، وحلل نفسه تحليلًا سوسيولوجيًا. نحن نعرف جيدًا التحليل النفسي psychoanalysis، لكن يبدو أن دوركايم هو رائد التحليل السوسيولوجي للذات المنتجة للمعرفة السوسيولوجية socio-analysis. لقد نظر دوركايم إلى نفسه بوصفه يهوديًا تمكن من النظر إلى المجتمع من خارجه ومن مسافة، فموقعه كيهودي مكنه من رؤية المجتمع على نحو أفضل، فاليهودي منفصل عن المجتمع لكنه ليس منعزلًا؛ إنه في المجتمع لكن لا يستغرقه المجتمع بالكامل. هذا الانفصال بغير عزلة، والابتعاد النسبي الذي يوفر مسافة نقدية كانتا في نظر دوركايم شرطًا مسبقًا مكنه من الرؤية السوسيولوجية للمجتمع. هكذا يربط دوركايم اكتشافه للسوسيولوجيا بطبيعة الموقع الاجتماعي الذي يشغله بوصفه يهوديًا. لكنه لم يكن يهوديًا متدينًا بل كان علمانيًا، ومن ثم كان في الوقت نفسه منفصلًا نسبيًا عن مجتمعه اليهودي وتراثه الديني، مما مكنه من اتخاذ مسافة نقدية من اليهودية كذلك.
هكذا يدلي دوركايم باعترافاته السوسيولوجية، كما لو كان يجلس أمام محلل نفسي، لكنه في حالته محلل سوسيولوجي لنفسه. إذا كان ديكارت قد دشن الفكر الحديث بمقولته الشهيرة “أنا أفكر إذن أنا موجود” cogito, ergo sum، فإن دوركايم كان أكثر راديكالية منه،إذ تساءل: كيف أمكنني التفكير سوسيولوجيًا؟ ما الذي جذبني إلى هذا العلم؟ كيف تمكنت من الإبداع في هذا العلم بالذات؟ أنا أفكر “سوسيولوجيًا” لأنني موجود “يهودياً”؛ فوجودي الاجتماعي هو الذي مكنني من ذلك. المكان الذي أشغله في المجتمع هو الذي يشرط تفكيري في المجتمع؛ إنتاجي الفكري مشروط بالموقع الذي أشغله في المجتمع. هذا التحليل ليس مجرد سوسيولوجيا للمعرفة السوسيولوجية؛ إنه أعلى مراحل التأمل الذاتي والانعكاس على الذات، يفوق تأملات ديكارت “الميتافيزيقية”.
يقول دوركايم:
“إنه لقانون عام أن تسعى الأقليات الدينية إلى التميز في المعرفة عن باقي المحيطين بها، كي تحمي نفسها من الكراهية التي تتعرض لها… وبذلك يسعى اليهودي إلى التعلم، لا لكي يحل التفكير العقلاني محل تحاملاته الجمعية”[36]؛
أي لا كي يحل نظرته العلمانية محل تراثه الديني؛ “بل كي يكون متسلحًا على نحو أفضل من أجل الصراع. فالتعليم بالنسبة إليه هو وسيلة لتعويض الوضع السيء الذي وُضِعَ فيه من جراء الرأي العام أو أحيانًا بسبب القانون“؛ أي اضطهاد الأقليات إما بسبب التحاملات الجمعية ضدهم من المجتمع المحيط، وإما بسبب تمييز قانوني ضدهم. “وبما أن المعرفة بحد ذاتها ليس لها أثر في تراث لا يزال بكل حيويته“؛ أي بما أن أفكار التنوير والعلمانية ليس لها من تأثير على دين مثل اليهودية لا يزال يتمتع بحيويته؛ “فهو يضع تلك الحياة الفكرية على نظامه الاعتيادي دون أن تؤثر الأولى على الثاني“؛ أي أنه سيجمع توجهاته العلمانية والتنويرية مع انتمائه لليهودية دون أن تؤثر تلك الأفكار على “نظامه الاعتيادي“، أي على التزامه بالشعائر اليهودية والتزامه الاجتماعي- الديني نحو أقرانه اليهود. هذا الاعتراف النادر من دوركايم يُظهِره بحياة مزدوجة وهوية مزدوجة، مقصودة منه وفرضها على نفسه ولكنه لا يعاني منها وليست عيبًا فيه، وهو ما يذكرنا بابن رشد الذي كان في نفس موضعه الاجتماعي، وبالهوية المزدوجة التي بدأ حي بن يقظان في تطويرها بعد أن خرج من عزلته على الجزيرة عندما اختلط بالناس ورأى منهم آراءهم المسبقة وتحاملاتهم، فأراد التكيف معها في البداية، لكنه آثر العودة إلى جزيرته منعزلًا.
ويستمر دوركايم واصفًا حالة المفكر اليهودي التي هي حالته هو قائلًا: “وهذا هو سبب الحالة المعقدة التي يمثلها. إنه يبدو بدائيًا من أوجه معينة“[37]؛ نظرًا ليهوديته التي تُظهِره على أنه يعتنق ديانة شرقية قديمة وغريبة عن محيطها المسيحي وملتزمًا بشعائر غريبة في نظر المجتمع الكبير؛ “لكنه من أوجه أخرى مثقف ورجل علم“؛ وهي حياة مزدوجة أيضًا، ربما في نظره أو في نظره ونظر المحيطين به في الوقت نفسه. بذلك يكشف دوركايم عن مكنونات نفسه، في فقرة واحدة وسط كتابه “الانتحار”. هكذا يعيش دوركايم، لا نقول حياة مستورة، بل حياة مزدوجة. ويستمر دوركايم قائلًا: “وهو بذلك يجمع بين مزايا الانضباط القاسي المميز للجماعات الصغيرة والقديمة”؛ أي بين مزايا الشريعة اليهودية التي تنظم كل تفاصيل الحياة اليومية لليهودي وتتحكم في طعامه وكيفية تناوله له؛ “ومزايا الثقافة العميقة التي تتمتع بها مجتمعاتنا الكبيرة. إنه يمتلك كل المواهب العقلية للإنسان الحديث، دون أن يشاركه يأسه despair”[38].
2) الوعي المبكر بتاريخ السوسيولوجيا وبالنظرية السوسيولوجية
والغريب في مسيرة النظرية السوسيولوجية أن الوعي بها والكتابة عنها كان مبكرًا للغاية بالنظر إلى حداثة هذا العلم وعمره القصير؛ إذ نجد عالم الاجتماع الروسي (الأمريكي فيما بعد) بيتريم سوروكين Pitirim Sorokin (1889 – 1968) يؤلف كتابًا سنة 1928 عنوانه “النظريات السوسيولوجية المعاصرة“[39]؛ هذا الكتاب ظهر قبل ظهور أغلب النظريات السوسيولوجية التي ننظر إليها الآن على أنها معاصرة، بل قبل ظهور من ينظر إليهم البعض الآن على أنهم قاربوا من أن يكونوا من الكلاسيك: أي قبل بارسونز وميرتون ومانهايم وريزمان ورايت ميلز. هذا الكتاب لم يُقدَّر له البقاء، لا بسبب ظهوره في فترة مبكرة وظهور الكثير من التيارات السوسيولوجية من بعده وحسب، بل لأن أسلوبه في العرض ومقاربته للنظريات السوسيولوجية كانت صعبة، خاصة في تلك الفترة المبكرة من تاريخ العلم. إذ لم يتبع سوروكين الأسلوب المعتاد في عرض النظريات السوسيولوجية انطلاقًا من الأعلام، كأن يعرض لكونت وماركس وسبنسر وتونيز وزيمل ودوركايم وفيبر..إلخ، بل صنف النظريات السوسيولوجية في اتجاهات ومذاهب ومدارس: المدرسة الآلية (الميكانيكية) والمدرسة الجغرافية (ولم يعرض فيها نظرية فيتفوجل في الاستبداد الشرقي وتفسيره بكونه نابعًا من التنظيم السياسي للحضارات النهرية القديمة، تلك النظرية التي ظهرت بعد صدور كتاب سوروكين)؛ ومدارس التفسير البيولوجي والأنثروبولوجي العرقي والمدرسة الديموغرافية والمدرسة الاقتصادية (ماركس وإنجلز)، وأخيرًا المدرسة السيكولوجية. والكتاب كما نرى في تنظيمه بهذه الطريقة كان صعبًا على أي قارئ حتى المتخصص، وافتقد الهدف منه وهو أن يكون مدخلًا عامًا للنظريات السوسيولوجية بمحاولة تبسيطها؛ إذ الملاحظ أن ممثلي المدارس التي كتب عنها سوروكين قد كتبوا بأسلوب أسهل وأبسط من أسلوبه. والظاهر من الكتاب أنه محاولة للتنظير للنظريات السوسيولوجية، لا شرحها أو تفسيرها، أي أنه تنظير للنظريات.
ولكن ما يهمنا من كتاب سوروكين هو التأكيد على الوعي المبكر بالنظرية السوسيولوجية، مثلما كان الوعي مبكرًا بالمنهج السوسيولوجي، إذ كتب عنه دوركايم كتابه الشهير “قواعد المنهج السوسيولوجي” سنة 1895. وتفسيري لهذا الوعي المبكر بالنظرية وبالمنهج هو أنه أتى بسبب تلقي رواد علم الاجتماع لتعليم فلسفي قبل أن يتحولوا إلى علم الاجتماع؛ إذ أن التعليم الفلسفي والتدريب الذي تلقوه في المنطق ومناهج البحث الفلسفية جعلهم على وعي مضاعف ومكثف للغاية بالنظرية والمنهج الخاصَّين بالعلم الجديد. فالمتلقي لتعليم في الفلسفة لديه إحساس عالٍ بالمنهج، ويعلم جيدًا أن الفكر الفلسفي الحديث كان يتميز بالوعي بالمنهج: فرنسيس بيكون و”الأورجانون الجديد“، وديكارت و”المقال عن المنهج” و”قواعد لهداية العقل“، ومنطق بور رويال، وكانط في “نقد العقل الخالص“.
من الأسباب التي جعلت سوروكين يسقط من الذاكرة الجمعية لعلماء الاجتماع ويتم تناسيه ولا تدخل أعماله في الكتب العامة المبسطة في تاريخ النظرية السوسيولوجية، سببان:
- أولهما أن أعماله ضخمة للغاية من حيث عدد الصفحات والمجلدات، مما يصعب على الدارس الإحاطة بها،
- والثاني أن هذه الأعمال تقدم رؤية تاريخية وحضارية واسعة للغاية بحيث تجعلها أقرب إلى فلسفة التاريخ أو فلسفة الحضارة أو الفلسفة الاجتماعية. وهذا يدلنا على أن النظرية السوسيولوجية إذا توسعت في نطاقها تحولت إلى فلسفة في التاريخ، وهذا هو ما نجده في أعمال سوروكين.
رغم أن كتاب بارسونز “بناء الفعل الاجتماعي” قد صدر في وقت مبكر من تاريخ علم الاجتماع (1937)، إلا أننا نراه ينشغل في دراسة النظريات السوسيولوجية السابقة عليه وكأن هذه النظريات ترجع إلى تاريخ سابق قديم، في حين أن ما يفصلها عن كتاب بارسونز هو بضعة عقود؛ لكن يبدو أن علماء الاجتماع قد حملوا معهم على الدوام إحساسًا بأن هذا العلم قديم في حين أنه جديد، أو ربما تتقادم النظريات السوسيولوجية بوتيرة متسارعة. قد يفكر عالم الاجتماع بالطريقة الاسترجاعية التي تنظر إلى التاريخ السابق للعلم بحثًا عن الشيء المشترك فيه وعن خط تطوري واحد، لكن يكون ذلك في مرحلة متقدمة لاحقة من تاريخ العلم، لا مرحلته الأولى ولا سنة 1937.
أما بالنسبة إلى توينبي فإن البصائر السوسيولوجية اللامعة التي نجدها في كتابه “دراسة للتاريخ“، مدفونة داخل هذا الكتاب المكون من 12 مجلد، ومبعثرة على الكتاب كله، وغير ظاهرة بسبب الإطار التفسيري العام الذي وضعه لتاريخ الحضارات ونشأتها ونموها وانهيارها واضمحلالها، مما صَعُبَ على الباحثين أخذ توينبي بوصفه مفكرًا سوسيولوجيًا أو اجتماعيًا. هذا بالإضافة إلى تصنيف توينبي بوصفه فيلسوف تاريخ، مما لم يجعل الباحثين يهتمون بفحص دراسته للبحث فيها عن فكر اجتماعي أو سوسيولوجي.
خامسًا – طه حسين ودوركايم (مثال عيني على كيفية تكوين المدرسة السوسيولوجية)
الحقيقة أن الذي يجعل أحد المفكرين رائدًا من رواد العلم ويجعل من مؤلفاته “كلاسيكيات”، وبالإضافة إلى أنها يجب أن تكون مكتوبة من الأصل كي تكون كذلك وبوعي من مؤلفها، هو المدرسة التي تتكون حوله، من التلاميذ والمعاونين والزملاء والأتباع والمريدين. والذي يعطي لنا مثالًا واضحًا – ومدهشًا كذلك – على ما نقوله هو طه حسين. يُشْتَهَر طه حسين بأنه أديب وبأنه “عميد الأدب العربي”، لكن التخصص الأساسي الذي بُعِثَ لدراسته في السوربون هو التاريخ، ثم تحول عنه إلى علم الاجتماع، وبسبب دوركايم. قد لا يعلم الكثيرون علاقة طه حسين بدوركايم، لكنه كان تلميذًا مباشرًا لدوركايم، وتكشف علاقته بدوركايم عن كيفية تَكَوُّن مدرسة دوركايم، أثناء حياة دوركايم. كان طه حسين يدرس في السوربون في الوقت الذي كان فيه دوركايم هناك يلقي محاضراته في علم الاجتماع، وحضر طه حسين هذه المحاضرات، وأعجب بدوركايم وبعلمه الجديد، وطلب من دوركايم الإشراف على رسالته للدكتوراه وكانت في موضوع من اختيار طه حسين وهو “الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون“. ومع سرد طه حسين لقصته مع دوركايم فنحن مع شهادة حية من تلميذ مباشر لدوركايم، والشهادات الحية من تلاميذ مباشرين نادرة للغاية في تاريخ المدارس الفكرية، وفي تاريخ علم الاجتماع على وجه الخصوص.
كان طه حسين مبعوثًا من الجامعة المصرية حديثة الإنشاء إلى فرنسا، لدراسة التاريخ ولإعداد رسالة الدكتوراه في التاريخ، لا في الأدب ولا في اللغة ولا في علم الاجتماع. لكن من بين الدروس التي حضرها طه حسين في السوربون، حضر دروس دوركايم، وانجذب إليه شخصيًا، لبراعته في إلقاء المحاضرات، ولحماسه للدعاية لعلمه الجديد، ونجاحه في جذب الطلاب إلى هذا العلم الجديد. وقرر طه حسين عندئذ أن يتخصص في علم الاجتماع وتخلى عن التاريخ الذي كان التخصص الذي بُعِثَ من أجله إلى السوربون. أي أن طه حسين قام بما نقول عنه بلغتنا اليوم “تحويل مسار”. يقول طه حسين: “ولم تكن الجامعة قد فرضت عليه هذه الرسالة [الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون]، بل لم يكن بين هذه الرسالة وبين برنامجه الدراسي سبب. فهو قد أُرسِل لدراسة التاريخ… وتطوع هو بهذه الرسالة لأنه سمع دروس الاجتماع التي كان يلقيها الأستاذ دوركيم . فشغف بهذا العلم أي شغف، وأراد أن تكون له فيه مشاركة، وأن يشرف الأستاذ على هذه المشاركة. فاتفق معه على موضوع الرسالة، وعلى أن يكون هو مشرفًا عليها من الناحية الفلسفية، وأن يشاركه في الإشراف مستشرق يحسن العلم بالشئون العربية والإسلامية. فكان كل فصل من هذه الرسالة يقرؤه أستاذان، يقرؤه الأستاذ المستشرق أولًا، ثم يقرؤه الأستاذ دوركيم بعد ذلك”[40]. نفهم من هذا أن طه حسين هو الذي اختار دوركايم مشرفًا على رسالته، وهو الذي حول مسار دراسته من التاريخ إلى علم الاجتماع، وهو الذي اختار موضوع رسالته للدكتوراه قبل أن يلتقي بدوركايم، وهو الذي أقنع دوركايم بالموضوع وبالإشراف عليه. لقد قرأ دوركايم كل رسالة طه حسين، فصلًا فصلًا. ولنتأمل قليلًا في هذا الثلاثي: دوركايم يشرف على رسالة عن ابن خلدون يعدها طه حسين؛ لن يتكرر هذا الثلاثي مرة أخرى في تاريخ علم الاجتماع، فهي حادثة متفردة نادرة. لكن ما يهمنا منها في دراستنا هو التشديد على أن قصة طه حسين مع دوركايم تدلنا على أن “مدرسة دوركايم” نشأت تلقائيًا وبمبادرة من التلاميذ، الذين كانوا أقرب إلى المريدين.
انتهى طه حسين من رسالته، لكن لم يُقَدَّر لدوركايم أن يناقشه، إذ توفى قبل المناقشة، وحزن عليه طه حسين حزنًا شديدًا، وكتب يقول في ذلك: “وكذلك خلص الفتى من مشكلات الليسانس، وأقبل على الرسالة يتهيأ لمناقشتها مستريح القلب هادئ النفس راضي الضمير، ولكنه لم يلبث أو رُوِّع بوفاة الأستاذ دوركيم المشرف الفلسفي على رسالته. وكان الفتى لأستاذه محبًا وبه معجبًا إعجابًا يوشك أن يبلغ الفتون، فأدركه للخطب فيه حزن عميق. ولكن للحياة حقائقها وتبعاتها. وليس بدٌ لهذه الرسالة من أن تُناقش، وليس بدٌ لمناقشتها من فيلسوف متخصص في الاجتماع“[41]؛ وهو سيليستين بوجليه Célestin Bouglé (1870 – 1940) تلميذ دوركايم الذي حل محله في الإشراف. والملاحظ أن طه حسين يقول إن دوركايم هو مشرف على رسالته من الناحية الفلسفية، ولعله يقصد من تلك الناحية الفلسفية، الناحية النظرية والمنهجية وليست النواحي الفلسفية المتخصصة التي تنتمي إلى حقل الفلسفة حصرًا.
قد يكون غريبًا لدينا نحن الآن أن يربط طه حسين بين علم الاجتماع والفلسفة، ويسمي دوركايم “المشرف الفلسفي” على رسالته، ويسمي بوجليه مشرفه الآخر البديل “فيلسوف متخصص في الاجتماع“. كيف يكون دوركايم مشرفًا فلسفيًا على الرسالة؟ وكيف يكون الفيلسوف متخصصًا في الاجتماع؟ قد نتعجب من هذه العبارة الآن، لكن في عصر طه حسين لم يكن قد ظهر بعد الشقاق الحاد بين علم الاجتماع والفلسفة، إذ أن أوائل علماء الاجتماع ورواده كانوا فلاسفة في الأصل، وقد أطلق أوجست كونت على علمه الجديد “الفلسفة الوضعية”، وكان دوركايم نفسه معلمًا للفلسفة قبل أن يتحول إلى علم الاجتماع، وألقى محاضرات جامعية في الفلسفة قبل أن يلقي محاضرات في علم الاجتماع بجامعة بوردو، وكان أساتذة الفلسفة هم الذين مكنوا علم الاجتماع من الدخول إلى الجامعة وسهلوا عملية الدخول هذه من البداية. فقد نشأ علم الاجتماع خارج الجامعة، وعلى يد مفكرين ليست لهم علاقة بالأكاديميا، ومن ثم كان هذا العلم الجديد في حاجة إلى أساتذة من داخل المؤسسة كي يأتوا به من خارجها ويسهلوا الاعتراف الأكاديمي به وييسروا عملية تدشينه الجامعي في صورة أقسام جامعية علمية. لقد كان أساتذة الفلسفة هم الذين أتوا بعلم الاجتماع من خارج الجامعة إليها وساعدوا على مأسسته داخلها.
عندما نرى طه حسين يكتب لاحقًا كتابًا في التاريخ الإسلامي وفي أحداث صدر الإسلام هو “الفتنة الكبرى“ عن الصراعات بين المسلمين في خلافتي عثمان وعلي، فلا يجب أن نتعجب من ذلك كما تعجب ناقدوه وقالوا عنه إنه أديب فكيف يكتب في التاريخ؟ لقد درس طه حسين التاريخ بالفعل في السوربون ثم علم الاجتماع، وبذلك تَعَلَّم النظر إلى التاريخ بالنظرة السوسيولوجية، الدوركايمية والخلدونية، وأخذ علم الاجتماع من منبعه الأول، من دوركايم نفسه.
والجدير بالذكر أن بوجليه الذي حل محل دوركايم مشرفًا على رسالة طه حسين، كان على الأرجح هو صاحب فكرة إنشاء “الحولية السوسيولوجية” L’Année sociologique، إذ اقترح الفكرة على دوركايم، وهو الذي عقد الاتصالات مع الباحثين لتكوين هيئة التحرير، وكان يقترح أسماء المؤلفين والأعمال المعروضة في الحولية، وكان على صلة بزيمل واستكتبه مع الكثير من علماء الاجتماع الذين شاركوا بدراسات في الحولية .
كانت رسالة طه حسين من أولى الدراسات التي ظهرت فيها أعمال دوركايم في قائمة المراجع – إذ ظهر في القائمة كتاب دوركايم “قواعد المنهج السوسيولوجي“، وكتبها طه حسين سنة 1917 وهي السنة التي توفى فيها دوركايم – والتي وظفت سوسيولوجيا دوركايم، وإن كان هذا التوظيف سلبيًا، إذ اتخذ طه حسين من “قواعد المنهج السوسيولوجي” معيارًا يحكم به على مقدمة ابن خلدون، وعلى أساسها نظر إلى “المقدمة” على أنها لا تنتمي إلى علم الاجتماع بل إلى الفلسفة الاجتماعية، إذ كان طه حسين متأثرًا بدوركايم في تحديد هوية علم الاجتماع بوصفه علمًا يدرس الظواهر الاجتماعية خالصة ومستقلة بذاتها sui generis دون اختلاط بأي ظواهر أخرى. فابن خلدون وفق تفسير طه حسين له لم يهتم إلا بشكل واحد فقط من المجتمعات وهو المجتمع السياسي: “نرى من قراءة المقدمة أنه لا يشير إلا إلى شكل اجتماعي واحد هو الدولة المنظمة التي يسميها أحيانًا بالشعب وأحيانًا بالأمة، وهو يجتهد في أن يدرس أطوارها المختلفة ومنشأها وكيفية تقدمها وعلوها.. ثم انحطاطها…”[42]. كما أن العلم الذي اكتشفه ابن خلدون ليس في نظر طه حسين مستقلًا بنفسه كعلم يتم السعي إليه لذاته ولنتائجه الخاصة، بل هو علم مساعد لعلم آخر أساسي هو علم التاريخ، وليس له من نفع سوى تنقيح وضبط الأخبار المتعلقة بالوقائع التاريخية، “فهو علم إضافي، ودرس المجتمع لا يفضي إلى نتائج ذات قيمة في نفسها تقنع الذهن الذي يعني بها“[43]. وعندما يأتي طه حسين باعتراض آخر على وصف ابن خلدون بأنه عالم اجتماع (إذ كان ينظر إليه على أنه فيلسوف اجتماعي وحسب)، نرى في اعتراضه هذا تأثرًا شديدًا بدوركايم في “قواعد المنهج السوسيولوجي“. يقول طه حسين: “والظاهر أنه لم تكن لابن خلدون فكرة واضحة عن المجتمع تتميز بوجه خاص عن فكرته عن الفرد. ومع أنه يقرر أن المجتمع السياسي ليس متحد الشكل في كل زمان ومكان، فإنه لم يلتفت إلى أن ذلك المجتمع قد يتميز تميزًا تامًا مخالفًا لتميز الفرد، وأن له وجودًا ثابتًا وحقيقة غير الحقيقة الفردية“[44]. وهذه هي نظرة دوركايم بعينها لمجال البحث السوسيولوجي، إذ يتمحور جانب كبير من كتابه “قواعد المنهج السوسيولوجي” على خصوصية الظاهرة الاجتماعية واستقلالها بذاتها وأنها لا يمكن أن تُرَد إلى أي ظواهر أخرى اقتصادية أو سياسية، وأنه لا يمكن رد المجتمع وظواهره إلى الأفراد المكونين له، من حيث إن الكل الاجتماعي أكبر من مجموع أفراده ومختلف عنه نوعيًا. كما أصر دوركايم على ضرورة تمييز علم الاجتماع عن علم النفس على أساس أن علم النفس يختص بالفرد وحالاته النفسية . ومع طه حسين نراه هو الآخر متأثرًا بدوركايم بشدة في مواجهته لعلم النفس واستبعاد النظرة النفسية من السوسيولوجيا، فابن خلدون في نظره قد وقع فيما يمكن أن نسميه النزعة السيكولوجية، لأنه حسب طه حسين كان متأثرًا بالمباحث الميتافيزيقية والكلامية عن النفس البشري، أي كان متأثرًا بتقسيم الفلاسفة وعلماء الكلام الإنسان إلى قوى نفسية، غاذية وحسية وناطقة أو عاقلة، والنظر إلى المجتمع على أنه يناظر النفس البشرية الفردية. وهذه النظرة هي التي أوقعت ابن خلدون في نزعة رد المجتمع إلى أفراده حسب طه حسين: “وإذًا فليس علينا لأجل أن نفهم المجتمع إلا أن نطبق عليه قوانين علم النفس الفردي، إذ ليست أفكاره إلا مجموعة لأفكار كل إنسان، وليست أعماله إلا ثمرة للجهود التي يقوم بها كل فرد ليصل إلى غاية واحدة” . وتكاد هذه العبارة تكرر ما قاله دوركايم حرفيًا في “قواعد المنهج السوسيولوجي”.
إن نظرة طه حسين إلى ابن خلدون على أنه وقع في النزعة السيكولوجية الفردية التي نقدها دوركايم في كتابه، هو ما يعد في نظري إساءة فهم شديدة لابن خلدون. لكن يجب عليَّ الاستمرار في عرض وتحليل انتقادات طه حسين لابن خلدون كي نكشف عن المزيد من تأثره بدوركايم. يحاول طه حسين إثبات أن ابن خلدون ليس عالم اجتماع (بالمعنى الذي قصده دوركايم من عالم الاجتماع) بقوله: “والذكاء الفردي كما نرى [عند ابن خلدون] هو الذي يعتد به، والذي يسيطر على شطر عظيم من الحركة الاجتماعية، بل إن الطريقة التي تنمو بها الدولة تشبه تلك التي ينمو بها الفرد، حتى أن ابن خلدون كثيرًا ما يشبه الدولة بالفرد، فالدولة كالإنسان، تولد وتنمو وتموت… تطورات حياتها هي نفس تطورات الحياة الفردية”[45]. وهذا الفهم لنظرية ابن خلدون في الدولة خاطئ تمامًا، لأن ابن خلدون لم يُرجِع أطوار الدولة إلى الفرد بل إلى العصبية القبلية، فهي عنده التي تمر بهذه الأطوار البيولوجية – الأنثروبولوجية التي اعتقد طه حسين خطأً أنها أدوار فردية؛ والملاحظ أن العصبية القبلية تنتمي عن جدارة وبامتياز إلى ما وصفه دوركايم على أنه “التساند الآلي” القائم على التماثلات والتطابقات في الوظائف الاجتماعية في المجتمعات التقليدية السابقة على الحداثة، و”الوعي الجمعي” الذي تحدث عنه دوركايم هو بالضبط الوعي القبلي الذي يسود الاجتماع البدوي الذي درسه ابن خلدون. وقد ضرب دوركايم نفسه مثالًا شهيرًا على التساند الآلي وما يسوده من وعي جمعي وهو مجتمع القبائل في الجزائر في عصره ، ومجتمع القبائل هو من المجتمعات التي ظلت باقية في العصر الحديث وتتطابق حياتها مع نمط الاجتماع الذي درسه ابن خلدون في “المقدمة”. حاول طه حسين إثبات أن ابن خلدون ليس عالم اجتماع بل هو فيلسوف اجتماعي معتمدًا على دوركايم في “قواعد المنهج السوسيولوجي”، لكن حسب دوركايم في كتابه السابق “تقسيم العمل الاجتماعي”، يعد ابن خلدون عالم اجتماع عن جدارة لوضع يده على ما يمكن أن نسميه نمط التساند الاجتماعي في المجتمعات البدوية والقائم على العصبية القبلية.
وقد بلغ تأثر طه حسين بدوركايم في تقييمه لابن خلدون إلى حد أنه نظر إلى عالم الاجتماع على أنه ذلك الذي ينظر إلى الظاهرة الاجتماعية نفس نظرة دوركايم لها، بوصفها مستقلة عن الوعي الفردي والظواهر النفسية الفردية، وتشكل كيانًا قائمًا بذاته. ولما كان ابن خلدون لم ينظر إلى الظاهرة الاجتماعية بهذه النظرة الدوركايمية فهو ليس في نظر طه حسين عالم اجتماع!! ويصرح طه حسين باسم دوركايم في ذلك الشأن قائلًا: “أما بحث ابن خلدون فلا يمكن إطلاقًا أن يعتبر تخصيصًا [بحثًا سوسيولوجيًا] إذ أنه لم يشعر بأهمية المظاهر الاجتماعية التي لم يدرسها”[46]؛ والأهمية المقصودة هنا هي أنها مستقلة بذاتها وتشكل كيانًا خاصًا وموضوعًا مستقلًا لعلم مخصوص؛ والمظاهر الاجتماعية التي يقصدها هي “الوقائع الاجتماعية” التي تحدث عنها دوركايم في “قواعد المنهج السوسيولوجي” وذهب إلى أنها هي موضوع البحث السوسيولوجي. وهذه المظاهر الاجتماعية حسب طه حسين يجب أن تكون هي نقطة انطلاق الباحث السوسيولوجي لا نقطة انتهائه، “كما يقول الأستاذ دوركايم”[47]. والذي يقصده طه حسين من قوله “كما يقول الأستاذ دوركايم”، ما ذهب إليه دوركايم في “قواعد المنهج السوسيولوجي”، من أن الواقعة الاجتماعية هي مجال البحث السوسيولوجي وهي موضوعه الأساسي وهي كذلك التي تحدد هوية السوسيولوجيا، ولما كان ابن خلدون في نظر طه حسين لم يدرك أهمية الوقائع الاجتماعية واستقلالها وتشكيلها لكيان ذاتي خاص بها “كما يقول الأستاذ دوركايم”، فهو ليس عالم اجتماع!!! لقد اتخذ طه حسين من دوركايم معيارًا للحكم على ابن خلدون وتقييمه بوصفه عالم اجتماع، وهذا لا شك ظلم لابن خلدون.
كان إشراف دوركايم على رسالة طه حسين من أواخر مهامه الأكاديمية وكانت الرسالة من أواخر ما قرأه دوركايم قبل وفاته مباشرة (1917). والطريف في الأمر أن بوجليه الذي حل محل دوركايم في الإشراف، كان على صلة وثيقة بجورج زيمل، أحد رواد علم الاجتماع الألمان، وكانت بينهما مراسلات، أغربها خطاب أرسله زيمل إلى بوجليه سنة 1899، وفيه أفصح زيمل له عن موقفه من علم الاجتماع، وأنه ليس عالم اجتماع بل فيلسوف!!! يقول زيمل لبوجليه: “لا تنس أن العلوم الاجتماعية ليست تخصصي. إن علم الاجتماع الذي أمارسه هو موضوع متخصص للغاية [جزئي ومحدود]، وأنا الوحيد الذي يمارسه في ألمانيا… وبوجه عام فيحزنني أنني في الخارج أُعرَف على أنني عالم اجتماع، في حين أنني فيلسوف، وأرى في الفلسفة رسالتي في الحياة، وأمارس السوسيولوجيا فقط بوصفها اهتمامًا جانبيًا. وحالما أنتهي من واجبي نحو علم الاجتماع بنشر [كتاب] شامل فيه… فلن أعود إليه”[48]. في ألمانيا في ذلك العصر، وفي فرنسا كذلك، كان الفيلسوف أعلى مقامًا في نظر الناس من أي عالم آخر، وكان يلقى تقديرًا واحترامًا فائقًا من كافة الفئات في المجتمع وفي الدولة. إذ كانت الفلسفة الألمانية جزءًا من الهوية الألمانية ومن التراث القومي الألماني، ومن دواعي فخرها بين الشعوب، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفلسفة الفرنسية وعلاقتها بفرنسا. ورغم إنكار زيمل كونه عالم اجتماع إلا أنه لا يزال يُعرَف بوصفه عالم اجتماع حتى الآن، واسمه حاضر في كل كتاب تاريخ علم الاجتماع والنظرية الاجتماعية، وحاضر كذلك كمرجع مهم في الدراسات السوسيولوجية في التَحَضُّر والصراع الاجتماعي وتكوين الجماعات. لكن لا يجب أن ننسى أن زيمل هو مؤلف كتاب شهير أسماه “فلسفة النقود”، ولم يسميه سوسيولوجيا النقود، وهو ليس سوسيولوجيا اقتصادية أبدًا. لكن يجب أن نلاحظ أن زيمل وفي خطاب سابق لبوجليه سنة 1894 ذكر أنه منشغل ومستغرق تمامًا – في ذلك الوقت – في أبحاثه السوسيولوجية، وأنه سعيد بتجمع الطلاب من دول أوروبية عديدة في محاضراته واهتمامهم البالغ بالعلم الجديد، وبأن أعماله قد ترجمت إلى لغات عديدة.
خاتمة
قد يُعتَقَد أن علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس المجتمع، وهذا صحيح نسبيًا ولكن من جهة واحدة، إذ أن علم الاجتماع يشتغل بالنصوص وعلى النصوص، إنه نشاط نصي في الأساس textual activity. فهو نشاط نظري، يتمثل في البحث عن النظريات والمناهج المناسبة في الكتب، للدراسة التجريبية، ويتضمن الكتابة الاحترافية للدراسة والتي تستخدم الحجج والأدلة وتحلل المادة العلمية وتستخرج النتائج. وهذا هو ما جعل رايت ميلز ينظر إلى علم الاجتماع على أنه عمل فكري احترافي intellectual craftsmanship (قد تدل كلمة crafts-man-ship على تحيز ذكوري، وقد كان يجب عليه أن يقول crafts-woman-ship أيضًا)، يعيش على قراءة الكتب، وعلى تنمية مهارات الكتابة، والتأمل الطويل في الكلاسيكيات الكبرى وفي تفاصيل البيانات الإحصائية في الوقت نفسه.
لاشك أن أعمال دوركايم وفيبر وزيمل تتصف بجاذبية عالية، وهي تظل هكذا إلى اليوم. لكن ما الذي يجعلها جذابة؟ الأسباب كثيرة، ومنها شغف البدايات الأولى، المرتبط بلحظة تأسيس العلم الجديد، والمصاحب بحماس له، وهو يشبه العلاقة الغرامية في بدايتها. كما أن هذه الأعمال ظهرت في فترة من البراءة نسبيًا، بالمقارنة بما سوف يحدث بعدها من أحداث جسام وكوارث طوال القرن العشرين؛ فكانت الكلاسيكيات سابقة على ظهور الحربين العالميتين (وإن عاصر القليل منها الحرب العالمية الأولى)، وسابقة على الفاشية والأنظمة السلطوية القمعية والحرب الباردة وتوحش الإمبريالية الأمريكية والاستقطاب الأيديولوجي الحاد بين الرأسمالية والاشتراكية. ولا ننسى أن العصر الذي ظهر فيه علم الاجتماع كان لا يزال عصر تفاؤل، وكان لا يزال في الإمكان للمفكر أن يخاطب “المجتمع”، قبل أن يصير هذا “المجتمع” ألعوبة في يد السلطة ووسائل الإعلام والهيمنة الرأسمالية. لم يكن من الممكن لعلم الاجتماع أن يظهر إلا بعد إدراك المفكرين الذين أسسوه أن “المجتمع” موضوع مستقل يصلح للدراسة الموضوعية والعلمية، أما عندما يفقد المجتمع كيانه المستقل ووحدته فلن يكون مجتمعًا من الأصل وسوف يكون مادة طيعة قابلة للهيمنة، وبذلك يكون اضمحلال المجتمع مصاحبًا لاضمحلال علم الاجتماع نفسه[49].
ونشهد في تاريخ علم الاجتماع أن النظرية السوسيولوجية تتحول إلى فلسفة اجتماعية لدى الجمهور. فطالما ظل موضع النظرية السوسيولوجية في الكتب والدوريات والأطروحات الجامعية، وطالما كان المتلقي لها هو المجتمع الأكاديمي، ظلت النظرية محتفظة بطابعها النظري المجرد والأكاديمي. أما عندما تخرج عن هذا الإطار وتنتشر في المجتمع أو على الأقل في المجال الثقافي العام، تتحول إلى فلسفة اجتماعية وتفقد طابعها الأكاديمي بعد أن يفهم منها الجمهور خطوطًا وأفكارًا في غاية العمومية وتصير شعبية. وأكثر النظريات الاجتماعية التي مرت بهذا التحول هو نظرية ماركس. وكذلك سوسيولوجيا دوركايم، إذ انتشرت لدى الأوساط الأعرض من جمهور المثقفين وفي الدوائر السياسية والتعليمية في الجمهورية الثالثة بوصفها فلسفة اجتماعية، تؤيد الجمهورية العلمانية، وتعمل على التوفيق بين الفردية والعدالة الاجتماعية، وبين مبدأ السوق الحر من جهة والعدالة الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بشيء من التخطيط من جهة أخرى، والجمع بين التوجه الوضعي في العلم الاجتماعي والتأكيد على الالتزام الأخلاقي ودور القيم والمعايير الأخلاقية في إحداث التماسك الاجتماعي. هذه المبادئ لن نجدها بصيغتها الواضحة البسيطة هذه في أعمال دوركايم، وإن كانت هي مقاصده الفعلية، لكنها في الأساس هي صورة سوسيولوجيا دوركايم في أذهان الجمهور الواسع من المتلقين والدوائر الحكومية.
ومن الصور الخاطئة التي انتشرت حول علماء الاجتماع، صورة هابرماس بوصفه من ممثلي الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت في النظرية النقدية؛ صحيح أن هابرماس نفسه كان حريصًا في بداية حياته على تقديم نفسه بهذه الصورة، إذ كان مساعدًا لأدورنو، وصديقًا لماركوزة، إلا أن فكره يبتعد تمامًا عن مبادئ المدرسة وعن فكر الجيل الأول، وكان مهادنًا لكل سلطة، واتضح في النهاية خضوعه للوبي الصهيوني في إعلانه الشهير عن تأييد دولة الكيان الصهيوني أثناء العدوان على غزة وتصريحه بأن من حق إسرائيل “الدفاع عن نفسها”. وليس هذا بقول مفكر نقدي ينتمي إلى تراث مدرسة فرانكفورت.
المصادر والمراجع:
[1]) Peter Baehr. Founders, Classics, Canons: Modern Disputes over the Origins and Appraisal of Sociology’s Heritage. (London: Routledge, 2002), p. xvi.
[2]) والحقيقة أنني وجدت الكثير من المقالات والدراسات التي تستخدم مفهوم “اللامسئولية المُمَأسسة” وتوظفه دون الإشارة إلى رايت ميلز. والملفت للنظر أن هذا المفهوم صار مستخدمًا كأداة نقدية، للدولة في عصر الليبرالية الجديدة التي تخلت عن مسؤولياتها الاجتماعية السابقة والتزامها بالتعليم والتوظيف والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وإعانة البطالة، تلك الالتزامات التي كانت من مهام دولة الرعاية الاجتماعية welfare state والتي انهارت في عصر الليبرالية الجديدة. لم يشهد رايت ميلز عصر الليبرالية الجديدة، لكن المفهوم الذي صاغه صار هو المعبر الحقيقي والأصدق عن موقف الدولة الليبرالية الجديدة من المجتمع وقضاياه. الدولة في عصر الليبرالية الجديدة صارت غير مسؤولة عن المجتمع، وهذه اللامسؤولية “ممأسسة”، بمعنى أنها صارت مؤسسية، أي منظمة ومُعتَمَدة وصارت سياسة مخططة ومقصودة. فقد صار التخطيط ليس من أجل تدخل الدولة في الاقتصاد، بل من أجل انسحاب الدولة من الاقتصاد.
[3]) Robert K. Merton. Social Theory and Social Structure. (New York: Free Press, 1968).
[4]) Pierre Bourdieu. Outline of a Theory of Practice. Translated by Richard Nice (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1977)
[5]) Weber, Max 1930. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (translated by Talcott Parsons). London: Unwin University Books.
[6]) Weber, Max 1978. Economy and Society, Vols. 1 and 2 (edited by Guenther Roth and Claus Wittich). Berkeley: University of California Press.
[7]) Mills, C. Wright 1959. The Sociological Imagination. London: Oxford University Press.
[8]) C. Wright Mills. White Collar; the American Middle Classes. (New York: Oxford University Press, 1951)
[9]) C. Wright Mills. The Power Elite. (New York: Oxford University Press, 1956).
[10]) Robert A Nisbet. The Sociological Tradition. (London: Heinemann, 1966), p. 5.
[11]) Stephen Lukes. Emile Durkheim: His Life and Work. (London: Allen Lane, 1973); “Alienation and Anomie” in Laslett, P. & Runciman, W.G. (eds.); Philosophy, Politics and Society, Third Series (1967, Blackwell, Oxford); “Durkheim’s Individualism and the Intellectuals”, Political Studies, 1969, XVII, 1, pp. 14-19 (+translation: pp. 19-30); “Prolegomena to the Interpretation of Durkheim”, Archives européennes de sociologie, 1971, XII, 2, pp. 1-209
[12]) Wolfgang J. Mommsen. Max Weber and German Politics, 1890-1920. (Chicago: University of Chicago Press, 1984); Mommsen. The Political and Social Theory of Max Weber: Collected Essays. (Cambridge: Polity, 1989); Mommsen. The Age of Capitalism and Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber. (New York, NY: Berghahn Books, Incorporated, 2021).
[13]) Alvin Ward Gouldner. The Coming Crisis of Western Sociology. (London: Heinemann, 1977).
[14]) Gouldner. Patterns of Industrial Bureaucracy. (New York: Free Press, 1967)
[15]) كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، الجزء 1، ترجمة السيد نفادي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2014.
[16]) Alvin Ward Gouldner. Enter Plato: Classical Greece and the Origins of Social Theory. (New York: Basic Books, 1965).
[17]) Niklas Luhmann. The Differentiation of Society. (New York: Columbia University Press, 1982); Luhmann, Social Systems. (Stanford: Stanford University Press, 1995)
[18]) Thomas Bottomore. Elites and Society (London: Watts, 1964);
[19]) Ralf Dahrendorf. Class and Class Conflict in Industrial Society. (Stanford: Stanford University Press. 1959).
[20]) Irving Zeitlin, M. Ideology and the Development of Sociological Theory. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1968)
[21]) Göran Therborn. Science, Class, and Society: On the Formation of Sociology and Historical Materialism. (London: Verso, 1980)
[22]) Michel Foucault. “What is an Author? (Translated by Josue V. Harari), in Paul Rabinow (ed.) The Foucault Reader, pp. 101-20. Harmondsworth: Penguin Books, 1984).
[23]) Pierre Bourdieu. Homo Academicus. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1988).
[24]) فضلت كلمة “بناء” على كلمة “بنية” لترجمة structure، وذلك كي لا تختلط كلمة “بنية” بمعناها في الاتجاه البنيوي وهو ليس له علاقة بسوسيولوجيا بارسونز.
[25]) C. Wright Mills. The Sociological Imagination. (New York: Oxford University Press, 1959), pp. 25ff, 50ff.
[26]) Pierre Bourdieu, and Loïc J. D. Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology. (Chicago: The University of Chicago Press, 1992).
[27]) David Harvey. A Companion to Marx’s Capital. Complete edition. (London: Verso, 2018);
[28]) Anthony Giddens. Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber. (Cambridge: University Press, 1971).
[29]) انظر خطاب إنجلز إلى تونيز بتاريخ 24 يناير 1895، حيث يُرجع كل أفكار وتوجهات كونت إلى سان سيمون، مما يقدح في أصالته:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1895/letters/95_01_24.htm
[30]) Marx, Capital, translated by Ben Fowks, vol.1. (London: Harmondsworth, 1977) p. 451, n. 18.
[31]) Marx to Engels. 7 July 1866, in Marx-Engels Collected Works, Volume 42 – Marx and Engels: Letters: 1864-1868. (London: Lawrence & Wishart, 1987), p. 292.
[32]) Anthony Giddens. “Weber and Durkheim: Coincidence and Divergence, in W.J. Mommsen and J. Osterhammel (eds.) Max Weber and His Contemporaries, pp. 182-9. London: Unwin Hyman, 1987), p. 182.
[33]) Thorstein Veblen. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. [New ed.]. (New York: The Macmillan Company, 1912).
[34]) David Riesman. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. (New Haven: Yale University Press, 1950).
[35]) Talcott Parsons and Winston White. “The Link between Character and Society”, in Lipset, Seymour Martin, and Leo Lowenthal, eds. 1961. Culture and Social Character; the Work of David Riesman Reviewed. [New York]: [Free Press of Glencoe], pp. 89 – 135.
[36]) Durkheim. Suicide, trans. John A. Spaulding and George Simpson. )London: Routledge, 2002[1897]), p. 122.
[37]) Ibid, p. 123.
[38]) Loc. Cit.
[39]) Pitirim Sorokin. Contemporary Sociological Theories. (New York and London: Harper & Brothers, 1928).
[40]) طه حسين، الأيام، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ص 463.
[41]) المرجع السابق، ص 472.
[42]) طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، ترجمه عن الفرنسية محمد عبد الله عنان، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1925، ص 42.
[43]) المرجع السابق، ص 59.
[44]) المرجع السابق، ص 60.
[45]) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
[46]) المرجع السابق، ص 63.
[47]) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
[48]) W. Lepenies. Between Literature and Science: The Rise of Sociology. Translated by R. J. Hollingdale. (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 243, cited in Baehr, p. 11.
[49]) من أهم الأعمال التي رصدت “تحلل” علم الاجتماع من جراء اضمحلال المجتمع الحديث، كتاب هوروفيتز:
Irving Louis Horowitz. The Decomposition of Sociology. (New York: Oxford University Press, 1995).
____________________
*المصدر: “تكوين”.