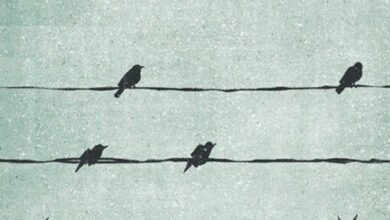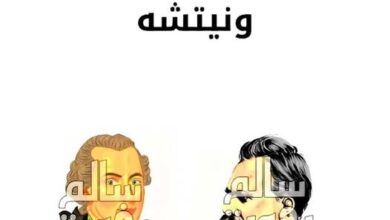فلسفة وميتافيزيقا
لماذا وُلدَت الفلسفة في المدينة الإغريقيّة؟
لماذا وُلدَت الفلسفة في المدينة الإغريقيّة؟
(مشير باسيل عون)
غالباً ما يستغرب الناس العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتمدّن الإغريقي. أعظم فلاسفة الألمان، في مقدّمتهم #هيغل و #هايدغر، أثبتوا الحقيقة الحضارية هذه. أمّا الوقائع فتدلنا على أن التفلسف الحقّ لم ينشأ عند العرب أو الفرس أو سكّان الهند أو الصين أو أفريقيا أو مجتمعات السكّان الأصليّين في القارة الأميركية أو الأسترالية. ومن ثمّ، يجدر بنا أن نستفسر عن العوامل الإجتماعية والسياسية الإقتصادية التي جعلت المدينة الإغريقيّة الناشئة في القرن الثامن ق. م. تساهم مساهمةً جليلةً في ولادة الفكر الفلسفي المحض. أعرف أن جميع الحضارات الإنسانيّة إختبرت ضروباً شتّى من التأمّل الوجدانيّ النفيس. غير أنّ إستخدام العقل في بناء قواعد المنطق وإستخراج أحكام النظر الموضوعي في الحياة ظاهرةٌ ثقافيّةٌ خطيرةٌ إقترنت بما إنعقدت عليه المدينة الإغريقية القديمة من خصائص بنيوية إنفردت بها إنفراداً إستثنائيّاً.
إذا كانت المدينة الإغريقية قد إستهلّت زمناً حضاريّاً جديداً في مسار التاريخ البشري، فذلك لأنّها إنطبعت بثلاث سماتٍ جوهرية بالغة الأثر. تجلّت السمة الأولى في مقام كلام التخاطب، وقد أولاه سكان المدينة الإغريقيّة الصدارةَ المطلقةَ على جميع وسائل النفوذ والسلطان المستخدَمة عصرَذاك. من جرّاء الإنتظام الإجتماعي في المدينة، أضحى كلام التخاطب الوسيلة السياسيّة البارزة، وباب السلطة في الدولة وسبيلها الأفعل والأخطر، وأداة الحكم وواسطة السيطرة على الآخرين. لا بد في هذا السياق من التذكير بـ«إلهة الإقناع» عند الإغريق القدماء، وقد أطلقوا عليها إسم «الإلهة بيثو» (Peitho) تُسعفهم في إتقان فنّ المحاجّة العقلية القادرة على إستقطاب تأييد الشعب. لا ريب في أنّ صورة «إلهة الإقناع» مستخرجة من الشعائر الدينيّة التي كانت تفترض في الأقوال الإبتهاليّة المنطوقة قدرةً خارقةً على الإستجابة للدعوة وتحقيق الأمنية. وما لبث سلاطين الممالك والإمبراطوريات القديمة أن إستأثروا بهذا السلطان، فغدت أقوالُهم محلَّ إكرامٍ وتبجيلٍ لما إنطوت عليه من قيمةٍ إنفاذيّةٍ خطيرةٍ.
بيد أن أهل المدينة الإغريقية لم يقلّدوا القدماء، بل أعادوا تعريف كلام التخاطب، فجرّدوه من صفاته الشعائرية التعظيمية ومن سلطانه الملوكيّ القاهر، ونسبوا إليه مقاماً تداوليّاً جعله ينبسط في صورة المباحثة الحرة والمناقشة المفتوحة والمحاجّة البرهانية الموضوعية. من جرّاء التحول الخطير هذا، أصبح الكلام التخاطبي النشاطَ الإجتماعي الثقافي الأبرز في حياة أهل المدينة، إذ أخذ الناس يعاينون في الجماعة الملتئمة جمهوراً مصغياً قادراً على التمييز والحكم على مضامين المناقشة العلنيّة المحتدمة. كذلك إكتسب القاطنون في المدينة الإغريقية صفة المرجعية القضائية التي تنظر في القضايا المتناقضة المطروحة على بساط البحث، وتقرّر أيّها الأقدر على الإقناع والأنفعُ لمدينتهم.
إعتلنت السمة الثانية في عَلانية المباحثة المنعقدة بين أصحاب الرؤى المتباينة والقضايا المتناقضة. ذلك بأن المدينة الإغريقية أتاحت للحياة الإنسانية أن تحظى بمنظوريّتها الإجتماعية في المجال العام أو العمومي، بحيث أجمع أهلها على البحث عن أسباب المنفعة العامة المشتركة وصونها من هيمنة المصالح الذاتية الخاصة. في قرائن هذا التحول، إضطر أهل السلطان إلى تقليص دائرة الممارسات الأرستقراطية النخبوية التواطئية السرّية، والإفصاح العلني عن عمليات التفاوض المفضية إلى إستخراج القرارات السياسية والإقتصادية. من البديهي، والحال هذه، أن يجرّد الناس أصحاب السلطة من هيمنتهم على مصادر المعرفة حتى يتسنى للجميع أن يطّلعوا على المعلومات الضرورية التي تؤهلهم للحكم الموضوعي على القضايا المصيرية المشتركة. بعد أن كانت المعرفة محصورةً في دائرة السلطان الحاكم، شاعت شيوعَ المساواة في الإطلاع والإستعلام. فنشأ من جرّاء هذا كله تحريض حميد على إعمال الفكر في شؤون الحياة المدنيّة العامة، فنهض الناس إلى الإعتناء بتهذيب عقولهم حتى يستطيعوا أن يواكبوا الحدث ويضطلعوا بمسؤولية الوعي النقدي المستجد.
أما السمة الثالثة فظهرت في خضوع الشأن السياسي كله لسلطان الكلام التخاطبي التداولي. ذلك بأن المناقشة والمحاجّة والجدل أعمالٌ أمست تضبط مسار النشاط الفكري والحركة السياسية. أما الجماعة الناظرة في القضايا العامة فتحولت إلى رقيب يدقق في إنتاجات الفكر وأعماله، وفي إجتهادات الدولة وقراراتها. فما لبث هذا التحول أن أفضى إلى تغيير ناموس المدينة الإغريقية، بحيث نبذ الناس الحُكم الإستبدادي المطلق، وآثروا نظام الإنتخاب المباشر والمواكبة الساهرة والمحاسبة الصارمة. ومن ثم، لم يَعد في مقدور السلطان السياسي أو الديني أن يفرض أحكامه بالقوة، بل إضطر إلى الإستعانة بالدليل الواضح والبرهان الجلي من أجل إقناع الناس بصوابية السبيل الإقراري الذي أفضى إلى مثل هذا التدبير أو ذاك.
لا ريب إذن في أن التحول الثقافي الذي أصاب المدينة الإغريقية أتاح إنبثاق نمطٍ جديد من التفكر المبني على النظر العقلي الموضوعي المجرّد. فإذا بالفكر الفلسفي يولَد في معترك التحولات البنيوية الذهنية الثقافية الإجتماعية هذه، فيحرر رويداً رويداً الوعي الإنساني من تصوراته اللاهوتية الميتولوجية الأسطورية، ويساهم مساهمةً حاسمة في تجلّي زمن العقل. في سياق هذا المنعطف، يمكن القول إن الفلسفة الإغريقية لم تشهد ولادة العقل، بل بَنت بنفسها العقل، أي أنشأت الشكل الأول من العقلانية الغربية. ذلك بأن العقل الإغريقي، في إعتلانه الأول، إضطلع بمسؤوليةٍ جليلة على قدر ما أكبّ ينظر في الأمور نظرةً منهجية موضوعية مجردة أتاحت له التأثير في عقول الناس، قبل أن يتمكن لاحقاً من تغيير مسار الطبيعة. وعليه، يصحّ القول إن العقل هذا، في طاقاته الإستكشافية وفي حدود إمكاناته، إنما هو إبن المدينة الإغريقية القديمة.
لا بد هنا من التذكير بأن هذه المدينة تكوّنت تكوّناً تاريخياً أفضى إلى قيامها على هيئة الإنتظام الإجتماعي الذي كان يتيح للمواطنين أن يتشاركوا تشاركاً عادلاً في ممارسة السلطة، بحيث إنّ القوانين لم تَعد تَتنزّل عليهم من سماء التعالي الإلهي أو من دائرة السلطان القاهرة، بل أضحت تنبثق من صميم مباحثاتهم المستندة إلى مراعاة مصالح المدينة المشتركة. بفضل التحول الخطير في البنية السياسية هذه، إستطاعت المدينة الإغريقية أن تستولد ضروباً جليلة من التغيير الثقافي الإجتماعي البالغ. إذا أراد المرء أن يستجلي طبيعة هذا التغيير، أمكنه أن يحصيه في أربعة حقول أساسيّة من حياة الناس في المدينة. تجلّى التغيير أوّلاً في حقل الإجتهاد القانوني، إذ إنبرى المشرّع الإغريقي الشهير #سولون (حوالي ٦٤٠ ق.م – ٥٥٨ ق.م) يصوغ دستور المدينة الأول، وقد عزّز فيه سلطة الشعب. لذلك عاين فيه #أفلاطون و #أرسطو مثالَ المجتهد المصلِح الجريء الذي جدّد الحياة السياسية الإغريقية. تحقّق التغيير ثانياً في إنتقاد التقليد الثقافي السائد، لا سيما في البنى السياسية والإجتماعية، بحيث عكف العقلاء على تعطيل القرارات التي كانت الأريستوقراطيا الإغريقية تستأثر بها وتُبرمها سرّاً وتفرضها على الناس. كذلك طفق الفلاسفة ينتقدون المنهج التربوي القائم على الذهنية العسكرية القتالية والإئتمار الإذعاني الذي لا يبيح الشورى. أما موضع الإنتقاد الأخطر فأصاب مقام الكلام الذي كان مقتصراً على تلاوة القصائد وحفظ الملاحم الشعريّة المبنية على تعظيم أصول المدينة الأسطورية.
لا عجب، من ثم، في أن ينعقد التغيير الثالث على إبتكار النظام الديمقراطي الذي أفضى إلى تدبير الحياة السياسية بالإستناد إلى مباحثات الساحة العامة العلنية (الأغورا) ومجادلات الناس الملتئمين فيها إلتئامَ التمثيل الإنتخابي العادل. أما السبيل الوحيد الذي كان يتيح تقلُّد المناصب التشريعية والتنفيذية، فالكلام التخاطبي التحاوري القادر على إقناع عقول الناس وإرشادهم إلى القرار السياسي الأنسب. من جرّاء الضروب الثلاثة الخطيرة هذه من التغيير البنيوي العميق، إنبثق التغيير الفكري الأخطر الذي أصاب الذهنية السائدة، إذ إنصرف الناس إلى ممارسة الفعل الفلسفي، فإلتأموا في مدارس محبّي الحكمة الذين شرعوا يحرضونهم على ترك التفاسير اللاهوتية الأسطورية والإعتصام بالتحليل العقلي الموضوعي. من أعظم هؤلاء الحكماء كان المعلّم #سقراط (حوالي ٤٧٠ ق.م – ٣٩٩ ق.م) الذي إنتهج في المحاورة الفلسفية الحرة سبيل التفكّر العقلاني الجريء. ولشدّة الإقبال على مزاولة المحاجّة الفلسفية، إنبرت فرقةٌ من حكماء الدهاء البرهاني عُرِفوا بالسوفسطائيّين، ومنهم #بروتاغوراس (حوالي ٤٩٠ ق.م – ٤٢٠ ق.م) الذي رسم أن الإنسان مقياسُ كلِّ حقيقة ومرجعها، فطفقت تحثّ الناس على تعلّم فنّ الكلام وأساليبه وإتقان لغة البلاغة والإحكام البياني الساحر. أما أفلاطون فجسّد مثال الفيلسوف القادر على إنتزاع نفسه من قرائن الخضوع لأحكام التقاليد، والإرتقاء إلى مستوى النظر في عالم المثُل السامية. لذلك إستهلّت كتاباتُه زمنَ الفلسفة الأصيلة التي إستثمرت تحولات المدينة الإغريقية، فأخذت تُسائل الوجود الإنساني وتستفسره عن معناه الأعمق والأرحب. إذا كانت الفلسفة بنتَ العقل النظيف الحرّ، فإن الإستبداد يخنقها ويُجهِض ولادته.