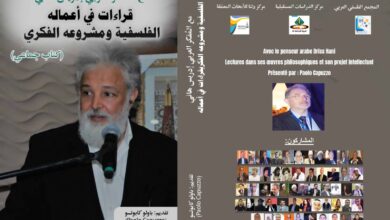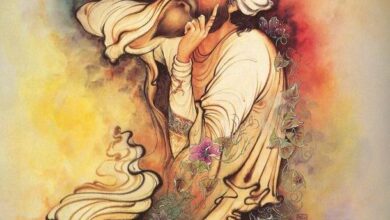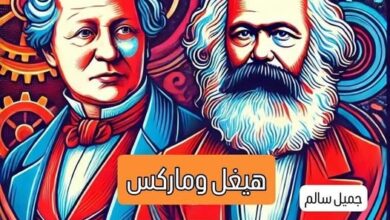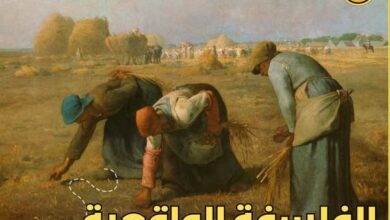فلسفة وميتافيزيقا
العلاقة بين التحليل النفسي والفلسفة: استخدام الفلسفة
مدان صاروب // ترجمة وتعليق: الدكتور: أزراج عمر
مقدمة :
ومن إنجازات جاك لاكان أنه ربط التحليل النفسي بالفلسفة واللسانيات والأدب، وشدد في الوقت نفسه على مكانته كعلم. دعونا نبدأ بالنظر إلى بعض الترابطات بين لاكان والفلسفة.
كان فرويد يكره تأملات الفلسفة لكن هذا لم يمنعه من تقديم فرضياته التأملية. ومع ذلك، فهي تخضع للتعديلات والتنقيحات اللاحقة.
تتضمن تجريبية فرويد درجة عالية من المفهمة . كان يعتقد أن التقدم في المعرفة مستحيل دون التجديد المستمر وإثراء عمل المفهمة. وهذا ما حاول لاكان أن يفعله في عمله.
مثل فرويد من قبله، يعترض لاكان بشدة على الطموحات الشمولية للفلسفة، وميلها إلى رؤية نفسها على أنها الشكل الأساسي للتفسير، وعلى ادعاءاتها القدرة على قول الحقيقة كاملة.
ولكن في حين اختار فرويد ربط عمله بالمسيرة العلمية البطيئة والمتوقفة، فإن لاكان يعارض الشمولية الفلسفية على أساس أنه من غير الممكن ببساطة قول الحقيقة كاملة. إن الكلمات التي قد تسمح للمرء أن يفعل ذلك هي ببساطة غير موجودة.
ومن بين المحللين النفسيين، فإن اهتمام لاكان بالفلسفة واستعداده للدخول في الجدل النظري هما الاستثناء من القاعدة. فهو يشير باستمرار، على سبيل المثال، إلى القديس أوغسطين، وديكارت، وهيجل، وكيركغارد، ومالبرانش، ولاروشفوكو، و سبينوزا وغيرهم كثير. تزود الفلسفة لاكان بترسانة من المراجع والتلميحات التي يمكن استخدامها لتقديم نقاط توضيحية أو تربوية.
تمتد مسيرة لاكان المهنية على مدى خمسين عامًا من الحياة الفكرية الفرنسية، ومن المتوقع أن تعكس العديد من التحولات الثقافية التي حدثت خلال تلك الفترة. هناك العديد من الإشارات إلى الحركات الفلسفية المختلفة وأخيرا (بعد عام 1953) إلى البنيوية القائمة على اللغة.
أريد في هذا الفصل أن أحدد اهتمامات بعض الفلاسفة الذين أثروا في عمل لاكان. سأركز على تلك الجوانب عند سبينوزا وهيجل وسارتر وهايدجر والتي تساعد في تفسير تفكير لاكان.
عندما نقرأ أعمال لاكان، ندرك بعض الافتراضات الأساسية حول طبيعة الحياة، والأشياء التي نحبها. تدين هذه الافتراضات إلى حد كبير لدراسته لكتاب سبينوزا ” الأخلاقيات ” Ethics . أول شيء يجب أن نفهمه عن سبينوزا هو أنه كان حتميًا ويعتقد أن كل الأشياء التي تحدث، تحدث وفقًا للنظام الأبدي وقوانين الطبيعة الثابتة. كان يعتقد أن جميع أفعالنا تتحدد من خلال تجربتنا الماضية، وتكويننا الجسدي والعقلي، وحالة قوانين الطبيعة. ثانيًا، يجب أن نلاحظ أنه كان نسبويًا. لقد رأى أنه لا يوجد شيء جيد أو سيئ في حد ذاته، ولكنه يكون كذلك فقط فيما يتعلق بشخص ما. وبما أن نفس الشيء قد يؤثر في أوقات مختلفة على نفس الشخص بشكل مختلف، فإن صلاح أو شر مثل هذا الشيء لا يمكن اعتباره خاصية متأصلة فيه، ولكن فقط خاصية تأتي إلى الوجود اعتمادًا على علاقتها بالإنسان. التواجد في لحظة تاريخية محددة.
لذلك، بالنظر إلى حقيقتين مفادها أن جميع الأحداث تتحدد بالقوانين الطبيعية ولذلك فإن الكائنات البشرية ليست حرة، وكذلك فإن الأشياء ليست جيدة أو سيئة في حد ذاتها، فبماذا تتكون الحياة الطيبة للبشر؟ بالنسبة لــ سبينوزا، مثل هذه الحياة تكمن في امتلاك موقف معين تجاه العالم ، وهذا الموقف عاطفي في جزء منه وعقلاني في جزء آخر، و يتمثل الجزء العقلاني منه في الاعتراف بحقيقة أن كل الأحداث محددة، وأما الجزء العاطفي منه فيتمثل في قبول هذه الحقيقة.
يؤكد سبينوزا فكرة أن البشر لديهم إرادة حرة هي فكرة خاطئة، وهو وهم ناتج عن عدم معرفة أسباب أفعالنا. ومن ناحية أخرى، يقول، هناك شيء اسمه عبودية الإنسان أو عبودية. تتمثل عبودية الإنسان في حثه على التصرف ببعض الأسباب دون غيرها. هناك بعض الأسباب – المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والكراهية – التي تتولد فينا بسبب التأثير المحبط لأجزاء العالم التي تقع خارجنا. ولكن بالإضافة إلى ذلك فهو يعتقد أن لدينا مشاعر نشطة، تلك التي تتولد عن فهم ظروفنا في العالم، ومعرفة ما يحدث بالفعل. إنه كلما كانت أنشطتنا ناجمة عن المشاعر النشطة، وكلما كانت المشاعر السلبية أقل، كلما قلت عبوديتنا، وكلما أصبحنا أنفسنا أكثر.
يعتقد سبينوزا أنه إذا كان هناك ارتباك في العقل، فهناك ألم في الجسم. وفي العاطفة يتم التأثير علينا (السلبية). الأفكار الواضحة تخلق إمكانية الفعل ، عكس العاطفة (النشاط). حسب وجهة نظره فإنه من خلال ممارسة العقل في اكتساب الفهم، يمكننا أن نجعل المشاعر السلبية تتلاشى بحيث تحتل المشاعر النشطة مكانها.
تقدم فلسفة سبينوزا التوجيه للناس، والذي إذا تم اتباعه، سوف يمكنهم من تجنب الخوف والقلق والتعاسة. وهذه تنشأ فقط عندما نصبح عبيدًا لعواطفنا؛ فالشخص الذي لا يأخذ وجهة نظر واسعة هو شخص يعيش “في عبودية الإنسان”.
و باختصار، فإنه يمكن للناس أن يحرروا أنفسهم من خلال فهم أن مسار الطبيعة مقدر وأيضًا من خلال فهم أنه “لا يوجد شيء جيد أو سيئ في حد ذاته، ولكنه يصبح جيدًا أو سيئًا فقط اعتمادًا على مدى تأثيره علينا”.
وبعبارة أخرى، يجادل سبينوزا بأن البشر سيكونون سعداء عندما يدركون أن هناك حدودًا للقوة البشرية؛ ومن خلال فهم أن كل ما يحدث لا بد أن يحدث بالضرورة، فلن يبدد الناس طاقتهم بعد الآن في النضال ضد هذه الأحداث.
ومن خلال النظر إلى كل حدث كجزء من نظام أكبر (“في سياق الأبدية”، باستخدام عبارته)، لن يعد المرء منزعجًا أو خائفًا من الأحداث التي تحدث في الحياة.
سبينوزا مهم لأنه يؤكد على فكرة أن اكتشاف المصادر الخفية لمشاعرك وأفعالك سيكون بطريقة ما تحررًا، على الرغم من أنها لا يزيد من حريتك. إنه يحررك من الإحباط الناجم عن كونك تحت رحمة قوى لا تفهمها. وهذا الفكر، بطبيعة الحال، هو محور أفكار فرويد و لاكان.
بالاعتماد على سبينوزا، يقترح لاكان أننا يجب أن نحلل ونطور أفكارًا واضحة، وأن المرضى (المحللين نفسيا) يجب أن يتعلموا التصرف (لكن هذا، بالطبع، يختلف عن ” القيام بتمثيل هذا التصرف ” ). على الرغم من أننا لا نستطيع تجنب كوننا ذواتا ، إلا أنه من الممكن أن يكون لدينا بعض الفهم للعمليات المعنية. يعتقد لاكان ذلك أنه عند نهاية التحليل هناك خلاصة , يمكن للناس التوصل إلى نتيجة حول رغبتهم بدلاً من أن يكونوا ضحايا لعواطفهم ، يمكن للمرضى المحللين نفسيا أن يتصرفوا.
يبدو لي أن لاكان قد تأثر بحتمية سبينوزا وبنزعته النسبية وبوجهة نظره حول أهمية فهم “العواطف” ، وسوف تصبح الترابطات الدقيقة بين أفكارهما واضحة عندما أشرح ” نسق ” لاكان المتطور باستمرار والجدلي في الفصول التالية.
كان جاك لاكان ينتمي إلى نفس جيل سارتر وليفي شتراوس، وهو الجيل الذي كان معاديًا للفلسفة الأكاديمية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. جيلً كان رد فعله قاسيا ضد هيمنة الكانطية الجديدة والتقليد الديكارتي. وقد كان هذا التقليد هو الذي استبعد هيغل من الدراسة الجدية.
لم يكن الفلاسفة الأكاديميون هم الذين جلبوا هيغل وهيدغر إلى فرنسا، بل شخصيات هامشية، حيث أن كثيرا منهم كانوا مهاجرين مثل ألكسندر كوجيف، الذي كان لمحاضراته عن هيغل تأثير هائل.
ألقى ألكسندر كوجيف سلسلة من المحاضرات، بين عامي 1933 و1939، والتي كان يحضرها بانتظام مثقفون مثل آرون، و جورج باتاي، وأندريه بريتون ، وكلوسوفسكي ، وميرلو بونتي، وكوينو ، ولاكان.
إنه يمكن إرجاع العديد من عناصر ” الهيغلية اليسارية” والإنسية الماركسية في عقود ما بعد الحرب إلى هذه المحاضرات.
تصف محاضرات كوجيف وجهة نظر عنيفة للعالم وتركز على لحظات التمزق والصراع بدلاً من التركيبة . بالنسبة لـــ كوجيف، فإن كتاب ” ظاهرية الروح ” Phenomenology of spirit لهيغل هو النص الرئيسي، وفي داخل هذا النص، فإن جدلية السيد والعبد هي التي يتم تقديمها في المقدمة لاستبعاد كل شيء آخر تقريبًا. إن اللحظة المركزية في ظهور الفردية تدور حول الرغبة بقدر ما تنطوي على جدلية بين الذات والآخر.
وبما أن جاك لاكان تأثر إلى حد كبير بمحاضرات كوجيف حول ظاهرة الروح لهيغل، فسوف أقدم الآن ملخصًا موجزًا لعرض كوجيف لطبيعة الرغبة الإنسانية، وللنضال من أجل الاعتراف، ومثل العلاقة بين السيد والعبد.
إن الإنسان هو وعي ذاتي. إنه واعي بذاته ، واعي بواقعه الإنساني وكرامته ؛ وفي هذا فهو يختلف جوهريًا عن الحيوانات. يصبح الإنسان واعيًا لذاته عندما يقول “أنا” لأول مرة.
فالإنسان الذي يتأمل يكون “مستوعبا ” من طرف ما يتأمله ؛ فالذات العارفة تفقد نفسها في الموضوع المعلوم. فالإنسان “المستوعب” من طرف الموضوع الذي يفكر فيه لا يمكن ” إعادته إلى نفسه ” إلا عن طريق الرغبة ؛ بالرغبة في الأكل مثلاً. وفي رغبته، أو بالأحرى، يتشكل الإنسان وينكشف لنفسه وللآخرين، باعتباره أنا. . .
وعلى النقيض من المعرفة التي تبقي الإنسان في حالة هدوء سلبي، فإن الرغبة تنزع عنه الهدوء وتدفعه إلى العمل. بما أن الفعل يولد من الرغبة ، ويميل إلى إشباعها، ولا يمكنه فعل ذلك إلا من خلال ” النفي “، أو التدمير، أو على الأقل تحويل الموضوع المرغوب: لإشباع الجوع، على سبيل المثال، يجب تدمير الطعام أو تحويله في أي حال . ومن ثم فإن كل فعل ” هو نفي” ، و لكن نفي الفعل ليس مدمرًا تمامًا، لأنه إذا كان الفعل يدمر واقعًا موضوعيًا، من أجل إشباع الرغبة التي ولد منها، فإنه يخلق في مكانه، وفي ذلك التدمير ذاته، وبواسطته، واقعًا ذاتيًا.
فالكائن الذي يأكل، على سبيل المثال، يخلق ويحافظ على واقعه الوحيد في واقعه الخاص من خلال “استيعاب” و” استدخال ” واقع “أجنبي” و”خارجي”.
بشكل عام، فإن” أنا ” الرغبة هي فراغ لا يتلقى محتوى إيجابيًا حقيقيًا إلاَ من خلال إلغاء الفعل الذي يرضي الرغبة في تدمير وتحويل و”استيعاب” ما هو ليس أنا المرغوب فيه.
إنه يجب أن تكون الرغبة الإنسانية موجهة نحو رغبة أخرى. وهكذا الأمر في العلاقة بين الرجل والمرأة، على سبيل المثال، و تكون الرغبة إنسانية فقط إذا رغب أحدهما، ليس الجسد، بل رغبة الآخر؛ وإذا أراد “امتلاك” أو “استيعاب” الرغبة التي تعتبر رغبة – أي إذا أراد أن يكون “مرغوبًا” أو “محبوبًا” أو بالأحرى “معترفًا به” في قيمته الإنسانية، في واقعه وكفرد إنساني.
إن الرغبة في رغبة الآخر هي في التحليل النهائي الرغبة في أن تكون القيمة التي أنا عليها أو التي “أمثلها” هي القيمة التي يرغب فيها الآخر: أريده أن “يعترف” بقيمتي كقيمة له، وبعبارة أخرى، فإن كل رغبة إنسانية هي، في النهاية، وظيفة الرغبة في “الاعتراف”. إنه لا يمكن للكائن البشري أن “يعترف به” إلا من قبل شخص آخر، أو من قبل كثيرين آخرين، أو – في أقصى الحدود – من قبل جميع الآخرين. إنه إنسان حقًا لنفسه وللآخرين.
لا يمكن للإنسان أن يتشكل إلا إذا واجهت على الأقل رغبتان اثنتان من هذه الرغبات بعضها البعض. إن أحد الكائنين اللذين يتمتعان بمثل هذه الرغبة على استعداد لقطع كل الطريق سعيًا لتحقيق إشباعه ؛ أي أنه مستعد للمخاطرة بحياته… لكي “يعترف” به الآخر، ويفرض نفسه على الآخر باعتباره القيمة العليا؛ وبناءً على ذلك فإن اجتماعهما لا يمكن أن يكون إلا قتالاً حتى الموت.
لا يتم خلق الواقع الإنساني ولا يتم تشكيله، إلا في النضال من أجل الاعتراف به ومن خلال المخاطرة بالحياة التي ينطوي عليها ذلك. إن الإنسان إنسان فقط إلى الحد الذي يريد أن يفرض نفسه على إنسان آخر، ليتعرف عليه… إذا بقي أحد الخصمين على قيد الحياة ولكنه قتل الآخر، فلن يتمكن الآخر من التعرف عليه ؛ فالإنسان المهزوم والمقتول لا يعترف بانتصار المنتصر. لذلك، لا يجدي الرجل المقاتل أن يقتل خصمه. إنه يجب عليه أن يتغلب عليه “جدليا”. أي أنه يجب عليه أن يترك له الحياة والوعي، وأن يدمر فقط استقلاليته. و بمعنى آخر، إنه يجب أن يستعبده.
برفضه المخاطرة بحياته في صراع من أجل الهيبة الخالصة، لا يرتقي العبد فوق مستوى الحيوانات. ومن ثم فهو يعتبر نفسه كذلك، ويعتبره السيد كذلك. لكن العبد، من جانبه، يعترف بالسيد في كرامته الإنسانية وواقعه، ويتصرف العبد وفقًا لذلك.
السيد ليس الوحيد الذي يعتبر نفسه سيدًا. بل فإن العبد أيضًا يعتبره كذلك. ومن ثم فهو معترف به في حقيقته الإنسانية وكرامته. لكن هذا الاعتراف أحادي الجانب، لأنه لا يعترف بدوره بحقيقة العبد وكرامته. ومن ثم، فهو معترف به من قبل الذي لا يعترف هو به . وهذا هو المأساوي في وضعه. لقد حارب السيد وخاطر بحياته من أجل الاعتراف الذي لا قيمة له بالنسبة له، لأنه لا يمكن أن يكتفي إلا بالاعتراف به من شخص يرى أنه يستحق الاعتراف به. إن موقف السيد هو بمثابة مأزق وجودي.
فالسيد ثابت في كونه السيد . فهو لا يستطيع أن يتجاوز نفسه، أو يتغير، أو يتقدم، أما بالنسبة للعبد فلا شيء ثابت لديه . إنه يريد أن يتجاوز نفسه من خلال نفي وضعه المعطى . فهو لديه مثال إيجابي يجب عليه تحقيقه، مثال الاستقلال الذاتي، والوجود لذاته. فالسيد يجبر العبد على العمل. عندما يصبح العبد سيد الطبيعة عن طريق العمل، يحرر نفسه من طبيعته الخاصة به ، وبالتالي، فإن المستقبل والتاريخ لا ينتميان إلى السيد المحارب، الذي إما أن يموت أو يحافظ على نفسه إلى أجل غير مسمى في هويته لنفسه، بل ينتميان إلى العبد العامل.
إن السيد الذي لا يعمل لا ينتج شيئًا ثابتا خارج نفسه. إنه فقط يدمر منتجات عمل العبد. فالعمل يُقمع الرغبة، فهو يُشكل ويُثقف. إنه لا يمكن للعبد أن يعمل لدى سيده إلا من خلال قمع رغباته . ومن ثم فهو يتجاوز نفسه بالعمل ، أو ربما على نحو أفضل ، بتثقيف نفسه.
لا يحقق الإنسان استقلاله الحقيقي، حريته الحقيقية، إلا بعد المرور عبر العبودية، وبعد التغلب على الخوف من الموت من خلال العمل الذي يؤديه في خدمة الآخر، وبدون العمل الذي يحوَل العالم الموضوعي الحقيقي، لا يستطيع الإنسان أن يغيَر نفسه حقًا.
لا يمكن للسيد أن ينفصل أبدًا عن العالم الذي يعيش فيه، وإذا هلك العالم فهو يهلك معه. فالعبد وحده هو الذي يستطيع أن يتجاوز العالم المعطى ولا يهلك. العبد وحده هو الذي يستطيع تحويل العالم الذي يشكله ويثبته في العبودية ويخلق عالماً قام بتشكيله والذي سيكون فيه حراً. والعبد لا يحقق ذلك إلا من خلال العمل القسري الذي يتم في خدمة السيد. ومن المؤكد أن هذا العمل في حد ذاته لا يحرره، ولكن من خلال تحويل العالم بواسطة هذا العمل، فإن العبد يحول نفسه أيضًا، وبالتالي يخلق الظروف الموضوعية الجديدة التي تسمح له بخوض النضال التحرري مرة أخرى من أجل الاعتراف الذي رفضه في البداية خوفًا من الموت. وهكذا، على المدى الطويل، فإن كل العمل العبودي لا يحقق إرادة السيد، بل إرادة العبد – غير الواعي في البداية – الذي ينجح أخيرًا حيث يفشل السيد بالضرورة.
جاك لاكان مدين بشدة للفكر الهيغلي. في الواقع، فقد كتب أحد النقاد أنه ليس من المبالغة القول إن المرحلة الأولى بأكملها من عمل لاكان كمحلل نفسي من عام 1936 إلى عام 1953 قد سيطر عليها تفصيل هذه الرؤية الهيغلية لمعضلات الوعي الذاتي وحلها.
أعتقد أن لاكان يعتمد على عمل هيغل بالطرق التالية. لقد أثر تحليل هيغل لوضع السلطة بين السيد والعبد واعتمادهما المتبادل بشكل كبير على لاكان الذي، كما سنرى، غالبًا ما يشير إلى جدلية السيد والعبد ويستخدمها. ثانيًا، أود أن أزعم أن حكاية هيغل حول كيفية سعي السيد والعبد للاعتراف بالرغبة تشكل جزءًا أساسيًا من فكر جاك لاكان.
يقال أن لاكان جمع بين مفهوم فرويد للرغبة الجنسية ومفهوم هيغل للاعتراف لإنتاج مفهومه الخاص عن الرغبة. بالنسبة إلى لاكان، لا توجد علاقة بسيطة بين الرغبة والموضوع الذي يرضيها؛ في الواقع، فهو يبين كيف ترتبط الرغبة بطريقة معقدة برغبة الآخر.
رغم أن انتقادات جاك لاكان للاستقلالية المطلقة للذات التي تفترضها الوجودية، إلا أنه يرى في سارتر زميلا هيغليا. عندما يرغب لاكان في مناقشة مشاكل التناوب والتأرجح الوجداني ، فإنه غالبًا ما يتجه نحو تحليل جدلية الذات والآخر، وأن ترى ، وأن تكون مرئيا ، والإذلال والسيطرة التي نجدها في كتاب سارتر ” الوجود والعدم” .
دعوني أن ألخص بإيجاز بعض التشابهات بين خطابات لاكان وسارتر.
لقد وصف لاكان الوجود والعدم كقراءة أساسية للمحللين النفسيين بسبب حدة عرضها للآخر وللتحديق.
يعتقد سارتر أن التحديق لا يقع فقط على مستوى العينين.
و قد لا تظهر العينان, حيث قد تكونان مقنَعتين. إن التحديق ليس بالضرورة في وجه زميلنا في الوجود؛ إذ يمكن أن تكون بنفس السهولة النافذة التي نفترض أنه ينتظرنا خلفها. إنها علامة X، الموضوع الذي عندما تواجهه الذات يصبح كائنًا.
لدى لاكان أشياء مهمة أيضا ليقولها حول هذا الموضوع. إن العيون، باعتبارها إحدى أشكال لوصول اللبيدو لاستكشاف العالم، قد تصبح أداة ” للمحرك المنظوري “. إنه يجب أن نتذكر أنه ليس مجرد بحث عن المتعة ، ولكنه يكون محصورا في النظام الدلالي ، وتأتي عملية الدلالة هذه لتؤثر على كل النظر .
فالعين ليست مجرد عضو للإدراك، ولكنها أيضًا عضو للمتعة، وطبعا هناك فرق بين العين والنظر.
إنه يمكن بطريقة ما أن يتم الاستيلاء على الذات بواسطة ومن قبل الشيء الذي تنظر إليه. وكما يشير لاكان: ” إنها بالأحرى هي ما يستوعبني” .
يوصي لاكان بفينومينولوجيا سارتر لكونها قراءة أساسية وذلك لأنها يمكن أن تساهم في فهمنا للبيذاتية . ويُحكم على فينومينولوجيا “الوقوع في الحب” الأخيرة بأنها “لا يمكن دحضها”.
يعتقد سارتر أن الذات تظل معارضة للآخر بشكل لا يمكن إصلاحه. وبالاعتماد على مثل هيجل الخاص بالعلاقة بين السيد والعبد، يعيد سارتر تفسير الصراع من أجل الاعتراف ويجادل بأن محاولة كل ذات لاختزال ذات أخرى إلى مجرد شيء أمر مستحيل. فالذي يحدث هو هذا: بالنسبة للشخص الآخر، الذي ينظر إليَ من الخارج، أبدو موضوعا ، و شيئًا؛ و تفلت ذاتيتي مع حريتها الداخلية من بصره. ومن ثم فإن ميله دائمًا هو إلى تحويلي إلى الشيء الذي يراه. إن تحديق الآخر يخترق أعماق وجودي، ويبرَده ويجمده، وهذا هو ما يحول الحب إلى صراع دائم وفقا لسارتر .
يرغب المحب في امتلاك معشوقه، لكن حرية المحبوب لا يمكن امتلاكها؛ ومن هنا يميل المحب إلى اختزال المحبوب إلى شيء من أجل امتلاكه. الحب مهدد دائمًا بالتأرجح الدائم بين السادية والمازوشية. في حالة السادية أقوم باختزال الآخر إلى مجرد كتلة، أتعرض للضرب والتلاعب كما أشاء، بينما في حالة المازوشية أقدم نفسي كشيء، ولكن في محاولة للإيقاع بالآخر وتقويض حريته.
إن أحد المفاهيم المهمة في فكر لاكان هو الرغبة، وهذا بالطبع هو أحد مصطلحات ثالوث : الحاجة – الطلب – الرغبة.
سأحاول أن أشرح باختصار معنى هذه المصطلحات. يبدأ لاكان ، مثل معلمه هيغل، من تجربة الحاجة الجسدية. نحن ندرك جميعًا أن الطفل يعتمد لفترة طويلة على الآخرين لتلبية احتياجاته الأساسية، ويمكن تعريف الحاجة بمصطلحات بيولوجية بشكل أساسي. ويرى لاكان أن تحوَلًا حاسمًا يحدث عندما يبدأ التعبير عن نداء الطفل لإشباع مطالبه باللغة، حيث أن طلب الإشباع أصبح الآن مصحوبًا بالتماس الاعتراف به باعتباره موضوع الحاجة إلى الإشباع. وهذا ما يسميه لاكان ” الطلب “. من هذه العملية ينبعث ما يصطلح عليه لاكان بالرغبة . إن الرغبة هي ما يتجاوز الطلب وينقل رغبة الذات في الكل Totality ، وهو ما لا يمكن أن يتحقق أبدا .
أذكر هذا لأن هناك عدة روابط وثيقة بين مفهوم الرغبة عند لاكان وسارتر.
إن مصطلح الرغبة لدى لاكان يأتي من هيغل، عبر ألكسندر كوجيف، و الفينومينولوجيا . يتحدث سارتر عن الإنسان الممزق بين “الرغبة في أن يكون” و”الرغبة في أن يملك “. بالنسبة لكل من سارتر و جاك لاكان فإن تعريف الرغبة يتم من حيث ” الافتقار إلى الوجود”.
يمكن أيضًا العثور على بعض أوجه التشابه بين “مرحلة المرآة” عند لاكان وأعمال سارتر المبكرة. وفي كلتا الحالتين، يُنظر إلى الأنا ego على أنه تمثيل وهمي، ومصدر وبؤرة للاغتراب. تستخدم الاستعارات البصرية من قبل كلا المؤلفين.
لقد قدم لاكان مرحلة المرآة في عام 1936. ومع مرحلة المرآة، بدأ لاكان العمل مع مفهوم الذات الإنسانية التي لا تملك وحدتها الخاصة بها في نفسها، ولكن مع الذات التي تجد وحدتها فقط في الآخر، من خلال الصورة في المرآة . ويعطينا هذا الرحم الذي ينشأ منه الاعتماد الأساسي على الآخر، وهو علاقة غير محددة على أساس اللغة وإنما على أساس الصورة.
من الناحية الفلسفية، تستمد مرحلة المرآة إلهامها عند لاكان من هيغل كوجيف، في حين أن الفينومينولوجيا المحضة عند سارتر تدين بإلهامها الأساسي لهوسرل. إنه يجب أن أضيف، بين قوسين، أنه رغم تأثر لاكان بالوجودية السارترية ، إلا أنه كان ينتقدها أيضًا. فهو لم يستطع قبول تشاؤمها الكئيب، وإيمانها بالوعي الذاتي، والبحث عن الحرية في وضعية العبودية، وإنكارها لفعالية الفعل.
تشابه آخر بين لاكان وسارتر هو اهتمامهما بهيدغر . يشير لاكان بشكل معتبر إلى فكر هيدغر ، وعلى وجه التحديد إلى هيدغر “الوجودي” في كتابه الوجود والزمان. ومع نشر هذا الكتاب، وهو أول عمل رئيسي له، في عام 1927، أعاد هيدغر صياغة منهج هوسرل الأصلي وأعطى الفينومينولوجيا توجها وجوديا. فبدلاً من أن يسأل ماذا يعني أن تعرف، فهو يسأل ماذا يعني أن تكون؟
وبعد ثلاثينيات القرن العشرين، مر تفكير هيدغر بـ “منعطفه” الشهير من فينومينولوجيا الوجود الإنساني- بالاستناد إلى الوصف الملموس لأمزجة الإنسان ومشاريعه باعتباره كائنًا في العالم- إلى فينومينولوجيا اللغة التي أكدت على أسبقية كلمة الوجود على الذات الإنسانية. في هذا العمل اللاحق، يحاجج هيدغر أن اللغة تعمل شعريًا باعتبارها ” بيتًا للوجود” حيث يتم تعزيز التفكير الحقيقي، وفي نظره نحن لا نقدم اللغة لأنفسنا؛ بل فإن اللغة هي التي تقدم نفسها لنا وتتحدث من خلالنا.
وفقًا لهيدغر ، فأنا لست نوعا من الكوجيتو ” الأنا افكر” الذي يطفو بحرية، ولكنني أرث عالمًا ليس من صنعي، عالمًا أُلقي بي فيه. أظل حرًا في اختيار الطريقة التي سأعيد بها صياغة معاني هذا العالم لنفسي من أجل إبرازها في أفق مفتوح من الاحتمالات المستقبلية. يرى هيدغر أن الإنسان ليس شيئًا ثابتًا بين الأشياء، وليس كيانًا متطابقًا ذاتيًا؛ إنه كائن يصل دائمًا إلى ما هو أبعد من نفسه نحو العالم، نحو آفاق من المعنى تتجاوز حالته الحالية. إن جوهر الإنسان هو الزمانية، لأننا لا نستطيع أن نفهم أنفسنا في الحاضر إلا من خلال الرجوع إلى الآفاق الزمنية لوجودنا، أي من خلال تذكر ماضينا وإسقاط مستقبلنا..
من وجهة نظر هيدغر ، لا يمكن للفكر الإنساني أبدًا أن يرتقي بنفسه من انغماسه في الماضي إلى موقع النظرة البانورامية الشاملة . فهو يعتقد أن محاولتنا لفهم تجذرنا في الماضي مدفوعة بالحاجة المستعجلة إلى إقامة علاقة أصيلة مع إمكانيات وجودنا التي لم تتحقق بعد. يتقاسم لاكان تأكيد هايدجر على البعد الزمني للمستقبل. من وجهة النظر هذه، لا يمكن النظر إلى أفعال الذات / الانسان على أنها محددة سببيًا بماضيها أو بماضيه ؛ ولكن الأهم هو التأويل . بالنسبة إلى لاكان، فإن الكيفية التي نفهم بها ماضينا هي التي تحدد كيف يحددنا هذا الماضي ، لكن هذا الفهم يرتبط في حد ذاته ارتباطًا وثيقًا بتوجهنا نحو المستقبل.
يعتبر هيدغر في كتابه ” الوجود والزمان ” أن الزمانية Temporality هي ” الوجود نحو ” ، وهو نمط توقعي للوجود. في تنظير لاكان لمرحلة المرآة هناك أيضًا بعد زمني وبصري. وفي مرحلة المرآة تتضمن الطبيعة المخادعة أو المغربة ( من الاغتراب ) لتماهي الأنا توقعا و بُعدًا مستقبليًا .
إن مركز اهتمام هيدغر هو معنى الوجود ، ويقود هذا المسعى إلى اللغة حيث يتجلى فيها الوجود. فاللغة تتحدث الوجود مثل التفكير. إن التفكير عند هيدغر ، وخاصة في أعماله اللاحقة، يكشف أن اللغة تتحدث عن الوجود، والوجود، بصفته كذلك يسكن في اللغة. هناك أوجه التشابه التالية بين هيدغر و لاكان: كلاهما يرفض وجهة النظر التقليدية القائلة بأن اللغة أداة لتوسيع إرادة الإنسان. فهما يتفقان مع العبارة التالية: “يتصرف الإنسان كما لو كان هو صانع اللغة وسيدها، بينما تظل اللغة في الواقع سيدة الإنسان”، وكلاهما يشير بطرق مختلفة، إلى أننا مغلق علينا في سجن اللغة. لا هيدغر ولا جاك لاكان مهتمان بمجرد التفسير ؛ بل فهما مهتمان أكثر بالتوضيح وبالإضاءة. إنهما لا يريدان أن يعلما ( من الإعلام ) بل أن ينفخا الحياة.
أعتقد أن قراءة لاكان لهيدغر كان لها تأثير كبير على تفكيره في اللغة ، فاسمحوا لي أن أعطي مثالا. إن فكرة لاكان عن الكلام الفارغ والمملوء تدين بشيء ما لـــ (الكلام الخامل) ولــ (الخطاب) عند هيدغر. بينما يرتبط ” الكلام الخامل ” بالنميمة والثرثرة، فإن ” الخطاب ” يتعلق بالكشف عن الحقيقة والوجود.
يعتقد لاكان أن الخطاب الفارغ هو خطاب مغترب وغير أصيل؛ أما الكلام المملوء فيعني التوقف عن التحدث عن النفس كشيء.