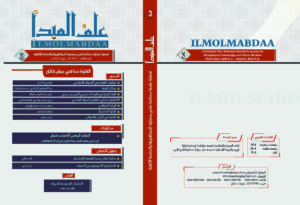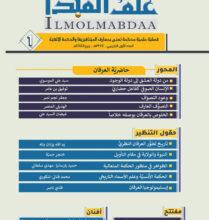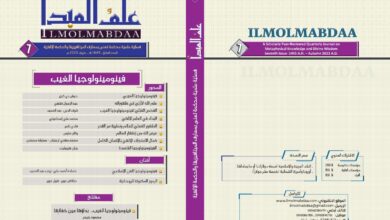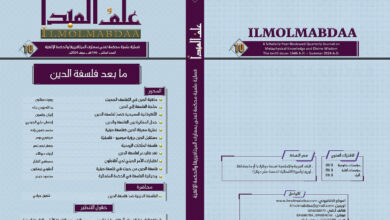فصليّة "علم المبدأ"
“علم المبدأ” العدد الثاني عشر
مجلَّة “علم المبدأ”(العدد الثاني عشر)
ميتا – فيزياء السؤال
دربة الاستفهام عن الله والإنسان والكون
صدر مؤخرًا العدد الثاني عشر من مجلة “علم المبدأ”، وهي فصليَّة علميَّة محكَّمة تُعنى بمعارف الميتافيزيقا والحكمة الإلهيَّة، وجاء محوره تحت عنوان: “ميتا – فيزياء السؤال / دربة الاستفهام عن الله والإنسان والكون”.
احتوى العدد أبحاثًا ودراساتٍ معمقةً حول الموضوع، وشارك فيه جمعٌ من المفكِّرين والأكاديميين من العالمين العربي والإسلامي، وعدد من دول العالم الغربي.
في أبواب العدد نقرأ ما يلي:
* في الـ “مفتتح”: كتب رئيس التحرير د. محمود حيدر مقالة افتتاحية بعنوان: “السؤال في عين كونه جوابًا”، وفيها محاولة تأصيلية لميتافيزيقا الترابط التكويني بين السؤال وجوابه أنَّ هذا الترابط ينقلنا إلى حقلٍ معرفيٍّ نميل إلى وصفه بـ “الوقوع الذاتيِّ” للإجابة في قلب الاستفهام. و”الوقوع الذاتيُّ” في رأي الكاتب، هو ذاك الذي يشير إلى واحديَّة السؤال والجواب، واستحالة انفكاك أحدهما عن نظيره. فالسؤال الخطأ لا مناص له من الجواب الخطأ. والمنطق نفسه يصحُّ كذلك على السؤال الصائب وجوابه. بهذا سنكون بإزاء كائنيَّة واحدة، مهمَّتها الاستفهام والتعرُّف على ما تختزنه حضرات الوجود من لطائفَ وكثائفَ لا حصر لها.
* في “المحور”: نقرأ مجموعة من الدراسات والأبحاث ترتَّبت على النحو التالي:
– بحث للَّاهوتي والمفكِّر الإيرلندي أليستر ماكغراث عنوانه ” الاستفهام القلق عن الله / اختباراتي الشخصيَّة مع اختبارات ريتشارد دواكينز الإلحاديَّة”، ويتحدث فيه حول جدوى أطروحات داوكينز المستندة إلى العلم، والتي تهدف إلى إبطال الاعتقاد بوجود الله، معتبرًا أنَّ إلحاده لم يكن حالة عارضة في مسيرته المضطربة، وإنَّما كان على صلة وطيدة بعلومه المكتَسبة وطريقة تفكيره المتأثِّرة إلى حدٍّ بعيد بمناخات العلْمَنة والنزعات الإلحاديَّة التي شاعت بقوة في المجتمعات الغربيَّة الحديثة.
– مهدي زماني، الباحث في الفلسفة والكلام عضو الهیئة العلميَّة بجامعة ” پیام نور”- إيران، قدَّم بحثًا بعنوان “في السؤال عن سرِّ العماء في الكنز المخفيِّ – استشرافات الحكمة المتعالية”، وفيه يستعرض رؤية مؤسِّس الحكمة المتعالية صدر الدين الشيرازي (الملَّا صدرا)، وشُرَّاح مدرسته؛ أوَّلًا لجهة أنَّ غاية الله في (فخلقتُ) هي التّشوُّق لذاته ولغيره من الموجودات، وكذلك لجهة أنَّ «الكنز المخفيَّ» يشير إلى مرتبة الأحديَّة الصّرفة، أي كُنه الذّات.
– الباحث و الأكاديمي المغربي جميل حمداوي، يكتب حول “السؤال عن السؤال في فلسفة الحداثة/ قراءة في حفريَّات الفيلسوف البلجيكي ميشيل مايير”، وفيه يرى أن الفلسفة الغربيَّة حاولت أن تبني أنساقها ومناهجها اعتمادًا على السؤال الفلسفيِّ الميتافيزيقيِّ، ولكنَّها لم تفكِّر في بناء فلسفات وأنساق وشذرات تهتمُّ بسؤال السؤال كما فعل الفيلسوف البلجيكيُّ المعاصر ميشيل مايير، ويعني هذا أنَّه لم يكن هدفها التفكير في السؤال أو الأسئلة التأسيسيَّة الجوهريَّة، بل كانت تطرح الأسئلة لبناء مواضيعها الفلسفيَّة والميتافيزيقيَّة.
– الباحثة الجزائرية نورة بوحناش، أستاذة الأخلاق وفلسفة القيم بقسم الفلسفة في جامعة قسنطينة 2 – الجزائر، قدمت مقارنة نقدية بين المفكرَين المغربيَّين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن، حملت عنوان “السؤال العرفاني وجدل الإحياء”، رأت فيها أنَّ المناظرة التي جرت بين المفكِّرَين المذكورين مثَّلت لحظة مهمَّة في مسار جدل النهضة؛ حيث اختصرت فلسفة الجدارة في ما يخصُّ الوسيلة التي يجب اتِّباعها.
– الباحث المصري غيضان السيد علي، أستاذ الفلسفة في كليَّة الآداب بجامعة بني سويف – مصر، يكتب تحت عنوان “السؤال السقراطي وغاياته”، مقدِّمًا مقاربة نقديَّة لطريقة الاستفهام المفتوح، تساءل فيها: كيف تستقيم نظريَّة سقراط في المعرفة مع ادِّعاءه أنَّه لا يعرف سوى أنَّه لا يعرف؟ وهل تأتي المعرفة من الخارج أم أنَّها عمليَّة تذكُّر؟ وكيف وَحَّدَ سقراط بين المعرفة والفضيلة، وإلى أيِّ مدى وُفِّقَ في ذلك؟
– “سؤال الحداثة العاثر عن الله” هو عنوان محاضرة قدَّمها أستاذ الفلسفة في جامعة مونتريال – كندا جورج هلال، وطرح فيها السؤال: مَن خلق مَن، الله أم الدماغ البشري؟، معتبرًا أنَّه ليس جديدًا على مدوَّنات الحداثة، فقد استهلك مساحة واسعة من الجدال في خلال القرون المنصرمة، لكنَّه يعود اليوم بقوة في سياق الجدل المستأنف بين التيَّارات الإلحاديَّة والإيمان الدينيِّ المعاصرة في الغرب.
– الباحث في الفلسفة الإسلاميَّة والتصوُّف في مصر، بهاء الدين سيد علي أحمد زيدان، قدَّم بحثًا بعنوان “أنطولوجيا السؤال في المسائل الصقليَّة”، أجرى فيه تحليلًا للاستراتيجيَّات الخطابيَّة التي استخدمها فريدريك الثاني في توضيح مقاصده الخاصَّة بمجموع الأسئلة الفلسفيَّة التي وجَّهها لإبن سبعين، إذ يرصد الآليَّات التي تمكِّنه من الوصول إلى المعاني غير المباشرة بوساطة المعاني المباشرة. وهو يستمدُّ أهميَّته من دراسته للاستفهامات الفلسفيَّة القائمة على محورَيْ السؤال والجواب في نموذج من مدوَّنة تراثيَّة معروفة، هي كتاب “الكلام على المسائل الصقليَّة”.
– الأكاديمي التونسي مفتاح حلَّاب، من جامعة جندوبة – تونس، تناول في دراسته المعنوَنة: “الاستفهام عن سر الأنوثة لدى ابن عربي”، مفهوم الشيخ الأكبر للسر الوجودي في الأنوثة، وفيه استعادة للوصايا الأكبريَّة في ظلِّ تحوُّل التصوُّف إلى وجهة فاضلة لأحرار العالم، هروبًا من جحيم الحداثة وما بعدها، وما آلت إليه العولمة من مادّيَّة «فاحشة» أعادت إلى الواجهة ظاهرة استغلال الجسد وتسليع المرأة.
– “الضجر وسؤاله عند هايدغر” عنوان البحث الذي قدَّمه الباحث اللبناني فرانك درويش أستاذ الفلسفة الغربيَّة المقيم في فرنسا، وطرح فيه تساؤلًا عما يحدث لو كانت اللغة العربيَّة مفتاح الألمانيَّة إلى الميتافيزيقا؟ وقد استند الباحث إلى نموذجيَّة مصطلح “الضجر Langeweile ” عند هايدغر، والكيفيَّة التي سيظهر فيها في سياق التصوُّرات الأساسيَّة للميتافيزيقا، وإمكانه نقله إلى الُّلغة العربيَّة بشكلٍ مناسب مع الإشارة إلى أنَّ كلمة واحدة لا تكفي لترجمته بشكلٍ دقيق بسبب من غموضه وتنوع دلالاته.
– تحت عنوان “ميتافيزيقا السؤال / دربة الاستفهام عن الوجود في زمانيَّته ولا زمانيَّته”، يكتب محمود حيدر حول البعد الوجودي والفينومينولوجي للسؤال. حيث يستهدف التعرُّف على ماهيَّة السؤال في مسرى الاستفهام عن الظاهر والمحتجب في الوجود. وذلك يفترض الكشف عن ضربين من الزمان الوجوديّ: أوَّلهما يسأل عن زمن الأشياء والماهيَّات، وثانيهما عن عالم فوق زمانيٍّ هو عالم الغيب المطلق.
* في باب ” حقول التنظير”:
– الباحثة التونسية في الفلسفة لبنى الكوكي كتبت عن “الُّلغة في سؤالها الأنطولوجيّ”، متسائلةً: إلى أيِّ حدٍّ يطابق الإسم ماهيَّته، وأشارت إلى أنَّ البحث في هذا الأمر يعود إلى العصر الإغريقيِّ الأول حيث رأى هيرقليطس أنَّ الأسماء تدلُّ على مسمَّياتها بالطبيعة لا بالاصطلاح، وقد سمِّيت من قبل الآلهة نفسها. وعلى العكس من ذلك اعتبر ديمقريطس أنَّ أصل الُّلغة تواطؤ واتفاق بين البشر. وكانت حجَّته في ذلك أنَّ الشيء الواحد يمكن أن يقْبل الكثرة من المسمَّيات المتبدِّلة والمتغيِّرة.
– نقرأ أيضًا نصًّا مستعادًا للفيلسوف اللبناني الراحل موسى وهبه يقدِّم فيه ترجمة لأحد نصوص هايدغر التأسيسيَّة التي جاءت تحت عنوان: “السؤال عن معنى الكون”، مؤسِّسًا علاقته بمنجز هايدغر الفلسفيِّ، على نحوٍ فَارَقَ فيه مسالك جمعٍ غفير ممَّن اعتنوا بفيلسوف “الكينونة والزمان” شرقًا وغربًا. فهو لم يشأ أن يتقدَّم بمدوَّنة تُعرِبُ عن هاجسُه الميتافيزيقي، أو أن تفصح عمَّا هو مقيمٌ في الصدر، بل كان ما يختزنه العقل والقلب هو أشبه بمركز الجاذبيَّة الذي تحوم حوله الأفكار، فيأنس لها ويلوذ بأحوالها على الرغم ممَّا فيها وبها من شقاء ومشقَّة.
– الباحث المصري غيضان السيد علي، أستاذ الفلسفة في كليَّة الآداب بجامعة بني سويف – مصر، يكتب تحت عنوان “السؤال السقراطي وغاياته”، مقدِّمًا مقاربة نقديَّة لطريقة الاستفهام المفتوح، تساءل فيها: كيف تستقيم نظريَّة سقراط في المعرفة مع ادِّعاءه أنَّه لا يعرف سوى أنَّه لا يعرف؟ وهل تأتي المعرفة من الخارج أم أنَّها عمليَّة تذكُّر؟ وكيف وَحَّدَ سقراط بين المعرفة والفضيلة، وإلى أيِّ مدى وُفِّقَ في ذلك؟
– “سؤال الحداثة العاثر عن الله” هو عنوان محاضرة قدَّمها أستاذ الفلسفة في جامعة مونتريال – كندا جورج هلال، وطرح فيها السؤال: مَن خلق مَن، الله أم الدماغ البشري؟، معتبرًا أنَّه ليس جديدًا على مدوَّنات الحداثة، فقد استهلك مساحة واسعة من الجدال في خلال القرون المنصرمة، لكنَّه يعود اليوم بقوة في سياق الجدل المستأنف بين التيَّارات الإلحاديَّة والإيمان الدينيِّ المعاصرة في الغرب.
– الباحث في الفلسفة الإسلاميَّة والتصوُّف في مصر، بهاء الدين سيد علي أحمد زيدان، قدَّم بحثًا بعنوان “أنطولوجيا السؤال في المسائل الصقليَّة”، أجرى فيه تحليلًا للاستراتيجيَّات الخطابيَّة التي استخدمها فريدريك الثاني في توضيح مقاصده الخاصَّة بمجموع الأسئلة الفلسفيَّة التي وجَّهها لإبن سبعين، إذ يرصد الآليَّات التي تمكِّنه من الوصول إلى المعاني غير المباشرة بوساطة المعاني المباشرة. وهو يستمدُّ أهميَّته من دراسته للاستفهامات الفلسفيَّة القائمة على محورَيْ السؤال والجواب في نموذج من مدوَّنة تراثيَّة معروفة، هي كتاب “الكلام على المسائل الصقليَّة”.
– الأكاديمي التونسي مفتاح حلَّاب، من جامعة جندوبة – تونس، تناول في دراسته المعنوَنة: “الاستفهام عن سر الأنوثة لدى ابن عربي”، مفهوم الشيخ الأكبر للسر الوجودي في الأنوثة، وفيه استعادة للوصايا الأكبريَّة في ظلِّ تحوُّل التصوُّف إلى وجهة فاضلة لأحرار العالم، هروبًا من جحيم الحداثة وما بعدها، وما آلت إليه العولمة من مادّيَّة «فاحشة» أعادت إلى الواجهة ظاهرة استغلال الجسد وتسليع المرأة.
– “الضجر وسؤاله عند هايدغر” عنوان البحث الذي قدَّمه الباحث اللبناني فرانك درويش أستاذ الفلسفة الغربيَّة المقيم في فرنسا، وطرح فيه تساؤلًا عما يحدث لو كانت اللغة العربيَّة مفتاح الألمانيَّة إلى الميتافيزيقا؟ وقد استند الباحث إلى نموذجيَّة مصطلح “الضجر Langeweile ” عند هايدغر، والكيفيَّة التي سيظهر فيها في سياق التصوُّرات الأساسيَّة للميتافيزيقا، وإمكانه نقله إلى الُّلغة العربيَّة بشكلٍ مناسب مع الإشارة إلى أنَّ كلمة واحدة لا تكفي لترجمته بشكلٍ دقيق بسبب من غموضه وتنوع دلالاته.
– تحت عنوان “ميتافيزيقا السؤال / دربة الاستفهام عن الوجود في زمانيَّته ولا زمانيَّته”، يكتب محمود حيدر حول البعد الوجودي والفينومينولوجي للسؤال. حيث يستهدف التعرُّف على ماهيَّة السؤال في مسرى الاستفهام عن الظاهر والمحتجب في الوجود. وذلك يفترض الكشف عن ضربين من الزمان الوجوديّ: أوَّلهما يسأل عن زمن الأشياء والماهيَّات، وثانيهما عن عالم فوق زمانيٍّ هو عالم الغيب المطلق.
* في باب ” حقول التنظير”:
– الباحثة التونسية في الفلسفة لبنى الكوكي كتبت عن “الُّلغة في سؤالها الأنطولوجيّ”، متسائلةً: إلى أيِّ حدٍّ يطابق الإسم ماهيَّته، وأشارت إلى أنَّ البحث في هذا الأمر يعود إلى العصر الإغريقيِّ الأول حيث رأى هيرقليطس أنَّ الأسماء تدلُّ على مسمَّياتها بالطبيعة لا بالاصطلاح، وقد سمِّيت من قبل الآلهة نفسها. وعلى العكس من ذلك اعتبر ديمقريطس أنَّ أصل الُّلغة تواطؤ واتفاق بين البشر. وكانت حجَّته في ذلك أنَّ الشيء الواحد يمكن أن يقْبل الكثرة من المسمَّيات المتبدِّلة والمتغيِّرة.
– نقرأ أيضًا نصًّا مستعادًا للفيلسوف اللبناني الراحل موسى وهبه يقدِّم فيه ترجمة لأحد نصوص هايدغر التأسيسيَّة التي جاءت تحت عنوان: “السؤال عن معنى الكون”، مؤسِّسًا علاقته بمنجز هايدغر الفلسفيِّ، على نحوٍ فَارَقَ فيه مسالك جمعٍ غفير ممَّن اعتنوا بفيلسوف “الكينونة والزمان” شرقًا وغربًا. فهو لم يشأ أن يتقدَّم بمدوَّنة تُعرِبُ عن هاجسُه الميتافيزيقي، أو أن تفصح عمَّا هو مقيمٌ في الصدر، بل كان ما يختزنه العقل والقلب هو أشبه بمركز الجاذبيَّة الذي تحوم حوله الأفكار، فيأنس لها ويلوذ بأحوالها على الرغم ممَّا فيها وبها من شقاء ومشقَّة.