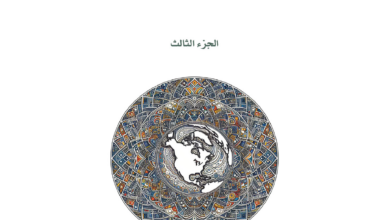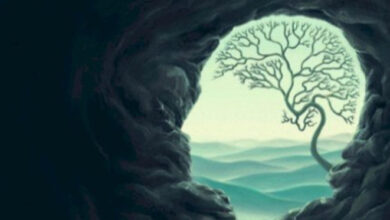مدوّنات د. محمود حيدر
في رحاب الوعي: من ديكارت إلى هايدغر، ومن سبينوزا إلى هوسرل
في رحاب الوعي: من ديكارت إلى هايدغر، ومن سبينوزا إلى هوسرل
“يُعد الوعي من أكثر المفاهيم الفلسفية إشكاليةً وثراءً، وقد مثّل محورًا مركزيًا في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، حيث انطلق من لحظة الشك الديكارتي، ومرّ بمفاهيم الجوهر عند سبينوزا، وتشكل الظاهرات عند هوسرل، وانغماس الكائن في العالم عند هايدغر. كل من هؤلاء الفلاسفة تناول الوعي من زاوية مخصوصة، تكشف عمق رؤيته للعالم والوجود والذات، وتؤسس لمدرسة فلسفية متمايزة.
ديكارت: الوعي كجوهر مفكر مستقل
في قلب المشروع الفلسفي لديكارت، يتجلى الوعي بوصفه جوهرًا مفكرًا قائمًا بذاته، وهو الأساس الذي تقوم عليه كل معرفة يقينية. ففي لحظة الشك الراديكالية، حينما شك في كل شيء – الحواس، الجسد، العالم – لم يستطع أن يشك في فعل الشك ذاته، أي في وجود ذات تشكّ. ومن هنا أطلق عبارته الشهيرة: “أنا أفكر، إذن أنا موجود” (Cogito ergo sum)، والتي شكلت حجر الأساس في الفلسفة الحديثة. الوعي، بالنسبة لديكارت، ليس مجرد حالة شعورية، بل هو ماهية الكائن الإنساني، وهو وجود متعالٍ ومنفصل عن الجسد، أي “جوهر مفكر” يختلف عن “الجوهر الممتد” الذي هو المادة. لقد أقام ثنائية بين النفس والجسد، بين الوعي والمادة، وهو ما سيطلق لاحقًا جدلًا واسعًا في تاريخ الفلسفة حول العلاقة بين الذهن والعالم. في نهاية المطاف، يرى ديكارت أن الوعي يتمتع بنقاء داخلي، وأنه هو الذي يمنح العالم الخارجي معناه ومعقوليته.
هايدغر: الوعي كتجربة وجودية منفتحة على العالم
أما هايدغر، فينسف الفكرة الديكارتية من جذورها، ويعيد صياغة مفهوم الوعي في أفق وجودي يربطه بـ”الكائن في العالم” (Dasein). فالوعي، في فلسفة هايدغر، ليس جوهرًا مفكرًا مستقلاً، بل هو شكل من أشكال الانكشاف الوجودي، إنه انفتاح الكائن الإنساني على العالم من خلال “الهمّ” (Sorge) و”الانشغال” بالوجود. لا يمكن فهم الوعي من خلال التأمل الذاتي المنغلق، بل من خلال علاقة الكائن بالعالم، وبالزمن، وبالآخرين. الكائن البشري، وفق هايدغر، لا يعي ذاته أولًا ثم يتجه نحو العالم، بل هو منغمس منذ البدء في عالم له دلالة، وعليه أن يستخرج إمكاناته الوجودية ضمن هذا الانغماس. الوعي ليس شيئًا داخليًا، بل هو حركة وجودية مشروطة بالزمن والتاريخ والفناء، ولهذا فإن هايدغر يعارض الفهم التقني أو النفسي للوعي، ويعيد ربطه بجوهر الإنسان بوصفه كائنًا مَقدورًا له أن يكون أو لا يكون.
هوسرل: الوعي كتدفق مقصدي ومرآة للمعنى
ينتقل هوسرل بالوعي من مستوى الجوهر الميتافيزيقي إلى مستوى التجربة الظاهراتية المحضة، حيث يؤسس منهجه القائم على “الردّ الفينومينولوجي” (epoché) لتحرير الوعي من الافتراضات الخارجية. الوعي، في فلسفة هوسرل، هو دائمًا وعي بشيء ما، أي أنه مقصدي بطبيعته (Intentionality)، وهو ليس مجرد حالة ذهنية داخلية، بل علاقة حية بين الذات والموضوع. من خلال التحليل الظاهراتي، يصبح الوعي هو الحقل الذي تنكشف فيه الظواهر بوصفها معطيات مباشرة للتجربة. يذهب هوسرل إلى أن كل وعي يحمل داخله بُعدًا زمانيًا، وأن التجربة الحية للوعي تحتوي على تدفق مستمر من “الحاضر”، و”التوقع”، و”التذكر”، وهي ما تؤسس للمعنى. بهذا المعنى، يصبح الوعي ليس فقط شرطًا لإدراك العالم، بل هو ذاته مصدر المعقولية والمعنى. وبهذا، يشكل مشروع هوسرل ثـ. ور . ة معرفية، تنقل مركز الفلسفة من موضوعية العالم إلى ذاتية الوعي كمرآة نقية لتكوين الواقع.
سبينوزا: الوعي كتعبير عن وحدة الكينونة
أما سبينوزا، فقد رفض الثنائية الديكارتية بين النفس والجسد، واعتبر أن الوعي ليس جوهرًا مستقلًا، بل هو نمط من أنماط التجلي داخل الجوهر الواحد، الذي هو “الله أو الطبيعة” (Deus sive Natura). في فلسفته المونيزمية (وحدة الوجود)، ليس هناك انفصال بين الذهن والجسد، بل هما تعبيران عن ذات الجوهر من منظورين مختلفين: الذهني والجسدي. الوعي، إذن، لا ينبثق من “أنا” منعزلة عن العالم، بل هو تدفق ضروري ضمن قوانين الطبيعة. لا مكان للحرية المطلقة أو الإرادة الحرة بالمعنى الكلاسيكي، بل الوعي يتدرج من حالات أدنى (كالإدراك الجزئي) إلى حالات أعلى (كالحدس العقلي)، ويبلغ ذروته عندما يدرك الإنسان أن وجوده جزء من نظام كلي تحكمه الضرورة. وفي هذا الإدراك، يكمن نوع من “الحرية المعرفية”، حيث يتحرر الإنسان من الأوهام والانفعالات، ويحقق نوعًا من السلام العقلي، أو ما يسميه سبينوزا بـ “حب الله العقلي”.
يتضح من تتبع هذه الرؤى المتنوعة أن مفهوم الوعي في الفلسفة ليس فكرة ثابتة، بل هو مرآة لتحولات الفكر الإنساني من الذاتية الميتافيزيقية إلى التجربة الوجودية، ومن التأمل العقلي إلى الانخراط الظاهراتي، ومن الانقسام الثنائي إلى الوحدة الكونية. كل فيلسوف منهم قدّم بناءً مفاهيميًا عميقًا للوعي، يعكس عصره، وينير عصورًا بعده. فمن الكوجيتو الديكارتي إلى الدازاين الهايدغري، ومن القصدية الهوسرلية إلى الضرورة السبينوزية، يبقى الوعي لغزًا حيًّا، مفتوحًا على الأسئلة، ومفعمًا بالإمكانات.”
د. حمدي سيد محمد محمود