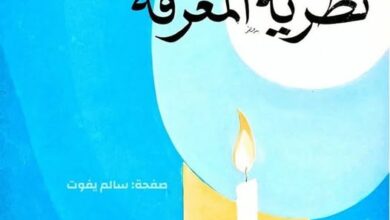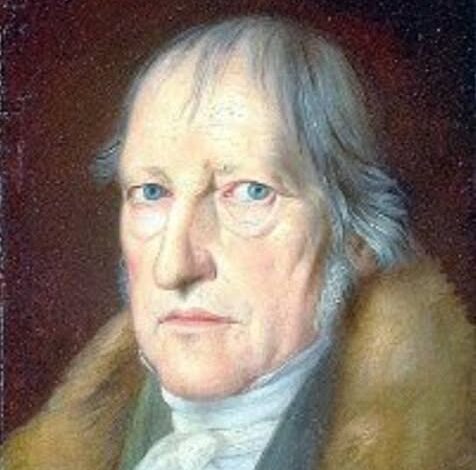
دراسات وبحوث معمقة
الأنساق والموقف المضاد لها في الفكر الحديث والمعاصر
الأنساق والموقف المضاد لها في الفكر الحديث والمعاصر
منذ بروز فلاسفة البنيوية، وما بعد البنيوية، وما بعد الحداثة، والنقاش يدور حول شرعية الأنساق الفكرية والفلسفية لعصر التنوير والنهضة بأوروبا. فما هي المشكلات المعرفية الكبرى التي يقدمها هذا النقاش الساخن في الغرب على نحو متميز؟ هذا ما يحاول هذا النص الذي كتبه مؤرخ الأفكار البريطاني مدان صاروب شرحه.
ترجمة البرفسور عمر ازراج
خلال السنوات الثلاثين الماضية، أو نحو ذلك، قام البنيويون وما بعد البنيويين ببعض الإضافات المهمة جدا من أجل فهم الإنسان، ولقد أنتج كل من ليفي ستروس، وجاك لاكان، وجاك دريدا، وميشال فوكو، وجيل دولوز، وجان فرانسوا ليوتار مجموعة من الأعمال المؤثرة. رغم أن البنيوية، وما بعد البنيوية مختلفتان، فالنظرية الأخيرة مثلا لا توظف الألسنيات البنيوية في أعمالها، ولكن بينهما بعض التشابهات. إن كلا الطريقتين تقومان بالنقد كما يلي:
ـ أولا، هناك الذات البشرية. إن مصطلح الذات يعود إلى شيء مختلف إلى حد ما عن المصطلح المألوف الذي هو ”الفرد”، فالمصطلح الأخير يؤرخ له ابتداء من عصر النهضة، ويفترض بأن الإنسان حر وقوة فكرية، وأن هذه العمليات الفكرية لا تفرض بالإكراه من قبل الظروف التاريخية أو الثقافية. إن فكرة العقل هذه قد تم التعبير عنها في العمل الفلسفي لـ”ديكارت”. لنأخذ بعين الاعتبار هذه العبارة: ”أنا أفكر، إذا أنا موجود”. إن ”أنا ديكارت” تفترض نفسها أن تكون واعية تماما، ومن ثم فهي المعرفة الذاتية SELF KNOWLEDGE، إنها ليست مستقلة ذاتيا فقط، وإنما هي متماسكة. كما أن الفكرة القائلة بوجود ”منطقة نفسية” مناقضة للوعي، لا يمكن تصورها.
يقدم لنا ديكارت في إنتاجه روائيا يتصور بأنه يتكلم بدون أن يكون متكلما في آن معا. ولقد سمى ليفي ستروس الذات البشرية (مركز الوجود) بطفل الفلسفة المدلل، وأعلن ستروس بأن الغرض النهائي للعلوم الإنسانية ليس لكي تؤسس الإنسان، وإنما من أجل أن تذيبه، وأصبح هذا بعدئذ شعار البنيوية.
أما فيلسوف اليسار البارز لوي ألتوسير، فقد ذوب الذات، وذلك في رد فعله ضد المذهب القائل بالاختيارية، فهو قد فعل ذلك بواسطة تأويل الماركسية كنظرية غير إنسانوية. إن هذه القراءة قد سرعت تقدم البنيوية. لقد حاول ألتوسير بعد أحداث 8691 أن يعدل أو يكيف نظريته، ولكنه لم يطور عمله بصفة إجمالية، وقد كانت النتيجة هي طمس وانحلال الماركسية الألتوسيرية التدريجية في أواسط السبعينات من القرن العشرين. يريد ما بعد البنيويين، أمثال ميشال فوكو، أن يفككوا المفاهيم ”التصورات” التي فهمنا بواسطتها ـ وحتى الآن ـ الإنسان. إن مصطلح الذات يساعدنا أن نعتبر حقيقة الإنسان كبناء وكثمرة نشاطات دالة، وكلاهما خاصيتان ثقافيتان.
إن مقولة الذات تضع محل التساؤل فكرة الترادف الذاتي مع الوعي، وتزيح الوعي من المركز. إذا، فإن ما بعد البنيويين يريدون إذابة الذات أيضا على نحو ما، لذا يمكن القول بأن جاك دريدا، وميشال فوكو لا يملكان نظرية الذات. إن الاستثناء هو جاك لا كان الذي كرس نفسه لبناء ”نظرية الذات”، بسبب تكوينه الفلسفي الهيجلي، وتكريس نفسه للتحليل النفسي.
إن أغلب ما لا تفهمه هذه النظريات هو أن البنية والذات مقولاتان متواقفتان (من التواقف)، حيث تعتمد فكرة البنية المستقرة حقا على تمايز الذات عنها• إن الفرد يستطيع أن يرى بأن الهجوم على الذات، كله كان يميل إلى أن يدمر في الوقت نفسه فكرة البنية أيضا.
نقد التاريخانية:
-ثانيا، فإن البنيوية ومع بعد البنيوية كلاهما تقدمان نقدا للتاريخانية، إنهما تكنان كراهية للفكر القائلة بأن هناك نمطا إجماليا في التاريخ. هنالك مثال مشهور وهو نقد كلود ليفي ستروس لـ”سارتر”، وذلك في كتابه ”العقل البشري”، حيث يهاجم رأي سارتر في المادية التاريخية، وافتراضه بأن مجتمع الوقت الحاضر أعلى من ثقافات الماضي.
ويواصل ليفي ستروس بعدئذ قائلا بأن نظرة سارتر التاريخانية للتاريخ ليست مشروعا معرفيا صالحا، وسوف نرى في المناقشة التالية بأن ميشال فوكو يكتب عن التارخ بدون أن يملك فكرة التقدم، وأن جاك دريدا يقول بأنه لا توجد نقطة النهاية في التاريخ.
– ثالثا، هنالك نقد للمعنى، حينما كانت الفلسفة في بريطانيا تحت تأثير نظريات اللغة القوى في السنوات الأولى من القرن العشرين (إنني أفكر في أعمال فيتغنشين، وآير، وآخرين) لم يكن الحال كذلك في فرنسا. بشكل ما، فإنه يمكن القول بأن البنيوية هي مدخل اللغة المؤجل في الفلسفة الفرنسية، ربما يمكن التذكير بأن فرديناند دي سوسير قد ألح على التمييز بين ”الدال” و”المدلول”، فالصوت الصورة المشكلة بواسطة كلمة ”تفاحة” هي الدال، ومفهوم التفاحة هو المدلول، فالعلاقة البنيوية بين الدال والمدلول تؤسس العلامة اللسانية، وأن اللغة مصنوعة من ذلك. إن العلامة اللسانية ”اعطباتية”، ويعني هذا بأنها ترمز إلى شيء ما وفقا للعرف والاستخدام المشترك، وليس وفقا للضرورة.
لقد أكد دي سوسير أيضا على قضية، وهي أن كل ”دال” يكتسب قيمته الدلالية فقط بفضل وضعه المتميز في داخل بنية اللغة. ففي هذا التصور للعلامة، هناك توازن غير ثابت بين الدال والمدلول. فالمدلول بحسب ما بعد البنيوية، قد أنزلت درجته، وجعل الدال مسيطرا. إنني أتحدث بشكل واضح وواسع، ويعني هذا أنه لا يوجد تشابه الواحد للواحد بين المقولات والحقيقة (الواقع). إن جاك لاكان يكتب، مثلا، حول الانزلاق المتواصل للمدلول تحت الدال. ويذهب جاك دريدا الفيلسوف ما بعد البنيوي إلى أبعد من ذلك، إنه يعتقد في منظومة من ”الدوال” العائمة الطافية والبسيطة، بدون علاقة حتمية على الإطلاق مع أي مرجعيات خارج الألسنية.
– رابعا، هناك نقد للفلسفة. في عمله المبكر، كتب لوي ألتوسير حول الممارسة النظرية، محاججا بأن الفلسفة الماركسية كانت علما، وقدم تمييزا واضحا بين كارل ماركس الشاب، الذي كتب من داخل الإشكالية الايديولوجية الهيجيلية، وبين ماركس العجوز الذي كان عالما عظيما، وذلك بفهمه للمفاهيم وللعمليات الاقتصادية.
إنه ينبغي ملاحظة أنه عندما نقل البنيويون اللغة إلى مركز الفكر الفرنسي، فإن ذلك قد مورس بطريقة فلسفية مضادة. أما قبل ذلك، فقد اتخذ منهجا مشابها من طرف ”أوغست كونت” و”دوركايم”.
بعدما لخصنا بعض التشابهات والاستمراريات بين البنيوية وما بعد البنيوية، فإنني أريد أن أذكر بعض معالم وخصائص ما بعد البنيوية. فبينما ترى البنيوية بأن الحقيقة موجودة ”خلف” أو ”داخل” النص، فإن ما بعد البنيوية تلح على تفاعل القارئ والنص كإنتاجية. وبكلمات أخرى، فإن القراءة قد ضيعت مكانتها كاستهلاك سلبي للإنتاج من أجل أن تصبح إنجازا.
إن ما بعد البنيوية تنتقد بصرامة وحدة العلامة المستقرة (النظرة السوسيرية)، فالحركة الجديدة تتضمن قفزة من المدلول إلى الدال. وهكذا، فإن هناك انعطافة دائمة على الطريق إلى الحقيقة التي قد فقدت الوضع، أو النهائية إلى حد ما.
إن ما بعد البنيوية قد قدمت نقدا للمفهوم الكارتيزي (الديكارتي) الكلاسكي القائل بوحدة الذات، أي الذات كمنشئة للوعي، وللسلطة، وللمعنى، وللحقيقة. إن ما بعد البنيوية تحاجج بأن الذات البشرية لا تملك وعيا موحدا، ولكن وعيا مبنيا بواسطة اللغة. وباختصار، فإن ما بعد البنيوية تقتضي ضمنيا نقدا الميتافيزيقا، ومفاهيم العلية، والهوية، والذات والحقيقة• إن كل هذا يبدو في هذه اللحظة صعبا ومجردا، ولكن هذه القضايا ستجد التوضيح في مكان آخر.
هنالك تواصل أكثر بين البنيوية وبين ما بعد البنيوية، بعكس ما بين البنيوية والظاهراتية (الفينومينولوجيا)، ولكن هناك الكثير من المفاجآت والتناقضات.
لقد قام جاك لاكان الفرويدي بدراسة هيجل، ودرس جاك دريدا ما بعد البنيوي إدموند هوسرل، وهيدغر بشكل عميق. كما أن دراسات ميشال فوكو التاريخية مؤسسة على الافتراضات الفلسفية المأخوذة عن نيشته. إن هؤلاء المفكرين يشتركون في موقف سياسي متميز وغير متلائم مع مفهوم البنية، إنه موقف مناهض وإلى حد ما جذريا للعلمي، فهم يضعون تحت التساؤل المكانة الشرعية للعلم نفسه، والإمكانية الموضوعية لأية لغة: لغة الوصف والتحليل، وهم يرفضون الفرضيات المتضمنة في النموذج الألسني لـ”دي سوسير” الذي أسست علية البنيوية”.
الترجمة عن الإنجليزية: أزراج عمر
المصدر : صحيفة العرب اللندنية الخميس 9/10/2008