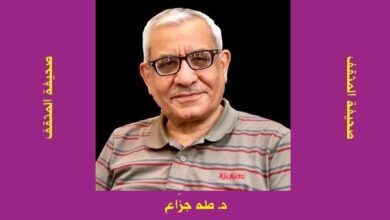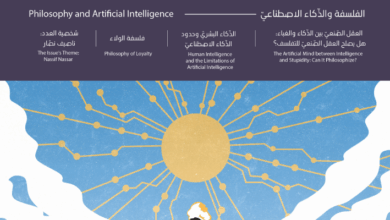مجدي إبراهيم: فلسفة العلوم الدينية لا فلسفة الدين
هل للدين فلسفة؟ والجواب، نعم! له فلسفته، إذا كانت له منطلقاته وقواعده وأحكامه. وكان معناه التأمل فيما يمس بؤرة الشعور الإنساني ويستغرق بالكلية منطق الوجدان، وكيف تُقام فلسفة (والفلسفة تقابل العقل، والعقل يفرز العلم والمعرفة العلميّة) على منطق ندّعيه هو منطق الوجدان؟
هذا سؤال من الأسئلة اللافتة للنظر من الوهلة الأولى غير أنه لافت للنظر مع غيبة البديهة، ولكن مع حضورها لا تجد له معنى.
نعم! تقام الفلسفة على منطق الوجدان كما تقام على منطق القانون أو على منطق اللغة أو على منطق الدين، أو على منطق العلم أو على أي منطق أرادت الفلسفة أن تقيمه. ليس هناك ما يمنع من قيامها على منطق الوجدان مع المعرفة التامة التي لا شك فيها بالفروق الفارقة بين منطق العقل ومنطق الشعور والوجدان؛ لأن هذه المعرفة مع دعوى تمامها ناقصة عجزاء إذا أغفلت بديهة حاضرة، وهى حقيقة الإنسان الأصليّة.
فليس الإنسان يعي أو يعيش بالعقل والفلسفة وحدهما، وليس هو بالشعور والوجدان إنساناً وحده، ولكنه يجمع بينهما في اتساق لا تناقض فيه، إذْ من المؤكد عندنا: استناد الفكر على الوجدان، والعقل على الشعور وهو المقرر هنا فيما لا شك فيه، كما تقرّر سلفاً لدى الإمام محمد عبده، وكما تقرر أيضاً لدى الدكتور محمد إقبال؛ لا بل كما تقرّر قبلاً لدى أفلاطون عندما قال: إنّ التفكير كلام نفسي، وصاغته ملكة الطبع العربي شعراً:
(إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنمّا جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلاً)
على أن توضيح الغرض من أي فلسفة، ولتكن فلسفة العلم (تاريخيّاً) يبدو في كون العلم ظاهرة إنسانية قديمة قِدم الإنسان، نشأت مع ظهوره؛ فاخترع رموز العدّ الرياضية قبل أن يضع الأبجدية المكتوبة؛ فطالما كانت الغاية تطويع البيئة بالسحر تارة، وبالتقنية التي يصيغها له العلم تارة أخرى، تلك الظاهرة المستمرة التي كانت حصيلة مجهودات بشرية متراكمة لم تتوقف أبدًا؛ فقد وضعت حضارات الشرق القديم أصوله، وصاغ الإغريق أسسه النظريّة، ثم اعتنى العرب بترجمته ودَرْسه وتطبيقه في عصورهم الذهبية، فلم يَضِع في ظلمات العصور الأوروبية الوسطى؛ فكانت ثوراته الكبرى في عصور العقلانيّة والتنوير.
وهنا تظهر الفلسفة في المشهد من جديد؛ فالعلم أصبح يشكل الواقع والمعقول؛ وبالتالي يحتاج لدراسة خاصّة تضبط منطقه وتتبع تطور أساليبه العلمية والمنهجية، كما تضطلع بعبء دراسة إطاره التاريخي وعمقه الحضاري؛ لنخرج بنظريّة فلسفيّة خاصّة بالمعرفة، وعلوم جديدة تتبع تاريخ العلم وترسم منطقه ومنهجيته وتدرس قوانينه ونتائج نظرياته في تطور لا يثبت على قرار.
غير أن فلسفة العلوم بصفة خاصة هي إحدى فروع الفلسفة، تُعنى بدراسة طرق وأسس ومضامين العلم، كما أن الأسئلة المركزية لدراسة فلسفة العلوم تتعلق بما هو مؤهل لأن يُلقب بالعلم، ومدى القدرة على الاعتماد على النظريات العلمية، والهدف النهائي للعلم.
فهل يصبح الدين علماً في مستقبل الأيام؟
نعم! تتعدد المداخل الفلسفية وتختلف باختلاف المذاهب والمدارس، وكذلك تختلف من حيث نوع العلم الذي تختص بصياغته ومناقشته وتفسيره وتحليله، ومن ضمن تلك العلوم الفلسفيّة ما يسمى بفلسفة العلوم، وهي فلسفة انتشرت على مرّ العصور، وكان لها تأثير بارز لا شك فيه.
فلئن كنتُ أنا لا أعني مطلقاً أن تكون هناك قطيعة معرفية تجئ بينا وبين الغرب، بل ولا نستطيع أن نفعل ذلك، فكل ما أقول به هو التفكير الدائب في التقليل من مثل هذا النزوع الغريب إزاء تقليد المدارس الغربية المعاصرة، ومحاولة محاكاة روّادها ومؤسسيها في مناهجهم ومذاهبهم، وليس محاولة نقدها وفحصها؛ بل لتطبيقها عنوة على عقائدنا وتراثنا وخصوصيتنا الحضاريّة وهُويّتنا الثقافية، وهى من بعدُ أفشل المحاولات!
مثل هذا الترقيع البغيض غير مقبول ببداهة المنطق من الوهلة الأولى، ومع ذلك يقع فيه الباحثون رغم عرفانهم ببديهة رفضه، وفشل الاعتماد عليه مع تطبيقه أو التنويه إليه، كما فشلت محاولات قبل ذلك ومحاولات، فمن يعتمد على الترقيع لا يَسْلَم آخر الأمر من المهانة العقلية؛ فهو موضع الخطر يقع فيه كثيرون ممّن مارسوا في السابق عملية نقد التراث أو تجديد التراث أو التماس لغة مغايرة للخطاب الديني أو دعوى التفكير العقلاني المُوغل في الدعوى المؤسسة على الاستقلال، وهى في نفس الحال دعوى غارقة في التقليد لعلماء الغرب ومفكريه والمحاكاة لهم في غير استقلال.
لا ينجمُ التقليد عن أصالة، ولا يسفر عن استقلال أو عن شعور بالتبعة من الوجهة الأخلاقية، يستوي في ذلك من يقلّد الأفكار الغربية أو يقلد الأفكار التي تنتمي إلى بني جلدته.
كل تقليد مذموم لأنه يؤدي إلى الاستكانة والجمود، وهو ضد المعرفة وضد التفكير، وهو مذموم في العقل مذموم في الدين، وفوق هذا هو مذموم في البحثّ عن الحقيقة.
وموضع الذم فيه أنه يعتمد على المتابعة التي لا يظلها جهد التفكير، ولا تجمعها وحدة معرفية أو عقلية، ولا غوص عميق في المصادر الدينية المعتبرة، بمقدار ما يعتمد على المغالطات لتزوير الحقيقة التي هو بصدد البحث فيها، لأنه لا يتوخىّ عرضها بالتجرّد والنزاهة والإنصاف، ولكن يعرضها بمطلق الهوى ومطلق الغرض وهما نقائض البحث العلمي ونقائض المنهجية العلميّة سواء، ثم لا يقتصر الأمر على هذا الحدّ؛ بل يتفاخر بمعرض السوء وصناعة الأمجاد الكاذبة.
لذلك كله؛ ومن أجل ذلك كله؛ نفضل من حيث الاصطلاح العلمي الدقيق ألا نقول “فلسفة الدين”؛ بل نقول “فلسفة العلوم الدينية”؛ لتجنب الخلط بين الوحي في ذاته، وهو مصدر الدين، وبين الفلسفة ومصدرها “العقل”، وما دامت الفلسفة تقف وراء العلم من حيث هو علم ديني لا من حيث هو دين، مصدره الوحي؛ فإنّ اصطلاح فلسفة الدين هذا، فيه مغالطة منطقية ومبالغة تصل إلى درجة الخطأ.
أمّا اصطلاح فلسفة العلوم الدينية؛ فهو اصطلاح مقبول عقلاً ومنهجاً؛ لأنه يقوم على علوم الدين لا الدين في ذاته.
وقد يُقال بالمقاربة على غرار ذلك؛ إننا نقول فلسفة العلم تماماً كما نقول فلسفة العلوم، ولا نجد غضاضة في التسمية؛ إذْ لا مشاحة في الألفاظ. والرد على ذلك بسيط جداً؛ وهو أنك عندما تقول “فلسفة العلم” لا تخرج بعيداً عن السياق المنطقي المستخدم في ميدان العلم، ولا تخرج عن ميدان الفلسفة ولا عن ميدان فلسفة العلم بوجه عام.
ولكنك حين تقول فلسفة الدين، فأنت تجعل للوحي شروطاً فلسفية فتخلط من حيث لا تدري مجالاً بمجال. ومعلوم أن مجال الدين في ذاته مقدّس، وسرُّ تقديسه أنه وحي من عند الله.
أمّا ما يُقام عليه من علوم فلا تقديس فيها، ومن حق الفلسفة أن تحيلها إلى منطقها وتتدخل فيها من حيث إضفاء الطابع النظري النقدي المنهجي على العلوم التي تتناول الدين.
أمّا الدين في ذاته، فلا. لا يمكن أن يتحوّل الدين في ذاته إلى فلسفة ولا شرط للفلسفة أن تناقش قضايا الوحي، وهو معصوم، مناقشة فلسفية حظ العقل فيها أكبر من حظوظ سواه، ما لم تقم على الوحي علوماً تفسيرية وتأويلية يتدخّل في تصنيفها العقل البشري ويطلع بالجانب الأكبر من تأسيسها، وإذْ ذاك يحق لمناهج العقل أن تبحث في فلسفة العلوم الدينية، وتظل مشروعية هذا الاصطلاح قائمة كلما توغل العقل البشري؛ ليخاطب بطرائقه المعرفية المعتبرة أصنافاً لا حدّ لها من ألوان التفكير في الدين.
ــ اصطلاحاً؛ نقول فلسفة العلوم الدينية ولا نقول فلسفة الدين؛ لتجنُّب الخلط بين مجال الإيمان الديني الذي يقوم على الوحي، ومجال العلم الذي يعتمد النظر في التجارب المعمليّة والمحسوسات الطبيعية، كما يعتمد منجزات العقل والمعرفة العقلية بمناهج يستخدمها العقل نفسه في مجال علوم الدين. وهذا أسلم للبحث العلمي وأقرب للموضوعية والنزاهة العلميّة.
وبنفس هذا المقياس في تلك الفوارق من حيث كونها مفاهيم مستخلصة، يستوقفنا التساؤل حول (العقيدة والدين)، أو حول الإيمان والعقيدة؛ ليقيم جدلاً نظريّاً إزاء ما يمكن طرحه عند دلالة المفاهيم المستخلصة؛ لتشكل رؤية قائمة مع كل مفهوم مطروح.
ولا شك أنّ جدل الأسئلة المطروحة يثير كثيراً من التساؤلات الفرعيّة ويتوقف الإجابة عليها على فعل القناعات الإيمانية والمعتقدات التي تواكب تأصّلها في الفكر والشعور؛ فنحن نضيف العقيدة أحياناً إلى الفكر كما نضيفها إلى الدين، فنقول “العقيدة الدينية” لتميزها عن العقائد الفكريّة سواء لدى الفلاسفة أو المفكرين أو الأدباء أو العلماء، فكل هؤلاء وأولئك لهم عقائدهم في مجرى التفكير والشعور، بمقدار ما لهم كذلك آراء تخصّهم أو تخص غيرهم ممّن يحيون على تلك الآراء عقائد يطبقونها على حياتهم الفعليّة ويقيمون عليها مجدّداً محاور البناء.
لا نشك في عموم الدين من حيث التّوجه به إلى أصل القداسة شعوراً من أعمق الأسس النفسية في كل ديانة؛ لأن شعور القداسة هذا هو الأصل الأصيل لكل حاسّة جديرة أن توصف بالصفة الدينيّة وتنبني عليها عقائد المؤمنين، ولولاها لما كانت ديانة على الإطلاق.
أيّهما الأعمُّ الشامل وأيهما الأخص الأضيق: العقيدة أم الدين؟
بداية لا يُقاس الدين ولا العقيدة الدينية بمعيار المنطق، وإنما معيار المنطق يجوز أن يفعّل في النتاج لا في الأصول، ويجوز أن يُرى في الوقائع لا في الأطر النظريّة.
وإذا نحن قلنا عقيدة دينية ونسبناها إلى الدين عزّ علينا أن نجرّدها من شعور القداسة، ويبقى معناها لازماً فيما يشتمل عليه وجدان المفكر في العصر الحديث؛ فهي من ثمَّ طريقة حياة لا طريق فكر ولا طريقة منطق ولا طريقة دراسة.
لا معنى للعقيدة الدينية عندنا إذا كان قصاراها هو ما تشتمل عليه الأوراق والمجلدات والمتاحف والمحفورات، ولا معنى لها عندنا اذا كان قصاراها أيضاً إقامة مجموعة دراسات نظريّة وفلسفات تمس الأطر الخارجة ولا تمس بواطن الأمور وجواهر الأشياء، وإنمّا معناها الحقيقي حاجة النفس كما يحسُّها من أحاط بتلك الدراسات، ومن فرغ من العلم والمنطق والمراجعة ليرقب مكان العقيدة من قرارة ضميره.
معناها بهذا المعنى تحقّق “الإيمان” في مسارب الفكر وخلجات الضمير.
يلزم عن هذا (من جهة المنطق) أن تتاح الحرية للعقيدة، ويتاح لها في الوقت نفسه الاستقامة، فلا شيء يقدح في العقائد غير نزع الحريات، ولا شيء يصيبها بالجدب والتجديف غير غيبة الاستقامة الصادرة رأساً عن الحرية، فالعلاقة أسمى ما تكون وأوثق ما تكون بين الحرية والاستقامة.