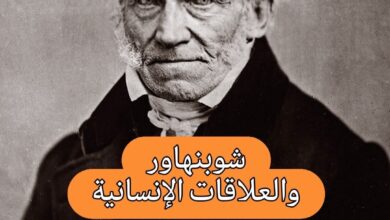في براءة الفلسفة وصلاح منتحليها
في براءة الفلسفة وصلاح منتحليها
فتحي المسكيني
ليس من شأن الفلسفة أن تدافع عن أيّ أفق روحي أو أخلاقي جاهز. وليس يهمّها أن تنافح عن استمرار أيّة رؤية للعالم أو أيّة عقيدة مستقرة لدى أهلها، مرضيّ عنها من قِبل جماعة إنسانية أو أخلاقية معيّنة. بهذا المعنى إنّ الفلسفة لا تدافع عن تقنية رجاء بعينها.
إنّما مهمّة الفلسفة – وهي وحدها التي يحقّ لها أن تعيّن مهمّتها الخاصة من حيث هي فنّ العقل البشري بعامة وليست أيّ شيء آخر- هي البحث في طبيعة العلاقة التي تربط عقولنا بما ما يتخطى ملكاتنا أو قدراتنا الذاتية أو الطبيعية. إنّ الفلسفة هي فنّ السؤال عن معنى كلّ أشكال “التعالي” على حدود عقولنا الطبيعية. وكلّ تخطّ نظري أو أخلاقي لعقولنا يطرح مشكلا فلسفيا. وهو مشكل في معنى محدّد أي أنّه لا يمكن ولا يحقّ لنا أن نعالجه إلاّ في حدود طبيعة عقولنا كما هي، أي في حدود طبيعتنا البشرية كما هي متاحة لنا، وليس كما تفرضها سردية خارجية عنها مهما كان نوعها.
كلّ أشكال التعالي هي مشاكل أو تطرح مشاكل فلسفية. وذلك أنّ الفلسفة هي فن احتمال قدرة البشر على حريتهم الكونية إزاء كلّ ما يتخطى عقولهم من جهة ما هم جزء داخلي من مساحة النوع البشري كلّها. ولأنّه ليس ثمة عقول أخرى أو نوع آخر من العقول، فإنّ الفلسفة هي صناعة العقل البشري بما هو كذلك. ولا معنى لأيّ تــ. ـطاول على العقل أو على طبيعته أو على حدوده أو على صلاحيته باسم الفلسفة. بل بمجرّد أن يدخل العقل لدينا في صلة إشكالية مع ما يتجاوز طبيعته البشرية هو يدخل في حالة فلسفية قصوى: أي في تساؤل مصيري عن نفسه باعتباره ملكة مهـــ. ـدّدة على الدوام بكل أنواع “الماوراء”، ما وراء الطبيعة المحسوسة لعقله أو للعالم الذي يعيش فيه. كلّ أنواع “الما وراء” تطرح مشكلا فلسفيا، أكان ذلك ما وراء العلم أو المجتمع أو اللغة التي نتكلمها.
نحن ننتمي إلى ثقافة تفترض أنّ تقنية “الما وراء” الفطرية للبشر هي الدين أو التألّه. ومن ثمّ أنّ صنوف الشعائر وفنون الاعتقاد والإيمان والتقديس والتنسّك..الخ هي تقنيات رجاء مناسبة لطبيعتنا “البشرية”، التي وقع في تأويلها، للغرض (وفقا للسردية التوحيدية الإبراهيمية) بوصفها “آدميّة”، أي “مخلوقية” أصلية. هذا التحويل المبكّر للمدعوّ “إنسان” (أي الحيوان الذي يتميّز بالقدرة على الأنس والمؤانسة مع بني جنسه أو القادر على “نسيان” أصله الحيواني) من رتبة “البشري” إلى منصب “الآدمي”، كان إجراءً ضروريا تماما من أجل أن يتمّ بشكل مبكّر أيضا تحويل سؤالنا عن أصل وجودنا في الكون إلى سؤال عن “الخالق” تحت أسماء شتى أشهرها “الله” وما يقابلها في كل اللغات. وهو إجراء افترض في نفس الوقت تحويل “الكون” من حولنا إلى “عالم”، أي إلى معلم أو آية أو علامة على ذلك الخالق.
الآدمية والألوهية والعالمية ثلاث أمارات على قرار تأويلي واحد: هو اختراع “الما وراء” أو “التعالي” الأخلاقي المناسب على بقية الكائنات وخاصة عائلة الحيوان، وفقا لتقنية الرجاء المناسبة لفطرتنا، أي “الدين” أي نمط الطاعة القائم على “دَيْن” أصلي لا يمكن تسديده أبدا: نعني اعتبار “الوجود” نفسه (وليس فقط وجودنا في أجسادنا أو في العالم) “دَيْنا” ومن ثمّ “أمانة” أو “إعارة” علينا أن نؤديها بشكل لائق.
لذلك ليست الفلسفة ضدّ الدين أو ضدّ أيّ دين، نعني ضدّ الطاعة المحضة بناءً على دَين أصلي في طبيعتنا. بل إنّ الفلسفة نمط بحث يقع سؤاله خارج أفق الأديان بعامة. ولذلك هي مساءلة غريبة عن كل أشكال الخصومة اللاهوتية حول قضايا الذنــ. ـب أو الضمير أو مسائل الإيمان أو مواقف الإلـــ. ـحا د. ورغم ذلك لا يمكن أبدا للفلسفة –لأسباب تخصها من داخل مساحة العقل البشري وليس من أيّ موقع آخر- أن تتجاهل تقنيات الرجاء وأشكال الآخرة وفنون الأمل في حياة مستقبلية التي طوّرها الحيوان البشري طيلة مسيرته السحــ. يقة القدم على الأرض، وكأنّها مسائل زائـ. فة أو بلا معنى أو ممّا يمكن حلّه بشكل خارجي. بل بالعكس إنّ الفلسفة لا يمكن أن تعمل إلاّ في ميدان السؤال المحـ. رج والخـ. طير وغير المشروط والكوني عن الصعوبات الجذرية والأبدية التي يثرها اصطــ. دام العقل البشري بحدود “الما وراء” بكل أنواعه وتعابيره (من قبيل الأزلي والأبدي والمطلق واللامتناهي والمفارق والمتعالي والغائب، الخ..والذي لا يُعدّ مفهوم “الإله”، بسيرته الإبراهيمية، إلاّ أشهر أسمائه فحسب، وتبعا لذوق مخصوص في التسمية تميّزت به ثقافات الشرق الأوسط القديم.(
بذلك فما يخصّ الفلسفة رأساً ليس نقد الدين أو التحرّر من سـ. ـطوته التي حوّلها الفقه إلى مؤسسة معيارية قا هـ. رة أو مخـ. يفة. بل مشكل الفلسفة هو خوض بحث واسع النطاق في طبيعة “الما وراءات” التي جعلت حاجة البشر إلى تقنيات الرجاء أمرا ملحّا ولا يمكن إلغاؤه بشكل خارجي أو إجرائي، أي بشكل “نقدي”، كما شاع منذ فيورباخ أو ماركس. ليست الفلسفة موقفا “سياسيا” من الدين كما أنّها ليست موقفا “ثقافيا” من العلم أو موقفا “أخلاقيا” من الفن. بل هي فن الفحص عمّا يتخطى أو يزعم أنّه يتخطى عقولنا ومن ثمّ يطرح مشكلا لا يمكن حلّه في حدود التجربة الممكنة بل فقط استشكاله بشكل جذري ابتغاء تحريره من هالته الغامضة والسيطرة الأخلاقية أو المدنية على نتائجه المد مّــ. رة لإمكانية الحياة معاً بين بني البشر.
وبالنسبة إلى الفلسفة لا يعدو الدين أن يكون سوى إحدى تقنيات الرجاء الأكثر شهرة، التي اخترعها الحيوان البشري طيلة تاريخه الطويل وبعد تمارين متعددة ومتباينة على فنّ الما وراء، تفوّقت فيها بعض الشعوب أو الثقافات على غيرها. وهو لم يصبح ظاهرة أخلاقية مركّبة وبالتالي مستعصية على الحلول الإجرائية الحديثة إلاّ لأنّه نتيجة لتراكم معياري طويل الأمد استوعب كلّ أشكال “الما وراء” التي بناها العقل البشري على حدوه الخارجية واستمدّ منها وسائل بقاء النوع في عصور متطاولة، بوصفها آفاق معنى، تبيّن من بعدُ أنّها شديدة النجاعة. بهذا المعنى يمكن أن عرّف الدين بأنّه تقنية رجاء نموذجية ورثت وتفوقت على كل أنواع الرجاء الأخرى السابقة أو المنافسة لها. ومن ثمّ يمكن للنوع البشري أن يطوّر في المستقبل تقنيات رجاء لا نعرفها وقد لا يمكننا أن نتصورها الآن.
ولذلك علينا التذكير بأنّ الفلسفة لا تنافس الدين في أيّ نوع من الرجاء. بل هي ليست تقنية رجاء أصلا، بمعنى أنّها لا تعدنا بأيّ أمل خاص. وشكل الوعد الوحيد الممكن والمناسب للفلسفة، من حيث هي فن إدارة شؤون العقل البشري بعامة، هو الحرية: حرية عقولنا من كل أشكال “الما وراء” التي تهددها وتريد تد جيـ. ـنها أو طمــ. ـس الطريق إلى شكل التذوّت أو التذاوت القادرة عليه من داخل طبيعتها.