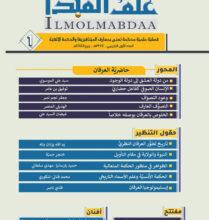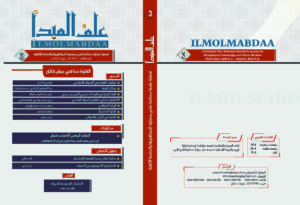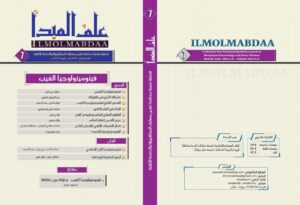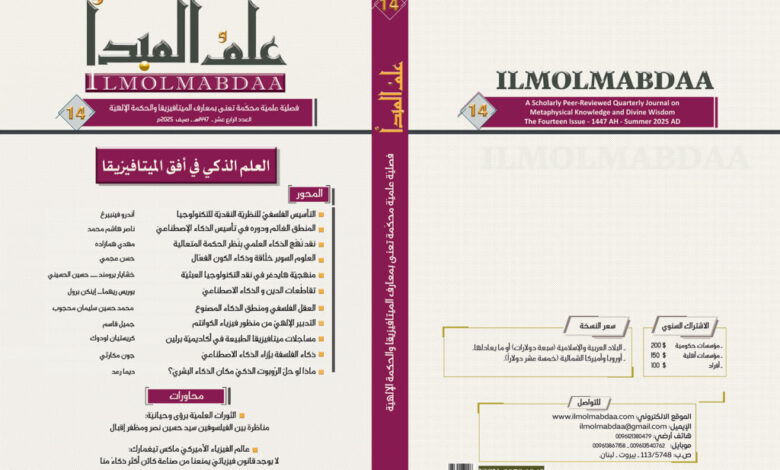
العدد 14 من مجلَّة “علم المبدأ”:
“العِلم الذكيّ في أفق الميتافيزيقا”
صدر العدد الرَّابع عشر من مجلَّة “علم المبدأ”، وهي فصليَّة علميَّة مُحكَّمة تُعنى بمعارف الميتافيزيقا والحكمة الإلهيَّة، ودار محوره حول عنوان “العِلم الذكيّ في أفق الميتافيزيقا”.
تضمَّن العدد أبحاثًا ودراساتٍ معمَّقةً قدَّمها جمعٌ من المفكِّرين والأكاديميين من العالمين العربيِّ والإسلاميِّ، والعالم الغربيّ، اتَّسمت بالشموليَّة والغنى الفكريِّ والفلسفيِّ والعلميّ.
في ما يلي موجزٌ لمضامين هذه الأبحاث والدراسات:
* في “المفتتح”، كتب رئيس التحرير محمود حيدر، مقالة بعنوان “ميتافيزيقا العِلم الذكيّ”، يتساءل فيها عن إمكان وجود صلة بين القوانين الحاكمة على الطبيعة وعوالم ما بعد الطبيعة، الأمر الذي يُعدُّ أحد أبرز العلامات الدالَّة على المعضلات التي سعى العقل الفلسفيُّ للوقوف عليها، واستخراج المبادئ المنطقيَّة المناسبة لها، وجاء العلم الذكيُّ بحادثاته وانعطافاته الكبرى، ليقارب الإجابة من محلٍ غير معهود. ورأى أنَّ من المنطقيِّ أن تنشأ مساءلةٌ تبادليَّةٌ بين الفلسفة والعلم، لافتًا إلى أنَّ للعلم حجَّةً على الفلسفة لكونه الواسطة البَدئيَّة في تأسيس معرفتها بالكون. كما لاحظ كيف احتجَّت الفلسفة على العلم من بعد أن تمكَّنت غزواته من إقصاء التأمُّل الميتافيزيقيِّ، واستنزال التفلسُف من متعاليات التجريد إلى أرض الفينومينولوجيا الفسيحة.
* في باب “المحور”، ـ نطلُّ على مجموعة من الدراسات والأبحاث جاءت على الترتيب التالي:
بحثٌ بعنوان “التأسيس الفلسفيُّ للنظريَّة النقديَّة للتكنولوجيا/ إرجاع المعرفة التقنيَّة إلى أصلها” للفيلسوف الأميركيِّ آندرو فينبيرغ (Andrew Feenberg)، يسعى فيه لتلخيص الأفكار الرئيسيَّة الواردة في النظريَّة النقديَّة الحداثية حول التكنولوجيا، وإظهار صلتها بمصدريْها الأساسيَّين: النظريَّة النقديَّة التي تبنّتها مدرسة فرانكفورت، وكذلك الجهود الأوليَّة في مجال دراسات العلم والتكنولوجيا. أمَّا أبرز الأفكار التي تطرَّق إليها البحث فهي تلك التي تتناولُ تحديد نظرية الفاعليَّة البشريَّة من جانب المنظومة التكنوقراطيَّة المهيمنة على المجتمعات المعاصرة.
* “المنطق الغائم ودوره في تأسيس الذكاء الإصطناعيّ/ رؤية تحليليَّة أبستمولوجيَّة”، بحث قدَّمه ناصر هاشم محمد، ورأى فيه أنَّ ظهور المنطق الغائم أحدث انقلابًا خطيرًا في مبادئ الفكر الإنسانيِّ، والعلم الحديث على المستويين العقلانيِّ والتطبيقيِّ، وأزاح ظهوره بعض المفاهيم التي وُصِفت بالمطلَقة والحقيقيَّة والثابتة، كالحتميَّة، واليقين والضرورة، والسببيَّة، وحلَّت بدلًا منها مفاهيم الَّلاحتميَّة، والَّلايقين، والإمكان، والاحتمال، والنسبيَّة.
* في “المحور” أيضًا مقالةٌ للباحث مهدي همازاده حملت عنوان “نقد النُّهُج الشائعة في الذكاء الاصطناعي/ تأمُّلات نظريَّة استنادًا إلى الحكمة المتعالية”، حيث ركّزت على مقاربتين أساسيَّتين في عمليَّات بنائه، واحدة كلاسيكيَّة والأخرى حديثة. مع الإشارة إلى أنّ المقاربة الحديثة تشتمل بدورها على استراتيجيَّتين محوريَّتين هما الترابطيَّة والتجسُّد.
وتمضي المقالة إلى البحث في ماهيَّة كلِّ واحدة من هاتين المقاربتين، وتبيِّن سبب قصورها من منظور الظهور وبناء الذكاء الاصطناعيِّ القويِّ، كما تشير إلى بعض الإشكالات الفلسفيَّة المهمَّة، لتخلص إلى تقديم مقترح يستند إلى الحكمة المتعالية، ويتوافق مع بعض الرُّؤى المعاصرة في العلوم المعرفيَّة.
* “تقاطُعات الدين والذكاء الاصطناعيّ/ تشكيلات موازية للديانات”، بحث وضعه كلُّ من
بوريس ريهما و إينكن برول، ويدرس مطارح الِّلقاء والافتراق بين الدين والذكاء الاصطناعيّ (AI)، ويذهب بعيدًا في معاينة موضوعه، مستكشفًا كيف يثير هذا الذكاء سرديَّات وممارسات دينيَّة، كما يولِّد تشكيلات موازية للديانات، لنكوِّن من نتيجة ذلك تطوير مفهوم هذه التشكيلات والتعامل معها كإطار نقديٍّ لفهم تداعياته الدينيَّة والثقافيَّة.
* كتب خشايار برومند وحسين الحسيني، بحثًا حمل عنوان “منهجيَّة هايدغر في نقد التكنولوجيا العبثيَّة/ دحض وثنية الآلة”، سَعَيا من خلاله أوَّلًا إلى إيضاح ماهيَّة التكنولوجيا الحديثة على أساس المنهج الفكريِّ لهايدغر. ثانيًا، إلى تحليلها ومعرفة ماهيَّتها كمقدِّمة لفهم المخاطر التي تُهدِّد الإنسان المعاصر. وثالثًا، إيضاح مفهوم الجستالت (gestalet) بوصفه ماهيَّة جوهرية للتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر سيادة هذا المفهوم على العالم الذي نعيش فيه.
* “العلوم السوبر خلَّاقة وذكاء الكون الفعَّال/ تقويض النظريَّات المهيمنة على العقل البشريّ”،
هذا البحث قدَّمه حسن عجمي أستاذ الفلسفة بجامعة ولاية أريزونا الأميركيَّة، وفيه تأصيل للأصل، أي للعقل البشريِّ المبدع، وهو في ذروة احتمالاته وتطوُّراته. وفي مثل هذا التأصيل ما يشير إلى مجاوزة جملة من الثوابت العلميَّة والمنطقيَّة التي حكمت مسار العلوم على امتداد قرون خلت.
* في “المحور” كذلك، مقال لـ جون مكارثي بعنوان “ذكاء الفلسفة بإزاء الذكاء الاصطناعيّ/
عودة إلى مفهوم الفطرة السليمة”، يتناول فلسفة الذكاء الاصطناعيِّ، ويحلِّل بعض المفاهيم المشتركة بينهما. كذلك يقدِّم نصائح للفلاسفة، وخصوصًا فلاسفة العقل. فمن وجهة نظر الذكاء الاصطناعيِّ، أنَّ النظريَّات الفلسفيَّة تكون مفيدة فقط إذا لم تستبعد إمكانيَّة وجود أنظمة اصطناعيَّة بمستوى الذكاء البشريِّ، وإذا قدّمت أساسًا لتصميم أنظمة تمتلك معتقدات، وتقوم بالاستدلال، وتخطِّط.
* كتب جميل قاسم بحثًا تحت عنوان “التدبير الإلهيُّ من منظور فيزياء الكوانتم/ جدل تكامل الرحمانيِّ – المادّيّ”، انحصرت مهمَّته ببيان الاتِّصال الوجوديِّ بين الرحمانيِّ والمادّيِّ في تشكُّل مادَّة العالم. وفي سبيل ذلك، يؤسِّس فرضيَّته على التدبير الإلهيِّ للعالم انطلاقًا ممَّا توصَّلت إليه الفيزياء الحديثة، وتحديدًا في ضوء الأسُس التي قامت عليها نظريَّة الكوانتم. وحسب منطق البحث، فإنَّ ثمَّة صلاتٍ وطيدةً تربط القوَّتين الروحيَّة والمادّيَّة لتشكِّلا معًا «كون الطاقة» الذي به ومنه تدوم السيرورة الحيَّة للموجودات.
*“مساجلات ميتافيزيقا الطبيعة في أكاديميَّة برلين/ أولويّة العلوم الفيزيائية على الفلسفة”، مقال لـ كريستيان لودوك، يناقش تصوُّرًا مفارقًا لميتافيزيقا الطبيعة، تقدَّم به كلٌّ من بيير لوي موبيرتوي (فيلسوف ورياضيّ فرنسيّ)، وليونارد إيلر(عالم رياضيَّات وفيزيائيّ سويسريّ)، هدفهما الرئيس من وراء هذا التصوُّر يتمثل في إعادة تحديد موقع علم الكونيَّات بالنسبة إلى علوم الطبيعة.
* قدَّم محمد حسين سليمان محجوب بحثًا بعنوان “العقل الفلسفي ومنطق الذكاء المصنوع/
تبادليّة التأمُّل الذكي”، يتناول مسألة مركزيّة هي درس العلاقة بين الفلسفة والذكاء الاصطناعيِّ بما تحتويه الفلسفة من مضامين نظريَّة ورؤى نقديَّة، وما يحتويه الذكاء الاصطناعيُّ من أنظمة تكنولوجيَّة… مثل هذه العلاقة هي التي تجعل صورة الذكاء الاصطناعيِّ منطقيَّة، كما تمكِّن الفلسفة بحكم طبيعتها من أن تصبح قادرة على استغراق هذا العلم البينيِّ. يأتي ذلك من خلال إيضاح دورها البارز في محور من محاورها، ما أسهم في ميلاد الذكاء الاصطناعيِّ بوساطة المنطق الإسناديِّ والمنطق الضبابيِّ.
* كتبت الباحثة والأكاديمية اللبنانية ديما رعد تحت عنوان “ماذا لو حلَّ الرُّوبوت الذكيُّ مكان الذكاء البشريّ؟/ سؤال في الإمكان والاستحالة”، فتساءلت: إلى أيِّ مدى يمكن الروبوت الذكيَّ في طوره المتجدِّد أن يصادر دور الفيلسوف والفنان والشاعر؟ ورأت أنَّه مع بداية الطفرة الكبرى للعلوم الذكيَّة ووسائل الاتصال، بات هذا السؤال متداوَلًا بشغف في الأوساط المختلفة. وأشارت إلى أنَّ العقل البشريَّ، وبعد ظهور وانتشار التكنولوجيا الحديثة التي أفرزت الذكاء الاصطناعيَّ، راح ينساق إلى المشهد بصورة آليَّة، حتى بدا أنَّ المرآة التي تعكس صورته الظاهريَّة هي أدنى إلى قراءة للنسخ الذهنيِّ الذي تركنه داخلها.
*”الذكاء الاصطناعيّ كما يُرى إليه في المعتقدات الدينيَّة/ تنظير في حقل الفلسفة”، بحث وضعه علي رضا قائمي نيا، ويتمحور حول السؤال التالي: ما التأثير الذي يتركه على المعتقدات الدينيَّة الادّعاء القائل: (إنَّ الحاسوب الآليَّ يفكّر، وأنَّه الشيء الوحيد الذي يستطيع التفكير.. ثمَّ إلى أيِّ حدٍّ يتعارض مثل هذا الادِّعاء مع مضامين النصوص الدينيّة؟. ولا شكَّ في أنَّ لهذا السؤال المركَّب منزلة محوريَّة في النقاش الدائر اليوم بين علماء ومفكِّرين ينتمون إلى مدارس وتخصُّصات علميَّة متعدِّدة الحقول.
* في باب “محاورات”، مناظرة بعنوان “الثورات العلميّة برؤى وحيانيّة” بين فيلسوفين مسلمين يعيشان في الغرب هما سيد حسين نصر و مظفر إقبال. وخلصت المناظرة إلى أنَّ التطوُّرات العلميَّة في طورها الأخير افترضت أسئلة لم تكن مسبوقة في سياق الجدل المتواتر بين الدين والعلم. وإذا كانت الثورات العلميَّة في الغرب استطاعت تقليص مساحات التباين مع الَّلاهوت المسيحيِّ عن طريق احتوائه أو «علمَنته»، فإنَّ سؤال العلم، أو ما يعرف اليوم بـ «العلم الذكيّ»، ينشئ تحدِّيات جوهريَّة تلقي بأثقالها على الحضارة المعاصرة، وكذلك على الفضاء الدينيِّ الإسلاميِّ على وجه الخصوص.
* أيضًا ثمة حوار مع عالم الفيزياء الأميركيّ ماكس تيغمارك اعتبر فيه أنَّه لا يوجد قانون فيزيائيّ يمنعنا من صناعة كائنٍ أكثر ذكاءً منا، لكنَّه دعا إلى التفكير بسرعة وبانفتاح حول المشكلات الكبيرة التي سنواجهها في المستقبل القريب، إذ قد يدفعنا الذكاء الإصطناعيُّ إلى اتِّجاهات لسنا مستعدّين لها كبشر.
* في باب “أفنان”، بحثٌ لـ رشيد ألاركو بعنوان “إسهامُ الصُّوفيّة فـِي فَنِّ الخَطِّ العَرَبيِّ/
ابنُ عربي مثالًا”، قصد من خلاله بيان إسهام الشيخ محيي الـدين بن العربي الحاتميِّ في فنِّ الخط العربيِّ، ونظر إلى هذا الإسهام بوصفه خطابًا معرفيًّا له علاماته الفارقة في الثقافة العربيَّة والإسلاميَّة.