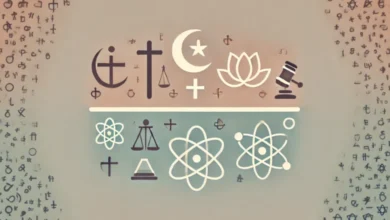فتنةُ المشاهدة
فتنةُ المشاهدة
مبتدأ الاستغراب العدد الحادي عشر ـ السنة الرابعةــ 1439 هـ ربيع 2018
د. محمود حيدر
هل الميديا عالمٌ افتراضيٌ كما قرر المحدثون من أهل الإصطلاح، أم هي عالمٌ حقيقيٌ يترجمُه نمطُ حياةٍ بالغ الكثافة والتعقيد؟..
ينطوي السؤال كما هو بيِّن على ضربٍ من التشكيك بصوابية التعريف. فالناظر في أفعال الميديا وآثارها والوقائع الناشئة منها، لا يلبث حتى يأخذه الذهول بعالمٍ مثقلٍ بالحقائق الواقعية.
لننظر إذاً، ماذا نرى؟..
لو كان لنا ان نعيِّن مقصداً للغاية التي من أجلها افتتحت الميديا زمنها المفارق، لانْصرفْنا الى القول: إنها الرغبة الجامحة بإغراق العالم بطوفان غير مسبوق من الأظلّة والأصوات والاصداء والصور والمعلومات. كما لو أن الآخذين بناصيتها أرادوا أن تفصحَ الحداثةُ الفائضةُ عما تبقى من أسرارها بعدما أعلنت عن نهاية التاريخ. فالليبرالية الجديدة، وقد فاضت عن نفسها حتى ضاق صدرها، لم تعد تقدر على الصبر طويلاً لتسوِّغ دعاويها وتعلن سيادتها على أربع جهات الأرض.
في مستهل القرن الجاري كشفت الميديا عن أعمق أسرار الحداثة، لمَّا أضافت نظرية “القوة الليِّنة” الى منهج التطويع القهري للغير على امتداد الأزمنة الاستعمارية المتعاقبة. وهي النظرية التي يجوز لنا أن نعبِّر عنها في عالم الميديا بـ”ثقافة الومضة”. إذ مع هذه الثقافة التي ولدت على حين بغتة جرَّاء الدَفَقِ الهائل للمعلومات بات المواطن العالمي يشعر ان لا حيلة له سوى التماهي مع سيولها العارمة.
هذه الوضعية المستحدثة التي جيء بها إلينا على صهوة الميديا، سوف تدعونا إلى التعرُّف على الأصل الذي منه ولدت “ثقافة الومضة”. لكن معرفة الاصل، تفترض العودة، ولو قليلاً، الى التأسيس الانطولوجي للخطاب الاعلامي الغربي.
الابتداءات الفعلية لهذا التأسيس جرت مع حداثة أقامت فلسفتها على اليقين بأن الإنسان يستطيع معرفة كل الأشياء في حد ذاتها؛ وان العلم والتفكير العلمي قادران، من دون سواهما، ان يحدِّدا ما ينبغي علينا ان نقبله على انه حقيقي.. وأن ما يتصل بالمعاني والقيم الروحانية، إنْ هي إلا متغيرات في كيمياء الدماغ التي تتفاعل مع مجموعة من القوانين الميكرو ـ بيولوجية المرتبطة بتطور الإنسان.
ولكن.. ما حدث في “المابعد” سيفتح الباب على إمكان تبديد هذا فلم اليقين. يكد يتسنى للحداثة أن تحشر انسانها المعاصر في عالمه الأرضي وتدفعه مجدداً نحو الوثنية، حتى جاء من أهلها من يُخبِرُ عن استحالة هذا المدَّعى. جمعٌ من مفكري التنوير المتأخرين ذهبوا الى القول: إن العقل المحض الذي يُعاد انشاؤه في مواجهة الصعود المتجدد للميتافيزيقا الدينية بات قاصراً عن تلبية مقتضيات الحضارة الحديثة. وكان ان ثَبُتَ بالتعقُّب التاريخي لمسار المعرفة ان هذه الأخيرة، ليست سوى سلسلة من الصياغات المجازية: من الشيء الى الصورة الذهنية، ومن الصورة الى الكلمة التي تعبِّر عن حالة الفرد النفسية، ومنها الى الكلمة التي تفرضها الإصطلاحات الاجتماعية بزعم أنها الكلمة الصحيحة.. ثم عودة إلى البدء: من هذه الكلمة الى الشيء الذي لا ندرك منه سوى الملامح التي تسهل صياغتها المجازية في المعاجم المتوارثة.
* * *
لمّا استشعرت الحداثة بنسختها النيوليبرالية مأزقها الأصلي، أي البحث الشاقّ عن بَدْءٍ جديد، راحت تحثُّ السير نحو انعطافة تمنحها القدرة على ترميم صدوعها، وإعادة تشكيل العالم الجديد طبقاً لأغراضها. لقد وجدت في “العولمة” ضالّتها الكبرى لتعثر على هذه الانعطافة. ألقت بجميع أثقالها داخل شبكة عنكبوتية من الأنباء والمعلومات والصور والرموز، وحوَّلتها إلى منظومة للتحكم والسيطرة. استعملت النيوليبرالية منظومتها المستحدثة بغلوّ صارخٍ، وراحت تزيل الستر عن الأصل الذي جاءت منه،ثم لترمي به في العراء. سوى أن الأثير اللامتناهي الذي أطلقته الحداثة الفائضة، من أجل ان تهيمن على العقول والمشاعر، سيكون له ارتدادات انقلابية على منبتها الأصلي. ظنَّت أنها بتوسيط الميديا تستطيع أن تبشِّر العالم كله بمشروعها الإنقاذي. ثم انبرت تقنع البشرية بأن روح الغرب هي روح التاريخ الانساني كله، وأن كل شيء في العالم الحديث بات رهن قِيَمِها وأحكامها.
* * *
حاصل التجربة التي لم تأخذ الكثير من الوقت، كان في جانب أساسي منه مخيِّباً للآمال. فلو حَسِبَت حكومات الحداثة ما ستؤول اليه أحوالها لحظة انفجار ثورة الاتصالات، لانعطفت عن مسارها واجْتَنَبت سوء الخاتمة. ربما غفلت عما نبَّه إليه بعض نقاد “الميتافيزيقا البتراء” وفي مقدمهم فريدريك نيتشه، من انه “بالمعرفة الكاملة بالأصل يزداد هذا الأصل تفاهة”. ومرامُه في ذلك، أن الفكرة المؤسِّسة للتنوير أخذت تهبط الى أدنى حدودها، وتفقد جاذبية احتوائها على السر لمّا أصبح أصلها معروفاً.
بمحض إرادتها أطلقت الحداثة الفائضة عن طريق الميديا كمّاً ضخماً مما اختزنته على مدى قرون من قيم ومعارف وأسرار. لقد أمست التلفزة الكونية – على سبيل المثال – معادلاً تكنولوجياً للإيديولوجيات الليبرالية الصارمة. باتت أشبه بتقنية أسطورية تستند إلى جماهير عريضة، تتكاثر كلما تطور سلطانها المعنوي.
كتمثيل لعمل هذا “الكائن الاسطوري المضلِّل” يحضرنا ما ذكره مرة أحد منتجي البرامج التلفزيونية في القناة الفرنسية الأولى: «كلما كان مستوانا متدنياً ومادياً، جلبنا عدداً أكبر من المشاهدين. أضاف: هم على الأقل لا يفكرون، فلنتوقف إذن، عن لعب دور الوعَّاظ»…
لهذه الغاية سعت مراكز التحكم بعالم الميديا الى بثِّ كل ما يشجع على القبول الأعمى بالمنتج الأثيري. وهذا بالضبط ما كان لاحظه الفيلسوف الفرنسي الراحل روجيه غارودي في بداية التسعينيات، لمّا بيّن أن فلسفة الإعلام في الغرب تنطوي على تحريض دائم وحاسم من أجل تجنيد المشاهدين بالإغراء، ودعوة إلى الغوغائية والخمول، والتوجه نحو رأي عام تتلاعب به الدعاية والإعلانات. أراد غارودي ان ينبِّه الى أن التلفزيون نفسه لا يقصّ حكاية التاريخ، ولكنه يصنعها بالتلاعب بها. بمعنى أنه يستسلم إلى انحرافات السوق، وإلى تهديم كل روح ساعية الى النقد الخلاَّق، وكل فكر يشعر بالمسؤولية.
لنا هنا من فضاء التلفزة الفضائية المثال التالي:
من غوايات العالم الافتراضي وأضاليله، ذاك الذي يطل عليك من دون استئذان بعبارة “الخبر العاجل”. وهذا النوع من المباغته الذي يملأ فضائيات العالم وبجميع اللغات يبدو باعثاً على سلوى المشاهدة ولو كان خطباً جللاً مثقلاً بالضحايا. حتى لقد غدت الكلماتُ المعدوداتُ أسفل الشاشة أدنى إلى “طقس نفساني”، يتلَّقُفه المشاهدون عن ظهر قلب.
تلقاء هذا النوع المستحدث في عالم الإعلام الفضائي يكاد كل شيء يصبح قابلاً للتصديق. والذي اصطُلح عليه بـ«الميديا» كوصف مكثَّف للسيطرة الإعلامية، سوف يتحول في خلال فترة عجولة إلى «وحش أسطوري» يلقي بظلِّه الرهيب على كل مواطن يتوقع نبأً ما، ينجيه مما هو فيه من هلع.
ظاهرة “الخبر العاجل” على وجه التعيُّن- لم تعد مجرد حالة عارضة. بل هي أمست مع تقادم الزمن وكثافته وسرعته، حالة “نفس – ثقافية” متأصّلة. فلو تحرّينا منشأ ولادتها وأسباب نموها وتوسعها، لتبيّن لنا بهتاناً وبراءتها المزعومة. فإنها موصولة بالأغراض والأهواء والمصالح، وكذلك بغايات سياسية وإيديولوجية واضحة المعالم،في المجتمعات الأهلية، كما في العلاقات بين الدول.
ولئن قال قائل إن مهمة الخبر هي ملء المساحة المجهولة من مجريات الأحداث، ومن حق الجمهور التعرّف على ما لا يعلم، فقوله صحيح في المبدأ. لكن الصحيح أيضاً وأساساً يكمن في الكيفية المهنية والأخلاقية التي تقدم فيها المعلومات فضلاً عن النتائج المترتبة عليها.
ولكي لا يبقى القول في “الخبر العاجل” ضمن حدود الوصف، تحدونا المسؤولية إلى النظر إليه بوصفه وسيلة غير منزهة عن الأغراض. فإنه على ضرورته في تغطية الأحداث، لا ينبغي أن يفارق القاعدة الكلية التي تحكم فلسفة الإعلام، وهي الحرية المقرونة بالمسؤولية. والمسؤولية هنا هي شأن معنوي وأخلاقي قبل أي شأن آخر.. فعلى أرض هذه المسؤولية يمكن إجراء الأحكام على أخلاقية، أو لا أخلاقية الخبر على أنحائه المختلفة. من هنا مسّت الحاجة إلى وجود «قانون للسلوك الحسن». وهو سلوك ينبغي أن يكون مؤسَّساً على أخلاق عالمية في الحد الأدنى، يتم تحديدها وتُفرض على الامبراطوريات الإعلامية، سواء على سلوكهم في ما بينهم، أو في العلاقة مع الآخرين.
المرارة التي يفصح عنها مثقفون غربيون حيال واقع الميديا في مجتمعاتهم، مردُّها إلى استشعارهم أن الحضارة الغربية تنحو بسرعة مذهلة نحو الاضمحلال الأخلاقي. حتى إن كثيرين منهم راحوا يصفون مستهل القرن الحادي والعشرين بأنه عودة متجددة لعصر فساد التاريخ وتدهوره، كما كان الأمر زمن انحطاط الرومان. وأن هذا التدهور الموسوم بهيمنة تقنية وعسكرية ساحقة، لا يحمل أي مشروع إنساني قادر على إعطاء معنى للتاريخ وللحياة.
الوجه اللافت في النقد الغربي لـ “الميديا” يمكث في بعده الأخلاقي والقيمي. وهذا جدير بالاعتناء والتقييم من جانب النخب العربية والإسلامية لما له من أثرٍ بيّن في التعرّف على طبائع النقاش الجاري اليوم في البيئات الثقافية الغربية. ومثل هذا النقد سوف يتخذ حيّزاً أكثر عمقاً في قيمته، حين يصوِّب على ماهية الأخلاق. من النقاد من يشير إلى الطابع الفلسفي للسؤال، فيلاحظ أن ما يخصنا، هو ذاك الذي يتعلق بسؤال الخير والشر. وأيضاً بكل ما يستحق العناية على صعيد القيم مثل الحق والجميل، والشجاعة والشرف والتضحية بالنفس.. ولغياب الضوء الكاشف يعود كثيرون من علماء الاجتماع والأخلاق في الغرب إلى إعادة إحياء ما يعتبرونه المعيار الأولي للخير العام. وهو ما يوفره لهم مبدأ كانط الأخلاقي: تصرّف كما لو أنك تستطيع أن تجعل من مبدأ فعِلِك قاعدة كونية».
وبعد…
كلنا يأمل ويرغب أن يتلقى خطاباً ينبئه بخبر سعيد، أو بمشهد يبتعث في داخله جمال العالم من حولـه، أو بحكمة تمنحه الأمان، وتنزع من ناظريه غشاوة القنوط والضجر والتشاؤم؛ إلا أن ما قصدت إليه فتنة المشاهدة كما قررتها الحداثة الفائضة هو مضاعفة اللاَّمعنى في عالم بات اليوم أشد حاجة الى استعادة مكانة الإنسان ومعناه.
* * *
هذا العدد من “الاستغراب” يعتني بالميديا المعاصرة كظاهرة استثنائية من ظواهر تداعيات الحداثة الكلاسيكية في الغرب. وقد حاولنا تغطية إشكالياتها ومشكلاتها المعرفية والأخلاقية والتقنية، وكذلك أثرها الحاسم على نظام القيم الإنسانية في مطالع القرن الحادي والعشرين.
شارك في هذه التغطية مفكرون وباحثون وأكاديميون من العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن منتخبات مترجمة لعلماء اجتماع وأكاديميين من أوروبا وأميركا الشمالية.