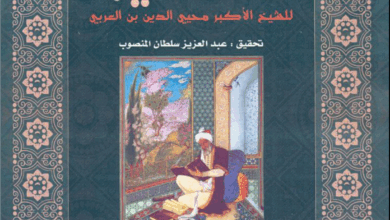التَّصَوُّف وخصائصُه الإنسانيَّة المُشتَركة
التَّصَوُّف وخصائصُه الإنسانيَّة المُشتَركة
د. طه جزاع
كان الدكتور عرفان عبد الحميد ” 1937 – 2007 ” – خريج جامعة كمبردج على يد المستشرق الشهير أرثر جون آربري-، متأثراً بأستاذه الانكليزي من ناحية اهتمامه بالتصوف الإسلامي وتاريخه ورجاله وآثاره، ومع أن اطروحته للدكتوراه كانت عن أثر الفكر الإعتزالي في فكر الشيخ المفيد إلَّا أنه قدم الكثير من البحوث الصوفية ومنها كتابه ” نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها “.
ومن محاضراته المهمة التي كان يؤكد على طلبته لتدوينها بدقة، تلك المحاضرة التي تحدث فيها عن الخصائص العامة المشتركة للتجربة الصوفية، فهذه التجربة هي تجربة إنسانية عالمية في خصائصها، وتسقط فيها من الاعتبار عوامل الزمن والمكان والجنس والعنصر. وقد وردت تلك الخصائص متفرقة في مدونات صوفية عالمية لعدد من كبار الفلاسفة الغربيين، أمثال وليم جيمس في كتابه “إرادة الاعتقاد”، وهنري برغسون في مؤلَّفَيْهِ المعروفين “منبعا اليدين والأخلاق” و” التطور الخَلّاق”، وبرتراند رسل في كتابه “المنطق والتصوف”، كما ذكر بعضها المستشرق الإنجليزي نيكلسون في كتابه الشهير عن التصوف الإسلامي وتاريخه. ومن تلك الخصائص قيام التجربة الصوفية على اعتقاد أولي مفاده أن ثمة منهجًا للمعرفة قوامه الكشف والإلهام والحدس والبصيرة النافذة، وهذه المعرفة حكمة خالصة تتميز بالإطلاق والمباشرة، وأنها قائمة على صدقٍ يقينيٍّ يتجاوز كل معاني الشك والريبة، وهي بهذا تتجاوز فتتسامى عن المعرفة العلمية التي طريقها العقل والحواس. ولكون هذه المعرفة هي وليدة الاستدلال والانطباعات الحسية، فهي معرفة غير يقينية، وبطيئة ومتدرجة وقابلة للتحول والتغيُّر فلا ثقة بها. والتجربة الصوفية ترفض كل تناقض أو تعارض أو تعدد أو كثرة في الوجود الطبيعي المادي، وترى أن الكثرة والتعدد والاختلاف والتناقض، إنما هي مظاهر خادعة، ووهم لا صحة فيه، ومن ثم فإن هذه التجربة تنظر إلى الوجود كونه وجوداً واحداً، أزلياً أبدياً، لا قسمة فيه ولا تعارُض، وإن هذا الوجود الواحد هو الوجود الحقيقي الكلي، أما التعدد والكثرة والتناقض والتعارض فليست سوى تجليات ومظاهر لهذا الواحد الكلي والحقيقي. ومن هنا ترفض المعرفة الصوفية عالم الظاهر والمظاهر، وتعدَّهُ مجرد أوهام وخيالات لا تنبئ عن حقيقة ثابتة. ويترتب على هذا الرفض للقسمة والتعارض رفض الاعتراف بالزمن، فيغدو الزمان أيضاً غير قابل للقسمة، فتتساوى أطراف الماضي والحاضر والمستقبل، بلا تفاوت بينها. ولأن التجربة الصوفية تجربة ذاتية تعبر عن فردانية خالصة، ولأنها أسقطت من الاعتبار العقل والحس كأدوات ووسائط إلى المعرفة، ولأنها تنتهي في دعوى أهلها إلى معرفة كشفية ذوقية مفاجئة ومباشرة، فقد أصبح من المتعذر على صاحب هذه التجربة أن يُعبر عما كُشف له وذاقهُ ذوقاً مباشراً، تعبيراً باللغة العادية، ولهذا قيل عن التجربة الصوفية، أنها غير قابلة للنقل إلى الآخرين. ومن هنا يجهد الصوفي نفسه من أجل تعريف الآخرين قدر الممكن والمستطاع بمضمون التجربة الروحية هذه، التي لا يمكن التعبير عنها مباشرة، ومن ثم اللجوء إلى التعبير الغارق في الرمزية، محاولة من الصوفي للتعبير عما يستعصي على التعبير. مثلما وصف أئمة التصوف الإسلامي تجربتهم على أنها تؤدي بصاحبها إلى الخَرَس. ثم إن التجربة الصوفية أو الروحية أو الجوّانية، تَسوق عادة إلى عدمية، تتفاوت في درجاتها من دائرة إلى أخرى، وتتشخص هذه النزعة العدمية عادة في صور شتى، منها إسقاط التكاليف الدينية وتجاوز المحرَّمات، ونزعات الاستباحة، والخروج عن قواعد الدين والنواميس والعادات المألوفة المُتَبعة، باعتبار أن هذه التكاليف، وتلك النواميس ، قيودٌ لا تربط العارفين – كما يقولون – فأسقطوا بذلك تناقضات العالَم المادي كلها باعتبارها أوهاماً لا تنبئ عن حقيقة. ومن صورها أيضاً، التسوية بين العقاب والثواب، والجنة والنار، والخير والشر، والصدور عموماً عن نزعة جبرية صارمة، جبرية إلهية كانت أم طبيعية – بحسب وحدة الوجود، هل هي وحدة وجود مؤلَهة أو طبيعية – كما جاء عن ابن عربي وغيره، الذين قالوا بالتفرقة والتمييز بين الأمر التكويني الذي قُدر بموجبه الإنسان منذ الأزل ما هو، وبين الأمر التكليفي، بمعنى الانصياع لأوامر الأمر والنهي في التكاليف. وبهذا الاعتبار تصحيح إيمان إبليس وفرعون، من حيث امتثالهما للأمر الإلهي التكويني – هكذا خلقهما الله – مع أنهما عصيا الأمر التكليفي أسجد، إذ يقول إبليس، لا أسجد : ” وَإذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ” . وتَظهر في دائرة التجربة الصوفية عادةً نزعة ثابتة – وإن اختلفت وتفاوتت في درجاتها – تدعو إلى إسقاط الفوارق بين الأديان، باعتبارها طرقاً مختلفة تؤدي إلى غاية معينة، لا اختلاف فيها، هي محبة الله، وإسقاط الفواصل والحواجز والموانع بين الإنسان وربه. ومن هنا دعوى الصوفية إلى عدم التقيُّد بمراسم الأديان باعتبارها قيوداً لا تربط العارفين بالله، وإن على الصوفي أن ينظر إلى الأديان على أنها تمثل حقائق نسبية، هي أدنى من الحقيقة الكلية التي يجهد الصوفي من أجل الوصول إليها والتحقق بها . ونجد صدى هذه النزعة عند الكثير من أكابر المتصوفة المسلمين، أمثال ابن عربي، وجلال الدين الرومي، بل وعند جميع فلاسفة الصوفية المُبَشِّرين بنظرية وحدة الوجود، أو الوحدة المُطلقة، من حيث إنهم ينظرون إلى الأديان المختلفة على كونها مظاهر وتجليات للذات الإلهية الواحدة التي تسمو – بحكم طبيعتها – على التعدد والاختلاف. وأخيراً، فإن التحليل الجواني للتجربة الصوفية، يشير إلى أن سالكي طريق التطهر الروحي، والسمو الأخلاقي، لابد وأن يمرُّوا بحالات من القلق، وعدم الراحة، وذهاب الطمأنينة، وفقدان الثقة بمعارفهم العقلية والحسية، وهي الحالة التي أسماها الباحثون ” الليالي المظلمة “، والتي عندما تبلغ ذروتها وشدتها وتوترها النفسي الحاد، تغدو تمهيداً واستباقاً لحالة ” الصحوة ” التي تليها. وتشير الدلائل إلى أن هذا التحول والانتقال من القلق إلى الطمأنينة – وهو ما أسماه برغسون التحول السكوني إلى الحركي – يكون عادة فجائياً وسريعاً، بحيث يتحول الصوفي من القلق إلى الراحة، ومن الشك إلى اليقين، وهذه الحالة هي ما يسميه الباحثون أيضاً بـ ” التصوف الكامل” ، بمعنى : إن النفس الإنسانية، وقد خاضت تجربة التوحد مع المطلق، وما تسبق هذه التجربة من حالات التوتر والقلق، يعود الصوفي بعدها إلى صحوة، بعد أن اختصه الله بنوع صلةٍ مميزة مخصوصة، يحاول من خلالها ضرب المثل للبشرية، وتقديم خلاصة تجربته لها، تطويراً داخلياً جوانياً للذات الإنسانية. ” يُستزاد في هذا الموضوع من : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح، المكتَبُ الإسلامي، بيروت 1974، والمعرفة الصوفية – دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة ، ناجي حسين جودة، دار عمار، عمّان ، دار الجيل، بيروت 1992 .
إن إسقاط الفوارق بين الأديان، وغيرها من الخصائص المشتركة للتجربة الصوفية، يمكن أن تنطبق على أية تجربة صوفية داخل أي دين من الأديان، سماوية كانت، أم وضعية، ولا تقتصر على الدين الإسلامي مطلقاً. مثلما نجدها في التاويَّة الصينية على سبيل المثال، ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن البحث في الفلسفة الشرقية عموماً، والأديان والنِحَل والفِرق والجماعات الروحية الآسيوية الشرقية، ليس بالأمر الجديد، ذلك أن الكثير من الباحثين الغربيين المحدثين، انتبهوا في وقت مبكر إلى هذا الأمر. ومن أوائل الباحثين العرب الذين بحثوا فيها الدكتور محمد غلاب، أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر المصرية، وخصَّص لها كتابه الشهير ” الفلسفة الشرقية “، الذي صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 1938، وفيه مبحث عن الفلسفة الصينية يشير فيه إلى فضل العالِم زانكير وأمثاله الذين ” كشفوا للعقل الحديث عن ناحية مهمة من نواحي الفكر البشري كانت مجهولة لدى العامة، ومعروفة معرفة مشوهة عند الخاصة. ولهذا الجهل أو التشويه ثلاثة أسباب، الأول صعوبة اللغة الصينية إلى حد يتعذر معه إتقانها واكتشاف أسرارها، والثاني فقدان الثقة نهائياً من جميع الترجمات التي نَقلت النصوص الصينية إلى اللغات الأوروبية، والثالث هو ذلك الغرور الأوروبي المتعجرف الذي ظل إلى ما قبل هذه السنوات الأخيرة يجزم في طفولة بأن أول فلاسفة الدنيا هو طاليس، وأن العقلية الشرقية – ولاسيما الجنس الأصفر – غير قادرة البتَّة على أن تنتج آراء فلسفية ذات قيمة عالية، إلى غير ذلك من الدعاوى السطحية التي أنزلتها البحوث الأخيرة عن الفلسفة الصينية منزلة الخجل والسخرية”. كما يشير الدكتور غلاب في مبحثه هذا إلى الفيلسوف الصيني لاو تسه، واضع فلسفة وكتاب ” تاو تي تشنغ ” الذي يعد بمثابة إنجيل للتاويِّين، ويذكر رأي بعض الباحثين في أن كلمة ” التاو” غير مفهومة، ولذلك فإن مذهب التاويَّة النظري غير مفهوم، مستذكراً في الوقت نفسه الشروحات التي توصل إليها ” زانكير” لهذه الكلمة، والتي من معانيها : الروح الأزلي الأبدي المشتمل على جميع القوى الحيوية، والكائن النقي، والجوهر الأساس لكل موجود، والمدبر العام للكون كله، والحياة الحَقَّة لكل كائن. غير أن خلاصة ما يقوله ” زانكير هو أن التاو تحمل من المعاني ما لا يمكن أن تؤديه أية لفظة أوروبية. ولهذا يكون خاطئاً كل من حاول ترجمتها بكلمة واحدة من لغاتنا الحديثة، بل الواجب ترجمتها بجملة طويلة، أو بعدَّة كلمات، وهذا الرأي، فيه شيء من التزمُّت، فإن كلمة ” اللوغوس” الإغريقية على غموضها، أقرب ما تكون إلى كلمة وفكرة ” التاو”، وبمعنى العقل الكلي، أو القانون الكلي وأساس العالَم، وهذا ما يؤيده على سبيل المثال لا الحصر روزنتال في موسوعته، إذ يشير إلى أن المفاهيم المماثلة للوغوس هي التاو في الفلسفة الصينية. أما عن علاقة التاو بالتصوف فقد ورد في بحث مهم ومُبتكَر للباحث عبد الحسين شعبان أن التاوية انقسمت لاحقاً إلى تاويَّة فلسفية أو ثقافية وتاويَّة دينية، والتاويَّة تعني الصِّراط، مثلما استخدمت في الفلسفة أو الثقافة أو المبدأ والمآل الذي تأتي منه وتعود إليه كل الأشياء، والتاو هو القانون الطبيعي أو الكيان الذاتي للأشياء، لكن الأساس في التاو هو الإطلاق. ويتضمن هذ البحث إشارات إلى بداية اهتمامه بالفلسفة التاوية والفلسفة منذ الثمانينيات. ثم ينظر بإيجاز في ثلاث عقائد أساسية لابد أن يتناولها من يبحث في الفلسفة الصينيَّة، وهي الفلسفة الكونفوشيوسيَّة، والفلسفة البوذيَّة، والفلسفة التاويَّة. والأخيرة تمثل في رأيه روحَ الصينيين، فيما تمثل الكونفوشيوسيَّة مظهرَهم الخارجي، منبهاً إلى استفادة التاوية من فلسفة الزن البوذية، فضلاً عن الطقوس الكونفوشيوسيَّة بهدف تحضير العقل الباطن الذي يساعد على الفهم والإدراك. وفي بحثه عن وحدة الوجود في الفلسفة التاوية، يشير شعبان إلى : إنها تدمج الإنسان بالعالم المطلق، فالتاو يقوم على القوة المادية في الموجودات، وهو ما ذهب إليه صدر الدين الشيرازي الذي جعل الله حضوراً فعلياً في الموجودات، انطلاقاً من مذهبه “الحلوليَّة”. ثم يشير إلى عدة نقاط مهمة يمكن اختصارها بالآتي: التاويَّة تؤمن بوحدة الوجود، أي أن الخالق والمخلوق متحدان في شيء واحد، ولا يمكن فصلهما، وإلّا سيحدث الفناء، مستنتجاً في ثنايا البحث، تطابُقَ مبدأ وحدة الوجود لدى ابن عربي مع الفلسفة التاويَّة تقريباً. وفي هذه النقطة يذكر مواصفات الصوفي التي تقوم على – التخلّي والتحلّي والتجلّي – والتجلّي يأتي نتيجة للتخلّي والتحلّي، ليكون الإنسان هو المثال للعالم الأكبر. كذلك تؤمن التاويَّة بمبدأ دورية الزمن، فليس هناك نقطة بداية ولا نقطة نهاية للأشياء والتاريخ والوجود. وهذه كلها خصائص مشتركة للتجربة الصوفية كان يؤكد عليها الدكتور عرفان عبد الحميد في كتبه ومجمل محاضراته عن التصوف التي كان يلقيها على طلبة قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة بغداد في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
________________________________
*نقلًا عن موقع ” مراصد”.