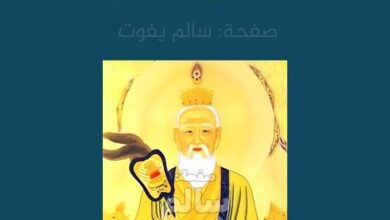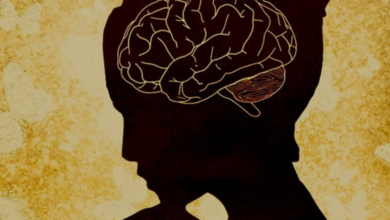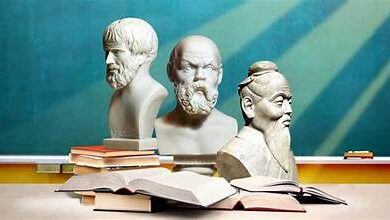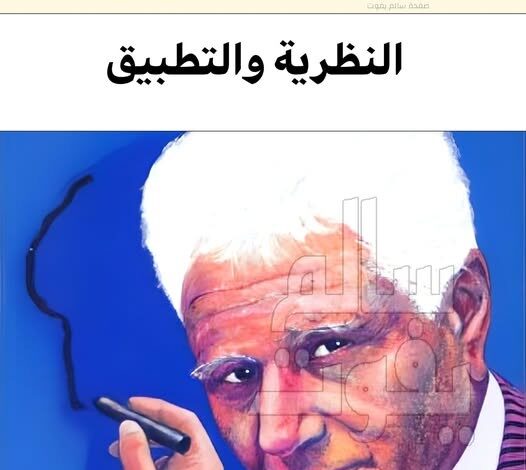
المنهج التفكيكي بين النظرية والتطبيق
المنهج التفكيكي بين النظرية والتطبيق
“التفكيكية ليست منهجًا بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هي استراتيجية نقدية أسسها الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا (1930–2004). تهدف إلى زعزعة ثبات المعاني وكشف التناقضات الكامنة داخل النصوص التي غالبًا ما تتسم بإطلاق الأحكام والمثالية. وقد طرح دريدا أفكاره الأساسية في ثلاثة كتب نُشرت عام 1967، هي: «حول علم القواعد»، و«الكتابة والاختلاف»، و«الكلام والظواهر”.
استند دريدا إلى إرث فلسفي ناقد للميتافيزيقا، أبرز رموزه نيتشه وهايدغر، وسعى من خلال التفكيك إلى تقويض مفاهيم مثل الحقيقة المطلقة، والواقع الثابت، وتوجيه الاهتمام نحو اللغة والتأويل بوصفهما الحقل الذي يُنتج فيه المعنى. فالمعنى لا يُعطى مسبقًا، بل يُعاد إنتاجه باستمرار من خلال القراءة.
التفكيك، أو Deconstruction، هو أهم التيارات ما بعد البنيوية في النقد الأدبي والفكري، وأكثرها إثارة للجدل. لا يسعى التفكيك إلى تدمير النص بل إلى الكشف عن الفجوات والانزياحات فيه. إنه قراءة مضادة تفضح ادعاء النص بامتلاك وحدة وبنية ومعانٍ مستقرة.
في التفكيك، يصبح القارئ فاعلًا أساسيًا؛ فالنص لا يكتمل إلا من خلاله. القارئ يُعيد بناء المعنى بناءً على ديناميات الاختلاف والتأويل. وبهذا المعنى، فإن التفكيك يرتبط بالهيرمينوطيقا، لكنه يختلف عنها من حيث غياب أي مركز ثابت يُحيل إليه المعنى.
ينتقد دريدا مركزية الصوت والحضور في الفلسفة الغربية، ويفضل الكتابة بما تنطوي عليه من تأجيل وتأويل. يرى أن التعويل على الأصل أو المعنى الحاضر هو نوع من الميتافيزيقا التي يجب تفكيكها. لا يقدم بديلاً إيجابيًا، بل يمارس مغامرة فكرية تُقوض ولا تبني، تهدم ولا تُنتج نسقًا بديلاً. لذا، فإن مشروعه هو هجوم دائم على الميتافيزيقا بمعناها التقليدي.
الميتافيزيقا التي يستهدفها دريدا هي كل فكرة ثابتة ومنغلقة على ذاتها، منزوعة من شروطها التاريخية والثقافية. لذلك يتّصف التفكيك بطابع فلسفي وسياسي في آن، إذ لا يكتفي بنقض المنطق الظاهري للنص بل يفضح خلفياته السلطوية والمؤسسة.
يرتكز التفكيك على تفكيك الثنائيات الميتافيزيقية (داخل/خارج، دال/مدلول، واقع/مثال…) ليكشف عن هشاشتها، ويؤسس لحقيقة منفتحة: لا هذا ولا ذاك، بل الاختلاف الدائم.
وتُعدّ خلفية دريدا الفكرية اشتباكًا مع التصورات اللاهوتية الغربية، وخاصة مع مركزية «اللوغوس» في الكتاب المقدس، حيث الكلمة تُعد تجليًا للحضور الإلهي. أما التفكيك، فيسعى إلى خلخلة هذه المركزية.
وقد لخّص عدد من الباحثين أبرز معطيات المشروع التفكيكي في خمس مفاهيم أساسية:
1-الاختلاف (Différance) :
يشير إلى تأجيل المعنى واستحالته إلى الحسم. فالمعنى لا يُستقر في نقطة واحدة، بل يظل منفتحًا على تعددية لا نهائية من التأويلات.
2 – نقد التمركز (Critique of logocentrism):
يسعى إلى تقويض مركزية الأصل أو الحقيقة أو المعنى الحاضر التي ميّزت الفلسفة الغربية منذ أفلاطون.
3– نظرية اللعب (Play) :
المعنى ليس حاسمًا، بل يتولد ضمن شبكة من العلاقات، في لعبة لا نهائية من الإشارات، تخلو من مرجعية نهائية.
4 -علم الكتابة (Grammatology) :
دريدا يعيد الاعتبار للكتابة مقابل الصوت، مقترحًا مفهوم “الأثر” بدل “العلامة”، حيث لا يوجد مدلول متعالٍ، بل سلسلة لا متناهية من الدوال.
5 -الحضور والغياب:
كل معنى يفترض غيابًا، وكل دال يحيل إلى دال آخر. لا معنى دون غياب، ولا حضور دون أثر لهذا الغياب.
لا يُفهم التفكيك كمجرد تقنية تحليلية، بل كموقف فلسفي جذري يعارض كل أشكال التمركز والمعنى الأحادي، ويكشف عن قدرة النصوص على توليد معانٍ متعددة ومفاجئة، باستمرار.”
______________
*المصدر: صفحة “سالم يفوت”.