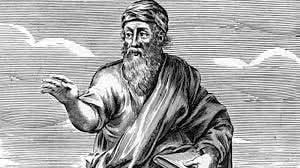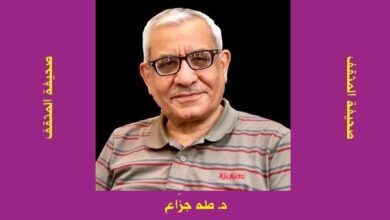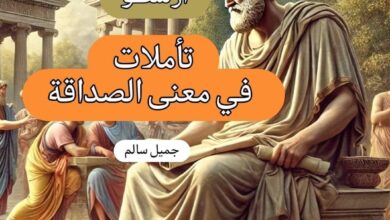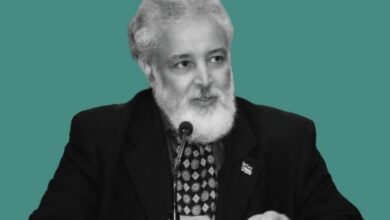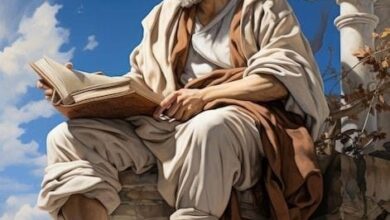مع د. حبيب فياض متأملًا فلسفة الدين
مع د. حبيب فياض.. متأملًا فلسفة الدين
إدريس هاني
يسبقني السؤال: هل في مُكنة العرب اليوم إنجاز فلسفة للدين بله فلسفة للتديّن، ولمّا تستكمل الفلسفة قوامها الممشوق جمالا وقوامها المعرفي المنظوم بيانا، في شرط تاريخي توتّرت فيه الأفهام الدينية، واحتدم النزاع بين ما للدين وما بالدين مع ما ليس لا للدين و لا بالدين؟
وسؤال فرعي يتمادى هو الآخر: ماذا عن لبنان الذي يعيش قدرية العيش المشترك، لا يمكن فيها تجاوز الدين ، به أو فيه، لأنّ العيش يقتضي الحوار، والحوار هنا يمرّ عبر صفائح الأديان، داخل لعبة أمم اقتضت أن تجعل من هذا البلد مأوى لأنارشية سياسية، كان ولا زال الدين فيها على المحك. إن كان لبنان قد خضع لترسيمة جغرافية وسياسية ممنوحة بقوة الغلبة والانتداب، فلقد رافق هذا الانتداب خيّالة لاهوت حاولوا تحديد هويته السوسيو-ثقافية ومظاهره الحضارية ضمن سقف الأساقفة وما يسطرون. كان الدين حاضرا في بؤرة لبنان الكبير الذي وُلد من رحم الانتداب واقتطاعاته وحساباته، حاضرا في الخرائط وإدارة الطوائف ودسترتها، وليس بعيدا عن كل ذلك تقريرات القس هنري لامانس.
يطفوا السؤال الأخير بغتة، وأنا في خلوة البحث عما يخفف من غلواء انشغال ظلت آثاره جاثمة على روعي، لأنّ البيئة والإيقاع مختلفان. ماذا يا ترى يمكن أن يقدّم كتاب الصديق د. حبيب فياض الموسوم بـ “فلسفة التّديّن، الطريق إلى الله في عالم متحوّل”؟ هل سيخرجني من كهفي وقد بات همّي تضميد جروح سنوات من المقارعة، وضع شروطها شكل من الفهم الديني ومظاهر من التديّنات تحتل المراتب البدائية للفهم الديني، مقارعة تُزرم الرغبة في الارتقاء بالدين والتدين معا، إلى محاضن الفلسفة، دراسة بالدين أو في الدين كما سنرى مع حبيب.
تأبطت كتاب حبيب، وكلّي يأس من أن ينتج العقل العربي ما به تقوم فلسفة الدين وتولد على طريقه فلسفة مكمّلة له: فلسفة التدين، يأس من وضعية التدين والفلسفة معا في البيداء العربية، في حافة انحطاطها الفكري، وغلبة الديماغوجية وسوء النّية في التفكير، وتنامي البُغاث في النظر والممارسة. وأمّا حبيب فقد حمّلني مسؤولية قرائية تدخل في معنى الدلالة الإلتزامية، أو في المغزى التداولي لغواية اللغة التي تفوق كونها أداة تعبيرية، أو غواية إنشاء مفتوح، وذلك حين قال لي: كل كاتب يستحضر أشخاص معينين أثناء الكتابة، وأنت من بين من كنت أستحضرهم وأنا أنجز هذا النّص.
وضعني حبيب أمام محنة سيميائية التّلقي، حين يحتلّ النّص البرزخ الرمادي بين المؤلف والقارئ، ليؤكد بتعبير أمبرطو إيكو على مفهوم النّص المفتوح الذي يتمثله كاتبه كقارئ أيضا. أو إن شئت فإنّ النص، حتى الفلسفي، هو بهذا المعنى حصيلة تفاعل ظاهري وباطني، حوار متدفق مع قارئ مفترض، بل لنقل هو نتاج تفاعل بين الكاتب والقارئ بتعبير فولفغانغ آيزر.
يضمن فعل القراءة سيرورة النّص في ضوء جمالية الاستقبال كما عند هانز روبرت ياوس، لكنها أيضا تثير عندي شواغل اللاّشعور، المأوى الذي يسعفنا في إسكان من يحضرون قرّاء نموذجيين، تحقيقا للقراءة المفتوحة لنص مفتوح.
أقنعني حبيب بتأمّلاته تلك، فما فرّط فيها من نكتة هنا وهناك في تاريخ الأفكار، متفاديّا المقاربة المدرسانية المملّة، والتي باتت صناعة جامدة تعيد إنتاج الجمود وتجرّي البُغاث على السّرنمة الممسرحة.
فهي تستند إلى لغة مطواعة، تحققت معها بُلغة البيان والتبيين، حملت مضمونا دقيقا، مما جعلها خارج غواية الإنشاء الأجوف الذي ميّز معظم ما ألّف عربيا في مجال فلسفة الدين. وبين تلك الثنايا، كان حسن النية وإرادة الإنصاف، المسؤولية التي تجعلنا لا نُؤْثر أحكام قيمة في سياقات وشروط تشجّع على تلك الأحكام دون أن تكون بالغة الإقناع.
قوة التأمّل، ومرونة المنهج، وبلاغة الخطاب، ومقاصد البحث، كل هذا يجعلنا أمام محاولة جادّة، لباحث لا يختفي خلف العبارة لرقّة في المضمون، ولا يخلط الأوراق في مجال الإقناع، مما جنّبه آفات الخطاب الأيديولوجي الجامد. وبهذا يكون مُنجز حبيب، حريّا بأن يكون مرجعية في التنظير الجاد في مجال فلسفة الدين عموما، ومجال فلسفة التّديّن التي تدور حولها محاولته تلك.
قد تكون مصادفة أنّني خرجت توّا من نقاش كنت أستشرف آفاقه المسدودة، تارة بين من ينطلق من الدين توتّرا وبين من ينطلق خارجه بالتوتر نفسه. عند تفكيك الخطاب، نقف على تكامل الأدوار.
المغالطة داخل الدين وخارجه، هي من يرسم محنة الحوار كفريضة غائبة. وما يجول في بيدائنا هو توترات وانفعالات مهجوسة بالسباق والرغبة في الحظوات، وتخونها الشجاعة في المصالحة مع الذات والموضوع.
فيصبح كتاب فلسفة التدين لحظة مهمّة لاستئناف النقاش في سلّمه الفلسفي الأعلى، خارج النشاز المتداول، المنتهك للنظام المعرفي والبيئي والصولفيج الكوني الذي تضمنه فطرة كائن مدرك للنّغم الأنطولوجي، والذي به يرقى الوعي بفلسفة الدين إلى ما يفوق الموسيقى، أي الهمّ الأعظم كما عند تيليش، أو المطلق والأبدي الذي يُجاوز بالفلسفة همّ العالم، بالمعنى الهيغلي. بهذا نستطيع تجاوز محددات النزاع في الدين وحول الدين، حين تتعاظم مفهماتنا، وحين نفتح الأفق الذي يرسم حدود ما هو علم وما هو فلسفة دينية وما هو فلسفة الدين.
ليس كتاب حبيب توصيفا لمظاهر السلوك الديني بالمعنى الذي تكفلت به السوسيولوجيا الدينية أو الأنثربولوجية الدينية. فهذه الأخيرة، تضعنا أمام أشكال متفاوتة للتدين ، تفتح طريقا لتأويل الظاهرة الدينية تماما كتحليل البنيات الرمزية لأي مجتمع يمارس تدينه، لكن لا يكتبه ولا يعيه، بل الممارسة اللاّواعية لعوائده تفرض هذا النوع من التأويل. لكن محاولة حبيب وإن كانت معنية بالبعد العملي لفعل التدين، فهي تسعى لربطه بمخرجاته النظرية كما تؤكد على الأثر المعكوس للبعد العملي على النظري أيضا. سيتصالح النظري مع الواقعي، الشفهي مع الكتابي، التمثّلات التطبيقية مع التعاليم الوحيانية.
هل ثمّة ما يجعلنا إزاء موقف هيغلي؟
في ثنايا المحاولة رغبة للربط والوحدة بين النظري والعملي، بين التجلي العقلي والتجلي الواقعي، وهذا يحفّزني لربط ثنائية الدين والتدين بثنائية العقل والتعقّل. وهي في نظري قضية تعفينا من كثير من غواية التفريع. فالدين لا يتنزل من منزلته الوحيانية خارج فعل التّعقل. والعقل عند التشخيص هو أيضا فعل وممارسة، يجري عليه ما يجري على كل عملية تنزيلية وتطبيقية، فهو تعاقد ينشأ عنه مبنى العقلاء، هو بهذا المعنى تجلِّي لعالم متحوّل بعمرانه البشري، بمبانيه العقلية التي تطرأ عليها اللّوابس، ليصبح جدل المعقول واللاّمعقول يرخي بظله على الدين والتديّن.
هذه الكائنات التي تتمثّل التعاليم الخام في أولى تنزّلها، تحبك معها علاقة إعادة إنتاج تحضر فيها مدارك المتلقي، فيحصل التفاوت في حاق التّديّن وأفهامه. وكان جديرا بفلسفة الدين وفلسفة التدين أن تحلّ معضلة جدل العمودي والأفقي في عملية التّلقي والفهم الدينيين.
هذا النّقاش يتجاوز بمسافة فلكية النقاش السّطحي حول أعقد ظاهرة في تاريخ الاجتماع البشري، كما تنضح به الميديا، ويتناقر به ديكة التبسيط. تصبح المقاربة المبسطة للدين خارج فلسفته، شكلا من التأزيم، وتهديدا لعقل حتى ونحن في ذروة هجاء الدين من خارجه توسّلا بعقل، هو في نهاية المطاف شكلا من التعاقلية الوظيفية في تاريخ اجتماعي محدد أو فضاء خاص.
ّعرّف حبيب بموضوع بحثه، حتى لا يتلاشى في متاهة النظر. ومع أنه سيثبت أنّه بصدد السير على منوال الشهيد الصدر في التمييز المنهجي بين العلم والمذهب – في مقاربته الاقتصادية- فهو حريص هاهنا على تحديد موضوع بحثه كما هو ضروري في مبتدأ تعريف موضوع كل علم، من حيث البحث في عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض، كما يعرفه الآخوند الخرساني في الكفاية. وهذا في ظنّي مهمّ حتى لا ترتبك تخوم العلوم في سياق فصلها عن بعضها، الحاجة المدرسانية لتحقيق المباني، لكنها في نظري هي مجرد بداية إجرائية قبل العود الأحمد لأصل النظرة الكلية التي تندك معها الحدود في مغامرة عبر-مناهجية لا أجد عنها محيصا. ويمكن في نظري وضع محاولة حبيب في سياق خدمة العبر-مناهجية، لأنها لم تنحشر في تعددية المقاربة من دون خطّة لتجاوز الحدود، فالمرور السلس بين فِجاج المناهج والمقاربات، سمة عبر-مناهجية بامتياز. يرى حبيب أنه بصدد مهمة تدشينية لفلسفة تُعنى بالجمع بين البحث النظري في التدين والبحث التطبيقي في الدين.
هي ليست محاولة لوضع تخوم بين التدين والدين، بنية الوقوع فيما ذهب إليه غوشيه في دين الخروج من الدين، بل هو يعمل على دراسة التدين متجليا في النصوص ودراسة الدين متجسدا في الواقع. بهذا يكون قد تجاوز معضلة الشرخ الذي فتح متاهة استبعاد التجسدات والأفهام الدينية لصالح تجسدات تمتحي أصولها من الرغبة في الاستبعاد.
وواضح بعد تاريخ من النزاع حول الدين، أنّه غير قابل للاستبعاد، وأنّ تفهمه يقتضي فهمه، وفهمه يقتضي استيعاب فلسفته. أما حبيب فهو يحاول خلق متحد ماهوي بين الدين والتدين، وهنا تكمن أهمية البحث.
ليس البحث في فلسفة التدين تقليل من أهمية النظرية الدينية، بل هي محاولة للحد من هيمنة النظري، والربط بين الممارسة وأصولها النظرية، وذلك بغرض الخروج من النزاع في الدين، والأخذ بعين الاعتبار الممارسة إلى جانب المفهوم، ذلك لأن المطلوب في التدين حسب حبيب هو “معقولية الدين في مقام الفهم، وإمكانية التدين في مقام الممارسة”.
وتكمن أهمية هذا المقصد في معالجة واقع غدا فيه الدين نظريا يساوي عند البعض اللامعقول، وهو كذلك إن نحن أخذنا بعين الاعتبار ما سبق وعبرت عنه بالتعاقل بوصفه تعاقدا في فضاء خاص، فهو ليس معقولا بلحاظ اختلاف فضاءات ومستويات التعاقد التعاقلي. ومثل هذا النزاع هو ما جعل التدين يقترب عند البعض لكي يكون مستحيلا. معقولية الدين وإمكانية التدين هي مقصد من مقاصد هذا البحث.
لا يتجاهل البحث تاريخية هذا التراكم بين إثبات المتدينين ونفي غير المتدينين، فالفكر الديني ولد داخل هذا التراكم ذي الطبيعة النزاعية. فالدين لم يعد قضية مبسطة، بل هو تركيب بين ما هو داخل_ديني وما هو خارج ديني، به قامت ضرورة التمييز بين التفكير في الدين والتفكير بالدين. وقد تكون هذه التفاتة جديرة بالاهتمام. ذلك لأنّ التمثّل الديني يخلق تجربة انفعالية مع التعاليم لا تخلوا من بعد معرفي: المعرفة الدينية، التي تشكل امتيازا في الفهم الديني وفلسفته. هل يا ترى يمكن للتفكير الخارجي أن يحقق الهدف عبر استبعاد التفكير بالدين؟ هل كان يا ترى هيغل في تدشين القول في فلسفة الدين، ناظرا إليه من الخارج أم من الداخل؟ ألم يكن هيغل ابن المدارس اليسوعية؟! فلم إذن فقدنا شرط الخبرة في الجدل القائم اليوم مع الموقف الخارجي؟ ففي كل مناكفة من هذا القبيل يتكامل التطرف من خارج الدين مع التطرف من داخل الدين، وهو ما يجعل العقل والتعقل مرة أخرى في المحك.
مايسمى خلطا بين الديني والبشري، أي المعرفة البشرية التي تساهم في تحقيق الفهم الديني، وهي الثنائية التي ولغ فيها سروش عبثا من دون حسن نية ديكارتية، هو واقع في ملحمة البرهان الذي كان مطلوبا في النص التأسيسي باعتبار أنّ الحقيقة الوحيانية هي نفسها لم تنفك عن الوسيلة البرهانية: (قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين). هذا البرهان هو ما تعاقل عليه البشر، وهو مطلوب وحيانيا، إذ الفهم الديني لا يستقيم من دون تعقّل. وسأغتنم الفرصة لبيان هذا التبييت، كما لو أنّ المعرفة البشرية تقع في عرض هذه الثنائية وليست بديهة التلقي، حيث في النص التأسيسي لا يوجد فارق بين مطلوب الوحي وعقلانية التّلقي.
إنّ تفكيك الخطاب والعبر-مناهجية تمكننا من الكشف عن أهداف هذا الشرخ، لا سيما حينما لا تحضر حسن النية. فلئن كان التعاقل تعاقدا على شكل المباني العقلائية، ما عدا ما هو ثابت ومركوز في تاريخ المعاقلة، فما الضامن أن لا يجري على تلكم البدائل هذا التنسيب؟ وهل يا ترى التفتنا إلى مغالطة ثاوية في ثنايا العنترية السروشية، بأنّ إعادة مقاربة الوحي سيكولوجيا لا تتحقق إلا بامتحاء إيحاءات ورجم بالغيب يتخفى خلف سلطة المفاهيم التي عادة تجعلنا أمام شكل من دين ضدّ دين: لكم دينكم ولي دين، في ذلك النزاع بين الخارج-ديني والداخل -ديني الخادع؟
يرى حبيب أن العناصر الدينية سرعان ما تلتبس بالعناصر غير الدينية، تلك العناصر التي تبدأ عند التأسيس ظاهرة، لكن سرعان ما تصبح خفية ومؤثرة وموجهة بفعل التراكم. هكذا تبدو المعرفة الدينية دينية وبشرية في آن معا، وليس دينية فحسب كما تتراءى للبعض أو بشرية فقط كما تتراءى للبعض الآخر.
لا تمثل هذه الإلماحة قراءة في بحث له أبعاد تفصيلية مهمّة، ولكنها تحفيز ولفت نظر لعمل على قدر من الجدية والعمق في تناول فلسفة التدين، وتقديم رؤية تحاول تحليل ما تعذّر أو صعب تقريبه، بحثا عن مصالحة بين النظري والواقعي، لأنّ الشرخ المتداول اليوم بين النظر الديني والممارسة، عمّق سوء الفهم الكبير.
أنجز حبيب عددا من الأعمال تصبّ في هذه المحاولة، هذه الأخيرة التي ما فتئت تتطوّر وتنضج، لتعانق بُعدا جديدا من مقاربة معضلة الفهم الديني من جهة فلسفة التدين، وهو ما يجعلنا نستعيد الثقة بمصير النقاش حول الفهم الديني وفلسفته دينا وتديّنا، خارج شقاوة النقاش الدائر اليوم، وغير المستوفي لكفاءة النقاش من حيث المعرفة بالدين والمعرفة في الدين، لنرقى بالنقاش ونعود به إلى عصر المعرفة – لا التّفاهة- ونستأنفه من داخل جيل الرواد. بعض ممن ينطلق من داخل الدين هو أكثر تطرّفا مقارنة بالنص التأسيسي وما يحبل به من آراء معجزة من حيث ملامستها للمعقول، وبعض ممن ينطلق من خارج الدين هو أكثر تطرفا مقارنة بفلسفة الدين وما تحبل به من آراء معجزة من حيث ملامستها لجوهر الدين.
إنّنا في زمننا السبراني نتقدم في كثير من العلوم، غير أنّ النزاع حول فلسفة الدين ارتهن لمنغصات كثيرة، غلبت عليها نظرية الألعاب السياسية، موجبات عصر التّفاهة، تراجع التفكير أمام المقاربات الاستهلاكية، لكن هذا لا يمنع من وجود محاولات جادة ومفيدة، كالمحاولة التي بين أيدينا، للباحث اللبناني والخبير في فلسفة الدين، د. حبيب فياض.
_________________________
*المصدر: “أنباء إكسبريس”.