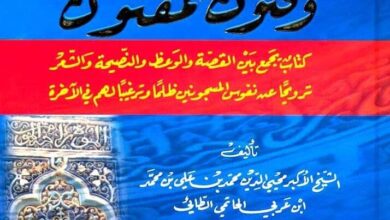المتخيَّـل والسَّرد في الفـكر الإسلامي
المتخيَّـل والسَّرد في الفـكر الإسلامي
آمنة عبايديَّة
تمهيد:
قاوم الإسلام بوجه عامٍّ فكرة الخيال والأدب القصصيِّ، فقد اعتُبرت بمثابة بدعة في العقيدة، والبدعة ضلال وكفر. ولكن، كما استنتج ستيفان ليدر وآخرون، يمكن رصد الجانب الخياليَّ في التأريخ الإسلاميِّ بوضوح من زاويتين: زاوية تأريخيَّة بحتة تعتبر أنَّ كتابة هذا التاريخ يميل إلى أن يكون نمطيًّا جدًّا ومخطَّطًا له ومبرمجًا، أي يتَّصف بمحدوديَّة المجاز والاستعارة، وأنَّه في الغالب من دون مصادر موثوقة يُعتدُّ بها وقويَّة الإسناد. وزاوية لغويَّة حيث أنَّ كلَّ المحاولات العربيَّة التي قاربت المتخيّل وتناولته من الجانب الُّلغويِّ، كانت تركن إلى الشعر العربيِّ، كما أنّ مرجعيَّة هذه الثقافات، بالإضافة إلى القرآن، كانت مسندة بالفلسفة الهيلينيَّة، إذ عادت إلى الثقافة اليونانيَّة لترتوي من معينها. ولقد اقتصر انفتاح الثقافة العربيَّة على الثقافة اليونانيَّة في بداية الأمر على كتاب “فن الشعر” لأرسطو طاليس، باعتباره قريبًا في طرحه في تناول الشعر اليونانيِّ من التصوُّر الإسلاميِّ، أو هكذا اعتقد فلاسفة الإسلام الأوائل؛ الشيء الذي جعلهم يعملون على الجمع بين النظرة الأسطوريَّة عند أفلاطون وبين عقلانيَّة أرسطو. وهذا يعني داخل السياق الإسلامي، الجمع بين البيان الدينيِّ للمعنى، وبين التركيب المنطقيِّ والبرهانيّ.
تحظى قصَّة الغار بمكانة عليّة في مخيال الأمَّة الإسلاميَّة، فهي تؤسِّس للكتابة، كما تؤسِّس لانطلاق الدين الجديد في الجزيرة التي كانت بحسب القرآن، ووفق مفهوم الدين الجديد، أمَّة أمّيَّة لا تعرف القرآن ولا تعرف الكتابة. هي قصة امرئ كان صادقًا لا يرى رؤيا في منامه إلَّا جاءت كفلق الصبح، وكان شديد الولع بالضرب في الشعاب وبطون الأودية حيث كان يسمع الصوت مردِّدًا «السلام عليك يا رسول الله »، فينظر ولا يرى إلَّا الشجرة والحجارة”[1].
أنظر الغار الآن ترَه فضاء الأحلام والرؤيا والغيب والتخيُّل والتقاء الربّ، أنظره تجده المكان المناسب لانطلاق الوحي والإلهام، أنظره ترَ الخلوة المثال للتعلُّم والدُّربة، أنظره فكلُّ امرئ كان له في الدين شأنٌ قد مرَّ ذات يوم بغار، هذا إبراهيم الخليل ولدته أمه في غار خوفًا عليه من بطش النَّمرود، ووجد في الغار رزقه وحياته. وهذا هرمس اليونان نظير إبراهيم الخليل في تلكُم الديار، ولدته أمُّه في غار فجاء ربًّا ليس كمثله في الأرباب، كان ابنًا لزوس أنجبته له “مايا”، وفي ذلك الغار الدامس صنع الحياة، وتعلَّم الحكمة، وكان مبدع نظام مدنيٍّ لا يعرف العنف “[2].
إنَّ هذا السعي من قبل المخيال العربيِّ الإسلاميِّ إلى إضفاء القداسة على العراء أو الجبال وتبجيلها، له نظيره في كلِّ الثقافات، فلقد كان لكلِّ شعب جبله المقدَّس الذي تدلُّ قمَّته على وجود الآلهة، ويرمز دخول الغار أو تسلُّق الجبل إلى التعالي بالنفس والوصول إلى مراتب عليا، ومنطلق الديانات الثلاث “[3].
هذا جبل “قاف” كما جاء عن الرُّواة والمفسِّرين أمثال (ابن كثير) والمتصوِّفة على غرار (ابن عربي)، فإنَّ صاحبه لم يتردَّد في جعل الديانات الثلاث جبليَّة، فتصبح (التين والزيتون) دالَّة على جبل بيت المقدس، الذي بعث الله منه عيسى بن مريم و(طور سنين) على جبل سيناء، الذي كلَّم الله عليه موسى بن عمران، و(البلد الأمين) على مكَّة، التي أرسل الله منها رسالة الإسلام لنبيِّه محمد “(صلى الله عليه وسلم) .
الخيال و التخيُّل عند الفلاسفة:
لا ريب في أنَّ مجموعة من النقَّاد والبُلغاء العرب وغيرهم، تطرَّقوا إلى مفهوم الخيال والتخيُّل، نذكر منهم:
– الفارابي وملكات الخيال المتدرِّجة:
يفرِّق الفارابي (توفّي سنة 339 ه) بين الأقاويل الشعريَّة والأقاويل الخطبيَّة، من حيث أنَّ الأولى تتميَّز بالتخييل على كتب من سبقوه، منها كتاب “فنّ الشعر” لأرسطو، ولكنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أفلاطون وأرسطو من حيث أنَّ عمليَّة الإبداع في الشعر عنده أساسها الروية، وليس الوحي والإلهام. الفارابي إذن لم يعرف التخييل، وإنما أشار إلى أثره الذي يتركه في نفس المتلقّي، و مثله مثل أرسطو، وضع الخيال داخل بنية متدرِّجة للملكات داخل الروح، لكن مكوِّنات هذه البنية لديه أصبحت أربع ملكات بدلًا من ثلاث لدى أرسطو، فقد أضاف الملكة الغاذية أو الغاذة إلى ملكات الإحساس والخيال والعقل، وظلَّ الخيال لديه خاضعًا للعقل، لكنه لم يعد ظاهرة محيِّرة مصاحبة للإحساس، لا موضع لها ولا مستقرّ كما كانت لدى أرسطو. كذلك أصبح للرغبة موضعها الخاصُّ بها في هذه القائمة، لكنها وضعت أيضًا مرتبطة بالإحساس وفي مستواه.
لقد تحدَّث الفارابي أيضًا عن ملكة مماثلة لما سمَّاه أرسطو الحسَّ المشترك، وقد كانت هذه الملكة تقوم بوظائف عدَّة، من بينها الرَّبط بين المظاهر الحسّيَّة المتنوِّعة، وكذلك لم يقل إنَّها وظيفة للخيال. أمَّا لدى الفلاسفة المسلمين عمومًا، ومنهم الفارابي، فقد أصبح الحسُّ المشترك قوَّة تركيبيَّة تؤلِّف بين الأحاسيس وتجمع بينها أيضًا بطرائق متنوِّعة، فأحيانًا تكون هذه الطرائق متَّفقة مع الحسِّ، وأحيانًا مناقضة له، وأكثر الفصول إثارة للاهتمام في كتاب الفارابي عن أخلاق أهل المدينة الفاضلة هي تلك التي كتبها حول “الأحلام والنبوءة والرؤى”، حيث تحرَّر مفهوم الخيال لديه من ذلك الأسر الخاصِّ بالتراث الأرسطيِّ. ففي الأحلام يمكن أن يكشف الخيال عن قوى يمكن أن تنسب – بعد ذلك – إلى الفنان المبدع. وهو لم يربط الخيال هنا بالشعر أو الفنون البصريَّة، لكنه نسب إليه الملكة الخاصَّة بالمحاكاة، حيث المحاكاة تشتمل على تكوين للصور في سلسلة الأحداث التي يمكن أن تحدث في الحياة الواقعيَّة*.
– ابن سينا والمخيّلات :
يتطرَّق ابن سيناء (توفّي سنة 427) إلى أقسام الكلام الثلاثة، هي: الاسم والكلمة أو (الفعل) والأداة التي عالجها أرسطو في مطلع “كتاب العبارة” أو (باري هرمنياس)، فإلى أقسام “الَّلفظ المركَّب” أو القضايا التي عالجها في الفصول اللَّاحقة من ذلك الكتاب. وبعدما تناول أقسام القياس الثلاثة أي الاقترانيَّ والاستثنائيَّ والشرطيَّ، يأتي على المقدِّمات التي يبني عليها القياس بأشكاله، وهي تسع: المحسوسات، والمجرَّبات، والمتواترات، والمقبولات، والوهميَّات، والذائعات، والمظنونات، والمخيَّلات، والأوّليَّات. ويخلص إلى أنَّ المخيَّلات هي مقدِّمات ليست تقال ليصدق بها، بل لتخيّل شيئًا على أنَّه شيء آخر، وعلى سبيل المحاكاة، ويتبعه في الأكثر تنفير للنفس عن شيء، أو ترغيبها فيه، وبالجملة قبض أو وسط، مثل تشبيهنا العسل بالمرة، فينفر عنه الطبع، وكتشبيهنا التهوُّر بالشجاعة، أو الجبن بالاحتياط، فيرغب فيه الطبع [4]“.
– عبد القاهر الجرجاني :
)توفّي سنة 471 ه). لم يناقش العرب “التخييل” بصورة عامَّة، فقد فصلوها في الفنون البلاغيَّة، ونجد عبد القاهر الجرجاني من أوائل النقَّاد، ينحو بمصطلح ” التخييل” منحى نابعًا من علمه بالبلاغة العربيَّة، مستمدًّا بذلك من القرآن الكريم ومن الآية الكريمة { فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} “[5] وقد عرّف “التخييل” بأنَّه : “ما يثبت فيه الشاعر أمرًا هو غير ثابت أصلًا، ويدَّعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولًا يخدع فيه نفسه، ويريه ما لا ترى “[6].
وهذا يعني أن الشاعر يقوم بخداع نفسه، وذلك من خلال استعماله للتخيُّل، ويوهمها بما هو غير حاصل، ولهذا لا نحكم على الشاعر بأنَّه صادق أو كاذب، لأن التخييل: “أظهر أمرًا في البعد عن الحقيقة، وكشف وجهًا في أنه خداع للعلق وضرب من التزويق“[7] . نفهم من ذلك أن عبد القاهر الجرجاني يذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء والنقَّاد بأن التخييل بمعنى الإيهام والخداع.
الفرق بين إدراك الحسِّ / التخيُّل وإدراك الوهم / العقل :
يمكن أن يكون كلُّ إدراك أخذ صورة من المدرك، فإن كان المادّيّ فهو أخذ صورة مجرَّدة عن المادَّة فقط تجرُّدًا ما. إلَّا أنَّ أصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة، فإن الصورة المادّيَّة تعرض لها بسبب المادَّة أحوال وأمور ليست هي لها بذاتها، من جهة ما هي تلك الصورة. فتارة يكون النزع للعلائق كلِّها أو بعضها، وتارة يكون النزع نزعًا كاملًا بأن تجرّد عن المادَّة وعن الَّلواحق التي لها من جهة المادَّة. مثاله أنَّ الصورة الإنسانيَّة والماهيَّة الإنسانيَّة طبيعيَّة لا محالة يشترك فيها أشخاص النوع كلُّهم بالسويَّة، وهي بحدِّها شيء واحد، وقد عرض لها أن وجدت لي هذا الشخص وذلك الشخص فتكثَّرت، وليس لها ذلك من جهة طبيعتها الإنسانيَّة، ولو كانت طبيعة الإنسانيَّة تستوجب التكثُّر لما وجد إنسان محمولًا على واحد بالعدد.
يبرّئ الخيال الصورة المنزوعة من المادَّة تبرئة أشدّ، وذلك بأخذها من المادَّة بحيث لا يحتاج في وجودها فيه إلى وجود مادّة، فالمادة وإن غابت أو بطلت، تبقى الصورة ثابتة الوجود في الخيال؛ إلَّا أنها لا تكون مجرَّدة من الَّلواحق المادّيَّة. فالحسُّ لم يجرِّدها من المادَّة تجريدًا تامًّا ولا جرّدها من لواحقها. أمَّا الخيال فقد جرّدها من المادَّة تجريدًا تامًّا ولكنه لم يجرِّدها البتَّة من لواحق المادَّة، لأنَّ الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوسة وعلى تقدير ما، وتكييف ما، ووضع ما. و ليس يمكن في الخيال البتَّة أن يتخيَّل صورة هي بحال يمكن أن يشترك فيه جميع أشخاص ذلك النوع، فالإنسان المتخيّل يكون كواحد من الناس، ويجوز أن يكون ثمَّة أناس موجودون ومتخيلون ليسوا على نحو ما تخيّل الخيال ذلك الإنسان. ولقد تحدَّث كلٌّ من الفارابي وابن سينا عن قوى الإدراك الباطنيَّة التي من ضمنها القوَّة المتخيّلة أو المفكِّرة، والتي تتولّى استعادة صور المحسوسات المختزنة من الخيال أو المصورة “[8]، بمعنى أنَّ هذه القوّة تأخذ الصور المختزلة في الخيال وتعيد تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحسُّ من قبل .
-الخيال عند الغزالي:
ينقل الغزالي (توفّي سنة 505 ه) عن ابن سينا تقسيمه للوظائف النفسيَّة، وعنهما انتشر هذا التقسيم بين فلاسفة القرون الوسطى اللَّاتينيين، من دون الدخول في تفاصيل كثيرة حول القوى والوظائف النفسيَّة التي يشترك فيها النبات مع الحيوان، والحيوان مع الإنسان، والتي قامت على أسُس أرسطيَّة قديمة. هذا ما اقترحه بعض الفلاسفة المسلمين، وخصوصًا الفارابي وابن سينا، مع فروق معيَّنة بينها حول القوى النفسيَّة الإنسانيَّة وحول موقع الخيال بين هذه القوى. فالنفس الحيوانيَّة تنقسم إلى قوَّة مدركة وقوَّة محرِّكة، وتنقسم القوَّة المدركة إلى قسمين: قوى تدرك من خارج، وهي الحواسُّ الخمس الظاهرة، وقوى تدرك من داخل، وهي الحواسُّ الخمس الباطنيَّة، وهي: الحسُّ المشترك والمصوّرة (أو الخيال) والمتخيّلة والوهم والذاكرة. وقد ذكر الغزالي أنَّه “إنما عرفت مواضع هذه القوى بصناعة الطبِّ، فإنَّ الآفة إذا نزلت بهذه التجويفات اختلَّت هذه الأمور”[9]، وهو رأي عامٌّ يشبه ما يقوله العلم الحديث إلى حدٍّ كبير.
في ما يلي وصف مختصر لكلِّ قوة من هذه القوى:
– الحسُّ المشترك:
إنه آلة الإدراك التي تصل ما بين الحسِّ الظاهر والباطن، وفيه تتجمَّع الأحاسيس المتباينة والمتنوِّعة، فيميِّز بينها ويجمعها ويؤلِّف بينها، ويقبل الحسُّ المشترك الصور الواردة من الخارج كما يقبل الصور الواردة من الداخل، فهو يقبل صورًا واردة من ملكة المتخيّلة أيضًا في حال سكون الحسِّ الظاهر أو في اليقظة أو المرض، وهذا هو الرأي الغالب لدى الفارابي وابن سينا.
– الخيال أو المصوّرة:
وظيفتها حفظ ما يقدِّمه إليها الحسُّ المشترك من الصور التي جاءت إليه عن طريق الحواسِّ الظاهرة. فالحسُّ المشترك يقبل الصور ولا يحفظها، والذي يقوم بذلك الخيال أو المصوّرة. والقوَّة الخياليَّة لدى ابن رشد تشبه المرآة التي تقبل صور أجسام المحاذية لها، لكن الصور في المرآة تنمحي بعد غياب تلك الأجسام، أمَّا في الخيال فتظلُّ باقية.
– القوَّة الوهميَّة:
إنَّها ملكة “التخيُّل” الأرسطيَّة الشهيرة، يضاف إليها هنا بعدٌ غريزيٌّ، سبق أن أشار إليه أرسطو أيضًا، وهو قوَّة مشتركة بين الإنسان والحيوان، حيث إنَّ الحيوان إذا استوحش أو خاف بدت له الأشياء أكبر أو أصغر أو مختلفة عن طبيعتها.
ابن رشد وملكة الخيال :
( توفّي سنة 595 ق.م). ثمَّة تأثَّر بالفكرة الأفلاطونيَّة المحدثة التي ترى الواقع بوصفه سلسلة من القوى الروحيَّة التي تصدر أو تفيض عن “الواحد” في سلسلة من التجلّيات الكونيَّة المستمرَّة الأزليَّة، والتي تشبه صدور الأشعة عن الشمس، كما أنَّ هناك أفكارًا أخرى كان لها تأثيرها الكبير أيضًا، ومنها ما قدَّمه أرسطو عن النفس وأنواعها” غاذية، ونباتيَّة وحيوانيَّة…إلخ. ويعدُّ التقسيم الذي وضعه ابن سينا للوظائف النفسيَّة في أساسه شبيهًا بذلك التقسيم الذي وضعه أرسطو من قبل، ولكنه يختلف عنه في عدد الحواسِّ الباطنة، فيقول أرسطو بثلاث حواسَّ باطنة فقط، هي الحسُّ المشترك والتخيُّل والذاكرة، أمَّا المصوّرة والوهم فغير موجودين عنده إلَّا ما ذكرناه عن تمييزه بين التخيُّل الحسّيِّ (التوهُّم) والعقليِّ (التخيُّل)، يضاف إليها هنا ذلك البعد الخاصُّ بالإيهام أو الإسقاط لما يشعر به الكائن من مشاعر على ما يدركه أو يسمعه أو يراه، والقوَّة الخياليَّة خادمة للوهميَّة، مؤدّية ما في الخيال إليها، والقوَّة الوهميَّة هي التي تدرك من الصور المؤلّفة في القوَّة المتخيّلة مجموعة من المعاني الجزئيَّة، مثلما تدرك الشاة من صورة الذئب معنى العداوة والغدر فتهرب منه، وهي لدى ابن سينا الحاكم الأكبر الذي يظهر كليَّة في هيئة انبعاث تخيُّليٍّ من غير أن يكون ذلك محقَّقًا، والوهم هو الباعث على الأفعال والحركات، وهو مصدر الإرادة والأوامر والأحكام. ويحدث إدراك الوهم للمعاني غير المحسوسة في ما يحسُّ “الخوف في مشهد قدوم الذئب مثلًا”، فيكون إدراكها جزئيًّا مرتبطًا بالحسِّ، ويتمُّ ذلك إمَّا بالغريزة عن طريق ما يسمِّيه ابن سينا الإلهام الإلهيَّ، أو الإلهامات الغريزيَّة الفائضة عن مبادئ الأنفس في العالم العلويِّ، أو تحدث عن طريق التجربة السابقة والاقتران بين صورة الشيء في الذاكرة (الذئب هنا)، والخبرات الأولى التي ارتبطت به (الألم والخوف والهروب…إلخ)، وهنا يكون هذا الإدراك الوهميُّ غريزيًّا أو مكتسبًا، لكنَّه أيضًا ليس حكمًا فصلًا كالحكم العقليِّ، فهو حكم تخيُّليٌّ مقرون بالغريزة الحسّيَّة، وهو يحكم على سبيل انبعاث تخيُّليٍّ من غير أن يكون ذلك محقَّقًا.
المتخيّلة أو المفكّرة : تتولَّى استعادة صور المحسوسات المختزنة في الخيال أو المصوّرة، لكن وظيفتها لا تقتصر على الاستعادة فحسب؛ وإنما لها أيضًا وظيفة ابتكاريَّة مميّزة، فهي تأخذ الصور المختزنة في الخيال، وتعيد تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحسُّ من قبل. وهذه القوَّة تسمَّى في الحيوانات متخيّلة، وفي الإنسان “فكرة”، وشأنها أن تركِّب الصور المحسوسة بعضها مع بعض، وتركِّب المعاني على الصور، وهي في التجويف الأوسط بين حافظ الصور وحافظ المعاني، ولذلك يقدر الإنسان على أن يتخيَّل فرسًا يطير، وشخصًا رأسه رأس إنسان وبدنه بدن فرس، إلى غير ذلك من التركيبات وإن لم يشاهد مثل ذلك، والأولى أن تلحق هذه القوَّة بالقوَّة المحرِّكة لا بالقوَّة المدركة.
القوَّة الحافظة الذاكرة : تحفظ ما تدركه القوَّة الوهميَّة من المعاني الجزئيَّة غير المحسوسة، وهي بذلك تقوم بالدور نفسه الذي تقوم به المصوّرة أو الخيال للحسِّ المشترك، فتكونان مجرَّد “خزانتين” للحفظ فحسب. وهي خزانة مدرك لوهم عند الفارابي وابن سينا، وأحيانًا ما نسب ابن سينا إلى المتخيّلة والقوَّة الوهميَّة عمليَّة استعادة الصور وتذكُّرها، وبمساعدة الحسِّ المشترك، هنا يصبح التذكُّر عمليَّة تمثُّل للصور المحفوظة في المصورة (أو الخيال) داخل الحسِّ المشترك، وهو القدرة المدركة لصور المحسوسات، في حين يتمُّ تمثُّل المعاني المحفوظة في “الحافظة” في الوهم، وهو القوَّة المدركة للمعاني، وهكذا تكون الحافظة أقرب إلى عمليَّة تخزين لمعلومات بالمعنى الحديث، ولكن الذاكرة أقرب إلى عمليَّة استدعاء هذه المعلومات من الذاكرة أيضًا.
حازم القرطاجنّي وشروط التخييل :
يقول صاحب “منهاج البلغاء” حازم القرطاجنّي ( توفّي سنة 684 ه) “إنَّ الأقاويل المخيّلة، لا تخلو من أن تكون المعاني المخيّلة فيها، ممَّا يعرفه جمهور من يفهم لغتها ويتأثَّر له، أو ممَّا يعرفه ولا يتأثَّر له، أو ممَّا يتأثَّر له إذا عرفه، أو ممَّا يعرفه، ولا يتأثَّر له لو عرفه و أحقُّ هذه الأشياء بأن يستعمل في الأغراض المألوفة من طرق الشعر ما عرف وتؤثر له، وكان مستعدًّا لأن يتأثَّر له إذ عرف…، وأحسن الأشياء التي تعرف ويتأثَّر لها إذا عرفت، هي الأشياء، التي فطرت النفوس على استلذاذها أو التألُّم منها، أو ما جد فيه الحالان، من الَّلذة والألم كالذكريات للعهود الحميدة المنصرمة، التي توجد النفوس تلتذُّ بتخيُّلها وذكرها، وتتألَّم من تقضيها وانصرامها”[10].
لقد تأثَّر القرطاجنّي بالفلسفة اليونانيَّة وخصوصًا بأرسطو، ثمَّ تأثَّر بابن سينا، واتَّبع عبد القاهر الجرجاني في أنَّ “التخييل إيهام دون أن يذهب مذهبه في أنه خداع “[11]، و “تصور تنشئه في نفس السامع عناصر الشعر المختلفة (اللفظ والمعنى، والوزن، والنظم، والأسلوب)، ويؤدي إلى انفعال لا واع “[12].
كما جعل القرطاجنّي التخييل جوهر الشعر من خلال ذلك عالج الكثير من القضايا أههمُّا الصدق والكذب من حيث التخييل، ويرى أنَّ “التخيل عمل ذكي يتطلب أن تتوالى في الكلام التركيبات المستحسنة، والاقترانات، والنسب الواقعة بين المعاني مما لها الأثر النفسي القوي“[13].
واعتبر في كتابه “منهاج البلغاء وسراج الأدباء” أنَّ من شروط التخييل الحسن اقتراب الشيء المحاكي من الشيء المحاكى، فإنَّه لا ينفي وجود تخييل يدخل من باب الممتنع العجيب الذي يمتع النفوس، وكلَّما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبدع، ومن هذه الجهة يعتبر عبد القاهر الجرجاني التخييل أظهر أمرًا في البعد عن الحقيقة، واكتشف وجهًا في أنَّه خداع للعقل وضرب من التزويق، (عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة) “[14].
لقد تعاطى القرطاجنّي مع “التخييل” بنظريَّة إيجابيَّة نظرًا لما أُلصق به من صفات كالكذب، حيث اعتبر أن ما يترتَّب عن التخيُّل من نزوع إلى استجلاب المنافع واستدفاع المضارِّ ببسطه النفوس إلى ما يراد من ذلك وقبضها عمَّا يراه بما يخيّل لها من خير أو شرٍّ، فما وضع من حدود الخيال، وما اشتقَّ منه من مصطلحات، قد يتَّفق في أنَّ المخيّل من الأشياء في الكلام يقتضي الإيهام بها، كما يقتضي التفنُّن في تقديمها وإبداعها قد يخرج بالمخيّل من نطاق المحتمل إلى نطاق الممتنع المخادع للعقل”[15].
يرى( ج.م كوكنج (Cocking. J. M. في كتابه “الخيال دراسة حول تاريخ الأفكار” الذي خصّص الفصل السادس منه حول “الخيال في الإسلام”، أنَّ الإسلام لم يشهد نهضة إبداعيَّة فقط، لكنه كان، أيضًا، بوتقة روحيَّة، البوتقة الأكثر كفاءة وفعاليَّة، لأنه كان أكثر تسامحًا وتقبُّلًا، مقارنة بالمسيحيَّة الموجودة في الغرب، لأشكال متنوِّعة كثيرة من الديانات الأخرى بما فيها المسيحيَّة واليهوديَّة، فقد تمَّ تنظيم النموِّ الخاصِّ بالمسيحيَّة وتطوُّرها من خلال مجالس الكنائس، ولم تكن هناك سلطة مماثلة لدى العرب والمسلمين تقوم بالتنظيم لأمورهم الدينيَّة، وبشكل عامٍّ كان الحكم في الإسلام متَّسمًا – مع بعض الاستثناءات – بالتسامح والتقبُّل والانفتاح العقليِّ على الآخرين، وقد انفتح الإسلام وحافظ على المعرفة التي تقوم على أساس الفلسفة اليونانيَّة القديمة، وقام بتجديدها أو على الأقل منحها قوَّة الاستمرار على قيد الحياة، ومن خلال ذلك حفظ العرب والمسلمون تلك النصوص التي فقدها الغربيون أو استبعدوها أو نسوها، فقد توافر لديهم الفضول المعرفيُّ والمشروع المماثل لما جاء بعد ذلك في أوروبا خلال عصر النهضة، كما أنَّ الإسلام كان أقلَّ التصاقًا مقارنة بأوروبا بماضيه الخاص – العصر الجاهلي – فقد بدأ معه عصر جديد”[16].
بعد قرن من وفاة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) العام 622م كانت الأمبراطوريَّة الإسلاميَّة قد وصلت إلى حدود الأطلنطي وإلى الهند والصين أيضًا، وحقَّق المسلمون انتصارات متوالية على الأمبراطوريَّة البيزنطيَّة والفارسيَّة، وتمَّ فتح مصر، ومن خلال غزو إسبانيا نشأت علاقات قويَّة مع أوروبا، ومع ثقافتها، مثلما نشأت علاقات مع بخارى وسمرقند، وتمَّ احتلال صقليَّة وغيرها، وهذا تاريخ يصعب، بل يكاد يستحيل أن نحيط به في هذا السياق الموجز، وسنركِّز بدلًا من ذلك هنا حول بعض الأفكار الأساسية التي قدمها المسلمون حول موضوع الخيال. تأثر الفكر الفلسفي الإسلامي والعربي حول الخيال بمؤثّرات يونانيَّة قديمة، خصوصًا ما يتعلَّق منها بأفكار أفلاطون وأرسطو والأفلاطونيَّة المحدثة.
مفهوم الخيال في النقد الحديث:
انعتق الخيال من المادّيَّة إلى اللَّاماديَّة ليعبر إلى فضاء مليء بالحريَّة والانفلات من القيود التي تعيق صفة الإنسان. فهو كما يعبِّر عنه صلاح فضل بقوله “إنَّ التخييل هو أجمل مظهر في إنسانيَّتنا، فإنَّ تحريره وتنشيطه لا يزالان من أهمِّ وظائف الفنون القوليَّة والبصريَّة، خصوصًا بعد أن صارت الحريَّة بؤرة منظومة القيم التي تحكم مسيرة الإنسان الحضاريَّة، وتحدِّد استراتيجيَّة في الوجود. فبقدر ما ينعتق من ضرورات المادَّة ويتخفَّف ممَّا تهدَّد في وجوده، وأثقل وعيه، وكسر بصره، وكأن في بناياته نوعًا من الخيال المتجمِّد، ينطلق مرة أخرى إلى فضاء الحريَّة الإبداعيَّة ليصبح أشدَّ قدرة على إعادة تشكيل حياته وصياغة فضاءاتها”[17].
وتنبغي الإشارة إلى تعدُّد المذاهب والاتجاهات الأوروبيَّة في النقد الحديث، حيث نجد المذهب الرومانسيَّ يتحدَّث عن مفهوم الخيال وأصبح عنصرًا فعَّالًا في العمليَّة الإبداعيَّة. كما دعمت الـتأكيد الرومانسيَّ للخيال اعتبارات دينيَّة وميتافيزيقيَّة؛ إذ سيطرت نظريَّات لوك على الفلسفة الإنكليزيَّة طوال قرن من الزمان، حيث ذهب إلى أنَّ العقل يظلُّ سلبيًّا تمامًا في حالة الإدراك، أي مجرَّد مسجِّل للانطباعات التي ترد إليه من الخارج أو (مراقب كسول للعالم الخارجيِّ)، ولقد كان مثل ذلك التفكير متناسبًا كلَّ التناسب مع عصر التأهُّل العلميّ.
في ميدان الشعر، كان الإيمان بالخيال جانبًا من إيمان العصر بالذات الفرديَّة، وأصبح الشعراء واعين بهذه القدرة المذهلة على خلق عوالم خياليَّة، ولم يعتقدوا أنَّ ذلك أمر تافه أو زائف، بل على العكس، كانوا يرون أنَّ كبح هذه القدرة إنكار لشيء لا غنى عنه لوجودهم كلِّه، ولذلك كان الرومانسيون يرون أنَّ هذه القدرة بالذات هي التي جعلت منهم شعراء، وأنَّهم – بتوسُّلهم بها – يصنعون صنيعًا أفضل من أولئك الشعراء الذين يضحّون بها في سبيل الحرص على الذوق العام “[18]. لقد أدركوا أنَّ الشعر أقوى ما يكون عندما يعمل الباعث الخلَّاق من دون عوائق، وذلك ما حدث لهم عندما شكّلوا من الرؤى الزائلة أشكالًا ملموسة، وتعقَّبوا الأفكار الشاردة حتى روَّضوها وأخضعوها لإرادتهم “[19].
في هذا السياق، اعتبر وليام وردزورث (William Wordsworth) أنَّ لملكة الخيال القدرة على الإنتاج والإبداع، وعلى انسجام العناصر المنفصلة، ومن ذلك يميِّز بين الخيال والوهم حيث يعدُّ الخيال أسمى من الوهم، ويقول: “الوهم سلبيٌّ يغترُّ بمظاهر الصور، ويسخِّرها لمشاعر فرديَّة عرضيَّة، أمَّا الخيال فهو العدسة الذهبيَّة التي من خلالها يرى الشاعر ما يلحظها أصيلة في شكلها ولونها “.[20]
لا يخلو التخييل في أغلب حالاته من صياغة الدلالات في صورها لتشكِّل بذلك معرفة شاملة للمتلقِّي، حيث تكون هذه المعرفة أقوى وأعمق، والفهم أسرع، لما يخلقه هذا العالم “الخيال” من عناصر الطبيعيَّة والفوق طبيعيَّة تتشابك مع بعضها البعض، محدثة بذلك ذبذبة مشتركة ومنسجمة بين النصِّ والقارئ، وهذا بالتحديد ما يجعل الخيال العنصر الأساس والفعَّال في السَّرد الخياليِّ، الذي يتطلَّب من القارئ أو المتلقّي فهم عالمه عن طريق التفسير والشَّرح بين الطبيعيِّ وغير الطبيعيِّ، كما أنَّ النصَّ السَّرديَّ والمعنى الأدبيَّ يخلقان من التفاعل بين النصِّ الدينيِّ “القرآن” وبين قارئ ذلك النصِّ، والقرآن من النصوص التي تُعرف بمداها الواسع من حيث المعاني والاحتمالات التفسيريَّة المرتبطة بالنصِّ ذاته، لكنَّها تولد في إنتاج نصٍّ جديد يكون في ذهن “الكاتب” أو”السَّارد” القارئ الضمنيِّ المحتمل، وهي مجموعة من الافتراضات والاحتمالات عن مدى معارفه وقدراته التي يحشدها لهدف إعادة القراءة برؤاه وعلومه وخيالاته وتخيُّلاته، وفي التفاعل بين النصِّ القرآنيِّ كنصٍّ ثابت ومدى اتِّساع تفسيره والقارئ “الفاعل” بذخيرته المعرفيَّة و تركيباته العقليَّة.
1- السَّرد الخياليّ:
– يمزج السَّرد الخياليُّ بين الجانبين: العجائبيِّ، والمحاكاتيِّ أو الواقعيِّ، ويؤكِّد أنَّ ما يقصده أمر واقعيٌّ. إنَّه هنا يعتمد على الأعراف الخاصَّة بالسَّرد أو القصِّ الخياليِّ، ثمَّ إنَّه يتقدَّم كي ينتهك أو يتجاوز هذا الافتراض الخاصَّ بالواقعيَّة من خلال تقديمه لما يتجلَّى ويظهر على أنَّه غير واقعيّ: إنَّه يجذب القارئ أو ينتزعه من تلك الألفة الظاهرة والأمان المرتبط بالعالم اليوميِّ والمعروف، ويدفعه، شيئًا فشيئًا، نحو عالم غريب، عالم تكون الاحتمالات فيه وثيقة الصلة بما يرتبط عادة بالعجائب والخوارق، ولا يكون ما يحدث –هنا- واضحًا أو مفهومًا بالنسبة إلى السَّارد أو البطل، كما أنَّ التفسيرات المقدَّمة لهذه الأحداث لا تكون واضحة أو مقنعة أيضًا. ويكون ما شوهد وسجِّل على أنَّه واقعيٌّ موضعًا للشكوك والمساءلة. هذا القلق أو هذا الاضطراب هو أمر جوهريٌّ في هذا الشكل الخياليِّ.
يعتبر السَّرد في النصِّ القرآنيِّ من السَّرد الأدبيِّ الرمزيِّ الذهنيِّ، فأحداثه ليست بالواقعيَّة المرئيَّة وليست بالخياليَّة الميتافيزيقيَّة، حيث إنَّ كلَّ الأحداث ترمز إلى مسيرة وجوديَّة من المبتدأ إلى المنتهى، هذه الأحداث تقمَّصتها شخصيَّات خياليَّة منها رئيسيَّة ومنها ثانويَّة كلُّها ترمز إلى الإنسان في تحمُّل مسؤوليَّته الإنسانيَّة في الوجود. وهذه الأحداث عن طريق شخصيَّاتها تستقطبها أطر مكانيَّة وزمانيَّة وظرفيَّة تتناسب مع الخيال. ويتداخل السَّرد بكلِّ تقنيَّاته لتحديد سلوك البطل الأول من الجنس البشريِّ “آدم” في مسيرته من انغلاق إلى انفتاح حسّيٍّ، من النزول من السماء (الجنة) والرجوع إليها، والانعتاق الموت المحتم. ونستشهد بقول للنروجي هنريك إبسن[21]* : « سنعلم يوم نبعث من بين الأموات»، الأمر الذي يذكِّرنا بالعبارة الصوفيَّة «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا [22]” لعليٍّ بن أبي طالب عليه السلام نفسه، ينوء بمكانته الروحيَّة، ولا ينفكُّ ساعيًا في التفتيش عن حقيقة الوجود وخفايا الإنسان وغاية الموجود، وفي هذا السعي اللَّاهب والحارق لا يتورَّع عن التمرُّد على كلِّ شيء، والمروق من الدين والأخلاق والأعراف والقوانين، وتحدِّي المستقرِّ في الأذهان والعقول، وانتهاك المحرَّمات، وفي افتضاض كل ما هو مختوم، وتخليع كلِّ ما هو مغلق، وكشف الاستار عن كلِّ ما هو محجوب، وهذا ما يذكِّرنا “بالروح الحرَّة” لدى نيتشه، أو “حي بن يقظان” لدى ابن طفيل، لكنَّه نقصان يصل إلى مراتب الكشف ومعرفة الحقائق الجوهريَّة من خلال العزلة في جزيرته النائية والخالية من البشر والمخلوقات، أي بالتأمُّل. أمَّا أبو هريرة فيكتشف الوجود والموجود من خلال مكابداته في العالم الحيِّ الواقعي فيفك مغاليقه بالحسِّ المباشر.
كان للمتخيل في رواية “حدَّث أبو هريرة قال” حيّز منطلق ذهنيٍّ وشعوريٍّ وإحساسيٍّ وتفكيريٍّ في كلِّ قضايا الوجود الإنسانيِّ مجتمعة بما يمكن تسميته الفلسفة. التفكير هو مظهر من مظاهر حياة الإنسان، ومهما كانت صورة ذلك النشاط، الباطن الذي قد نسمّيه تفكيرًا أو نسمّيه فلسفة أو شعرًا، أو كلّ ذلك، هو النشاط الحيويٌّ الباطن في الإنسان ويتَّخذ صورًا مختلفة مع أنَّه في الأصل شيء واحد. وحتى لو كان هذا النصُّ يحفل بالأسئلة أكثر من بحثه عن الأجوبة إلَّا أنه يطرح ما يجده من بديهيَّات حول الوجود الإنسانيِّ والإرادة والحياة والموت والحريَّة والزمان والمسؤوليَّة والحيرة والشكِّ واليقين والمطلق والنسبيِّ، هذا من جهة، أمَّا من جهة ثانية فالكاتب يشتغل على قطبين ظاهريَّين ينتميان إلى التخييل المحض والفكر الممتدِّ في التأمُّل والتفلسُف: القطب الأول تراثي، والقطب الثاني حداثي، وعبرهما يتدبَّر تأمٌّلات ضمن برامج على تماس مع التاريخيِّ والأسطوريِّ محيلة في شبكات مرموزة ومجازيَّة على الدينيِّ، وهو في كلِّ هذا يزاوج بين النجوى الذاتيَّة والتأمُّلات الفكريَّة والفلسفيَّة بلغة تفيض قوَّة ومراوغة لتعبِّر عن محور المأساة والمعاناة والخيبة، وهو حالة بحث وخلق ينتج موادَّ تخييليَّة ذات حيويَّة في الدلالة والمعنى بخلفيَّات ممتلئة بالثقافيِّ والمجتمعيِّ، وهي حمل الذات الواعية والمتطلِّعة للبحث عن الخلاص .
أ- السَّرد الخياليّ ورمزيَّة الوجود:
يقول سعيد يقطين في هذا الصدد «لقد أنتج العرب السَّرد وما يجري مجراه وتركوا لنا تراثًا هائلًا منذ القدم (من قبل الإسلام). وظلَّ هذا الإنتاج يتزايد عبر الحقب والعصور، وسجَّل لنا العرب من خلاله مختلف صور حياتهم وأنماطها، ورصدوا مختلف الوقائع وما خلَّفته من آثار في المخيِّلة والوجدان، وعكسوا عبر توظيفهم إيَّاه جُلَّ، إن لم نقل كلَّ صراعاتهم الداخليَّة والخارجيَّة، كما تجسَّدت لنا من خلاله مختلف تمثُّلاتهم للعصر والتاريخ والكون، وصور تفاعلاتهم مع الذات والآخر… وإذا ما عرفنا السَّرد بأنَّه نقل الفعل القابل للحكي من الغياب إلى الحضور وجعله قابلًا للتداول، سواء كان هذا الفعل واقعيًّا أم تخيُّليًّا، وسواء تمَّ التداول شفاهيًّا أم كتابة … لظهر لنا أنَّ الحضارة العربيَّة لا يمكنها أن تقوم فقط على الشعر، ولكن على السَّرد أيضًا»[23].
في هذا الإطار، قدَّم تودوروف تصنيفًا للأنواع المختلفة من الأدب الفانتازيِّ أو “العجائبيِّ” – الخالص إلى سرديَّات مثل حكايات الجنّيَّات الخرافيَّة، وقصص الرومانس (الفرسان)، وكثير من قصص الخيال العلميِّ. ويأتي بعده العجائبيُّ أو العجيب الخياليُّ (أو الفانتازيُّ)، والذي يشتمل على أعمال لتوفييل جوتيه وغيره، وهي أعمال تعرض تأثيرات غير قابلة للتفسير تُعطى لها في النهاية أسباب ما وراء طبيعيَّة. و”العجائبيُّ: هنا – هو كما وصفه “نوفاليس” – “سرد من دون تماسك، لكنه سرد يزخر بالتداعيات، مثل الأحلام”. ويشتمل الغريب الخياليُّ (الفانتازيُّ) على أعمال إدغار آلان بو، إمَّا ضمن الغريب الخالص أو المحض، وقريبًا من فئة الغريب الخياليِّ غير المحدَّد توجد أعمال لكتاب، مثل هنري جيمس، حيث يشغل الخيال فترة من عدم اليقين، في حين يترك القارئ يخمِّن والشكُّ يهيمن عليه حول أصول (أو منابع) الأشباح بوصفها تمثيلات أو حالات حضور طبيعيَّة أو ما وراء طبيعيَّة، وقد يميِّز الخياليَّ الخالص من خلال الخطِّ الوسيط الذي يفصل بين الخياليِّ العجيب والخياليِّ الغريب”[24]. في العجائبيِّ – الغريب، تتلقَّى الأحداث التي تبدو على طول القصة تفسيرًا عقلانيًّا في النهاية، أمَّا إذا كانت هذه الأحداث قد أدَّت بالشخصيَّة والقارئ إلى الاعتقاد في تدخُّل فوق طبيعيٍّ؛ فذلك لأنَّها كانت تحمل طابعًا غير مألوف…وقد صنّف النقد هذه النوعيَّة تحت اسم “فوق-الطبيعيِّ المفسّر”[25]. ومن أنماط التفسير التي تنزع إلى تبسيط فوق الطبيعيِّ أو اختزاله نجد: الحظّ والمصادفات، والمخدَّرات والخداع، والألعاب المدبّرة مسبقًا، وخداع الحواسِّ والجنون. أمَّا الغريب المحض فيوجد في تلك الأعمال التي يمكن تفسير أحداثها بقوانين العقل، لكنها تكون كذلك أحداثًا غير معقولة، خارقة، مفزعة، فريدة، مقلقة غير مألوفة، وهي لهذا السبب تثير لدى الشخصيَّة والقارئ ردود فعل شبيهة بما هو موجود في النصوص العجائبيَّة. وينتمي أدب الرُّعب الخالص إلى الغريب، ووسط ردود أفعال متباينة يحقّق الغريب وليس بواقعة ماديَّة تتحدَّى العقل .”[26]
ب- المتخيّل و السَّرد في الزمان والمكان :
لقد همِّش الزمن في بنية الرواية القرآنيَّة مطلقًا العنان للأفكار التي تتجاذب نفسها والقارئ على حدٍّ سواء، فبات صراع الفكرة هو المسيطر على مجريات الأحداث المتعلِّقة بشخصيَّة آدم المحوريَّة، وصاحب السيادة في التحدُّث والكلام مع الله وبثّ الرؤى. وقد تجلَّى هذا التسيُّد أو الإبراز في شخص آدم، ومع أنَّ الأخبار المساقة إخباريًّا وسندًا لا أصول لها في التاريخ إلَّا أنَّ البنية الإخباريَّة الموظَّفة هي بنية الحديث أو الخبر ضمن إطار من التراث الدينيِّ وعبقه الآسر، وفي فضاء نصّيٍّ يخرق خطيَّة الزمن، فمن الحاضر إلى الماضي، ومن الماضي إلى المستقبل، فضلًا عن رغبة في التمرُّد على السائد المألوف، ومرافقة المغاير والمختلف والعكسيِّ عندما زواج بين المتعة والمرض، والنشوة في الذات المتجاورة للاستقامة، وهذا التغاير من شأنه أن يربك القارئ وهو منشغل بترتيب الأحداث ونظمها، فيخرق أفق توقُّعه ويحوِّل النصَّ السّرديَّ إلى نصٍّ جدليٍّ مناهض للاعتياد. وتكمن الإشكاليَّة في أنَّ بنية الخبر تتحدَّى القارئ وتربكه وترغمه على معاودة الكثير من مرجعيَّاته الجماليَّة التي ينطلق منها قبل الدخول إلى عوالم النصِّ سواء أكان شعريًّا أم سرديًّا، وإن كان السَّارد الأول الأصل (الله) يمارس مغامرة في تشكيله السَّرديِّ عبر نصِّه الدينيِّ المقدَّس (القرآن)، الذي ينفتح على الطرح الفلسفيِّ- الوجوديِّ، فإنَّ القارئ سيكون مضطرًّا إلى مغامرة تشكيل – بناء، استراتيجيَّة القراءة التي تكشف مغامرة الشكل السَّرديَّ بالبحث في خصوصيَّة الزمن السَّرديِّ، وهو زمن ينفتح على التنوُّع الدلاليِّ الذي تتحدَّد فيه الوحدات الأساسيَّة للأعمال السَّرديَّة – وهي الزمان والمكان والشخصيَّة – وتفكّك بشكل خاصٍّ في الأعمال الخياليَّة، فلم يعد الفنُّ المنظور، ولا خاصيَّة البعد الثالث، من القواعد العظيمة التي يحسن التمسُّك بها، كما كانت الحال في الماضي، وقد أصبحت معالم أو محدَّدات المجال البصريِّ تميل في اتجاه اللَّاتحديد (مبدأ هايزنبرج) *، كما يعبِّر عن ذلك مثل هذا التحوُّل في الأطراف أو الحواف أو الهوامش، كما توجد تلك الممرَّات المتراجعة بلا نهاية والامتدادات الخاصَّة بالمتاهات، وتظهر تلك الحوائط القابلة للمرور منها، والقابلة للتحوُّل إلى حالة سائلة، إن الأمر هنا كما لو كانت الطبيعة المحدودة للمكان أو المحدَّدة، والتي تحدَّث عنها كانط، قد أدخلت في بُعد إضافيٍّ أو أدخل بعدٌ إضافيٌّ فيها، فيه يمكن أن توجد المكوِّنات غير المتطابقة معًا، وفيه -أيضًا- يكون التحوُّل الذي وصفه كافكا بأنَّه “تبدُّل أو تحوُّل كبير من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى” تحوُّل كبير ومؤثِّر. تنزلق النصوص الخياليَّة نحو نوع من الالتباس البنيويِّ، ويمكن تصنيف هذه الموضوعات المتكرِّرة هنا إلى مناطق عدَّة مترابطة، منها: أ – اللَّامرئي أو الحالة اللَّامرئيَّة و- التحويل والتحوُّل و- الازدواجيَّة والازدواج و- الخير في مقابل الشر. وتحتوي هذه الموضوعات المتكرِّرة – بدورها- على عدد من الصور المتكرِّرة : الأبطال المحوريين : الله – الملائكة – الشيطان – آدم- حواء، الظرف المكاني، الجنة/السماء/الأرض، الخطاب : حوار الله من ملكوته مع الملائكة – مع الشيطان ثمَّ مع آدم/ نوع الخطاب : خطاب تنازليّ، آدم يتوب ويطلب المغفرة من الله خطاب تصاعديّ الخ… و تتحوَّل الدوافع هنا أيضًا بدورها إلى انتهاكات تتَّجه نحو موضوعات، مثل: الثنائيَّة الجنسيَّة – النرجسيَّة – الميول الغريزيّ والحالات السيكولوجيَّة التي يتداعى لها الحسُّ الماديُّ “البارانويا”، ولمقاربة هذه الأنماط السَّرديَّة كطريقة تقنيَّة عالية الجودة في إعداد وإخراج النصِّ القصصيِّ من القرآن بغية تحقيق غاية المرسل “الأصل” أو السارد “الأصل” الرؤية، وهنا يستخدم اللَّا يقين والاستحالة والعجائبي والميتافيزيقى المفروضة على مستوى البنية من خلال التردد والالتباس، وعند المستوى الخاص بالموضوعات من خلال الصور غير ذات الشكل المحدَّد، والأماكن اللَّا معلومة و اللَّا معروفة، وكذلك استغلال الفراغ والمكان للاشتغال عليه انفعاليًّا، وخصوصًا ما يتعلَّق بالجوانب “اللَّا مرئيَّة” منه أيضًا بطرائق بارعة وجديدة. فما لا يُرى ولا يُقال، وما هو مجهول يظلُّ مع ذلك موجودًا وممتدًّا لهذا الأمام، كمنطقة مظلمة من الممكن أن يخرج منها أي شيء أو شكل أو مخلوق في أي لحظة، ويدخل عالمنا المخيال الشعبيّ (المقدَّس).
2 – بنية السَّرد العجائبيِّ في النصِّ الدينيِّ العربيِّ الإسلاميِّ:
يتأسَّس السَّرد في النصِّ الدينيِّ العربيِّ الإسلاميِّ في صور متراصَّة متماسكة رغم اختلافات السرود والشهود، وتدور حول حدث/أحداث عجائبيَّة تستدعي جهدًا لتبيان الخيط الواصل بين المشاهد العجائبيَّة في ترابطها، وذلك بهدف خلق علاقة معقولة بين القصَّة وبين الخطاب، علاقة محكومة ومبنيَّة على العجيب، لكونها تتمثَّل النموذج التحليليَّ الإسلاميّ. فوقائع وأحداث وحكايات ” خلق آدم ” تشكِّل أساس بنية العمل برمَّته، وإن كان السَّرد يقوم ذريعة للحدث في بنية عجائبيَّة من خلال تعرُّضها لعالم فوق طبيعيٍّ داخل عالم طبيعيِّ، وعبر شخوص يتعرَّضون للتبدُّل والتحوُّل في إطار نصٍّ قائم على ما يسمَّى بـ “خرق الواقعي” لعالم تختلط فيه مخلوقات مختلفة: الملائكة و الشيطان، المألوف والخارق، بما يولِّد الحيرة عند المتلقّي.
يكمن الخرق العجائبيُّ في النصِّ عبر جناح المخيّلة، باعتباره قريبًا من المتخيّل وجزءًا منه، وأحد تجلّياته، إذ هو قريب من المتعالي الذي يبدع الصور الخارقة للعادة، من حيث البنية والتشكُّل ومن حيث العناصر المؤلِّفة لها، من دون نسيان أنَّه قريب من الواقعيِّ، لكونه ينطلق منه نحو رحابة المتخيّل، واستحضار الأسطورة التي تضرب في الماضي البعيد المقترن بالمتعالي.
يعرِّف تودوروف العجائبيَّ بكونه “تردُّد كائن لا يعرف سوى القوانين الطبيعيَّة أمام حادث له صبغة فوق طبيعيَّة “.[27]” وتكمن أهمِّيَّته في الكشف عن المناطق المظلمة في اللَّاوعي الجمعيِّ، وبذلك تتأسَّس علاقة المتلقِّي مع النصِّ من خلال خطوط ثلاثة:
- ابتداع شروط جديدة للوقوف على طبيعة الأحداث، عبر الآليات العقليَّة أو المنطقيَّة.
- التصديق بالفوق طبيعيِّ بغية الابتعاد عن حالة الحيرة المذكورة آنفًا.
- التعامل مع الحدث، على أساس افتراض إقحام العنصر الفوق طبيعيِّ في عالم خاضع للعقل، ما يضفي على عنصر التردُّد والحيرة تماسكًا واستقرارًا يقتسمها فترة مسار القراءة. بينما يرى روجيه كايوا أنَّ العجائبيَّ هو “فوضى وتمزيق ناجم عن اقتحام لما هو مخالف للمألوف في العالم الحقيقيِّ المألوف، إنَّه قطيعة للتماسك الكونيّ”.[28] مؤكِّدًا ضرورة توظيف الفوق طبيعيِّ لتثمين الحبكة وإعطائها بعدًا عجائبيًّا، لأنَّ غياب هذا العنصر (الفوق طبيعيّ) يعني غياب الشيء المولِّد للحيرة والدهشة، بحسب رأيه، بينما يستلزم حضوره منطقًا ما، وفي هذا المنطق ثمَّة خلق أدبيٌّ يتمُّ ترتيبه على تلك الشاكلة، فالمألوف والعاديُّ هما الثابت، بينما العجائبيُّ هو المتحرِّك الذي يبثُّ الفوضى في المألوف.
على هذا الأساس، يكون حضور العجائبيُّ أساسيًّا في أيُّما نصٍّ لكونه يبيِّن لنا آليَّات اشتغال العالم من حولنا. وانطلاقًا من عنصر الخرق للمألوف يتمفصل العجائبيُّ في ثلاثة عناصر:
-العنصر الأوَّل، إحداث أثر ما – عند القارئ – لم يكن بمقدور الآثار الأخرى إحداثه.
-العنصر الثاني، إسهامه في إغناء فعل الردِّ لكونه ينظِّم الحبكة.
-العنصر الثالث، السماح لوصف عالم عجائبيّ.
بالعودة إلى تمظهُرات العجائبيِّ في النصِّ الدينيِّ العربيِّ الإسلاميِّ، فإنَّها تبدو بعد طول تأمُّل أنَّها خرجت من رحم جملة من التصوُّرات وعناصر الفوق طبيعيِّ (حوار الله مع الملائكة / مع الشيطان إلخ…) ومن محكيَّات الميث، في ارتباطها مع المتخيّل[29]“. ودور المخيّلة داخل المجتمع وخلقها لمواقف تتموقع في جانب ما من سلوكات وأنماط العقل العربيِ، و ذلك إمَّا عبر الإدانة والرفض، أو عبر التزكية والقبول. فالمتأمِّل في ثبوت أصل الواقعيِّ (خلق آدم) يلاحظ استثمار عمليَّة الأخبار من صميم الواقع وباستعمال الخيال، وبحبكة فنيَّة محكمة، إنَّما هو نمط سرديٌّ غاية في الدقَّة والتقنيَّة المستخدمة في إعداد وإخراج نصٍّ قصصيٍّ (قرآنيٍّ) يغلب عليه الزمن الماضي وكثرة الروابط الظرفيَّة والأسلوب الخبريُّ ممَّا يضفي عليه لمسة فنيَّة تجعله في خانة الفنون الأدبيَّة التي تتزامن وكلَّ العصور لما لها من قدرة على جذب القارئ . من هنا نلاحظ ذلك التداخل والتمازج بين الواقعيِّ والمتخيَّل، وذلك الكسر اللَّامتوقَّع للفهم المباشر لشخصيَّات النصِّ القرآنيِّ لا نعرف كنهَه مباشرة، وذلك الرحيل اللَّامفهوم في الزمان والمكان، ممازجة حيث يحضر التاريخ من جهة، والحكايات الشعبيَّة والصوفيَّة والخارق بهدف التعريج على العجائبيِّ بهدف التواصل العميق مع الأسئلة المصيريَّة التي تهدف إلى معرفة الإنسان واختباره على حافَّة الحيرة والتردُّد، ذلك أنَّ العجائبيَّ يهدف، في ما لم يستطعه السَّرد المباشر، إلى مناوشة الواقع والإطاحة به، قصد تحريره من أوهامه، وليس بهدف تقديم أجوبة جاهزة. يعمل العجائبيُّ كما نلاحظ، على تغذية التصوُّر العامِّ للنصِّ برؤيا عن العالم، أي تعبير عن بنية فكريَّة وشعوريَّة تتحكَّم، عبر بنية السَّرد، بمصائر الشخصيَّات، حيث يقوم السَّرد بشكل موجَّه من الحدث الواقعيِّ نحو الحدث العجائبيّ.
الخاتمة:
يتموقع الحدث السرديُّ المتخيّل بين إيقاعين عجائبيّين، أو بين إيقاع عجائبيٍّ وآخر واقعيٍّ، حينما يكون المتلقّي والحدث على تماس وترقُّب في تحديد سيرورة العمل برمَّته. فإذا ما انتهينا من معنى النصِّ إلى تفسير ونتيجة طبيعيَّتين، كنَّا إزاء أدب ذي صبغة غرائبيَّة، بعدما نكون قد صادفنا أحداثًا ذات بعد فوق طبيعيّ. غير أنَّها تجد لها حلًّا طبيعيًّا، سرعان ما يدخل في سيرورة رمزيَّة أخرى لتتفتَّق ثانية مسارات السَّرد في رحلة الغريب والعجيب، فنكون مع حدوث أحداث ووقائع غير طبيعيَّة، تنتهي بتفسير فوق طبيعيّ، وحينها إمَّا أن يقبل القارئ بأنَّ هذه الأحداث فوق طبيعيَّة، وإما أن يقبل بوجود هذه الأحداث كما هي، وعندئذٍ سيجد نفسه في العجيب كما يقول تودوروف.
انطلاقًا من هذا التحديد الأوليِّ، يمكن الوقوف على تجذُّر العجائبيِّ في النصِّ القرآنيِّ، وطرق اشتغاله، وتطعيمه بألوان المتخيّل الزاهية. من هنا تكمن أهميَّة العجائبيِّ وهو يتحرَّك في دائرة السرد لإغناء المتخيّل بكلِّ عناصره، حيث يؤسّس عبر الأحداث المتلاحقة، وسط بنية سرديَّة تتميَّز بسارد متقن للعبة الغواية ومتمكّن من أدواته وفق شروط وغاية مصمَّمة بدقَّة متناهية، نصًّا كثيفًا، يتَّخذ هيئات مختلفة، وهو يرتحل من برزخ إلى آخر، تجعله مكوّنًا دلاليًّا يتموقع بشكل يراوح بين الغموض والتجلّي، ويستمدُّ راهنيَّته من المواقف والعلاقات والبنى ومن الهويَّة الإلهيَّة إلى الهويَّة الإنسانيَّة ليكتسب العجائبيُّ في النصِّ الدينيِّ العربيِّ الإسلاميِّ بعدًا قدسيًّا يحمل على تعجُّب المرويّ له، أو المتلقّي، من كلِّ حديث هو علامة قبول للدخول في لعبة السرد، أو الرحلة التي يقترحها المؤلِّف أو السارد (الأصل) باعتبارها، متفرِّدة ومتخمِّنة لأشياء جديدة، عبر تضمُّن لحظات السرد لعبة التأكيد والإظهار وتعدُّديَّة وتنوُّع المحكيِّ في تصوير الكائنات بشكل مفارق. وأخيرًا على التشارك، حيث ينهض السرد على إضفاء صفات فوق طبيعيَّة على كائنات طبيعيَّة في نفس سرديٍّ يمتدُّ في المغامرات الكبرى، ويتقارب متسارعًا في أشدِّ الفترات حيرة وتأزُّمًا، حتى ترد الحوادث بتعدُّد رواتها من زوايا نظر بعيدة وقريبة من داخل العالم وخارجه ومن قبل أو من بعد، قصة مضمرة تترك لك حريَّة تخيُّل تفاصيلها وهي قصة ظروف رواية الخبر وتشتمل عليه كإطار له، كما يقول توفيق بكار، كلّ متن في الخبر يندرج في إسناده كقصَّة داخل قصَّة ودائرة في دائرة أوسع ولا تنقفل آخر دائرة في النص إلَّا انفتحت أخرى لأنَّ سلاسل الرواة تفضي إلى المؤلِّف (الأصل) ومنه إلينا، فيصبح القارئ بدوره من المحدثين وحلقة في إسناد الرواية، أو بمعنى أدقَّ القصَّة.
لائحة المصادر والمراجع:
– العربيَّة:
- القرآن الكريم.
- ” فضل، صلاح : إشكاليَّة التخيّل (من فئات الأدب والنقد)، الشركة المصريَّة العالميَّة للنشر، لونجمان، القاهرة، ط1، سنة 1996،.
- الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجراجاني النحوي، أسرار البلاغة، تحقيق : محمود محمد شاكر، دار المدني بجدَّة، جمادي الأولى سنة 1412، 23 نوفمبر سنة 1991.
- سليم الشريطي: الأسطورة في مسرحيَّة السد للمسعدي، مجلَّة “الحياة الثقافيَّة”، 2002، عدد 176 .
- بورا، س. موريس : الخيال الأسلوب الحداثة، ترجمة وتقديم جابر عصفور، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 2 ، سنة 2009.
- تودوررف، تزفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبي (ترجمة الصادق بوعلام) القاهرة سنة 1994، دار شرقيَّات للنشر والتوزيع، .
- الحسين ابن علي ابن سينا : كتاب النجاة – في الحكمة المنطقيَّة والطبيعة الإلهيَّة، نقَّحه وقدّم له ماجد فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا ، ص 207.
- السعفي وحيد، العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن، صفحات للدراسات والنشر الطبعة الأولى، سنة 2007.
- السعفي وحيد، في قراءة الخطاب الديني، مؤسَّسة الانتشار العربي- لبنان، الطبعة الأولى، سنة 2008.
- سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجلّيات، منشورات الاختلاف/ دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2012.
- عصفور جابر : الصورة الفنيَّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1983 .
- محمج عزام : المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، بيروت- لبنان .
- موافي، عثمان: “في نظريَّة الأدب”، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج 1، دار المعرفة الجامعيَّة للطباعة والنشر القاهرة، مصر، سنة 2000.
- معجم السرديَّات، تأليف القاضي محمد و مجموعة ، إشراف القاضي محمد، ناشرون، ط 1 سنة 2010 .
-الأجنبيَّة:
- Todorov, Tzvetan : Intoduction à la littérture fantastique, Ed.Seuil, Paris, 1970, p. 29
- -Roger, Caillois : Obliques, Ed. Stork, France, 1975, pp. 14-15
- السعفي وحيد ، العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن، صفحات للدراسات والنشر الطبعة الأولى، سنة 2007 ، ص ص 106 – 107
- المرجع نفسه ، ص 62.
* اعتمدنا في كتابة هذا المبحث بالخيال في الإسلام على المرجع الآتي : محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة : هاشم صالح، دار الساقي، بيروت/لندن، الطبعة الأولى، سنة 1987، ص 58.
- الحسين ابن علي ابن سينا : كتاب النجاة – في الحكمة المنطقية والطبيعة الالهية، نقحه وقدّم له ماجدم فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا ، ص 101
- سورة طه، آية 66.
- الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجراجاني النحوي، أسرار البلاغة، تحقيق : محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، جمادي الأولى سنة 1412، 23 نوفمبر سنة 1991، ص 121.
- عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة، ص 121.
- عصفور جابر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1983، ص 28.
- الحسين ابن علي ابن سينا : كتاب النجاة – في الحكمة المنطقية والطبيعة الالهية، نقحه وقدّم له ماجدم فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا ، ص 207
- موافي، عثمان : “في نظرية الأدب”، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج 1، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر القاهرة، مصر، سنة 2000، ص، ص 135 – 136.
- محمج عزام : المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، بيروت- لبنان، ص 180.
- المرجع نفسه، ص 180.
- المرجع نفسه، ص 180
- الحسين ابن علي ابن سينا : كتاب النجاة – في الحكمة المنطقية والطبيعة الالهية، نقحه وقدّم له ماجدم فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا ، ص 207.
- معجم السرديات، ناشرون، ط 1 سنة 2010، مرجع السابق، ص 75.
- ” فضل، صلاح : إشكالية التخيّل (من فئات الأدب والنقد)، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، ط1، سنة 1996، ص2.
- بورا، س. موريس : الخيال الأسلوب الحداثة، ترجمة وتقديم جابر عصفور، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 2 ، سنة 2009، ص 70.
- المرجع نفسه، ص 70.
- محمد عزام : المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، مرجع سابق ص 389.
- هنريك إبسن شاعر ومسرحي نرويجي، ت (1906) يعرف ب “أبو المسرح الحديث” له أكثر من 26 مسرحية أشهرها : البطة البرية، عندما نبعث نحن الموتى، ذكره محمود المسعدي، “حدث أبو هريرة قال”، المصدر نفسه، ص 12.
- حديث: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا جاء في :
لحديث المذكور ذكره الغزالي في بعض كتبه؛ مثل: الإحياء (4/23)، والمنقذ من الضلال (10)، وفضائح الباطنية (45)؛ كذلك البطليوسي في الحدائق في المطالب العالية (72 و125) وورد عن السبكي في الطبقات (6/357) ضمن أحاديث الإحياء التي لم يجد لها إسنادًا. ونص السخاوي في المقاصد الحسنة (1240)، والسيوطي في الدرر المنتثرة (427) فمَن بعدهما من المصنفين في الأحاديث المشتهرة أنه من كلام علي – رضي الله عنه –
- سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، منشورات الاختلاف/ دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2012 ص 61.
- تودوررف، تزفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبي (ترجمة الصادق بوعلام) القاهرة سنة 1994، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ص 17.
- المرجع نفسه ص 59
* مبدا هايزنبرج : هومبدأ عدم التأكد، أو عدم اليقين معناه أن علم الفيزياء لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن تكون لديه تنبؤات إحصائية فقط. فالعالم الذي يدرس النشاط الإشعاعي للذرات مثلا، يمكنه أن يتنبأ فقط بأن من كل ألف مليون ذرة راديوم مليونان فقط سوف يصدران أشعة جاما في اليوم التالي، لكنه لا يستطيع معرفة أي ذرة من مجموع ذرات الراديوم سوف تفعل ذلك. ويمكننا القول أنه كلما زادت عدد الذرات كلما قل عدم التأكد وكلما نقص عدد الذرات كلما زاد عدم التأكد. وكانت هذه النظرية مـُقلقة للعلماء في وقتها لدرجة أن عالماً كبيراً مثل أينشتاين قد رفضها أول الأمر. وهو الذي قال ” إن عقلي لا يستطيع أن يتصور أن الله يلعب النرد بهذا الكون” متناسياً إدراكه الشخصي. ومع ذلك لم يجد العلماء أمامهم إلا قبول هذه النظرية التي اهتدى إليها هايزنبرج والتي وضحت للإنسان خاصية هامة من خواص هذا الكون.
[27] -Todorov, Tzvetan : Intoduction à la littérture fantastique, Ed.Seuil, Paris, 1970, p. 29
[28] -Roger, Caillois : Obliques, Ed. Stork, France, 1975, pp. 14-15