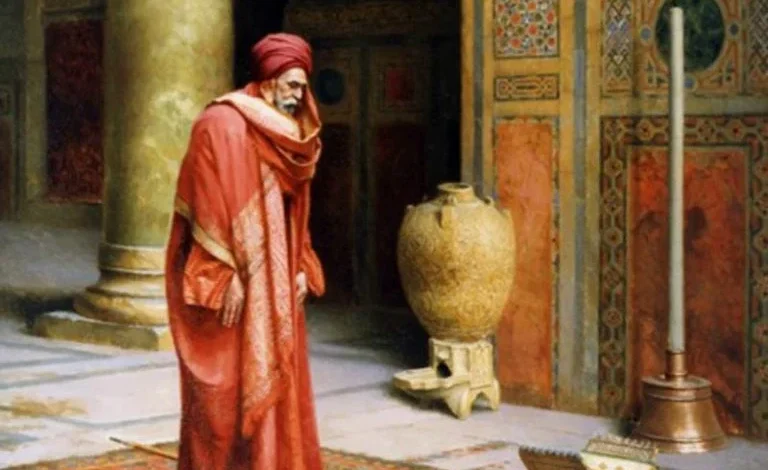
الغناء والسماع في فكر شيخ العرفاء محيي الدين ابن عربي
الغناء والسماع في فكر شيخ العرفاء محيي الدين ابن عربي
مقدّمة
لقد كان السماع في ساحات العرفان والتصوف، وقبل أن يتشكل ويتلون بألوان وأهواء فرق الصوفية، مرآة تتجلى فيها المشاعر والتفاعلات الباطنية للإنسان، وذلك على مدار المسيرة التاريخية للبشر([1]). يقال: إن فيثاغورس الحكيم اليوناني (القرن الخامس قبل الميلاد) سمع بصفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نغمات حركات الأفلاك والكواكب، فاستخرج بجودة فطرية أصول الموسيقى ونغمات الألحان، وهو أول من تكلَّم في هذا العلم، وأخبر عن هذا السر من الحكماء([2]). وتوالت الأيام، فاكتست الموسيقى وسماع الألحان والأشعار بكسوة المذاهب والأديان والثقافات والأفكار التي تنوّعت وتفنَّن أهلها في عرضها بألوان وأطياف مختلفة، لتبلغ كمالها في أحضان العرفان النظري والسلوك العملي، الذي شكَّلها وفق مبانيه وأصوله.
وقد أضفى الراهب المسيحي الشهير «يوحنا كسيان» (القرن الخامس قبل الميلاد) صبغة الرهبانية على آداب محفل السماع، وذلك في كتابه «النظم». ومنذ ذلك الوقت بدأ الرهبان يظهرون ضمن المشاركين في مجالس السماع، بحيث تلتقي جموع من الرهبان، ويحومون حول بعضهم البعض، ويبدأ شخص ذو صوت صدّاح وبنغمات شجيّة ومحزنة يقرأ المزامير والأناشيد المقدَّسة، وكذلك الأشعار الدينية الواردة في الديانة المسيحية. وكانوا يختارون مقاطع من المزامير تتوافق والحاجة واستعدادات المستمعين الروحية. ويرافق هذه المجالس الصلاة، مع بعض الحركات البدنية، إلى جانب البكاء والصراخ، في محاولة لإظهار التأثُّر. وهي مجالس لقيت القبول بعد مدّ وجزر([3]).
ولعل التأريخ للبدايات الأولى لفنّ السماع ومعرفة المروِّج الأول له في التصوف الإسلامي أمرٌ صعب، لكنْ في مقاربة تاريخية لبعض الأحداث والمستندات يظهر أن العارف الكبير «ذو النون المصري» هو أول مَنْ وضع تعريفات للوجد والسماع والمقامات العرفانية، وذلك في بدايات القرن الثالث الهجري، وكان اليونانيون يعرفونه باسم «توبوليس»([4]).
وقد كانت لـ «ذي النون المصري» علاقة قوية مع القديس «فليمون»، الذي كان أول من وضع حجر الأساس للدير في العالم الشرقي والغربي. وقد انطلق البعض من هذه العلاقة ليتَّهم ذا النون المصري بأنه نقل سلوك الرهبان إلى الإسلام، وابتدع في الدين ما ليس منه. وهي التهمة التي ألَّبت فقهاء العصر ضدّه، وأدخلته في مواجهة عنيفة معهم، أفضت بهم إلى اتّهامه بالزندقة، والوشاية به عند حاكم العصر([5]).
موقف الشرع الإسلامي من الموسيقى
لقد أجاز الشرع قراءة القرآن في الصلاة بالخفض والجهر. كما أكَّد على تحسين الصوت في قراءته في غير الصلاة، وتجويد الصوت فيه مع مراعاة ألحان العرب. ومن هنا فإن تعدُّد الروايات التي يحثّ فيها النبي الأكرم والأئمة المعصومون^ على تلاوة القرآن بصوت حسن شجيّ، ووفق موسيقى لطيفة ومعبِّرة عن انسجام معانيه مع الفطرة في الإنسان. وتحريك مشاعر الحزن والشوق إفصاحٌ بأسلوب المعنى المفهومي عن أصالة موسيقى القرآن في الإسلام([6]). وقد كانت موسيقى القرآن ونغماته الملكوتية في صدر الإسلام سبباً مباشراً في إسلام العديد من المشركين وأهل الكتاب، الذين انجذبوا إلى ألحانه الملكوتية. وقد كثرت الروايات عند الفريقين (الشيعة والسنّة) عن النبيّ الأكرم| يخبر فيها أنّ الأنبياء جميعهم قد وهبوا الصوت الحسن والنبرة الشجية. قال|: «أوتيت مزماراً من مزامير داوود»([7])، بمعنى أنه| قد بعثه الله بصوت شجيّ ونبرة عذبة. كما قال في موضع آخر: إن الناس ليس لهم طاقة على سماع صوته في تلاوة القرآن، لذلك لم يكن يقرأ لهم مرتلاً، وإنما كان يقطعه آية آية؛ رحمة بهم([8]). ويذكر أنّ الإمام علي بن الحسين× كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، حتّى أن السقّائين كانوا يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته، وقد كان صوته شجياً لدرجة أنه لا يفقدهم الإحساس بثقل ما يحملون من القرب فحسب، بل إنّهم لو قطعت أيديهم وأرجلهم ما كانوا سيشعرون بها أو يحسّون([9]). وقد شرع الأذان في نفس الفترة من تاريخ الإسلام، كما رخص لقراءة شعر المدح وذكر المصائب والرثاء. وكان النبيّ الأكرم| أوّل مَنْ رخَّص للبواكي على عمّه حمزة. وورد عن المعصوم× الأمر بتحسين الصوت في النوح على الميت؛ استجلاباً للحزن، وأمرهم بأن ينوحوا بالشكل الذي يتقنونه ويعرفونه([10]).
ومن الجدير بالإشارة أنّ تلك المجالس، سواء شكّلت لأجل المديح في الأفراح أو للمراثي في المآتم ومجالس العزاء، لم يكن يتخلّلها ما يمسّ بالأخلاق والآداب الإسلامية. وكلّ ما كانت تستهدفه هو تنشيط النفس وتقوية القلوب على السير إلى المقامات العليا، وإشعال مشاعر الحزن والأسى والبكاء على شهداء صدر الإسلام، وسيّدهم حمزة، ولم يكن يتخلّلها حركات في البدن، سواء المعبِّرة منها عن الطرب أو الاضطراب. ووفق ما روي عن النبيّ الأكرم| فقد أمر بالتباكي وإظهار الحزن لمَنْ لم يحظَ بالفيوضات الرحيمية، فقلّت فيه الدمعة، وبخل عنه القلب بالخشوع؛ لأن الخشوع والسكينة والطمأنينة في التوجُّه، والإخلاص إلى الله في التضرُّع، شرط القبول، وعلامة على كمال العبادة، ونجاح الطلبة والنجوى. وعلى النقيض من ذلك الرياء والظهور بمظهر العارف الورع والزاهد السالك، الذي أصبحت الدمعة والآهات والأنين سلاحه، يروِّج بها لبضاعته في مجالس السماع، وجزءاً من آدابه وشروط ولوج سلكه وميدانه، لدرجة جعلت بعض كبار الصوفية يتبرأ من هذه الآداب ويشذِّبها. فهذا الجنيد البغدادي، وما أدراك ما الجنيد!، وهذا أبو يزيد البسطامي، والقشيري، والعارف القطب ابن عربي، يتَّفقون جميعهم على ذمّ هذا السلوك، واعتباره سدّاً منيعاً أمام العروج بالنفس نحو الكمال، ومانعاً في طريق السير والسلوك.
ومن جملة البدع التي وقف منها العرفاء موقفاً حاسماً في الرفض وعدم الرضا دخولُ آلات ووسائل الموسيقى، كالدفّ والشبابة، إلى ما يتعارف عليه بينهم بمجالس الذكر، بحيث يتمّ التغنّي بالأشعار والمدائح (الذكر) على إيقاعها ونغماتها، بل يتجاوز ذلك إلى قراءة الآيات القرآنية على أوتار الموسيقى، ويتغنّى بها على أوزانها وألحانها. وهو تشبُّه ممسوخٌ بسلوك الرهبان في الكنائس، الذين يتغنّون بمزامير الكتاب المقدَّس على نغمات آلات الموسيقى وألحان الأوبرا. وقد خدع بعض مغفّلي الصوفية فأخذوا الجمل بما حمل، ولم يفقهوا الأمر، ولم يكونوا فيه من المتدبِّرين، فوضعوا العادات موضع السنن. فضرب الأرض بالأقدام، والرقص بالأكمام، وكشف الرؤوس، وتخريق الثياب، عندما تبلغ به النشوة حدّ التجرُّد، ويحصل له الانجذاب، كلّها من سلوكيّات الرهبان. وأوّل مَنْ ابتدعها الراهبان «بوس» و«أنطوان»، فقد ذهبا إلى القول: إن المستمع (الواجد والمجذوب) لما يصل إلى مرحلة الأوج يبدأ بحركة الدوران، لينتقل إلى مرحلة خلع العمامة أو الرداء، والإلقاء بها إلى الأرض. ويبدأ القوّال في التغنّي بأبيات من شعرهم أو من الرباعيات والغزل المعبِّر عن العشق لله، ويتبعه الآخرون الذين يتحلَّقون حوله في شكل دائريّ، ويتحركون وفق حركات خاصة، وذلك في اعتقاد منهم أنّ الله سبحانه وتعالى يعتني عناية خاصّة بالشخص الواجد، الذي وصل مقام الوجد، ويحلّ على ردائه من بركاته. وهي الأفكار التي تتبنّاها الصوفية مع اختلاف قليل. وعلى أيّة حال فإن كبار العرفاء قد أنكروا هذه المعتقدات، ونهوا عنها بشدّة([11]).
وقد تعرَّض ابن عربي لهذه الفرقة من الصوفية ضمن رسالته «روح القدس»، ونعتها بالمتظاهرة بالتصوُّف، وقد ذمّها كثيراً وطعن في أفكارها وسلوكياتها. أما عن السماع الذي ينادي به ابن عربي فهو السماع الخالص والخالي من كلّ تلك الشوائب والعادات والاقتداء الأعمى برسوم وعادات الرهبانية، ويتجلّى خلوصه في كونه سماعاً لكلام الحقّ وللقرآن.
ظهور العالم والسماع لكلام الحقّ
لقد خصّص الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربي باباً مبسوطاً للسماع، وذلك ضمن كتابه «الفتوحات المكية»، كما جعل ثلاثة أبواب أخرى للوجد والتواجد والوجود. ولم يقتصر حديثه عن السماع ومتعلَّقه على هذا الكتاب، بل كان له حديث متناثر في كتبه الأخرى. وسنحاول في هذا المقال عرض آرائه ومواقفه من السماع، وطروحاته العرفانية.
يرى ابن عربي أنّ الاعتقاد المطابق لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنّه ما من شيء في عالم الوجود إلاّ وهو يسبِّح لله تعالى، مصداقاً لقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (الإسراء: 44). ولأنّ كلّ شيء في هذا العالم يسير وفق نظام وحركات موزونة، وفواصل متناسبة، فإنّه وبشوق وعشق يطوي المسافات ويقطع المنازل نحو مقصوده: كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (يس: 40). وكونها تسبِّح في فلك يعني أنّ لها نغماتها وإيقاعاتها الخاصة، أو كما يعبِّر عنه ابن عربي نفسه: إن الكلّ صنع قول الله وإيقاعاته الملكوتية، وفقط أهل الله، أهل صفاء القلب وأصحاب الكشف والشهود، يسمعون وينظرون هذه الحقائق الإلهية([12]).
لأنّ عبادتك عن عشق وفناء فيكفي صوت دولاب الماء ليسقيك كأس الوجد، ويغيبك حتّى السكر.
بل يذهب ابن عربي إلى القول: إن تحقق الوجود والخلق منوطٌ بسماع كلام الحقّ تعالى. ويستشف هذا من أبياته الشعرية، التي يقول فيها([13]):
|
لولا سماع كلام الله ما برزت أعيننا وسعت منه على قدم إلى الوجود، ولولا السمع ما رجـ ـعت على مدارجها لحالة العدم |
أي لو أنّ قلوبنا لم تسمع نداء وكلام الحقّ تعالى لما تحقَّق لنا وجود في عالم الوجود، ولما سلكنا خطوة في ساحة الوجود وعالم الإمكان. فوجودنا منوط التحقُّق بالسماع لكلام وقصيدة الحقّ. فنحن في عالم البرزخ، وهناك يتساوى وجودنا بين الحدوث وبين القدم، وخروجنا من عالم البرزخ نحو الحدوث متوقِّف على السماع لكلام الحقّ، والذي يتحقق بإرادته وحكمته الأزليّتين.
وينطلق من قوله تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل: 40) ليقول: متعلَّق الوجود ومتعلَّق الأمر التكويني كلام الحقّ. والكلام مشتقٌّ من الكلم من حيث أثره في المتجلّي له. فعندما يحدث الأمر بكلام الحقّ، وحين يسمع أهل الله هذا الكلام بأذن القلب، وحين يفهمونه ببصيرتهم، ينتقلون من حالة الوجد إلى حالة الوجود… فالتعلُّق به منّا: القول منه، والسماع منّا، فكان عنه الوجود. وكذلك نقول في هذا الطريق: كلّ سماع لا يكون عنه وجدٌ، وعن ذلك الوجد وجودٌ، فليس بسماع. فهذه رتبة السماع، التي يرجع إليها أهل الله ويسمعون، فقوله تعالى للشيء قبل كونه: «كُنْ» هو الذي يراه أهل السماع في قول القائل. وتهيّؤ المقول له «كُنْ» للتكوين بمنزلة الوجد في السماع، ثم وجوده في عينه، لينتقل أمره إلى «فيكون». ونجد العارف الكبير شمس المغربيّ قد نظم هذه الحقيقة في أبيات نذكر منها قوله:
فمن سماع قول الحقّ: «كُنْ»، ومن نغمة يوم قول الحقّ: «ألستُ» في عالم الشهود، كلّ الأرواح وكلّ الخلائق هبَّت تصرخ وتلبّي بصوت العهد والميثاق «قالوا: بلى»([14]).
أنواع السماع: السماع المطلق؛ والسماع المقيّد
قسَّم الشيخ الأكبر ابن عربي السماع إلى: سماع مطلق؛ وآخر مقيّد.
فأما السماع المطلق فهو الذي عليه أهل الله، ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظيم بالموازين، حتّى يفرِّقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاء. ولهذا السماع موسيقاه وإيقاعاته التي هي في حقيقتها مظهرٌ للحقّ تعالى، فموسيقاه ربانية، وكذا ألحانه وإيقاعاته ملكوتية، فالوجود كلّه رقّ منشور، والعالم فيه كتابٌ مسطور، فالأقلام تنطق، وآذان العقول تسمع، وهو السماع من كلّ شيء، وفي كلّ شيء، وبكلّ شيء. فالوجود كلّه كلمات الله، وكلماته لا تنفد، وكذلك الأسماع في قِبَل كلّ هذا لا تنفد، تحدث في السرائر كما تحدث في العلن. ويفرق السماع المطلق عن المقيّد في أنّه منزَّه عن النغمات والترنُّم الحاصلة من الطرب المعتمد على الصناعات. ووفق نظر ابن عربي فإنّ قلب العارف السالك لا ينصاع لقالب الموسيقى، ولا لما تصدره أوتار آلاتها، وإنما يجد بغيته في ما يسمعه من عالم الأفلاك، وعالم العقول، وما تحدثه الكائنات في عالم الأرض من أصوات التسبيح والتهليل. قلبه متعلِّق بها، ونفسه تهفو إليها.
أما السماع المقيّد أو السماع الطبيعيّ، أو ما يصطلح عليه في الفقه بالغناء والموسيقى، وهو المقيَّد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله، فهو يتقيَّد بأنّ فهم المعاني ليس شرطاً فيه. فحصول حالة الوجد والانسجام بين الحركة الحقيقية والباطنية إنّما تكون في السماع المطلق؛ لأنه فهم المعاني شرط تحقُّق الوجود والحركة فيه، وهذا الإدراك والإشراق الباطني للمعاني أفاض على النفس والروح أشعة من النور، لينعكس هذا النور في العلم والوصول إلى معرفة حقائق الأمور. فمن خلال نوع الحركة الحاصلة ينكشف نوع السماع، وهل هو مطلق أو مقيّد. فلو كانت الحركة دوريّة فهذا علامة على أن السماع طبيعي ومقيّد؛ لأن الحركة الدورية إنما هي للروح الحيوانية، التي هي تحت الطبيعة والفلك، فلا فرق بينه وبين الحيوان أو النفوس الحيوانية([15]). وحسب قول ابن العربي: كيف لنا الاطمئنان إلى صدق مَنْ ليس قادراً على التمييز بين نوع فهمه وبين نوع الحركة والوجد الذي حصل له؟
من هنا فابن العربي يذهب إلى القول بأن العارف الحقيقي لا يقول إلاّ بالسماع المطلق، ويوصي أصدقاءه بالابتعاد عن سماع الألحان والنغمات الموزونة الصادرة من الآلات الموسيقية والمحرِّكة بالطبع للمزاج، التي ترافق عادةً قراءة أبيات ومقاطع من الشعر الوصفي والخيالي، الذي لا تجد لمحتواه معنى أو فائدة، وأن يتنعَّموا بالسماع لكلام الحقّ، ويملؤوا أوقاتهم بذكر الله. وأنشد قائلاً:
| خذها إليك نصيحة من مشفق ليس السماع سوى السماع المطلق
واحذر من التقييد فيه فإنه قولٌ يفند عند كلّ محقّقِ |
السماع ومسألة وحدة الوجود
وفق نظر العارف الكبير محيي الدين ابن العربي، المؤسِّس الأول لنظريّة «وحدة الوجود»، فإن حقيقة الوجود هي أصل ومنشأ كلّ الآثار.
فالوجودُ خيرٌ محض، ومطلقٌ عن كل القيود، حتّى عن قيد الإطلاق. ولا وجود حقيقيّاً إلا وجود الله تعالى. والحقيقة واحدة صرفة. وهذه الحقيقة لها شؤونات، وتعيّنات وتجلّيات وظهورات تظهر في الأعيان الثابتة وفي الأذهان والموجودات الخارجية. وظهورها هذا يوحي بالكثرة التي تبدو ظاهرة في العالم. إذاً فالحقّ موجود، والخلق موجود، فتكون بذلك الوحدة والكثرة. وليست الكثرة اعتبارية، بحيث يتنزَّل الحقّ تعالى ـ نعوذ بالله ـ إلى مستوى الخلق الداني، أو حلول وتعطيل وما يلزمها من أحكام، ولكنّ الحقّ حقٌّ، والخلق خلقٌ. ولو لم تكن هذه الحقيقة الحقّة بسيطة لما كان لها ظلٌّ وخيال. فإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة بلحاظ الوحدة كانت هي الحقّ تعالى، وأما إذا نظرنا إليها بلحاظ الكثرة كانت هي الخلق. والحقّ باعتبار ظهوره في صور الأعيان والموجودات، وقبوله للأحكام المرتبطة بها، خلقٌ، أمّا باعتبار أحديّة الذات حقّ. والأسماء الذاتية في مرتبة الألوهية ليست خلقاً، بل هي الحقّ المتعالي عن الخلق([16]).
وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه عينه([17]).
ويربط في موضعٍ آخر بين السماع ونظريته في وحدة الوجود قائلاً:
| فما نظرت عينٌ إلى غير وجهه
وما سمعت أذني خلاف كلامه وكل شخيص لم يزل في منامه([18]) |
فابن العربي ينظر إلى السماع من خلال نظره إلى وحدة الوجود، ومن خلاله يعرِّفه، ويقيم له الوصف. ولهذا وجدناه يرجِّح السماع المطلق على السماع المقيد، ويقول في أبيات، موضِّحاً هذا الموقف:
| إن التغنّي بالقرآن سماعنا
والحق ينطق عند كلّ منطقِ |
ويرى ابن عربي أن كلّ موجود حين يسمع كلام الحق ويفهم أوامره فإنه يبلغ الوجد، ومن ثم يخرج للوجود. ولأن السماع الطبيعي (الغناء) مرحلة نازلة من روح الإنسان فإنّه يجعلها مقيّدة ومحدودة، ولا يكون نصيب النفس الإنسانيّة من السماع الطبيعي سوى الالتذاذ بنغمته، وحسن ألحانه، ولا يجتمع حصول فهم المعاني والسماع الطبيعي والمقيّد. والعارف من أهل الله لا يترك السماع المطلق، والذي يتركه الأكابر إنما هو السماع المقيّد، وهو المتعارف عليه بـ (الغناء).
ويروي لنا ابن عربي موقف أستاذه أبي السعود ابن الشبلي البغدادي، حيث سئل عن رأيه في السماع؟ فقال: هو على المبتدئ حرام، والعارف المنتهي لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إليه القوم المتوسِّطين أصحاب القلوب([19]).
أنواع السماع المطلق
1ـ السماع الإلهي
و هو السماع للأسرار الإلهية. وهو عين درك وفهم المعنى. السماع من كلّ شيء، وفي كل شيء، وبكل شيء. والوجود عندهم مظهر لأسماء الله على كثرتها، لا تقبل الفناء مطلقاً. ولكلّ اسم لسان، ولكل لسان قول، وفي مقابل كلّ قول سمع. والعين واحد من القائل والسامع. فإن كان نداءً أَجَبْنا، وكان مثل قوله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: 60)، فأعطانا قوّة الكلام، وأمرنا بالدعاء، فنقول، ويسمع منا: «فالله عند لسان كلّ قائل». وبما أنه ليس في الوجود إلاّ الله كذلك ليس هناك قائل ولا سامع إلاّ الله. وحين يصل العارف إلى مرتبة الكمال يتمثَّل فيه قوله تعالى: «كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به». هذا هو السماع الإلهي، وهو يسري في جميع المسموعات. وأما عن تأثير هذا النوع من السماع على روح ونفس العارف الحقّ فذلك أنه يصل إلى مرحلة العلم، ويطّلع على الأسرار الإلهية، ولا يظهر في الحركة، أو ما يصطلح عليه عند الصوفيّة بـ (الحال)، وإنّما حاله السكون.
والفرق يكمن في ما يجب لكلّ واحد منها. فليس الوارد الإلهي للقلب كالوارد الطبيعي، فالوارد الطبيعي إذا ورد وارده في قلب الإنسان تظهر آثاره من خلال تحريك الجسم تحريكاً دورياً، وإنّما التحريك للروح الحيواني الذي هو تحت الطبيعي والفلك، يتحرك إلى أن يصل حالة الهيام، وهي الوجد الشديد والجنون، وتجعله يتخبَّط كمَنْ يتخبّطه الشيطان من المسّ. فعلم أن الوارد الطبيعي تحركه الحركة الدورية. بينما الوارد القلب من السماع الإلهي إذا ورد وارده فعليه في الجسم أن يضجعه لا غير، ويغيبه عن إحساسه، ولا تصدر منه حركة أصلاً، وإنّما تتجلّى فيه السكينة، وكأنه قد تجرّد عن عالم المادة، وأصبحت روحه تحلق في أجواء الأرواح والعقول. وسبب ظهور هذه الحال يرجع إلى قوة عنصر التراب فيه، فقد قال تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (طه: 55). وفي مقام التمثيل قال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: 59). فالطين العنصر الأعظم والأعلى من كلّ العناصر الأخرى. وما دام أصله التراب فإنّ ما يصدر عنه من الحركة، من قيام وقعود وركوع وغيرها، إنما هي بالعرض. وأما تفسير ما يظهر أثناء السماع الإلهي، حيث يظهر وكأنّ المستمع قد التصق بالأرض، ولم تعُدْ تصدر منه أيّة حركة سوى السكون، فذلك مردّه إلى أن ورود الوارد الإلهي ـ وهو الذي يحمل صفة القيّومية، وهي في الإنسان من حيث جسمه بحكم العرض، وروحه المدبّر هو الذي يقيمه ويقعده ـ يشغل الروح المدبّر عن تدبيره بما يتلقّاه من الوارد الإلهي من العلوم الإلهية، وتحصل له حالة التجرّد، ولم يبقَ للبدن مَن يحفظ عليه قيامه وقعوده، فيرجع إلى أصله، وهو ركونه إلى الأرض. فإذا فرغ التلقّي، وصدر الوارد إلى ربه، رجع الروح إلى تدبير جسده. وهذا هو سبب اضطجاع الأنبياء على ظهورهم عند نزول الوحي عليهم. وما ثبت عن نبيٍّ قطّ أنه تخبَّط عند نزول الوحي، ولا اهتزّ، ولا دار، ولا غاب عن إحساسه، وكذلك فإنّ الوارد الإلهي لا يغيِّره عن حاله، ولا إحساسه. هذا إذا كان الوارد الإلهيّ بواسطة جبرائيل×، فكيف به إذا كان من دون حجاب. وكذلك إذا كان الوارد عن طريق الإلهام فإنه لا يحدث تغييراً في الحالة النفسية أو الخيالية التي تظهر عادةً من ضعف الإحساس عند الإنسان([20]).
2ـ السماع الروحاني
أما الروحاني من السماع فهو سماع صرصارة وصريف ونغمات الأقلام الإلهية على اللوح المحفوظ أثناء المحو والإثبات والتغيير والتبديل. فالوجود كلّه رقٌّ منشور، والعالم فيه كتاب خطت سطوره من لدن الرحمن الرحيم. تنطق الأقلام في تخطيطها، وتسمع العقول بآذانها، وما رقم من كلمات شاهد بينهما. وعين شهودها عين الإدراك واستيعاب المعنى فيها. ولا يرقى إلى هذا السماع إلاّ ما اكتمل من العقول. وكما أنّ السماع الإلهي قائم على مبانٍ أربعة: ذات، ونسبة، وتوجه، وقول، فإنّ السماع الروحاني مبنيّ على: ذات، ويد، وقلم، وصرير. قلم حين يخطّ على لوح القلوب بالتقليب والتصريف، وهكذا يكون سماع أهل الله. وفي السماع الروحاني ـ والذي هو من السماع المطلق ـ يحصل للعارف المستمع العلم والفهم والمعرفة بالجملة. والسماع الإلهي إنّما يحظى به من الأفراد مَنْ وجدت فيه القابلية، ويتفاوت فيهم تفاوت الأشدّية، كما تتفاوت في الأشدية القابلية والاستعداد. ومن ظفر بالقدرة والبلغة اجترع منه جرعته، واحتسى من كأس شرابه، وطرب بنغماته. وإنّ ما تحدثه الحقائق الإلهية إذا عزفت على أوتار النغمات الإلهية في روح العارف أكثر ممّا يفعله سماع الحقائق التي تصدر بالطريقة العادية للكلام. فقد يقرأ القارئ آيات، وينشد الشاعر أبيات، بطريقة تفتقد للحسن، فلا تحدث تفاعلاً أو أثراً، ولا ترشد إلى إيجاد حركة الانسجام بينها وبين السامع، بل يكون الحال على العكس، بحيث يضجر المستمع، ويتكدّر خاطره؛ وذلك لأن القراءة كانت على خلاف الإيقاع واللحن الصحيح، ولم تكن على الوزن الطبيعي، لكنْ إذا قرئت نفس الآيات أو أنشدت نفس الأبيات بصوت شجيّ ونغمة عذبة ووزن يتوافق مع الطبيعة فإنه يحدث الوجد، ويوجد الحركة. هكذا هو الميزان في المحسوسات، أما الميزان في المعقولات فهو حكمة الترتيب والترتّب الإلهي في العالم. فإنْ كنّا من أهل السماع الإلهي ننظر ترتيب الأسماء الإلهية، فيكون سماعنا بالتَّبَع من هناك؛ وإنْ كنا من أهل السماع الروحاني ننظر ترتيب آثار تلك الأسماء في العالم الأعلى والأسفل. ووفق نظر أهل السماع الروحاني فإنّ لكلّ المسموعات نغماً، غاية ما في الأمر أن بعض النغم تكون لها حركة محسوسة، والبعض الآخر لا تكون له. لكن الحركة الروحانية موجودة بالضرورة، بحيث تتوجَّه في حركتها من حركة الوجد الروحاني نحو حركة الوجد الإلهي. ولا يمكن حصول هذا التكامل إلاّ لأهل السماع الحقيقي والمطلق.
السماع المقيّد (الغناء أو سماع العوام من الناس)
سبق أن أشرنا إلى أن محيي الدين ابن عربي يذهب إلى الاعتقاد بأن السماع المقيد سماع منحصرٌ بالنغم واللحن الطبيعي، من دون أن يحمل الفرد إلى فهم المعاني. وغاية ما يحدثه حالة من الهيجان، ويحصِّل السامع فيه بغيته الشهوية. ورغم إطلاقه اسم الغناء على هذا النوع من السماع فقد رهن الحكم بالحرمة أو الوجوب فيه بنوع السامع، ونوع الكلام المقروء برفقة تلك الألحان.
ويعتقد ابن عربي أن السماع الطبيعي يقوم على أربعة أمور، والطبيعة قائمة على فاعلين ومنفعلين. وتظهر في المقابل النشأة الطبيعية على أربعة أخلاط وقوى، وكلّ خلط يطلب ذاتياً مَنْ يحركه ولا يتركه ساكناً؛ لأن السكون يعني تلقائيّاً العدم. ولذلك لمّا سمع الحكماء (العلماء) صريف وصرصارة الأقلام ابتكروا لتلك الأخلاط الأربعة نغمات، وكل نغمة في آلة موسيقية، فكانت أربع آلات: الزير، والمثنى، والمثلث، والبم. وكلّ واحدة منها تتناسب مع واحد من العناصر الأربعة، التي تقوم بتحريكها، وتحدث في الإنسان أحاسيس مختلفة ما بين الفرح والبكاء (الحزن) وأنواع الحركات الأخرى. مع العلم أنّ هذه النغمات وألحان الآلات لا ترقى إلى مستوى جلب العلم أو حصول فهم للمعاني، وإنما حظّ السامع لها ينحصر في حصول الطرب والإحساس بالنشوة اللحظية من خلاله. فهي لا تصل إلى مرتبة إغداق أو إفاضة العلم، فلا تفهم معنى، ولا تحدث شيئاً. وكلّ ما يجده صاحب السماع الطبيعي هو الطرب أو الحزن في نفسه تبعاً لنوع النغمات. ويرى ابن عربي أن هذا إنّما هو سماع العوام، فلا هو يوصل إلى حال الفهم الصحيحة، ولا إلى حالة الوجد. والعارف السالك في الجملة لا يحتاج هذا النوع من السماع، رغم اعتقاده بأنّ كلّ العالم له نغمات موزونة، يسمعها بقلبه ويطرب بترنُّمها، بل يذهب إلى أكثر من ذلك في قوله: إن النهي عن السماع المقيّد لا يختصّ بالعارف السالك، بل كذا المريد، ومَنْ هم في طور التلمذة والمبتدئين بشكل عام.
ولعل موقف ابن عربي من السماع الطبيعيّ ينمّ عن معرفته الكاملة بالآلات الموسيقية، وكل ما يرتبط بها. وكذا اطّلاعه التامّ على كلّ مباحث الفلاسفة في خصوصها.
إنّ السماع الطبيعي، أو المصطلح عليه بالمقيد، والذي يطلق عليه ابن عربي اسم الغناء ـ والظاهر أن هذا الاسم هو الرائج في زمانه ـ، أمرٌ مباح. لكنّ الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي يرى أن الغناء أو السماع الذي يترافق والعزف على الآلات الموسيقية، مثل: الدف والناي، في مجالس طابعها الفسق وارتكاب المحرمات، حرامٌ. وهو بالتالي خلاف الآداب والأخلاق الدينية([21]).
يظنّ ابن عربي أن السماع الطبيعي مكوَّن من شكل وقالب لقراءة الأشعار. أما السماع الإلهي والروحاني فهو للاستماع إلى القرآن. وكما جاء في «رسالة الروح القدس» ـ التي فصَّل ابن عربي فيها القول، وصبّ كامل ذمّه على هؤلاء المتشيّخين المتطفّلين على التصوّف، والمتظاهرين بألوان أصحاب الحال، حين يدّعون وصولهم إلى مقام الوجد والحركة من طريق السماع الطبيعي، فرأى عملهم خلاف الشرع، بل هو بدعة قبيحة ومذمومة ـ فإنّ ابن عربي يرى أنّ الحركة الحاصلة من نغمات الموسيقى حركة دورية، وناشئة من البعد الجسماني. ونظريته الثابتة أن العارف إنّما يصل حالة الوجد بالسماع للآيات القرآنية ولكلام الحقّ، لا بسواهما، وتنبعث عن هذا الوجد حركة باطنية تتناسب وهذا الوجد الإلهي، وتفتح طريقها إلى قلبه([22]).
وما يشجبه العارف الكبير محيي الدين ابن عربي أن تتمّ قراءة القرآن على نغمات آلات الموسيقى، وليس وفق ألحانه وموسيقاه الداخلية، التي رغب فيها النبيّ الأكرم|، وكذا الأئمة المعصومون^. وما ذهب إليه ابن عربي من ترفُّع العارف، وكذا المبتدئ، عن سماع الأشعار برفقة العزف على الآلات الموسيقية، وأنها إنّما تناسب العوام، رأيٌ خالفه فيه الكثير من العرفاء أو علماء الصوفية. فهذا أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» وفي «كيمياء السعادة» قد بيَّن أدلّة تجيز للعرفاء سماع الأشعار سماعاً طبيعياً، غير أنّها لم تلقَ القبول لدى ابن العربي، وعدّها أدلة باطلة.
السماع من خلال المشاهدة
من أنواع السماع المقيّدة الأخرى التي لم تلقَ القبول عند ابن العربي، بل وجدت من لدنه إعراضاً وتقبيحاً وشجباً لاذعاً، السماع بالمشاهدة.
ورغم تكرار المنع من طرف ابن عربي لسماع المريدين ـ والذي يتم بالمشاهدة ـ فإنّ عدم تحسُّس المسؤولية من طرف بعض المشايخ، وعدم وعيهم بما فيه الكفاية، جعلهم يسمحون لمثل هؤلاء بالحضور في مجالسهم، بل تعدّى الأمر إلى تجرّؤ بعض ذوي النفوس الضعيفة على هؤلاء المشايخ، فروَّجوا لسلوكيات تخالف كلّ الأعراف والآداب والأخلاق السوية. ولكي يسندوا أعمالهم تلك قالوا بالتفكُّر الأفلاطوني، بحيث يستجلبوا إلى مجالسهم بعض الفتيان حديثي العهد بالبلوغ، فيتوجَّهون إليهم بالنظر أثناء السماع، وقالوا بأن النظر إلى هؤلاء الفتيان من ذوي الوجوه الوضّاءة والسمة اللطيفة يقوّي فيهم التغلُّب على شهواتهم الجسمانية، وهذا موجبٌ لظهور الفضائل في النفس، وبالتالي يجلب مرضاة الله. وقد شنّ ابن عربي على هذه الأفكار ومَنْ يعمل بها حملةً عنيفة، ووجدها مجرّد بدع مبتذلة، ومشابهة لتلك البدع التي كانت من محدثات الراهب «كسيان المسيحي»، الذي ابتدع الرقص، واعتبره من آداب السماع، وجزءاً مهمّاً فيه. وهكذا ظهرت العديد من المحدثات في التصوّف. وكان العديد منها مورد سخط كبار العرفاء والمشايخ، أمثال: ابن العربي، والجنيد البغدادي، والقشيري، وأبي يزيد البسطامي.
الوجد الصوفي وأقسامه
| إذا أفناك عنك ورود أمر
فذاك الوجد ليس به خفاء |
إنّ الوجد عبارة عمّا يصادف القلب من الأحوال المُغْنِيَة له عن شهوده وشهود الحاضرين. وقد يكون الوجد عندهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب.
ويرى البعض أن الوجد يحصل بحزن القلب المعنوي، ونتيجة هذا الوجد الذي يأتي من السماع الإلهي يحصل العلم الذي يفهمه، ويرشد به نحو التعالي، ويغدق عليه نورانية خاصّة. وفي غير هذه الصور يكون باقي الوجد مجرّد وهم، ونتيجة للخيال والتخيُّل؛ لأن الوجد الحاصل من الوارد الإلهي، بمعنى كونه من جانب الحضرة الإلهية المتعالية، لا بدّ وأن يفيض العلم، وبالطبع يشترط في حصول الوجد الطهارة، وحصول صفاء الباطن. وهذا ليس شرطاً في الوجد العام والمقيّد، رغم ما يظهره أصحابها من الوجد، فإنه وجدٌ غير صادق ومجرّد كذب. وهُمْ من المهارة بحيث لا يمكن التمييز بين الوجد الحقيقي وغيره، فأهل الرياء يستطيعون التلبُّس بلباس الصادقين، وهم من الصدق بعيدون([24]).
كتب الشيخ الكبير محيي الدين ابن عربي في رسالة «لا يعول عليه»، يصف هذا النوع من الوجد: الوجد الذي يكون حاصلاً من التواجد عديم الفائدة، وما يترتب عنه من وجود هو الآخر غير مستحقّ لكل عناية، والحال الذي يأتي من هذا الوجد وما يرافقه من حركة وتمايل رغم كونه مورد جلب توجُّه الآخرين لا يعدّ حالاً. فالحركة التي تأتي من الطرب الحاصل من سماع الموسيقى والألحان الجيدة لا فائدة ترجى من ورائها. وحتى لو اعتبرنا ذلك الحال إلهياً، وما صدر من حركة هو نتيجة لحصول الوجد الإلهي، ولكنْ بما أنّه وجدت معه تحولات حسية وجسمية فهو باطل. وكذا السماع الذي يكون نتيجة السماع لنغمات وألحان آلات الموسيقى والصوت الحسن يعدّ ضرباً من النقص والضعف للعارف([25]).
الحركة الناتجة عن السماع، وأقسامها
الرأي الثابت عند محيي الدين ابن العربي، أو كما يسمّيه البعض: الشيخ الأكبر، أنّ الحركة الناتجة عن السماع نوعان: حركة حسّية؛ وحركة قلبية.
والحركة الحسية تحصل نتيجة السماع المقيّد، وهي أمر باطل، والوجد الذي ينشأ عنها إنّما هو نتاج التواجد. وتأتي هذه الحركة عند سماع النغمات الموسيقية الموزونة والوصول إلى الطرب، وليس لصاحبها حظّ سوى التمرّد الظاهري، وادّعاء الحال، وما هو بحال.
أما الحركة القلبيّة فهي تعبير واقعيّ عن الانتقال من حال إلى حال، وهو ناتج عن الوجد الصادق، هذا الوجد الذي يصاحبه العلم الإلهي، ويفيض من خلاله النور الذي يتجلّى في حصول الفهم والاتصال الحقيقي بمعاني الكلام. ولعلنا نستطيع القول بلغة أكثر وضوحاً: إن علو درجة هذا الوجد متعلّق بمستوى الإدراك والفهم للسامع؛ فمتى كان مستوى إدراكه عالياً كان وجده كذلك في مرتبة عالية، وتتحقق فيه الحركة بذلك المقدار من الفهم لمعاني الكلام. ورغم تأثير الأوزان والألحان الموسيقية الشجية على الروح إلاّ أن ما يكون علّة في الوجد والحركة وحصول العلم هو تلك المضامين العالية والمعاني القدسية والنورانية، التي يكون الوجد الصحيح عاملاً فعلياً في استجلابها والفوز بعبقها.
ويرى ابن عربي أنّ ظهور الممكنات والموجودات إنّما هو بفعل هذا الفهم الذي هو نتاج سماع الخطاب المولوي لحضرة الحقّ المتعال. فالذي سمع كلام الحقّ، ووصل من خلاله مقام العبودية، يحظى بمقام يكون الحقّ تعالى سمعه الذي يسمع به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به. كذلك كان حال موسى كليم الله×، فحين كلّمه الحقّ تعالى بالخطاب بواسطة الشجرة المباركة فإنّ ما سمعه موسى× في الحقيقة هو الحقّ تعالى؛ لأن الحقّ تعالى كان سمع موسى الذي يسمع به([26]).
التواجد
| ليس التواجد حالاً فتحمده
ولا مقام له حكم وسلطان وما له في طريق القوم ميزان([27]) |
ويحكي ابن عربي قصّة في التباكي، فيروي أنّ عمر بن الخطاب دخل يوماً على رسول الله|، وكان معه أبو بكر، فرأى النبي الأكرم| يبكي، وكذلك أبو بكر، فقال لهما: ما يبكيكما؟ لعلّي أبكي معكما أو أتباكى؟ فأجابه النبيّ الأكرم|: إنما أبكاني تذكّر شهداء وأسرى بدر.
فالتباكي يعني إظهار حالة البكاء والوجد كالبكاء، بمعنى إظهار حالة الوجد الخيالية. ولأن الأمر المتخيل وجودي فإنه يتطابق مع الواقع في نفس الأمر. ومن هنا يعمل المتواجد على إبراز تواجده حتّى يصدّق الحاضرون أنه صاحب وجد حقيقي، وهو في الحقيقة لم يكن من زمرة الواجدين، وإنما يتظاهر بذلك. والبون شاسع بين الحقيقة والظهور بلباس تلك الحقيقة.
الوجود
إن الوجود وجدان الحقّ في الوجود([28]).
فحالة الوجود أعلى من حالة الوجد مرتبةً، رغم ظهورها في حالة الوجد. في الوجود يظهر الشاهد والمشهود ينتقد بعضهم بعضاً، من غير أن يحدث نسياً وتغيّراً في الحال والقول. والسماع يكون عند الأنبياء والأولياء^ مع حالة الوجود والشهود. والوجود هو حالة من الثبات والاستقرار، كما أن الوجد يوجد حالة من الاضطراب والتفاعل الداخلي. وبين مستوى هذا الوجدان وشهود الحقّ واستعداد نفس الواجد وكلٍّ من الصفات والأسماء الإلهية علاقةٌ وترابط. وقطعاً من الممكن أن لا يطّلع صاحب الوجد على حقيقة وجود الحقّ، ولكن العارف الحقيقيّ يأخذ المعرفة به من خلال وجد صاحب الوجد.
أقسام السامعين
يقول العارف السعدي: الأَوْلى أن أعرف المستمع وخصوصياته، وبعد ذلك يكون السؤال عن السماع.
ويقول أوحدي مراغي: إنما هذا السماع هو حلالٌ للعارف الذي وصل إلى حقيقة الحال، وحرامٌ على غيره ممَّنْ لم يصل إلى معرفة حقيقة الحال.
وكتب أبو القاسم القشيري، نقلاً لقول أستاذه أبي علي([29])، يقول: السماع حرامٌ على عوام الناس الذي يستمعون بأنفاسهم، ومباحٌ للزهّاد، ومستحبٌّ لأصحابنا (العرفاء) الذين يستمعون بقلوبهم.
ويقسِّم أبو عثمان الحيري السماع إلى ثلاث مجموعات([30]):
1ـ المريدون والمبتدئون، الذين لا يكون السماع بالنسبة إليهم سوى عامل فتنة وزيغ.
2ـ الصادقون، الذين إنّما يستمعون إذا وصلهم الحال.
3ـ العارفون أو العرفاء، الذين هم أهل الاستقامة والمقاومة والاستقرار.
وفي هذا الباب يقول أبو سليمان الداراني، أستاذ محيي الدين ابن العربي: إن مَنْ تقع النغمة واللحن الموسيقي في قلبه وتحدث فيه شيئاً إنسانٌ ضعيفٌ، وهو في أمسّ الحاجة إلى المداواة؛ وذلك لأن اللحن والنغمة الموسيقية لا تضيف إلى القلب شيئاً، بل عملها إنْ وَجَدَتْ في القلب شيئاً أن تحرِّكه([31]). وهذا هو رأي الجنيد البغدادي أيضاً.
و يقول ابن العربي، في باب أقسام السامعين: البعض يسمع بنفسه، وهم العوام من الناس؛ والبعض الثاني يسمعون بعقولهم، في كلّ شيء، ومن كل شيء، وبكل شيء، يسمعون فينتهي سمعهم إلى العقل، فيسمعون به كلّ ذلك، وهو السماع بالله، حيث يكون الحقّ سمعهم الذي يسمعون به، مصداقاً لقول النبيّ الأكرم|: «كنتُ سمعه الذي يسمع به…»([32]). وهؤلاء الذين يسمعون بأنفسهم لا يستطيعون أن يسمعوا شيئاً إلاّ إذا كان مقترناً بالنغمات والألحان والأصوات الحسنة، كما أن حركتهم تكون حسّية، وتكون دورية، وفارغة من كلّ الوجد والحال الصحيح. وعلى العكس من ذلك مَنْ يسمع بعقله فإنه يفيد العلم ويؤدّي إلى الطاعة، لا يضيف الحركة إلى ظاهر بدنه، بل يكون إلى حدٍّ كبير من السكينة والوقار، وهم هؤلاء الذين يظلّ قلبهم مفتوحاً لنداء الحقّ، ويكون مجذوباً نحو باطنه، وفي حركة نحو تلك الجاذبية، ليصل إلى حالة الوجد والشهود والعلم، لدرجة أنّه قد تحدث له غيبوبة، فيخرج عن طور الحسّ بعالم المادة([33]).
وضمن باب «مقام ترك السماع»، وبعد أن قسَّم السامعين، قال: إن حكم السماع منوط بالمستمع([34]). وأضاف قائلاً:…وهو عندنا مباحٌ على الإطلاق لأنّه لم يثبت في تحريمه شيء عن رسول الله|؛ فإنْ كان عارفاً فسماع المقيّد لا يفتنه ولا يجلبه، لكنّ من كان قلبه محلاًّ للأغيار، وسماعه بنفسه، ويجد قلبه فيه، وجب عليه تركه، فهو إنّما يجد قلبه فيه، وحاله يتلوّن بأحوال لسماعه. أما العارف الذي يسمع بعقله، وعين سمعه عين، ولا يكون هذا إلاّ لمن أوتي جميع الأسماء وجوامع الكلم، فهو يسمع جوامع الكلم والأسماء سماعاً إلهياً وروحياً، وليس هناك فرق بين روحه التي يسمع بها وبينه هو، بل هما وحدة واحدة([35]). والعارف يكون عارفاً بالتفصيل، فيميز بين سماعه الإلهي والروحاني والطبيعي، فلا يلتبس عليه أمرهم، بل هو قادر على الفصل بينهم، ويعرف الحال في كلّ واحد منهم. ولذلك أُبيح له السماع، وأصبح في حقّه مباحاً.
وينقل شيخ العرفاء نفس الرأي في قولٍ لابن السعود الشبلي، الذي قال فيه بحرمة السماع للمبتدئ، والمنتهي (يريد العارف السالك) والعارف ليست له حاجة إليه، وإنما السماع للمتوسِّطين أصحاب القلوب.
وفي كتاب «تهذيب الأخلاق» ينصح شيخ العرفاء ابن عربي الذين يقصدون قمع الشهوات أن يتركوا السماع المقيّد، وأن لا يلقوا السمع للمغريات والمغويات من الأصوات، وبالأخصّ أصوات الإناث من النساء المغنَّجات والمختالات بدلالٍ؛ لأن الخضوع لهنّ بالسمع يسحب القدرة على مقاومة الشهوة([36]).
وفي ختام مبحث «حضرة الجمال» يقول ابن العربي: إن المؤمنين قد نهوا عن الاشتغال بالأمور اللهوية، وقد ذمّ مَنْ يجلس في مجالس تضرب فيها الدفوف، ويعزف فيها على الناي وآلات الموسيقى والعزف. وإنما المطلوب منهم ـ أي من المؤمنين ـ أن يفتحوا آذان قلوبهم لسماع كلام الحقّ المتعالي؛ حتى يتمكّنوا من الوصول إلى مقام الشهود. وقد استنكر ابن عربي واستقبح مَنْ قالوا بأن صناعة الموسيقى جزءٌ من أمور وآداب الدين، واعتبرها من التقوُّل على الله بغير علم. ويعتقد أن ليس في الإسلام طريقٌ للوصول إلى مقام الوجد والشهود بغير سماع كلام الحقّ تعالى، فوحده سماع الحقّ يجعل الروح تفنى في معشوقها، وبه تصل إلى الشهود. وإنّ ما يجب أن يكون عليه العارف من وقار وآداب تتناسب وآداب وسلوك المؤمن تتنافى كلّياً مع السماع لآلات الموسيقى، أو الطرب لألحانها، بل إنها تضرب حجاباً على القلب، فلا ينظر الحقّ مطلقاً. وقد وصف هذه المعاني في أبيات قائلاً:
| ما الدين بالدفّ والمزمار
واللعب لكنّما الدين بالقرآن والأدب ذاك السماع وأدناني من الحجب إلاّ الذي شاهد الأنوار في الكتب([37]) |
ملامة المتظاهرين بالسماع والوجد
كتب ابن عربي رسالة إلى أبي محمد عبد العزيز القرشي (مقيم تونس) ـ وقد نعته بوليّه ـ يصف له فيها أوضاع وأحوال أهل التصوّف وخانقاه (صوامع الدراويش ومشايخ الصوفية) مصر والقاهرة([38]). وممّا جاء فيها قوله: لما وصلنا هذه البلاد أول ما سألنا عنه كان أهل الطريقة والسير والسلوك، فقالوا لنا: إن أهل بلاد المغرب هم أهل حقيقة، لا طريقة، وهم أهل طريقة، لا حقيقة. وكفى من هذا الكلام أنه يحمل من الفساد الكثير؛ إذ لا وصول إلى الحقيقة إلاّ بعد تحصيل الطريقة. وقال أبو سليمان الداراني: إنّما حرموا الوصول بتضييعهم للأصول، فحرموا الطريقة، وشهدوا على أنفسهم بفراغهم من الحقيقة. وهؤلاء هم تلك المجموعة من الصوفيّة الذين أخذوا من التصوّف القشور، فلبسوا الصوف، وتظاهروا بالرياء، وعظمت الدنيا في قلوبهم، فلا يرَوْن دونها مطلباً، وصغر الحقّ في نفوسهم فلا تجد له فيها أثراً، فكان الحلال والحرام عندهم وفق أهوائهم، فكانوا كالأنعام بل هم أضلّ. وقد نظم أبو القاسم الجنيد أبياتاً يذمّ فيها حالهم لما عاينهم، فقال:
| أهل التصوف قد مضوا
صار التصوّف مخرقة صار التصوّف صيحة سنن الطريق الملحقة |
وبعد أن ذكر ابن عربي في رسالته تلك ما لأجله يذمّ المتظاهرين بالتصوّف والعرفان عرج على ذكر أحاديث ومأثورات عن كبار الصحابة ومشايخ الطريقة، وبعد ذلك التفت إلى نفسه ليتبادل معها الحديث والكلام.
وقد نقل ابن عربي قصّة عن سلمان الفارسي، فكتب يقول: في الفترة التي كان فيها سلمان والياً على المدائن ذاع في يومٍ خبرٌ بأن سلمان جالس في المسجد يتلو القرآن، فأتى إليه الناس جماعات جماعات، وكان يقرأ سورة يوسف×، ولم يمكثوا إلاّ قليلاً حتّى تفرقوا، وتركوا المسجد، فتوجَّه إليهم سلمان معاتباً: أكنتم تنتظرون مني أن أقرأ عليكم أبياتاً من الشعر اللهوي؟ ليتوجَّه ابن عربي إلى نفسه بالسؤال ـ على عادته في هذا الكتاب ـ، فقال: فأخلو بنفسي حيث مسكني، فَأَزِنُ المواهب التي أنا عليها بالحال، فلا أجد بينهما نسباً يربط، ولا سبباً يضبط، فخفت والله يا وليي مكر الله بي، واستدراجه إيّاي، فخلوت بنفسي وقد داخلني من ذلك ما لا يعلمه إلاّ الله المتعالي، فقلت لها: يا نفس، وعزة مَنْ جبلك على المخالفة، لماذا حين تكونين في مجلس الحقّ، وتسمعين كلام الله، لا يظهر عليك أي أثر أو تغيير، بينما حين تسمعين شعراً تتأثَّرين، وتبدو عليك ملامح التأثّر فاضحة، فتأخذك نشوة الطرب، ويأخذك الحال، وتقولين بكامل الأسف: أنا والله مدمنة على هذه الحال، وهذه أضعف الحالات التي لديّ، ولا أعرف لماذا حين أستمع إلى القرآن سرعان ما أشعر بالتعب والضجر؟! أيّتها النفس ما بالك غير كلام الله تسمعين وتنصتين، وتدلين بالإعجاب والانبهار، تشاركين، تترنمين، وتطربين، ولا تبدين التعب أو الضجر، لكن عندما تتلين القرآن تستثقلين وتملّين، بفتور ترتّلين، وبالتحدير تقرئين، وهذا حالك كذلك في الذكر وقراءة الأوراد والأدعية؟! فوجدتُها قد انطوت على مكر وخداع.
أتراه هكذا يكون حال المؤمن؟ لا والله، بل كلام الله تعالى للمؤمن ألذّ وأشوق إلى سماعه من الظمآن للماء العذب الزلال. فإنّا لله وإنا إليه راجعون على نقص الإيمان، بل والله على ذهابه. يا شؤم نفسي، ويا حسرتي، كم مرّة والله سمعت آية من كلام الله فثقلت عليّ ومججتها، وتبرّمت منها نفسي، وكم من رنّة شعر سمعتها فاستطربت إليها، واستعذبتها في نفسي. إني والله لأخاف على نفسي أن ينقل اسمي من ديوان المؤمنين إلى ديوان مَنْ قال الحقّ فيهم: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
وابؤساه! حين يقول القوّال زخرف القول أهتزّ، وأقوم، وأقول: هذا والله قولٌ حسن، فلا يزال الشيطان اللعين يُرقصني، حتّى إذا أخذ حاجته منّي صفعني، ليسلّط عليّ النوم والنعاس، فأضطجع، وما إن أنام حتّى ينادي المؤذِّن: أن حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، فأقوم لأصلّي، وأكتفي من الوضوء في أقلّ ما يطلق عليه الوضوء، وأكتفي في الصلاة بقصير السور، من مثل: إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ، ولأنّ القنوت ليس واجباً أتركه، وأنقر الصلاة نقر الديكة للحبّة. فإن حالفني التوفيق خرجت إلى المسجد، فيقول الناس لي: قد صلّى الناس وتمّت الجماعة، فلا أجد في نفسي لذلك حزناً، وأمنّي نفسي فأقول: إن النية أبلغ من العمل، فلنا أجر الجماعة وثوابها، وأنا في قرارة نفسي مستبشرٌ، فقد خلَّصني الله من تطويل الإمام وطول وقوفه في التلاوة والقنوت، أما إنْ وُفقت فأدركت الجماعة فليس لي منها سوى ما أرى الناس يفعلونه، أقوم حين قاموا، وأسجد متى ما سجدوا، وكلّ فكري إما مشغولٌ بما كان منّي طوال الليل من الأنس بالصوت الحسن والنغمة الشجية، أو يكون النوم قد أخذ منّي مأخذه، أو ينشغل قلبي بإمام الجماعة، فأغتابه في نفسي: ما لنا والقراءة بالحشر أو الواقعة؟ ألا تدري أنّ النبيّ الأكرم| قد أوصى الإمام أن يرأف بحال مَنْ يؤمّهم، فلا يطيل القراءة فيؤذيهم. ما أثقله من إمام مبتدع قد خالف السنّة. ويطيب لي الخيال فأغرق فيه، وأقول مع نفسي: لقد كنت البارحة وإلى منتصف الليل مع الله، وفي الله، وقمت لله، في الله شطحت، وإلى الله وصلت. وقد زيّن لي الشيطان سوء عملي، وألبس عليّ حالي، فتخيّلت أنّني محسن العمل، ولم أدرك أنّني من مصاديق قوله تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
ثم ينتقل ابن عربي بعد هذا إلى سرد حكاية عن شيخه، ويصفه بأنه من أهل الكشف والشهود، حيث يروي أن رجلاً من الصالحين فقد نور البصر حضر مجلساً في السماع، وبينما هو جالس إذ دخلت مغنية للمجلس، فقال الأعمى: هذا إبليس قد حلّ ضيفاً على مجلسكم، وأراه يشمّ الجماعة واحداً وحداً، ووصف الأعمى كلّ فرد من تلك الجماعة واحداً واحداً، وما كانوا عليه من اللباس والهيئة، وقال: أرى الملعون ينظر إليكم فرداً فرداً، وأراه قد وقف عند واحد منكم عليه عباءة حمراء، فالتفت الكلّ إلى الرجل، فرأيناه يستجلب الحال، ويظهر الوجد، ليقول الأعمى: أرى أن إبليس ينطحه بقرنه، وقد تغلَّب عليه، فكان أن صاح ذاك الرجل صيحةً، وانقلب حاله، وقام من هوسه إلى الشطحات، وهو ينشد أشعاره، وقام المجلس لقيامه، وغرقوا في شطحاتهم…
وصدق سلمان الفارسي حين قال: «الحق أحقّ أن يتبع». ورحم الله ابن مدين حيث قال: «المريد مريدٌ ما عمل بالقرآن».
فكيف للعارف السالك أن يصل ويعرج إلى ربّه بغير سماع وامتثال كلام الحقّ؟!
الحال المنبعث من سماع القرآن، ومن الشعر
للإنسان حالات مختلفة باختلاف الظروف. ومن جملة تلك الحالات: حالتا الانقباض والانبساط، وبمعنى آخر: حالتا الخوف والرجاء، الوحشة والأنس، الهيبة والأنس، وهلم جرا. فكلما تمكن العارف من هذه الحال أو تلوّن بلونها يستحيل أن يكون ذلك قد حصل بدون موجب وعامل. لهذا ترى أهل التحقيق يتخوّفون من حصول القبض والبسط دون أن يكون السبب معلوماً، ويجدون في ذلك نوعاً من المكر الالهيّ المخفي. من هنا وجب على السالك أن يكون على علم بسبب حصول حالتي القبض والبسط له، فإذا تبين له أن السبب كان آية من آيات القرآن فحاله صحيح وموافق للقرآن؛ وذلك لأن النفس لا تستطيع تحمّل القرآن؛ لأن القرآن يحوي كلّ الحقائق، ونفس الإنسان إحدى تلك الحقائق، لهذا فهو إنما يدرك جزءاً من القرآن، وليس كلّه. وكذلك فإنّ النفس محلّ نفوذ الشيطان وتلبيساته؛ لأنها أخذت على عاتقها أن تحمل القرآن وتحميه. لذا فالشيطان يعمل جاهداً ليحول بينها وبين سماعه، وأن تصل إلى الحال من سماعه، والحال إنما هو في العقل، والعقل في الروح، وليس في النفس. والروح من هذا الموقع هي التي تملك وتتملك، والتملك يكون لصاحب العلم، والفراسة، والإلهام، والآخرة، والذكر، والحق، واليقين.
ويضيف شيخ العرفاء ابن عربي قائلاً: أما إن اتّضح له أن مرجع حاله الشعر والسماع، والتصفيق، والألحان والنغمات، فإن حاله إنما كان من هوى نفسه. والنفس منشأ الهوى، كما أنها محلّ تلبيسات إبليس وشيطنة الشياطين. والشعر كذلك يكون من الشيطان إلاّ ما استثني منه، بأن كان ناصراً للحقّ أو نابعاً ومستلهماً من كلام الحقّ، فحُمد ووصف بالحسن، وكان مرغوباً. والشيطان من النفس كما الروح من النفس، فحيث إن الروح ملك على النفس، فالشيطان يتملك النفس، مع فارق يكمن في أن الروح مالك أمين، وصاحبة أوصاف في الكمال والخير، لكنّ الشيطان على طرف النقيض، صاحب أوصاف فاقت كلّ حدٍّ في الخبث والشر، فهو صاحب الجهل، والوساوس، والدنيا، والغفلة، والباطل، والشكّ، والمصائب، والتشبيه، والشرك.
وكلّما كان الحال منبعثاً من القرآن كلما كان سماعه يزيد صاحب الحال علوّاً وشرفاً، وتوافق حاله وحال القرآن، والسامع له المدرك لحقائق معانيه لا ينحرف عن الصراط المستقيم، حتّى في خياله تجده لا ينجذب إلى عشق غير الله، ولا تزداد الدنيا عنده إلاّ صغراً.
أما إذا كان مبعث حاله الشعر والسماع فتجده يتلبَّس بأوصافها في الانحطاط والسوقيّة. ففي حين يكون الحال المنبعث من القرآن مردّه الكلام المقدّس والمنزّه عن كلّ باطل ونقص، يكون ـ وعلى العكس من ذلك ـ الحال المنبعث من الشعر ـ وهو من كلام مخلوق ـ مميَّزاً بالنقص والانحراف والباطل، ولا يكون منه الطاهر إلاّ في النزر اليسير، فتكون طهارة الشعر ناقصة ومشوبة بالباطل، وكذلك يكون الحال المتأتّي منها بالتَّبَع مشوباً بالباطل والخبث…
وهذا كلامي ـ يقول ابن عربي ـ إنّما أوجّهه إلى العرفاء والسالكين، أما المدَّعين من المريدين، والذين حالهم في درجة أقلّ وأضعف، فليس لي كلام معهم. وهذا هو السبب الذي حدا بأبي يزيد البسطامي لأن يقول في سماع العرفاء: هؤلاء أصحاب الكدّ والتسوّل، وأنا أستعيذ بالله منهم، وما طيّهم للأرض ومشيهم على الماء أو طيرانهم في الهواء إلاّ للتوسّل والشحاذة.
وفي خصوص المريدين يقول: إذا وجدت المريد يتمايل عند السماع فاعلم أن جزءاً من الباطل لا زال يخالطه.
وأخيراً يقول ابن العربي: كما سبق أن أوضحنا: السماع بالنسبة للعرفاء كدّ، وهذا ما نقلناه عن المتقدّمين من العرفاء، حتّى لا تؤخذ علينا صغيرة، ونتّهم بتبعيّة وتقليد المتأخِّرين في ذكر ما يلحقه السماع من نقص في السير والسلوك والوصول إلى المقامات.
وقد صرح الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي، في مواضع متفرقة ضمن رسائله، بقوله: وفق نظرنا مطلق السماع ليس حراماً، بل هو مباحٌ، وكذلك الشعر والغناء ـ المقيّد بما قيّده به الشرع المقدّس ـ مباحٌ. وقد عرضنا بشكلٍ مفصّلٍ ومجمل تفاوت السماع باختلاف مراتب ومقامات الأفراد والمستمعين، الذين يختلف حالهم بين هذا وذاك.
الهوامش:
______________________
(*) أستاذ جامعي متخصِّص في الفلسفة الإسلامية، وخريج الجامعة الإسلامية في لندن، ناشط في مجال تحقيق التراث.
([1]) مصعب كان يتغنّى بالقرآن، لدرجة أبهرت العديد من أهالي المدينة. وكان هذا دافعاً لإعلان إسلامهم.
([2]) رسائل إخوان الصفا، رسالة الموسيقى؛ ابن أبي جمهور الأحسائي، مسلك الأفهام: 244، الطبعة الحجرية، 1329؛ نايب الصدر، بستان السياحة: 508.
([3]) انظر: عبد الرحمن البدوي، ابن العربي: حياته ومذهبه، مصر، 1965م.
([4]) انظر: ابن العربي: حياته ومذهبه.
([5]) الشاطبي، الاعتصام 1: 357، مصر، 1913م.
([6]) انظر: محمد هادي معرفة، دور اللحن في تلاوة القرآن، مجلّة كيهان أنديشه، العدد 28: 60.
([7]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 12: 85؛ المجلسي، بحار الأنوار 79: 128.
([8]) الفيض الكاشاني، الوافي 3: 33؛ الترمذي، المنهيّات 2: 578.
([10]) الحميري، قرب الإسناد: 159.
([11]) هجويري، كشف المحجوب؛ السهروردي، عوارف المعارف؛ ابن العربي، الفتوحات المكّية؛ رسالة القشيري؛ وكتب أخرى في مبحث السماع.
([12]) طه عبد الباقي وسرور النعيم، محيي الدين ابن العربي: 129.
([13]) الفتوحات المكية 4: 87، الباب 456، طبعة بولاق.
([14]) شمس المغرب، كليات المغربي: 77، الطبعة الأدبية.
([15]) الفتوحات المكية: 87، الباب 456.
([16]) فضل الإدريسي، فصوص الحكم (شرح القيصري): 69.
([17]) الفتوحات المكية 1: 272، باب 50.
([19]) المصدر السابق 2: 368، الباب 183.
([20]) المصدر السابق 1: 211، الباب 33.
([21]) المصدر السابق، الباب 541؛ حضرة الجمال 4: 269 ـ 271.
([22]) ابن العربي، كتاب التراجم: 40، باب ترجمة السبب، طبعة حيدر أباد كن، 1367هـ.
([23]) الفتوحات المكية 2: 707، الباب 236.
([25]) رسائل ابن العربي، رسالة لا يعوّل عليه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
([26]) الفتوحات المكية: 705، الباب 235.
([28]) المصدر السابق: 708 ـ 709، الباب 237.
([29]) رسالة القشيري: 600، تصحيح: بديع الزمان فروزانفر، انتشارات علمي فرهنكي، 1361.
([30]) المصدر نفسه؛ هجويري، كشف المحجوب: 510، أوفست طهران، 1336.
([31]) كشف المحجوب، باب السماع.
([32]) ابن العربي، التدبيرات الإلهية: 227 ـ 233، طبعة ليدن، 1331.
([33]) ابن العربي، التجليات الإلهية: 225 ـ 227.
([34]) الفتوحات المكية، الباب 183.
([35]) المصدر نفسه؛ حضرة السمع 4: 297.
([36]) ابن العربي، تهذيب الأخلاق: 163، المطبعة العلمية، مصر، 1328.
([37]) الفتوحات المكية 4: 269 ـ 271، الباب 541.
([38]) محيي الدين ابن العربي، رسالة روح القدس في محاسبة النفس: 5 ـ 25 (بتلخيص)، مؤسسة القلم للطباعة والنشر، دمشق، 1384هـ.





