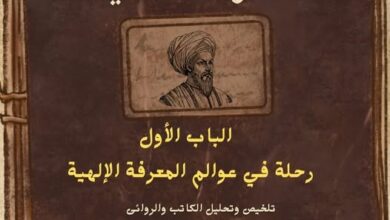بشريَّة النبيّ بين الأسطورة والضرورة
من التصورات الأساسية التي ينبغي مراجعتها في سبيل صياغة فكر ديني يُسهم في بناء معارفنا وتطور مجتمعاتنا هو التصور المتداول حول بشرية النبي، والذي امتزج بتصورات أسطورية نتيجة تأثر المجتمعات الإسلامية بالمعتقدات السابقة، واختلاطهم وتفاعلهم اليومي مع أتباع المعتقدات الأخرى؛ حيث كان الاعتقاد بقدرة فئات مخصوصة من البشر على اجتراح المعجزات وتجاوز الضرورات البشرية سمةً عامة في ثقافة تلك المجتمعات.
وخلافاً لهذه النظرة الأسطورية، يؤكد القرآن بشرية النبي في كثير من آياته؛ كما في قوله: “قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ” (الكهف: 110)، فالأصل في أفعال النبي وسلوكه أنها تصدر عن بشر، والاستثناء يتمثل بالمعرفة الموحاة من الله. ومن المعاني البليغة التي تشير إليها الآية في قوله “مِّثْلُكُمْ” هي التأكيد على وحدة التكوين البشري بين البشر، وخضوعهم جميعاً للضرورات والاحتياجات البشرية، مهما كانت معارفهم وتصوراتهم.
وانتقد القرآن النظرة الأسطورية تجاه شخصية النبي، والتي تخرجه عن طبيعته البشرية، كما في قوله تعالى: (وقَالُوا لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأَرضِ يَنبُوعاً * أَو تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلَالَهَا تَفجِيراً * أَو تُسقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمتَ عَلَينَا كِسَفاً أَو تَأتِيَ بِاللَّهِ والـمَلَائِكَةِ قَبِيلاً * أَو يَكُونَ لَكَ بَيتٌ مِن زُخرُفٍ أَو تَرقَى فِي السَّمَاءِ ولَن نُؤمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَينَا كِتَاباً نَقرَؤُهُ قُل سُبحَانَ رَبِّي هَل كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً)، (الإسراء: 90-93).
ويلفت القرآن أنظارنا إلى أن الرافضين لرسالة الأنبياء كانوا يعللون رفضهم بكون الأنبياء من البشر، فالبشر وفق تلك النظرة الأسطورية غير جديرين بتلقي المعرفة الإلهية؛ لكونهم كائنات ناقصة وملوثة بالخطايا والآثام.. كما في قولهم: (مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثلُكُم يَأكُلُ مِمَّا تَأكُلُونَ مِنهُ ويَشرَبُ مِمَّا تَشرَبُونَ. ولَئِن أَطَعتُم بَشَراً مِثلَكُم إِنَّكُم إِذاً لَّخَاسِرُونَ)، (المؤمنون: 33-34).
وفي آية محكمة تضع الأسس لنظرة واقعية للإيمان، يُقدم القرآن نقداً عقلياً لمقولة الفصل بين النبي وبشريته وشيوع التصورات الأسطورية “للنبي الملاك”، في قوله: (قُل لَو كَانَ فِي الأَرضِ مَلاَئِكَةٌ يَمشُونَ مُطمَئِنِّينَ لَنَزَّلنَا عَلَيهِم مِن السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً)، (الإسراء: 95). فنجاح الرسول في مهمّته يقتضي أن يكون من جنس المرسل إليهم؛ حتى يستشعر ذات المشكلات والهموم التي يعيشها الناس، ويكون ذلك أدعى لتحقيق مصلحة البشر. كذلك فإن بشرية النبي تؤكد حرية الإيمان والاعتقاد، ولا تقوض سنن التكوين والاجتماع البشري.
وصف القرآن الأنبياء بأوصاف تؤكد بشريتهم وضعفهم، كما هو الحال في وصف آدم بأنه نسي ولم يكن له عزماً: “وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً” (طه: 115)، ووصف عمل نوح عندما غلبته مشاعره الأبوية وطلب من ابنه الركوب في السفينة معه: “يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ” (هود: 46)، وقال في حق يوسف: “وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ” (يوسف: 24)، وقال عن موسى بعد أن وكز المصري فقتله: “قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ” (القصص: 16)، وقال في يونس عندما ذهب مغاضباً: “وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ” (الأنبياء: 87)، وقال معاتباً النبي محمد في قصة زواج زيد: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (الأحزاب: 37).
وكان حَرِيَّاً بهذه النظرة القرآنية الواقعية لبشرية الأنبياء أن تكون منطلقاً لمراجعة نقدية عميقة للمرويات التي تُضفي على شخصية الأنبياء صبغة أسطورية عجائبية تُخرجهم عن مقتضى بشريتهم؛ كما هو الحال مع مرويات: “إن الله عز وجل قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام”. (النسائي)، ورواية: (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً) (البخاري)، ورواية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: “أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منكن ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه” (مسلم).
فنسبة هكذا خوارق للأنبياء تحت مسمى الإيمان وعظمة القدرة الإلهية قد مهّد الطريق أمام مزيد من المعتقدات الأسطورية التي تُخرج الأنبياء عن مقتضى بشريتهم. وأشير هنا إلى أن هذه المشكلة كانت تُعبر عن نمط معرفي سائد للعقل القروسطي، الذي رأى في الخوارق والمعجزات شرطاً لقبول المعتقدات، وحتى كبار المتكلمين واللاهوتيين في الشرق والغرب لم يستطيعوا الانفكاك من قيد ذلك النمط، كما هو حال اللاهوتي المعروف توما الأكويني، الذي برّر عدم اعترافه بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بعدم ورود معجزات له، وقد خفي عنه أن القرآن هو المعجزة الكبرى على صدق نبوته والتي لا حاجة معها لمعجزة أخرى.
يؤكد النبي بشريته وما يعتريه من ضعف في كثير من الأحاديث، كما في قوله: (إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون) (مسلم)؛ وقوله: “إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النار” (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ). وقوله عندما مرّ بقوم يلقحون النخل، فقال: (لو لم تفعلوا لصلح)، قال: فخرج شيصاً فمر بهم، فقال: (ما لنخلكم؟)، قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) (مسلم). وقول حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: “خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةِ بَدْرٍ فَعَسْكَرَ خَلْفَ الْمَاءِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبِوَحْيٍ فَعَلْتَ أَوْ بِرَأْيٍ؟ قَالَ: بِرَأْيٍ يَا حُبَابُ، قُلْتُ: فَإِنَّ الرَّأْيَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَاءَ خَلْفَكَ، فَإِنْ لَجَأْتَ، لَجَأْتَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنِّي”. (رواه الحاكم).
وهنا يجب تحري مفهوم العِصمة ومراجعته، والذي يختلف في معناه القرآني عن المقولات العقدية الرائجة في الثقافة الدينية. فالعصمة في حق الأنبياء تتوقف على تيسير أسباب التبليغ وأداء الرسالة، وليست إلغاء بشرية النبي وتحويله إلى أداة أو قناة لا إرادة لها ولا اختيار.
ومن أكثر المفاهيم التي أسهمت في التباس بشرية الأنبياء مفهوم السُّنة، الذي صعب التمييز فيه بين التصرفات النبوية الموحى بها والتصرفات البشرية الاجتهادية. فلم يكن التمييز بين هذه التصرفات واضحاً عند كثير من الناس، وقد اجتهد بعض الفقهاء في تقسيم هذه التصرفات النبوية، حتى بلغت عند ابن عاشور في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية” اثني عشر حالاً؛ وهي: التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهدي، والصلح، والإشارة، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرد عن الإرشاد.
فالأصل في تصرفات النبي أن تكون بمقتضى بشريته، والاستثناء هو في حال التبليغ الذي يحتاج إلى قرائن تدل عليه. وخاصّة إذا أخذنا بالاعتبار أن تبليغ خاتم الأنبياء ينصبّ في الأساس على القرآن، الذي كان نزوله مفرقاً وفق ضرورات المجتمع واحتياجاته، الأمر الذي يحفظ للعقل حريته واجتهاده، ويفتح أمام البشر أفقاً واسعاً ليكتشفوا قدراتهم العقلية، وينطلقوا بعيداً عن سلطات معرفية أعاقت تقدمهم وارتهنت مصيرهم.
____________________
*المصدر: “حوار الثقافات”.