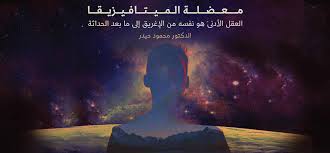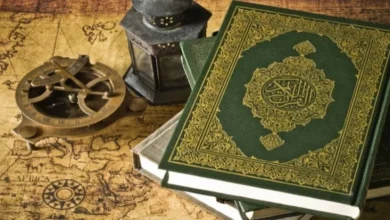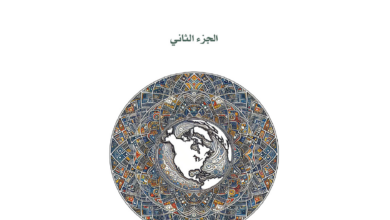العقلُ بوصفه إسمًا لِفِعل..
العقلُ بوصفه إسمًا لِفِعل..[1]
د. محمود حيدر
الذين يحسبون الرُّجوع إلى استقراء مبادئ العقل، والاستفهام عن طرق عملها، ضربًا من تمرين لا طائل منه، ظنُّوا أنَّهم “عقلوا العقل”، وبلغوا خواتيمه العظمى. لم يجد هؤلاء حَرَجًا من الجهر بلا جدوى تعريف العقل ما دام سبق للأسلاف أن عرَّفوه، وصار أمرُه بديهيًّا. ولأنَّ صِبغة الفكر البشريِّ مفطورةٌ على الاستفهام، ومسكونةٌ بالجدال، فلا يحدُّها سؤال، ولا تستكين على حال، فقد جاوزت الحدود التي صنَّعتها لها الفلسفة الأولى. وسيتَّفق لنا أن نرى كيف واصَلَ القولُ الفلسفيُّ ملحمةَ التعريف، حتى تشابهت عليه مفاتِحُ الأفهام، وهالَه من بعد ذلك أن وجد العقلَ قد أشكل عليه العقل، وأنَّ مزيَّة العقل الكبرى في استشكالِهِ على نفسه.
ولأنَّ فضاء التعقُّل أوسع ممَّا في الحسبان، فإنَّه بفضل سَعَتِهِ، يستطيع أن يحيط بالأشياء الواقعة تحت دائرة نظره، فضلًا عن قدرته على تعقُّلِ ذاته بالفحص والنقد. وإذ يفعل العقلُ ما يفعله – نقدًا وفحصًا.. أو تقويضًا، فإنَّه يستطيع احتواء التناقضات وتوحيد الأضداد من دون أن يقع في شبهةٍ منطقيَّة، أو أن يتخلَّل عملَه أيُّ تناقض. فالعقل جوهرٌ درَّاكٌ يحيط بالأشياء من جميع جهاتها، ويدركها حتى من قبل أن تجد لها حيِّزًا في الواقع. بل هو في ماهيَّته الوجوديَّة، علَّةٌ أولى تُعرفُ بها الموجودات كلُّها، وهذه العلَّة ليست كينونة مفصولة عن معلولها، بل مُحتواة فيه، وبوساطته يظهرُ اسمُها لينال شرف الفعليَّة.
* * *
لا يُعرف العقلُ إلَّا كفعلٍ متحقِّق في حيِّزٍ ما. أي حين يصبح فعلَ تعقُّلٍ لشيء متعيِّن في الواقع. يفيد هذا القول، أن لا تعريف للعقل كمفهوم معزول عن معقولاته. ولا يُدرَك اسمه ومعناه إلَّا لكونه فعل إدراكٍ ونظرٍ واعتناءٍ بمعقول ما؛ سواء كان هذا المعقول واقعًا أعيانيًّا أم وجودًا ذهنيًّا، أو كان هو العقلُ إيَّاه حين يكون هو نفسه موضوع التعقُّل. فإذا كانت فعليَّة العقل هي الإمساك بالشيء على ما هو عليه في الواقع، صار الممسكُ بالشيء اسمًا للفعل الذي نسمّيه عقلًا. لا يتوقَّف الأمر على هذا الحدِّ، فلإسم الفاعل أفعالٌ وصفاتٌ مشرَّعة على السرَيَان والتمدُّد. فالعقل من حيث هو فعل، هو فاعلٌ استكشافيٌّ يختزن قدراتٍ لا حدَّ لها في تعقُّل الأشياء. لهذا الداعي، لا وجود لجهة في ذاته لا تتعقَّل أو تستكشف. جميعُ أنشطته وفعاليَّاته في التفكير والاستدلال، وفي تدبير الأحوال التي يتولَّاها ما سمِّي “العقل العمليّ”، إنَّما هي تعبير عن هذه الخاصِّيَّة الفريدة. فالإدراك والاستدلال والكشف والاستخراج هي عوامل تعكس الفاعليَّة الاستكشافيَّة في كلِّ مرتبة من مراتبه. وبتعقُّله للشيء الذي ينبسط أمام كشَّافه يكتسب العقل ماهيَّة هذا الشيء، ويتمثَّلُها قصْدَ إدراكها على ما تمامها. يعني هذا، أنَّ عناية العقل بالأشياء هي إعرابٌ عن فعليَّته التي بها اكتسب اسمهُ ورسمَهُ وهوّيَّتَه. بل قد يُجوَّز القول أنَّ الفعليَّة المنتجة للاسم تعكس شيئيَّة العقل في امتداده مع الأشياء، كما تترجم تجاوزه لها، عندما ينتقل بها إلى طور أعلى من أجل التعرُّف على حقيقتها.
على هذه الوضعيَّة لن تكون معرفة الإنسان وصفًا للواقع الخارجيِّ، بل نتاجًا، وإلى درجة حاسمة، لأداة الذات العارفة أي العقل المتعرِّف نفسه. فالقوانين الحاكمة على العمليَّات الطبيعيَّة هي نتاج تنظيم الراصد الداخليِّ متفاعلًا مع أحداث خارجيَّة غير قابلة، بحدِّ ذاتها، لأن تُعرف بالمطلق. وإذن، فلا التجريبيَّة المحضة، ولا العقلانيَّة الخالصة مؤهلّتين لتشكيل استراتيجيَّة معرفيَّة قابلة للحياة. لهذا السبب تعرَّضت مهمَّة الفيلسوف لاهتزازات جوهريَّة، حيث لم يعد قادرًا على تحديد تصوُّر ميتافيزيقيٍّ للعالم بالمعنى التقليديِّ، بل بات ملزمًا بالمبادرة إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل رغم عجزه عن الحسم قبليًّا في قضايا متعالية على التجربة، قادرٌ على تحديد جملة العوامل المعرفيَّة الجوهريَّة بالنسبة إلى التجربة البشريَّة، وهو قادر كذلك، على إغناء التجربة كلِّها بنظامه. لذا باتت مهمَّة الفلسفة الحقيقيَّة متمثِّلة، إذًا، بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل وطريقة عمله، لأنَّه المكان الوحيد الذي يمكن الاهتداء ـ به ومنه ـ إلى الجذر والأساس الحقيقيَّين لمعرفةٍ يقينيَّةٍ بالعالم.
I
واحديَّة الشاهد والمشهود
يحيل ما مرَّ من قبل، إلى فكرة الواحديَّة الجامعة بين الشيء وعاقل هذا الشيء. ومع نُجوزِ هذه الواحديَّة تكون قد تعيَّنت الخاصّيَّة الجوهريَّة للعقل التي تُمكِّنهُ من الإدراك الصائب. هكذا سيُنظر إلى نظريَّة اتِّحاد العقل والعاقل والمعقول كإحدى أهمِّ نظريَّات علم الوجود. فهذه الأخيرة، إلى جانب نظريَّة “أنَّ العقل الفعَّال هو كلُّ الموجودات”، استحوذتا مكانة استثنائيَّة في الأنطولوجيا الإسلاميَّة، وتعتبران من غوامض علم الإلهيَّات. إلَّا أنَّ هاتين النظريَّتين سوف تعزِّزان معًا، ما سنذهب إلى التعبير عنه بـ “واحديَّة الشاهد والمشهود”. بيان الأمر، أنَّ تحقُّق هذه الواحديَّة يتمُّ حين يحضر المعقول أمام شاهد العقل. ففي هذه الحضرة تنعقد وحدةٌ لا انفصام لها بين الشاهد ومشهوده. بل إنَّ المشهود في تبدِّياته وظهورِهِ ينالُ من شهود العقل قدَر تبدِّيه وحضوره. ولنا أن نتبيَّن كيف يستطيع العقل في طوره الابتدائيِّ معرفة ما يظهر من الشيء استنادًا إلى المبادئ والقوانين الطبيعيَّة الحاكمة على الأشياء. أمَّا ماهيَّة الشيء نفسه – التي حارت الوضعانيَّة بشأنها – فلن تستعصي على الإدراك لو أنَّ العقل جاوز دنيا المقولات، وحاذر كهف المفاهيم، وأعرض عن ما يحجبه عن فهم الأشياء في ذواتها. ولئن مضَينا زيادة في الاستفهام، قد نعرف من بعد مكابدةٍ، كيف يستطيع العقل في نشاطه الفيزيائيِّ أن يحيط علمًا بالظواهر، مثلما يتَّضح لنا قصوره وعجزه في التعرُّف على ما لم يظهر منها. مردُّ ذلك، أنَّ ما لم يقدر العاقلُ على تعقُّله، له صلة تكوينيَّة بماهيَّة القوَّة الإدراكيَّة التي بوساطتها تُعقلُ الموجودات. وهذه القوَّة الإدراكيَّة التي نسمّيها العقل، تتحوَّل من فورها إلى حقلٍ تأويليٍّ فسيح. الأمر الذي يجعل العقلَ كفاعلٍ إدراكيٍّ يُشكِلُ على نفسه إلى الحدِّ الذي يشقُّ عليه فهم ذاته المدركة كجوهر غير مستقلٍّ عن ذاته. ولئن كان الإنسان لا يعرف الواقع الموضوعيَّ بدقَّة إلَّا بمقدار ما يكون ذلك الواقع منسجمًا مع بُنى عقله الأساسيَّة، فذلك لأنَّ العالم الذي يتناوله العلم متوافقٌ مع المبادئ المكوَّنة للعقل. فالعالم الوحيد المتاح لمدركات العقل منظَّمٌ سلفًا وفقًا لعمليَّاته الإدراكيَّة الخاصَّة. وما من معرفةٍ إنسانيَّة للعالم إلَّا وتكون متأتِّية عن طريق مقولات العقل البشريّ. كما أنَّ حتميَّة المعرفة العلميَّة ويقينيَّتها مستمدَّتان من العقل، ومتجذِّرتان في إدراكه وفهمه للعالم. ثمَّة من يمضي إلى القول أنَّ العقل في المعرفة الإنسانيَّة لا يتطابق مع الأشياء؛ بل الصواب أنَّ الأخيرة تتطابق مع العقل. لكن المطابقة بين الهندسة التكوينيَّة للعقل والهندسة التكوينيَّة للعالم لا تتوقَّف عند قدرة العقل على الإحاطة العلميَّة بالقوانين الحاكمة على حركة العالم، وإنَّما تشتمل أيضًا على العلم بالكيفيَّة التي يُدار فيها العالم الطبيعيّ. فمنطق المطابقة بين الخارطة التكوينيَّة للعقل وهندسة العالم لا يقبل الفصل بين ما يظهر من الموجودات وما يستتر منها؛ ذلك لأنَّ التطابق هنا متعلِّقٌ بالماهيَّة التكوينيَّة لكل من العقل والعالم معًا. ولقد أعربت “الحكمة المتعالية” عن هذين التناغم والمطابقة، لمَّا رأت إلى العقل باعتباره نفسًا مدرِكةً تستطيع إدراك العالم إلى الحدِّ الذي تصبح فيه نظيرًا لهذا العالم. ففي هذه الحال تصيرُ النفسُ عند تعقُّل الأشياء على ما هي عليه، عالَمًا عقليًّا مضاهيًّا للعالَم العينيّ. من بعد ذلك، تصير صحيفة النفس [العاقلة] كتابًا تامًّا تُطالَعُ فيه صور الأشياء مجرَّدُها ومادّيُّها، وصولًا إلى بلوغها العلم بالله وصفاته وآثاره، والعلم بكيفيَّة رجوع الأشياء إليه. [المظاهر الإلهيَّة – ص 254].
سوف يكون علينا أن نستنتج من نظر ملّا صدرا إلى النفس كجهاز إدراكيٍّ لا متناهي الامتداد والسِّعة، أنَّه أراد بها عقلًا مُفارقًا للذي شاع لدى الإغريق ومن تبعَهُم من المذاهب الفلسفيَّة الَّلاحقة. تبيينًا لهذا المستنتج، وَجَدنا أن للعقل العاقلِ للأشياء قوى خلاَّقة فوق وضعانيَّة من قبيل الحدس والنفس والروح. وهي تجلّيات الإدراك المتحقِّق في الواقع من خلال العلم بالوجود علمًا حضوريًّا لا يحتاج لإثباته وساطة المفاهيم. مع هذه التجلّيات يغدو العقل بما هو إسم للفعل، فصلًا للعلم والمعرفة والاكتشاف والكشف. فهو الذي ينظِّم الأفعال وردود الأفعال، ويستخرج من جوفها النتائج. وإلى كونه مركَّبًا من الفهم والنَّباهة والقدرة على المجاوزة، فضلًا عن التفكير والاستدلال والاستنباط، فإنَّه يشتمل على الإحساس أيضًا. والإحساس العقليُّ يعني شعور العقل بشكل عَقلانيٍّ حيال كلِّ ما يتحسَّسُه أو يستشعره من باديات الظواهر وخفاءاتها. ومع أنَّ الفلسفة الحديثة – ولا سيما الوضعانيَّة منها – لا تعتقد بوجود حاسَّة للعقل، وأن ليس بإمكان العقل الوصول إلى الواقع، تقرّر الحكمة الدينيَّة أنَّ للحسِّ العقليِّ – أو لشهود العقل على مشهوداته – حضورًا أصيلًا في البنية المكوِّنة لماهيَّة العقل. ينبري بعضهم إلى الافتراض بأنَّ الإحساس العقليَّ هو الوعي نفسه في مرتبة عليا من مراتبه. فإذا افترضنا وعيًا أعلى يكون سيدًا للعالم، سيكون من البيِّن أنَّ هذا الوعي هو أمرٌ حقيقيٌّ لأنَّه واقعيٌّ وممكنٌ في مقام كونه عنوانًا للمعرفة الفائقة والهادي إلى غايتها. ففي منزلة كونه عقلًا إحساسيًّا، يصير قادرًا على وعي واستيعاب الأشياء كافَّة. والقائلون بهذا الافتراض يرون أنَّ الوعي الأعلى لا يكتفي باستيعاب صور الأشياء التي يخلقها بوصفها تعبيرًا عنه وحسب، بل يضعها أمامه دائمًا، وفي داخل كيانه الخاصّ، ثمَّ ينشئ معها علاقة خاصَّة عن طريق ما يسمُّونه “الوعي المستوعِب”. وبما أنَّ صور الاِشياء تُرفع أمام “وعيٍ مستوعب” وداخل كيان وعيٍ مشتمل، سيكون العقل الأعلى والحاسَّة العليا مختلفين تمامًا عن عقلنا وأشكال إحساسنا، بل سيكونان وسيلتَيْ معرفة واحتواء كاملين لا وسيلتَيْ جهل ومحدوديَّة.
II
مسلَّمات العقل ومعضلة الفهم
مبتدأ اختبار المسلَّمات العقليَّة، جرت كما هو بيِّنٌ، مجرى معرفة التعرُّف على الكون؛ والعلم بالمبدأ الذي منه ظهرت الموجودات. تعود معضلة الإدراك إذن، إلى الَّلحظة التي انعقدت فيها صِلاتُ الوصل بين العقل والسؤال عن مبدأ الوجود ومآلاته. لكن هذه المعضلة التي ركنت إلى علوم الطبيعة وقوانينها سوف تتحوَّل إلى مبادئ ناظمة للعقل الحديث، وحاكمة على وعيِهِ ومنطق تفكيره. حتى لقد بدا كأنَّ ثمَّة خطْبًا جللًا يدعو العقل إلى الوقوف على خللٍ جوهريٍّ في تكوينه. في مرتبته الوضعانيَّة يحسب هذا العقل أنَّه يستطيع بوساطة العلم أن يحيط بكلِّ شيء. وقد ظهر حينئذٍ، كما لو أنَّه يثلم نفسه بملء مشيئته، من أجل أن يأنس بأمان إلى دنيا الممكنات وسحر ألوانها المبهرة. ربَّما لم يكن يدري أنَّه بفعلته تلك، سوف يدفع نفسَه دفعًا إلى كهف العزلة. ولمَّا حسِبَ أنَّه أفلح بالميثاق الأعظم الذي سيتيح له فكَّ لغز الوجود من خلال ثورته العلميَّة، وقع في تيه الأنانيَّة وجنونها. لقد أخذته العِزَّة بـ “أناه” حتى ظنَّ أنَّه الكائن الفائق الذكاء، الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلَّا وقف على سرِّها.. أو أنَّه الجوهر الفريد المكتفي بذاته، وليس له بعدئذٍ من حاجة إلى من يسدُّ نقصه متى استشعر النقص، ولا إلى من يمدُّه بالاغتناء متى استشعر الفقر…
لا يعني الذي مرَّ الكلام في شأنه، إنقاصًا من جلال العقل وجمال ما يختزنه من الحكمة ومحاسن التدبير.. فالمقصود على وجه التحقيق، هو الكيفيَّة التي استُعمِل فيها العقل – بما هو عقل أدنى – لإعمار الحضارة الحديثة.. أمَّا العقل في أصل نشأته وعلَّةِ وجوده، فهو أولُ الموجودات وأشرفُها. وهو الشيء المفارق الذي ينفرد به الكائن الآدميُّ عن سائر الكائنات. بل إنَّه السرُّ الذي لا ينفكُّ مصدر حيَرة الإنسانيَّة منذ بداية وعيه في تعقُّل الأشياء من حوله. لكنَّ الإشكال هو بالتحديد ما أنشأه العقل الوضعانيُّ من تأسيسات دنيويَّة لعلم الوجود ابتدأت مع الإغريق، ثمَّ لتشكِّل الفلسفة الحديثة تتويجًا صارخًا لها. مع المنعطف الأرسطيِّ واستحواذه على نظام التفكير البشريِّ، بلغت الحضارة المعاصرة نقطة النهاية في “ماراثون العقل المنفصل” الذي افتتحه الإغريق، وتابعته الحداثة بأطوارها المختلفة. وللذكرى، فإنَّ الأرسطيَّة لم تكن كما هي في مشهدها وشهودها سوى تراثٍ مبنيٍّ على المنطق، والتجريبيَّة، والعلوم الطبيعيَّة. والمدرسة التي أسَّسها أرسطو وأدار فيها مناقشاته، عكست هذه التراث فكانت مركزًا للبحوث العلميَّة وتجميع البيِّنات أكثر منها مدرسة فلسفيَّة شبه دينيَّة، كأكاديميَّة أفلاطون. ومع أنَّ الأخير كان يُعدُّ عمومًا في العصور القديمة المعلِّم الأكبر، فإنَّ ذلك الحكم كان سيتعرَّض لاختلال دراميٍّ مثيرٍ في أوج العصور الوسطى، وبدا أنَّ مزاج أرسطو الفلسفيَّ هو الذي سيحدِّد التوجُّه السائد للعقل الغربيّ. فنظامه الموسوعيُّ في الفكر كان بالغ الأهميَّة إلى درجة أنَّ جلَّ النشاط العلميِّ في الغرب، حتى القرن السابع عشر، أخذ بمضامين كتاباته العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد، بل كان من شأن العلم الحديث، حتى حين راح يتجاوزه، أن يواصل توجُّهه ويستخدم أدواته النظريَّة.
من أظهر الجنايات التي اقترفها العقل الحديث، اختراعُه لمذهبٍ حمَّله اسمه ليكون وليًّا على حياة الإنسانيَّة ومرشدًا لها.. يُقصد بذلك المذهب العقلانيِّ الذي زعم مناصروه امتلاكهم حُزمةً كاملةً من الإجابات الكبرى، على حُزمةٍ كاملةٍ من الأسئلة الكبرى. من السؤال لماذا كان الوجود وليس العدم، إلى الاستفهام عن الكيفيَّات المناسبة لإدارة المجتمع والدولة وحركة التاريخ… وعليه، فقد عُدَّت النزعة العقلانيَّة وفق الصورة التي ظهرت بها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب، نسَقًا ميتافيزيقيًّا ناجزًا.. بل إنَّها عوملت في أكثر المواضع والأحيان، كبديل من الدين… من مفارقات العقلانيَّة أنَّها تعاملت مع العلم كموضوع من مواضيع نشاطها الفكريّ. وضمن هذا المنحى تمَّ الاستيلاء على مقاليد الثورة العلميَّة وتوظيفها لخدمة أيديولوجيَّتها الحاكمة على حضارة الحداثة برُمَّتها.
لقد ظهرت الوضعانيَّة كفجوة تتوسَّع يومًا إثر يوم في بنية العقل الغربيّ. لعلَّ أشدَّها وقعًا دفع العقل إلى مواجهة الإيمان، والتقنيَّة إلى مواجهة البعد الروحيِّ للإنسان. والحاصل، وقوع العقل الحديث في أحاديَّة جائرة أفقدته إمكانات هائلة كانت ضروريَّة لتجديد نفسه وتصويب المجال الحضاريِّ الذي يتسيَّد عليه. أمّا السبب فيعود إلى شغف العقل الحداثيِّ بعقلانيَّة العلم المحض ومنجزاته. وقد دلَّت الاختبارات التاريخيَّة أنَّ الغلوَّ بالعقلنة الحادَّة حين يصل إلى حدِّه الأقصى يُحدثُ مسارًا ارتداديًّا على العقل نفسه، بحيث تظهر علاماته باضطراب السلوك وعدم القدرة على ضبط حركة التقدُّم في الميادين الحضاريَّة كافَّة. من المنطقيِّ القول بإزاء فجوة التناقض بين التقدُّم العلميِّ والإيمان الدينيِّ، أنَّ الأشياء والظواهر لا تتضادّ أو تتصارع إلَّا بين أجناسها. ولكنَّ العقل التقنيَّ لم يدرك – وبسبب من استغراقه في دنيا الرقميَّة الصمَّاء – أنَّ العلم لا يمكن أن يحتدم إلَّا مع العلم، والإيمان يستحيل أن يحتدم إلَّا مع الإيمان. والصراع الشهير بين نظريَّة التطوُّر ولاهوت بعض الطوائف المسيحيَّة – على سبيل المثال – لم يكن صراعًا بين العلم والإيمان، بل بين علم يجرِّد إيمان الإنسان من إنسانيَّته، وإيمان شوَّهَه التأويل الحرفيُّ للكتاب المقدَّس. تأسيسًا على هذه الفرضيَّة لن يكون ثمَّة من صراعٍ بين الإيمان في طبيعته الحقيقيَّة، والعقل في طبيعته الحقيقيَّة. وهذا التأكيد يشمل حقيقة تالية، هي أنَّه لا يوجد صراع جوهريٌّ بين الإيمان والوظيفة الإدراكيَّة للعقل. [بول تيلش – بواعث الإيمان- ص 96].
III
“الكوجيتو” مُهَيمِنًا في مملكة العقل الأدنى
عند مبتدأ الحداثة، صارت العلاقة بين العقل والدين موضع اهتمام غير عاديٍّ في حقلَيْ الفلسفة والَّلاهوت. تصوَّر آباء الفلسفة الحديثة وفي مقدَّمهم فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت، أنَّهم إذا فصلوا مملكة العقل عن مملكة الإيمان أمكنهم تفادي الاصطدام بين المملكتين. فلو تحقَّق ما أرادوا، سينعمون بمواهب التحيُّز للفكر العقلانيِّ من دون الوقوع في أخطار مجابهة الدين. لقد سبق أن قال بيكون في هذا الخصوص: إذا رغبنا في دراسة الَّلاهوت المقدَّس، وَجَب مغادرة زورق العقل البشريِّ الصغير والركوب في سفينة الكنيسة التي تمتلك هي وحدها حقَّ تشخيص المسار الصحيح. أمَّا ديكارت فقد دعا إلى ضرورة التسليم بالوحي الإلهيِّ في الموضوعات المتعلِّقة بالله. فإذا أوحى الله حول نفسه بأشياء فوق طبيعيَّة أي فوق قدرة عقلنا مثل رموز التجسُّد والتثليث، فيجب أن نتقبَّلها من دون تريُّث، حتى ولو لم نستطع إدراكها بوضوح، لأنَّ وجود أشياء فوق حدود إدراكنا فيما يخصُّ عظمة الله ومخلوقاته وَجَبَ ألَّا نعتبرها أمرًا عجيبًا.
في تلك الَّلحظة من تأمُّلاته الفلسفيَّة لم يكن ديكارت قد انعطف بعد إلى محاريب الكوجيتو وضراوة أحكامه. كان الرجل وقتذاك يستعين بأسلوب آخر غير أسلوب الفرز بين مملكتَي العقل والإيمان لحلِّ التعارض بين العقل والدين، وكان يدعو إلى وجوب الاعتماد على يقينيَّة المعارف المستمدَّة من الوحي الإلهيّ. بيد أنَّ هذه الرؤية وإنْ جاءت على صورة لاهوتيَّة، إلَّا أنَّها لم تدم طويلًا، عدا عن أنَّها لم تكن تعني عدم الاكتراث للعقل والتقليل من أهميَّته. هكذا عاد ديكارت ليولي قضيَّة المنهج اهتمامًا خاصًّا، ويشدِّد على قدرة العقل في اكتساب المعرفة اليقينيَّة، ثمَّ ليمهِّد السبيل لنزعة عقلانية سوف تُعرض وتُصاغ في ما بعد على يد جون لوك(1632-1704). ورهطٌ آخرون من بعده. أمَّا خلاصة النزعة العقلانيَّة المستحدثة التي استظهرها لوك تبعًا لديكارت فهي أن يكون الاعتقاد بوجود الله مقبولًا فقط عندما يؤيّده العقل. غير أنَّ هذه الأطروحة ما لبثت أن شكّلت مفتتحًا جديدًا ستسود فيه العقلانيَّة الصلبة على حساب الإيمان، وضدَّ الاعتقاد بواقعيَّة الاعتناء الإلهيّ بالعالم.
المعضلة التأسيسيَّة التي وقع فيها العقل الحديث، انسحاره بدءًا من ديكارت نفسه، بموازين العقل الرياضيِّ وقدرته على حلِّ أسئلة الوجود حتى من دون الاستعانة بالوحي. قد يكون القَدَرُ هو الذي سيحمل فيلسوف الحداثة على اقتراف دابَّة العقل، ليجعله خطَّ الدِّفاع الأوَّل عن الإيمان المسيحيّ. والذين أدركوا متأخِّرين ما اقترفه الرَّجل، ربَّما كانوا نصحوه ألَّا يفعل. وما هذا إلَّا لأنَّ حصاد الفعليَّة جاء خلاف مقصود النيَّة. لكنّ القَدَرَ سيتمِّمُ رحلته ويستحثُّه ليتّخذ “الشكَّ المنهجيَّ” دربةً لمسعاه. وما كان ذلك إلّا لأجل أن يستدلَّ منطقيًّا على حقيقة الألوهيَّة، ثمَّ ليبلغ من طريق الاستدلال ضالَّة اليقين.
من المبين أن نقول إنَّ ديكارت ما كان ليهتدي إلى “الكوجيتو” لولا أنَّ غَلَبته شَقْوَةُ فَقْدِ الوجود، ثمَّ سعى ليعثر عليه عن طريق “الأنا” المكتفية بذاتها. الخَيارُ سيكون شاقًّا بالنسبة إليه؛ بل ويحتاج من المكابدة أقصاها. لقد وَقَعَ الرجلُ في معثرةِ الجمعِ المستحيلِ بين نقيضين غير قابلين للتواؤم في هندسات العقل الأدنى: الإيقان بالألوهيَّة الذي لزومُهُ التّسليم والإيمان، والأخذ بالعقل البرهانيِّ الذي مقتضاه الجدل والسؤالُ، والسّببيّةُ، والعلَّة المفضيةُ إلى ظهور المعلول. لم يجد ديكارت ما ينفذُ به إلى مجاوزةِ هذه المَعْثَرة الممتدَّةِ جذورُها إلى الميراثين الفلسفيَّيَنْ اليونانيِّ والرومانيِّ، إلَّا أن يلوذَ بـ “الأنا” لكي ينجز مبتغاه. قرَّر الرُّجوع إلى نقطة البداية؛ ليكشف لنا أنَّ الشّيء الوحيد الذي كان واثقًا منه، أنًّه هو نفسه كائن يشكُّ، وجوهرٌ يفكِّر. وها هنا يمكث الظنُّ الذي سيحمله على الاعتقاد بأنَّ الإنسان ذهنٌ محضٌ، وأنَّ معرفتَه بنفسه وبغيره منحصرةٌ بالعقل المحض، هذا الكائن العجيب الذي يسأل عن كلِّ شيء، ويشكِّك بكلِّ شيء.
في سياق دعوته لفكرته الأساسيَّة ولهيكل نظامه الفلسفيِّ، سيعلن ديكارت عبر “الأنا أفكِّر” أنَّه أنشأ أوّل قضيَّة يقينيَّة غير قابلةٍ للشكّ. ولعلَّه أراد في هذه المطارحة أن يظهر كفيلسوف يقين حاول أن يبحر ليجد يقينه عبر سفينة الشكّ. ربّما أخذته أسحار الرياضيَّات التي ظلَّت تلازمه حتى آخر عمره من أجل أن يعْثُرَ على فردوسه الضائع. كان عليه أن يبتدئ من الَّلايقين، لينتهي إلى بداهة المعرفة اليقينيَّة بالوجود. غير أنَّ معثرته الابتدائيَّة هي تلك التي كشفها في “التأمُّلات”. يقول: “أنا موجود.. يعني أنا لي وجود”، أمَّا إلى متى؟ يجيب: طالما أفكِّر.. ومتى ما توقَّف تفكيري عن التفكير، لربَّما توقَّف الوجود ووجودي حينها. إنّ قولًا كهذا، وإن جاء لتوكيد “مشروعيَّة الكوجيتو”، إلَّا أنَّ تداعياته ستطال بالأذى مقاصده الأولى في الدِّفاع عن الألوهيَّة. ربَّما لم يكن ديكارت يدرك، وهو يستظهر هذا التّأمُّل، أنَّه يؤسِّس لعدميَّةٍ صمَّاءَ، تلغي الكون كلَّه حالما تنعدم “الأنا” التي كانت ترى موجودات العالم وتفكِّر فيها…
من بعد مخاض، يأتي دور الشّكِّ المنهجيِّ لكي يتولَّى مهمة الوصول إلى المعرفة الصائبة للوجود. ومنهج الشكِّ – بالنسبة إلى صاحب الكوجيتو-، هو أقرب إلى واسطةٍ لتقطير جميع القضايا التي نشكُّ بها منطقيًّا، وذلك بغية تحصيل المعارف التي لا يرقى إليها الشكّ. فالغاية من “الشكِّ المنهجيِّ” ليست تحديد ما هو معقول أو غير معقولٍ الشكِّ فيه، وإنَّما ما هو ممكن الشكِّ فيه منطقيًّا. في هذا المنهج تُحذف جميع القضايا التي لا تستطيع أن تشكِّل مقدِّماتٍ في نظامٍ فلسفيٍّ استنباطيّ. غير أنَّ الشكَّ المنهجيَّ له افتراضات محدَّدة: أظهرُها ما يفيد بأنَّ الفرد هو الذات المفكِّرة الوحيدة التي تثير الأسئلة. ومنه نستنتج، ومن دون ذهول واستغراب، أنَّ الجواب – أي اليقين الذي يقطع الشكّ – هو عند ديكارت يقين الفرد المفكِّر. والحاصل، أي النهاية الأكيدة للشكِّ هي بطريقة ما متمثِّلة في طريقة إثارته السؤال. وهكذا، يكون معيار الصدق عند ديكارت ما يحدِّده نظام العقل، والعقل الرياضيِّ على وجه الضَّبط. فما يصل إليه هذا العقل ويراه واضحًا ومتميّزًا بعد تفكيرٍ منظّمٍ ومدروسٍ، يمكن قبوله واعتباره صادقًا. واستطرادًا لهذه الفرضيَّة، يوصي ديكارت بوجوب إخضاع الخبرة الحسّيَّة لسلطان العقل ومعاييره؛ لأنَّ خبرة الحواسِّ هذه، هي بصورةٍ فطريَّةٍ أقلّ إيحاءً بالثِّقة من العقل.
حقيقة الأمر، أنَّ ديكارت لم يكن لينأى قيدَ أنملةٍ من شريعة الإغريق وهو يستغرق هموم “الكوجيتو”. ونميل إلى القول أنَّه لم يقطع مع أرسطو، بل جاءت نظريَّته في المعرفة امتدادًا جوهريًّا لمنطِقِه؛ حيث خضعت لوثنيَّة الأنا المفكِّرة. وسيجوز لنا أن نلاحظ، أنَّ الكوجيتو الديكارتيَّ ما هو إلَّا استئناف مستحدث لـ “دنيويَّة المقولات العشر الأرسطيَّة”. وبسببٍ من سطوة النّزعة الدنيويَّة هذه على مجمل حداثة الغرب لم يخرج سوى “الندرة” من المفكِّرين الذين تنبَّهوا إلى معاثر الكوجيتو وأثره الكبير على تشكُّلات وعي الغرب لذاته وللوجود. من هؤلاء – على سبيل المثال لا الحصر- الفيلسوف الألمانيّ فرانز فون بادر الذي قامت أطروحاته على تفكيكٍ جذريٍّ لمباني الميتافيزيقا الحديثة وحكم بتهافتها الأنطولوجيِّ والمعرفيِّ في آن. وإذا كانت فلسفة بادر النقديَّة طاولت الأُسس التي انبنت عليها الميتافيزيقا الأولى، فإنَّ نقده للديكارتيَّة يشكِّل ترجمةً مستحدثةً للميراث الأرسطيِّ بمجمله، حيث يمكن إجماله في النُّقاط الثلاث التالية:
أوّلًا: إنَّ الكوجيتو الديكارتيَّ «مبدأ الأنا أفكِّر» يؤدّي إلى قلب العلاقة التأسيسيَّة للوعي بجناحيه المتناهي والَّلامتناهي. والسّؤال البديهيُّ في هذا المحلِّ هو التالي: «كيف يمكن المرء أن يعرف الله بتفكير لا إلهيٍّ، أو بتفكير لا إلهَ فيه، أو بتفكير مدعوم إلهيًّا، مع أنَّ نفس وجود أو لا وجود اللَّه يُحدَّد فقط من خلال معادلة مختلَّة الأركان قوامها: “اللَّه موجود مجرَّد نتيجة للأنا موجود”».
ثانيًا: ما يريد الشكُّ الديكارتيُّ أن يقوله فعلًا، بوصفه استقلاليَّةً مطلقةً للمعرفة، ليس أقلَّ من أنَّ الإنسان بوصفه مخلوقًا يكوّن معرفته الخاصَّة، ويجعلها تؤسِّس ذاتها من دون مسبقات. الـ “أنا موجود” (ergo sum) التي تلي «الأنا أفكِّر» (co gito) هي – في منطق ديكارت – تعبير عن كيان يريد إظهار نفسه بالتفكير والكينونة، بمعزل عن الله. وبسببٍ من كونه عاجزًا عن فعل هذا، يمنع تجلّي نفسه وتجلّي الله. فالموجود المتناهي – الإنسان – ومن خلال تأسيس يقينه الوجوديِّ والمعرفيِّ في “الأنا الواعي”، يحاول إظهار ذاته كموجودٍ مطلقٍ، ويجعل نفسه إلهًا مؤسِّسًا لذاته”.
ثالثًا: يشكِّل الكوجيتو الديكارتيُّ، بالأساس، انعطافةً أبستمولوجيَّةً نحو الأنا، ما يستلزم انعطافةً أنطولوجيَّةً تليها انعطافةٌ أبستمولوجيَّةٌ منطقيَّةٌ أنطولوجيَّةٌ للعودة إلى ذاتها. وفي أيَّة حال، ستؤدّي الأَنَويَّة الأبستمولوجيَّة والأنانة الأنطولوجيَّة لـ «الأنا أفكِّر أنا موجود» في ميدان تطبيقها الاجتماعيِّ والسياسيِّ والحضاريِّ إلى ولادة أنانيَّة سياسيَّة ليبراليَّة ذات نظامٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ أنانيّ. وهذا هو على نحو البيان والوضوح ما أظهرته قيم الرأسماليَّة من “بربريَّات” صارخة في حقبة التّطاول الكولونياليِّ على الشّعوب الواقعة خارج المركزيَّة الغربيَّة.
على هذا النحو من النَّظر إلى “العقل الأنانيِّ” المستكفي بذاته، سيؤسِّس ديكارت عقلانيَّة العصر الحديث. وجلُّ الفلاسفة الذي خَلَفوا ديكارت، أو تبعوا دربته الاكتفائيَّة، رأوا أنَّ ذات المرء كافيةٌ في تأسيس وجوده وتفكيره، وأنَّ الإنسان بسبب هذا الاكتفاء الذاتي لا يحتاج إلى اللَّه في التأسيس والمساعدة، ولا في وجوده، ولا في معرفته، ولا في وعيه الذاتيّ.
لقد نبَّه التّحليل النّقديُّ لـ «الأنا أفكر إذاً أنا موجود» إلى أنّ الأنا، عندما تتأمّل المكان الذي أتت منه، سوف تدرك أنّها لا تملك “كوجيتو” خاصاً بها، ولا وعياً ذاتياً خاصاً بها، أو منسجماً معه. عندما نفكّر بشكلٍ أعمق في شروط الوعي -كما يبيّن نقّاد الكوجيتو- يصل المرء إلى إدراك أنّ الوعي المتناهي يعرف ذاته على أنّه وعي لشخص لا يُحدِثُ نفسَه، ولا يعرف نفسه بنفسه وحده. وفي الوقت ذاته الذي يعرف الوعي المتناهي «الأنا أفكر» ماهيته، يعرف أنه «مفكَّر فيه». فالوعي المتناهي مؤسَّسٌ في وعي مطلقٍ مستقلٍ بشكلٍ كاملٍ عن الوعي المتناهي. أمّا «مبدأ المفكَّر فيه»، فإنّه يعبّر عن عقيدة حضور كلّ الأشياء في اللَّه على مستوى الوعي، بمعنى أنّ الوعي المتناهي مؤسَّسٌ في اللَّامتناهي، ومن ناحيةٍ أخرى يُبيّن أنّ معرفة الإنسان، بل هي موهبة إلهية.
Franz von Baader Fermenta cognitionis (abbr. FC) in SW Vol. II، p. 178
IV
انقلاب العقل على العقل
مبعثُ الضلالة التأسيسيَّة لـ الأنا الديكارتيَّة” يتأتَّى من افتراضها أنَّها هي سبب نفسها، وأنَّها مكتفيةٌ بذاتها ولا حاجة لمبدأٍ يؤسِّسُها. ويمكن أن نمضي إلى أبعدَ لنقول طبقًا لزعم ٍ كهذا إنَّها واجدةُ نفسها. هنا نسأل: كيف لديكارت أن ينجو من عثرة التّناقض حين يزعم أنَّه كرَّس نظريَّته لإثبات وجود الله، وفي الحال عينها يتصرَّف كما لو أنَّ “أناه المفكِّرة” هي خالقة نفسها. واقع الحال أنَّ هذه الفرضيَّة المتسلِّلة إليه من طغيان منطقِهِ الرياضيِّ، لم تلحظ نقطة البَدءِ التي خرجت بسببها الأنا إلى الوجود. فقد تقدَّمت عنده الأنا المسكونة بفقرها ومحدوديَّتها على الوجود الأكمل الحاوي لكلِّ موجود والراعي لكلِّ شيء. حقيقة الأمر أنَّ “الأنا” التي تتوِّج الكوجيتو بدت شديدة الادِّعاء بالاقتدار، إلَّا أنَّها ظهرت مبتورةً عن أصلها الوجوديِّ، حيث لا تمتلك صفة التأسيس للوجود، بل حتى لوجودها هي بالذات.
غير أنَّ الجناية الأشدَّ أثرًا على الفكر الفلسفيِّ الحديث، أنَّ الكوجيتو سيدفع بسيرورةٍ من عدم اليقين أفضت في كثير من الأحوال إلى ضربٍ من الضلال المعرفيّ. وسيكون لهذه السيرورة تداعيات جمَّة ليس على ميتافيزيقا الحداثة وحسب، وإنَّما على مجمل العلوم الإنسانيَّة في العصور الَّلاحقة.
في حقبة ما بعد ديكارت ستظهر مؤثِّرات الكوجيتو على شكل مسارٍ انحداريٍّ سريع باتِّجاه العقلانية الصلبة. وستشهد ساحة الفكر تحوُّلات انعطافيَّة مع الفيلسوف الإنكليزيِّ ديفيد هيوم (1711-1776) الذي لم يُحِط الغموض بفيلسوف من فلاسفة الحداثة كمثل ما أحيط به. جلُّ من عاصروه، أو أولئك الذين جاؤوا من بعده ارتابوا من غموضه؛ وأخذهم الذهول حيال موقفه من العقل. انبرى هيوم إلى ما يتعدَّى الذي وضعه أستاذاه فرانسيس بيكون وجون لوك من قواعد للفلسفة التجريبيَّة. ولأجل أن ينفرد باختباراته الشخصيَّة، فقد خالفهما الرأي ليُعرِض عن كلِّ نزعة إيقانيَّة، وآثر التعامل مع التراث الميتافيزيقيِّ كلِّه بوصفه نقيضًا لأفهام الطبيعة البشريَّة. ربما كانت معضلة هيوم الأصليَّة أنَّه ركب موجة الثورة العلميَّة في القرن الثامن عشر من أجل أن يتربَّع فيلسوفًا أوحد على عرشها. ولكي يتَّفق له ما يريد، مضى بشغفٍ غير مسبوق إلى مناصبة الميتافيزيقا العداء، وحرص على زعزعة أركانها من داخل من دون أن يستغرق عالمها المكتظَّ بالعناء. ولقد فعل هذا إمَّا لقصور في الإحاطة بمفاهيمها، أو لخشيته الامتثال لمهابة أسئلتها العظمى.
ومثلما نالت الميتافيزيقا من هيوم نصيبها من الهدر، سينال العقل حتى في مرتبته الأداتيَّة، حظَّه الأوفى من تهمة التقصير والغموض؛ ولأنَّه عدَّ الغموضَ موجعًا للعقل مثلما هو موجِعٌ للعين، قرَّر أن يجتنب الوجع المحتَّم، وينساق نحو منهجٍ غرائزيٍّ يجعل العقل أقلَّ تحليقًا في الأعالي ممَّا اتَّخذه أيُّ فيلسوف حديث. هو لم يفترض أنَّ لدينا مَلَكَة أخرى أفضل قدرة لتزويدنا بمعرفة طبائع الأشياء؛ بل رأى أنَّ الشكَّ هو الموقف المعقول الوحيد الذي يتعيَّن اتِّباعه.
لقد أدان هيوم الميتافيزيقا واستنزَلَها منازل الأفكار الزائفة، ثمَّ لينتهي إلى ضربٍ من السخرية ممَّا توصَّل إليه من استنتاجات: «أنا خائفٌ ومرتبكٌ من تلك الوحدة البائسة التي وضعت فيها فلسفتي». هكذا قال. لكن مرجع خوفه يعود على أرجح تقدير إلى «لا أدريَّته» حيال سؤال الوجود، وكذلك إلى شكوكيَّته بمنطق العلم ومنطق التجربة في آن. ولو عدنا قليلًا إلى تاريخ الفلسفة منذ إرهاصاتها اليونانيَّة الأولى، لتبيّن لنا أنَّ الرجل لم يأتِ بخطب جلل. مَثَلُه كمثل سائر فلاسفة الحداثة ممَّن ذهبوا مذهب الشكِّ، حتى استوطن بعضهم أرض العدم، وهوى بعضهم الآخر إلى وادي الإلحاد. جلُّ هؤلاء أخذوا عن أسلافهم الإغريق عصارة الانعدام والشكِّ ثمَّ لم يأتوا بجديد يُعوَّل عليه. في الفترة التي تلت عهد سقراط، أي قبل قرون مديدة من ظهور الحداثة في الغرب، أطلَّت الشكوكيَّة برأسها مع رائدها الأوَّل بيرون حين رأى أنَّ: «المعرفة تُعدُّ أمرًا مستحيلًا، والمصير المحتوم للبشريَّة هو الشكُّ والَّلاأدريَّة. بعد ذلك تمادت الشكوكيَّة، لتتحوَّل إلى مذهبٍ فكريٍّ يفيد أصحابه بأنَّ المعرفة الحقيقيَّة في حقل معيَّنٍ هي عبارة عن معرفة غير محقَّقة وليست ثابتة لدى الإنسان، أي أنَّ الحقيقة خارجة عن نطاق إدراك الذهن البشريِّ، وأنَّ الإنسان لا يمتلك القابليَّة لمعرفة الحقائق الثابتة، باعتبار أنَّ الحسَّ والعقل معرَّضان للخطأ. فضلًا عن ذلك، فقد عُدَتَّ الأصول المنطقيَّة التي وضعها أرسطو لصيانة الذهن من الخطأ غير كافية، وأنَّ السبيل الصحيح في التفكير هو التوقُّف عن إصدار آراء جَزْميَّة، ثمَّ بالغوا في منهجهم هذا لدرجة أنَّهم طبَّقوه على مسائل الرياضيَّات والهندسة معتبرين أنَّها قضايا احتماليَّة وتشكيكيَّة.
لم يكتفِ هيوم بما اقترفه بحقِّ الميتافيزيقا لمَّا حكم عليها بالبطلان، بل راح يبحث عن ذلك الفيلسوف الذي لا يقصد أكثر من أن يكون ترجمان الحسِّ الإنسانيِّ العامّ. ربَّما كان بما له من “ذكاء”، أن يحدِّد المسار العامَّ للفلاسفة والمفكِّرين من بعده. وسنرى من بعد ذلك كيف استولدت مسارات الحداثة سلالة متَّصلة من الفلاسفة الْتَمَّ شملُها على ذمِّ الميتافيزيقا وعبادة العلم المحض. من الشواهد الصارخة أنْ تحقَّق لديفيد هيوم مع إيمانويل كانط ما كان يرنو إليه. ففي عام 1756م قرأ الأخير ترجمة ألمانيَّة لنظيره حول الشكوكيَّة كانت كافية لتهزَّ إيمانه بشرعيَّة المعرفة الميتافيزيقيَّة، وهو ما عبَّر عنه بعد سنوات في مؤلَّفه «مقدِّمات نقديَّة» Prolegomena بجملته العصماء: «لقد أيقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوغمائيّ»….
V
يأس العقل الأدنى من الميتافيزيقا وإنكاره لها
أدَّت فراسة هيوم على كانط إلى الاندفاع على غير هدى نحو اليأس العامِّ من المعرفة الميتافيزيقيَّة؛ ثمَّ كانت معضلته الكبرى عندما شرع في تحويل الميتافيزيقا إلى علم. جاء الأمل الموهوم لكانط من المصدر نفسه الذي جيء به إلى ديكارت؛ أي من الثورة العلميَّة التي أبهرت الجميع بسحرها. ابتهج كانط بالنور الخافت الذي أدركه في فوضى الهندسة المعاصرة، وصار يبصر في نور العلم منبعثًا لبداية إصلاح العلوم. كان ثمَّة تباين بارز بين الضعف الواضح للأنظمة الميتافيزيقيَّة الغربيَّة وحالة الازدهار التي شهدها العلم الوضعيُّ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فقد حافظت الرياضيَّات على حُسن سمعتها القديمة، وبلغت الفيزياء مع نيوتن عزَّا لم يعهده علم الطبيعة من قبل، لكنَّ الفلسفة ظلَّت تواجه معضلة العزلة حتى كادت تذوي تحت وطأة الضربات القاسية للعلم.
ربَّما كان من الضروريِّ في السياق إيَّاه أن نستفهم عن نوع الميتافيزيقا التي استيأس منها إيمانويل كانط (1724-1804) وكان للعقل فيها نصيب وفير. حسب الذين قرأوا نقديَّة العقل المحض وصلوا إلى قرار أنَّ كانط لم يخصِّص مكانًا لعلم الوجود بما هو وجود لا في الميتافيزيقا العامَّة ولا في الميتافيزيقا الخاصَّة. لذلك لم يكن له أيُّ شأن أو علاقة بالعلل النهائيَّة لكلِّ الأشياء الموجودة ومنها الله باعتباره عنده العلَّة الأولى. في الإلهيَّات الطبيعيَّة فقط حاول أن يثبت وجود الله عن طريق برهانين هما البرهان الوجوديُّ والبرهان الكوسمولوجيُّ، لكنَّه لم يبدِ أيَّة محاولة لإثبات سائر التعاليم الدينيَّة إثباتًا عقلانيًّا، وبذلك ترك تأثيرًا مهمًّا في الَّلاهوت البروتستانتيِّ خلال القرن الثامن عشر للميلاد.
حين راقب كانط الجدل المفتوح حول الميتافيزيقا، كان عليه أن يستقرئ ثلاثة اتِّجاهات، ثمَّ يختار الاتِّجاه الذي يناسبه منها: – الأوَّل: ما يذهب أهله إلى اعتبار موضوع الميتافيزيقا هو الوجود على نحو كليّ. – الثاني: من يرى أنَّ الميتافيزيقا هي العلم بالموجودات غير المادّيَّة (المجرَّدات). أمَّا الاتِّجاه الثالث فهو الذي سيأخذ به كانط، أي اتِّجاه الذين قالوا إنَّ الميتافيزيقا هي العلم بالأصول الأولى للمعرفة البشريَّة، والتي تشتقُّ منها أصول كلِّ العلوم الأخرى. لم تعد الميتافيزيقا العلم بالوجود بما هو وجود، بل العلم بأصول المعرفة البشريَّة. ولقد وجد كانط أنَّ الاتِّجاه الثالث للميتافيزيقا، هو الشكل الوحيد الممكن لها.. وعليه، فإنَّه عندما يقول إنَّها غير ممكنة، فقصده في ذلك هو الميتافيزيقا بالمعنى والتفسير الثاني. والحقيقة هي أنَّ التفسير الثاني، كما سيلاحظ القارئ بنفسه، انبثق من قلب الميتافيزيقا الخاصَّة عند فولف. وكما مرَّ بنا فإنَّ الميتافيزيقا الخاصَّة تنتج ثلاثة علوم فلسفيَّة: علم الكون، وعلم النفس، والإلهيَّات الطبيعيَّة (العلم بالله). يعتقد كانط أنَّ موضوع كلِّ هذه الفلسفات الثلاث يقع خارج نطاق المحسوسات، بمعنى أنَّ كلَّ واحدة من هذه الفلسفات تتعامل مع تصوُّر متعالٍ (transcendental idea)، وتعمل على دراسته والتحقيق فيه. ومراده من التصوُّر هنا واضح تمامًا: أي التصوُّر بما هو مفهوم ضروريٌّ للعقل لا يمكن للتجربة الحسّيَّة أن تمنح أيَّ متعلِّق مناظر له.
في المسار الَّلاحق للفكر الغربيِّ، قضى قَدَر كانط بأن تميل كفَّة نقده المعرفيِّ إلى الرجحان مقابل كفَّة تأكيداته الإيجابيَّة حيال الدين والعلم على حدٍّ سواء. فمن ناحية بدا الهامش الذي وفَّره للإيمان الدينيِّ شبيهًا بنوع من الفراغ، لأنَّ هذا الإيمان كان قد افتقد إلى مجمل أشكال الدعم الخارجيِّ، سواء من العالم التجريبيِّ أم من العقل المحض، ناهيك بالافتقار إلى المعقوليَّة والملاءمة الداخليَّتين بالنسبة إلى شخصيَّة الإنسان العلمانيِّ لحديث. ومن الناحية الأخرى بات يقين المعرفة العلميِّ مفتقرًا أيضً إلى الدَّعم من جانب أيِّ ضرورة معرفيَّة داخليَّة بعد قيام فيزياء القرن العشرين بإحداث انقلاب مثير في جملة المقولات النيوتنيَّة والإقليديَّة التي كان كانط قد افترض أنَّها مطلَقة.
من الذين نقدوا بعمق ودراية النظام الفلسفيَّ الكانطيَّ، سيبيِّن أن مجمل مشروعه في نقد العقل المحض كان متناقضًا. إذ كيف لكانط أن يسوِّغ استخدامه للعقل ويعتبره وسيلة للبرهنة على فشل العقل في الوصول إلى المعرفة الفعليَّة بالأشياء كما هي في الواقع؟ ثمَّ كيف له أن يعلن أن المرء لا يستطيع تحصيل المعرفة بالشيء في ذاته، وفي الوقت نفسه يستمرُّ في وصف العقل كشيء في ذاته – أي بنيته المطلَقة؟ و – حسب أصحاب هذا الرأي – أنَّ كلَّ حججه في نقد العقل المحض لا أساس لها ما لم تكن قادرة على وصف العقل كما هو حقيقة، وهذا لا ينطبق عليه فحسب، بل على الحالات المشابهة كلِّها. فإذا كنَّا لا نعرف إلَّا ظواهر الأمور، فكيف يمكننا أن نعرف العقل بذاته؟ وإذا كنا لا نعرف إلَّا الظاهر فقط، فهل ثمَّة معنى، في التحليل النهائيِّ، لقولنا إنَّنا نعرف شيئًا ما؟ أمَّا سبب هذه التناقضات، فيعود وفقًا لبادر، إلى أنَّ الفلسفة النقديَّة استثنت معرفة اللَّه والدين النظريِّ من حقل المعرفة التي يمكن الحصول عليها عن طريق العقل. [Franz von Baader, ipid, p.180 ].
VI
العقل الأدنى في عيوبه ومعاثره
أغلب الحكماء الإلهيون لم يستعملوا لفظ العقل مصطلحًاً خاصًّا بهم، بل ذهبوا إلى إعطائه صفة التدبير والمعاينة. البيِّن أنَّ حذرهم، أو نأيهم عن هذا الاستعمال، جرى بسبب تقليص المتكلِّمين والفلاسفة المسلمين لمدلوله المنحصر بخصائص العقل الأدنى وسماته العامَّة. وإذا كان بعض العرفاء قد استعملوه اضطرارًا، فإنَّما لدواعٍ متَّصلة بضرورات معرفيَّة، وبحسب ما يتيحه اشتراكه الَّلفظيُّ بين الفئات التي استعملته، وكلٌّ حسب إطلاقها ومرماها من ذلك الاستعمال. ولقد كان أكثر استعمال الصوفيَّة لمادَّة “عقل” مصدرًا أو وصفًا، على أنَّ العقل وظيفة. لذا نجد في بعض أقوالهم ما يُظنُّ منه أنَّهم جعلوه ذاتًا مثل قول بعضهم: “العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة…” أو قولهم “العقل والهوى متنازعان… والنفس واقفة بينهما فأيُّهما ظفر كانت في حيِّزِه”. [الرسالة القشيريَّة – ص 143].
لقد شملت الدلالة الإصطلاحيَّة للعقل عند عرفاء الصوفيَّة في القرن الثالث الهجريِ كلا المفهومين المتعلِّقين بالعلم النظريِّ والعلم الخُلقيّ. وهما المفهومان الَّلذان كانا معروفين في البيئة العربيَّة منذ العصر الجاهليِّ، وأضفى عليهما الإسلام المقاصد الدينيَّة والغايات الأخرويَّة. في تلك الحقبة عنَى مفهوم العقل كلَّ ما وافق الشرع وهذَّب الطبع؛ ومن هنا أعطى العرفاء للعقل أوسع مدلول عرفه في تاريخه إذ شمل كلَّ الحيِّز المعرفيِّ والخُلُقيِّ الممكن لدى الإنسان؛ فنجد عند الحارث المحاسبي (ت 243هـ) مثلًا أنَّ العقل يبتدئ مدلوله من فطرة الإنسان ويمتدُّ إلى آخر درجات المرقى الروحيِّ المعرفيِّ له (العقل عن الله)، أي عندما يصير بصيرة تفهم عن الله تعالى، مرورًا بالمفاهيم النظريَّة والشرعيَّة والعمليَّة. وفي مسرى جهودهم التنظيريَّة لإرساء نظريَّة معرفة، مضى العرفاء إلى تظهير ترقيات العقل وامتداداته ضمن أربعة منازل:
الأوَّل: الاستعداد، وهو عقل الغريزة أو الفطرة.
الثَّاني: التفكير، وهو الفهم الذي تقوم به حجَّة التكليف والتجربة الحياتيَّة.
الثَّالث: التخلُّق، ويجملونه في مخالفة الهوى.
الرَّابع: التحقُّق، وهو العقل عن الله، بأن يصير العقل لبًّا أو بصيرةً تعرفُ الحقّ.
إلى هذا، لم يكتف العرفاء بترك مصطلح “العقل” بسبب اشتراكه الَّلفظيِّ مع غيرهم، بل أبرزوا ما أمسى عليه هذا المصطلح من الضدِّيَّة التي نجمت عن ذلك الاشتراك. لذا سنجد ابتداءً من أواخر القرن الثالث، أنَّ مفهوم “العقل” عندهم يمكن أن يحمل على الهداية والإضلال معًا. في هذا المقام يُنقل عن أحد أبرز عرفاء المتصوِّفة في القرن الثالث الهجريِّ وهو أبو العباس بن مسروق (توفّي سنة 299هـ): قوله: “من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله”. بهذه الكلمات الدالَّة والدقيقة يستعمل ابن مسروق لفظ العقل أربع مرات. ولو رجعنا إلى مقصوده منها سنلاحظ علاقة التضادّ بين معنى الَّلفظ الأول ومعنى الثاني، إذ إنَّ مراد القائل من العقل الذي ابتدأ به قوله، ليس كالمراد من العقل الذي يليه. فالعقل الأوَّل هو وساطة وأداة احتراز من الثاني الذي هو سبب هلاك، كما يبين ذلك العقل الرابع الذي هو الثاني نفسه؛ أمَّا العقل الثالث فيحتمل أن يعود الضمير فيه إلى الأول فيصيرا شيئًا واحدًا متزايدًا بتزايد الاحتراز من العقل الثاني، كما يحتمل أن يعود الضمير على العقل الثاني فيعود حينئذٍ معنى العقل إلى أصل الاستعمال الُّلغويّ (وهو القيد)، وفي النتيجة يصير المعنى هو الاحتراز بالعقل الأول لكي يقيّد العقل الثاني عن التسبُّب في الهلاك، ومنتهى القول أنَّ مصطلح العقل في هذه الجدليَّة من الأضداد، إذ إنَّه يكون أداة هداية كما يكون أداة إضلال، وهذا المفهوم مؤسَّس على التقابل الموجود في السلوك الصوفيِّ بين العقل النفسانيِّ والعقل الربَّانيِّ؛ وما المجاهدة الصوفيَّة إلَّا محاولة لإخضاع الأول للثاني حتى يستمدُّ منه ويقوم به!. [محمد المصطفى عزام – الخطاب الصوفي – ص 267].
في الفضاء العرفانيِّ الإسلاميِّ سنجد تأصيلًا غير مسبوق في التمييز بين العقل المستغرق في ميتافيزيقا المقولات العشر، والعقل الممتدِّ إلى ما بعد ذاته. عند ابن عربي – على سبيل الذكر – يتَّخذ نشاط العقل صورتين: صورة فاعلة، يكون فيها العقل مرادفًا للـ “فكر”، أي للقياس والممارسات الاستدلاليَّة والحدِّيَّة بصفة عامَّة، وصورة منفعلة، يتَّخذ فيها العقل معنى المكان، أي مكان قبول المعارف الآتية إليه إمَّا من الله، أو من الفكر، أو من القلب. في هذا المحلِّ يوجِّه ابن عربي نقده العنيف فقط لصورة العقل بمعناه الفكريِّ، أي العقل الأدنى، ويسجِّل اقترافه لثلاثة عيوب أساسيَّة هي: عيب التقليد، وعيب التقييد، وعيب الموضوعيَّة والحياد.
أوَّلًا: عيب التقليد: إذا نظرنا إلى الكيفيَّة التي يحصِّل بها العقل في منزلته المظاهريَّة على معطياته المعرفيَّة، نجده لا يستطيع أن يدرك بنفسه لا الظواهر الخارجيَّة ولا المعاني الغيبيَّة، وإنَّما هو يقوم بذلك بالوساطة، عن طريق الاستدلال والحدِّ، سواء على صعيد الطبيعة، أم على صعيد ما بعد الطبيعة. فبالنسبة إلى ظواهر الطبيعة، كالألوان مثلًا، أو أسرار الذات والأسماء الإلهيَّة، يبدو العقل عاجزًا عن أن يقف عليها بنفسه ومباشرة. عن افتقار العقل إزاء غيره يقول ابن عربي: “إنَّ العقل ما عنده شيء من حيث نفسه، وإنَّ الذي يكتسبه من العلوم إنَّما هو من كونه عنده صفة القبول”. فـالعقل مقلِّد، ولهذا اتَّصف بالخطأ”. أمَّا الصفات والأسماء والذات الإلهيَّة فلا يمكن أن يدركها الإنسان إلَّا بالقلب والبصيرة. هكذا يبدو العقل غير مستقلٍّ بنفسه بالنسبة إلى موارده المعرفيَّة، سواء إزاء الحواسِّ والخيال أم إزاء القلب. من هنا جاء افتقارُه وتبعيَّته لغيره. أما إذا كان لا مناص من التقليد، فلنقلِّد الخبر؛ فهو أولى من تقليد العقل، لاسيَّما عندما يتعلَّق الأمر بمعرفة الذات الإلهيَّة، التي يتكفَّل الله نفسه بالإخبار عنها.
– ثانيًا: عيب الحصر والتقييد، ويتجلَّى في أرقى وسائله للبحث عن الحقيقة والتعبير عنها، وهما الحدُّ والبرهان. ويظهر عيب التقييد بكيفيَّة سافرة وغير مقبولة عندما يتطاول العقل على الذات الإلهيَّة التي هي، بالتعريف، غير قابلة للحدِّ والتقييد، ولو كان تقييد إطلاق [الفتوحات- 2]. لكن ليس معنى هذا أنَّ ابن عربي يتَّخذ موقفًا لاأدريًّا من الذات الإلهيَّة؛ بل إنَّه يقترح بديلًا للوقوف على غناها وقابليَّتها للتحلِّي بصور لامتناهية، هو طريق القلب، لأنَّه مكان يَسَعُ كلَّ شيء، ولأنه لا يقيِّد ولا يحصر، بل يحيط بكلِّ الصور في تقلُّبها وتواردها المستمرّ على الذات.
– ثالث عيوب العقل البرهاني، ويظهر في ادِّعائه القدرة على الوصول إلى معرفة موضوعيَّة ومحايدة تصمد أمام تحوُّلات التاريخ، وتتعالى عن صراع الآراء وتَطاحُن المعتقدات. ثمَّ يذهب الشيخ الأكبر إلى القول بأنَّ كلَّ معرفة مشروطة بذاتٍ ما، وبوضع معرفيٍّ وتاريخيٍّ معيَّن؛ ولا يمكن الاعتقاد بحقيقة خارجة عن مُدرِكِها وفاعِلِها الذاتيِّ والموضوعيّ. وممَّا يدلُّ على ذلك أنَّ المبادئ الأولى التي يستند إليها العقل في عمليَّاته المعرفيَّة، كمبدأ الذاتيَّة وعدم التناقض والثالث المرفوع والسببيَّة إلخ، ليست في مأمن من الخطأ والضلال.
[محمد المصباحي- ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة www.maaber.org].
VII
نقد العقل الأدنى بالعقل الممتد
لنضع ما سنعتني به الآن في منزلة الاستفهام المركَّب عمَّا إذا بمقدور العقل أن ينقد نفسه بنفسه.. ثمَّ عن طبيعة القوَّة الإدراكيَّة التي تتولَّى عمليَّة النقد، وأين تقع وفي أيِّ مطرح تتموضع، أهي داخل العقل نفسه أو أنَّها مرتبة من مراتبه المتقدِّمة، أم مستقلَّة عنه استقلالًا ما؟
لا تتوقَّف الأسئلة عند هذا الحدِّ، بل هي تتواصل لتستفهم عن الكيفيَّة التي يحصل فيها تصوُّر نقد العقل لنفسه، وصيرورة هذا التصوُّر إمكانًا واقعيًّا. ربَّما ينبغي أن نؤسِّس أيَّ جواب على هذه الاستفهامات استنادًا إلى مبدأ يُقِرُّ للعقل بأنَّه الجهاز الإدراكيُّ الوحيد الذي يمكنه من دون سواه الإحاطة الواعية بذاته وبغيره في الوقت نفسه. في عالم الممكنات ينفرد العقل بمثل هذه الخصوصيَّة بسبب من قيام ماهيَّته ووجوده على الكائن الأول والمحض والضروريِّ، ما يحول دون الوقوع في التناقض. دلَّ هذا على أنَّ العقل حين يمارس وظيفته الإدراكيَّة تكون أسئلته واستفهاماته وإجاباته متضمنَّة فيه. ولأنَّها متضمَّنة فيه ولا تأتيه من خارج ذاته، فذاك برهان ذاتيٌّ على جوهريَّة تمكِّنُه من الإشراف على غيره من الموجودات؛ كما تتيح له تعقُّل الوقائع والأحداث على تكثُّرها وتعدُّدها وتباين أفرادها وجزئيَّاتها. ومع أنَّ العقل البشريَّ قابل للخطأ مثلما هو قابل للصواب، فإنَّ ماهيَّته المفطورة على الإدراك والتعقُّل لا تتوقَّف عند حدود محدوديَّته التي يفترضها عليه عالم الممكنات المتناهي. فرغم اجتيازه لمساحة التجربة والاستدلال تبقى مساحة ما بعد الطبيعة مشرَّعة له لاستكشاف الَّلامحدود. ومع أنَّه يُعدُّ محدودًا من زاوية القدرة والمعرفة إلَّا أنَّ هذه المحدوديَّة التي تمثِّل مملكة العقل هي من السعة والقابليَّة على الاستكشاف بحيث تمنحه إمكانيَّة العثور على سبيل لتحقيق غاياته الكبرى التي يبحث عنها بمقتضى طبيعته التكوينيَّة وهي التعرُّف على واجد الموجودات وموجبها.
لقد سبق وأشرنا، إلى أنَّ النظام العقليَّ في عالم الإمكان والممكنات هو نظامٌ فريدٌ وواعٍ لما هو عليه. ثمَّ إنَّه يستطيع أن يلاحظ نفسه ويفحصها كما يفعل مع الموضوعات الخارجة عنه. بل ويمكنه أيضًا أن يكتسب معرفة عن نفسه بنفسه من دون الوقوع في محاذير منطقيَّة. من هنا يمكن لأيِّ عمليَّة وأسلوب في هذا الجهاز أن يبدي رأيه في النظام العقليِّ، كما بوسعه إبداء رأيه حول الأشياء الأخرى. فهو يستطيع أن يكون مدَّعيًا ومدَّعىً عليه في الآن نفسه، وإلى كلِّ ذلك يمكن أن يكون حَكَمًا عن نفسه، ويمكنه أن يكون في الوقت ذاته شاهدًا على دعوى نفسه. هذه الخصوصيَّة غير ممكنة التصوُّر في أيِّ نظام إمكانيٍّ آخر منسلخ من العقل. من هنا، كان نقد العقل أمرًا ممكنًا لأنَّ النقد يتضمَّن تثبيت العقل في مرحلة سابقة للنقد. بمعنى أنَّ حجِّيّة العقل بالمعنى العقليِّ مقرَّرة مسبقًا في نقد العقل، لأنَّ نقد العقل بالذات غير ممكن إلَّا بواسطة العقل ذاته. وعليه، يتعيَّن أن يكون العقل حجَّة قبل النقد. كما أنَّه محجوج عليه في نقد العقل، بمعنى أنَّه يمكن إقامة الحجَّة عليه، وأن يتعرَّض للمؤاخذة، والحكم عليه. أمَّا بخصوص مسألة أنَّ العقل يمكن أن يكون محجوجًا بالذات، وهو في الوقت نفسه حجَّة داخليَّة بالذات، فهذا لا ينطوي على أيِّ تناقض. ولو كان لهذا الوضع الثنائيِّ الاتِّجاه تناقضٌ لما أتيح فحص العقل بالعقل.[الشاهرودي – العقل والعقلانيَّة – ص 204].
بالرُّجوع إلى فكرة معاينة العقل لذاته، وبالتالي نقده ومجاوزة ما هو عليه، يطرح السؤال التالي: كيف يمكن معاينة إدراكات العقل ومستوى نشاطه بواسطة العقل نفسه؟ في مثل هذه الحال يقترح أهل التحقيق، ضرورة أن يكون هناك على الأقلِّ مبدأ واحد لا يطاله التغيُّر والتبدُّل. كما يجب أن يصدق هذا المبدأ في كلِّ افتراض، إذ بغيابه يتعذَّر فعل النقد الذي هو فحص الشيء المراد نقده بمعيار ثابت مستقلٍّ عن الناقد والفاحص والشيء المراد فحصه. هذا المعيار غير ممكن التصوُّر سوى في العقل، لأنَّ كلَّ جهاز، وخصوصًا أجهزة الحواسيب، تتبع كلَّ أمورها بنية الجهاز وبرنامجه، فلا يوجد مبدأ يسود جهاز مستقلًّا عن بنيته وبرنامجه بحيث يُصْلِح بنحو مستقلٍّ برامجَ الأجهزة. إذن، مثل هذه الأجهزة من المتعذَّر تحسين الجهاز وفحصه والحكم عنه وحوله عن طريق الجهاز نفسه وبصورة أصيلة. أمَّا في العقل فيوجد مثل هذا المبدأ ونعني به. مبدأ «الإثبات المطلق». مؤدَّى هذا المبدأ: أنَّنا سواء أثبتنا شيئًا أم نفيناه يقوم العقل في الحالتين بعمليَّة الإثبات. إذ في حالة إثبات الشيء يكون الإثبات قد حصل، وفي حالة نفي الشيء يكون العقل قد أثبت نفي هذا الشيء. بكلام آخر، سواء قرر العقلُ القضايا الإيجابيَّة أم قرَّر القضايا السلبيَّة، فإنَّه في الحالين يكون قد أثبت كلتا القضيَّتين. ذلك يشير إلى أنَّ طبيعة العقل في الإمساك بالأشياء منوطة بضرورة غير محدودة وغير مشروطة هي ضرورة مبدأ «الإثبات المطلق» المستقلِّ عن طبيعة العقل. ولأنَّ هذا المبدأ غير محدود وغير مشروط فهو ضرورة محضة، ولأنَّه ضرورة محضة فهو لا يقبل التعدُّدية والكثرة. من هذا الأساس يقرِّر المحقِّقون أنَّ هذا المبدأ يرجع إلى الجهات الضروريَّة لواجب الوجود، وكما أنَّ كلَّ الأشياء الممكنة مرتبطة بالواجب كذلك كلّ التعاريف والقضايا ضرورة أزليَّة تعود إلى جهات مرتبطة بالواجب أيضًا، إذ ثمَّة في أساس التعاريف والقضايا ضرورة أزليَّة تعود إلى جهات واجب الوجود. وإلى ذلك، ففي أساس الأشياء ومبدأ تحصيلها يوجد تأثير لواجب الوجود على الأقلِّ مع أنَّ كلَّ جهات واجب الوجود تعود إلى جهة واحدة، إذ إنَّ واجب الوجود أَحَديُّ الذات وأَحَديُّ المعنى، وأمَّا التعدُّديَّة فهي على حسب انتزاعاتنا لا على حسب منشأ الانتزاع. [الشاهرودي- العقل والعقلانيَّة- ص 195].
VIII
العقل الممتدُّ إلى تعاليه
من بعد أن سعينا إلى تنظيرٍ أوليٍّ حول إمكان إدراك العقل لذاته وإمكان تصويب أعطاله ومعاثره؛ نواصل المسعى لنستطلع إمكانًا ما بعديًّا ينقشع فيه الأفق عن خاصّيَّة جوهريَّة للعقل، هي خاصّيَّة الامتداد نحو معرفة المحتجب من حقائق الوجود.
العقل الممتدِّ أو (العقل الامتداديِّ) الذي نقصده، هو الذي تنعقد فعليَّته وحضوره على استكشاف المطارح والفضاءات المابعد طبيعية. من أظهر مفارقات هذا العقل في مساره الامتداديِّ، أنَّه يجاوز كلَّ مشاغل العقل المقيَّد من دون أن ينفصل عنه. ولمَّا كان من خصائص العقل الامتداديِّ جمعه للأضداد، فهو يستطيع أن يُدرج العقل البرهانيّ كمرتبة لا مناص منها في مراتبه المتعدِّدة الأطوار. دأب العرفاء على نقد العقل الحسِّيِّ باعتباره عقلًا مانعًا لفهم حقائق الوجود. كانوا يقولون إنَّ من أعجب الأمور كون الإنسان يقلِّد فكره ونظره، وهما محدثان مثله، وقوَّة من قواه التكوينيَّة التي خلقها الله فيه، وجعلها خادمة العقل، مع علمه أنَّها لا تتعدَّى مرتبتها، وأنَّها تعجز في نفسها عن أن يكون لها حكم قوَّة أخرى مثل القوَّة الحافظة والمصوّرة والمتخيّلة. ناهيك بقوى الحواسِّ من لمسٍ وطعم وشمٍّ وسمعٍ وبصر. ومع هذا القصور الذي تنطوي عليه هذه القوى، فإنَّ العقل يقلِّدها في معرفة ربِّه ولا يقلِّد ربَّه في ما يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله، فهذا – حسب قولهم – من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط.
إذن، فإنَّ الوظيفة الأساس للعقل الممتدِّ، هي قبول الحقائق وتأييدها بعد تنزُّلها عليه من عالم التعالي. ولعمليَّة القبول دور بالغ الأهميَّة في المعرفة العقليَّة، وهو ينسجم في الأصل مع دقَّة العقل ووظيفته الوجوديَّة، والتي هي التقييد والضبط من وجهة نظر العارف. يقول ابن عربي في هذا الموضع: “إن مما هو عقل، حدَّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده، فقد يهبه الحقّ المعرفة به فيعقلها، لأنَّه عقل لا من طريق الفكر هذا ما لا نمنعه، فإنَّ هذه المعرفة التي يهبها الحقُّ تعالى لمن يشاء من عباده لا يستقلُّ العقل بإدراكها مع أنَّه يقبلها، ولكن لا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنها وراء طور مدارك العقل.[الفتوحات- الجزء الأول- ص 94]. ولنا في هذا المضمار أن نلفت إلى شأنٍ جوهريٍّ في نشاط العقل الممتدِّ يمنحه خاصّيَّة المفارقة للأطوار التي سبقت:
أوَّلًا: خاصِّيَّة الجمع بين أطوار العقل
لتأصيل هذه الخاصِّيَّة تفترض نظريَّة المعرفة الإجابة على التساؤل عمَّا إذا كان ثمَّة من دربة معقولة لاستكشاف إمكان وصل العقل بين عالمَين متغايرين: عالم الغيب والعالم الواقعيّ. والكلام على العقل في هذا المقام ينحو نحوًا مُفارقًا في سياق بحثه الشاقِّ عن الرابطة الامتداديَّة بين أطواره المتعدِّدة في سبيل الوصول إلى الميثاق المفترض بين الوحي وحركة التاريخ. وعلى ما يبيِّن منظِّرو هذه الخاصِّيَّة، فإنَّ من شأن العبور إلى ما هو عقلانيٌّ، بوساطة ما ليس عقلانيًّا – أي الإيمان- أن يفضي، إلى زيادة التصوُّر العقلانيِّ عن الله عمقًا [أوتو، رودولف – فكرة القدسي – دار المعارف الحِكْميَّة- بيروت – 2010 – ص 137.].
يُراد من هذه المعادلة، التأسيس لمركزيَّة الإيمان بالغيب والوحي باعتباره طورًا عقليًّا واقعًا فوق طور العقل الفيزيائيّ. وليس من ريب، أنَّ مثل هذا التحويل الذي يجريه الإيمان، ولا سيَّما لجهة توحيد العقلانيِّ والَّلاعقلانيِّ يفتح الباب على الوصل المنهجيِّ بين فاعليَّة الغيب في الواقع، ومؤثِّرات هذه الفاعليَّة في تنشيط قابليَّات العقل واستعداده للامتداد إلى ما وراء عالم الحسّ. وهو ما يتيحُ للإيمان بالغيب حضورًا بيَّنا في الواقع يفترضه الترابط العميق بين فيزياء الواقع وميتافيزيقا المعرفة الإلهيَّة. والذين يأخذون بخاصّيَّة الجمع بين أطوار العقل، لا يجدون تناقضًا بين المناهج العقليَّة، إلا أنهم يلحظون تمايزاً في مستوى ودور كل منها، غير أن ما هو مهمٌ في هذا التمايز، هو التوحيد المعرفي الذي يحدثه في عالم المناهج. مع خاصّية الجمع البنّاء يختص بها العقل الممتد لا يعود ثمة اختصام بين العقلانيين الذين يتَّبعون مناهج الاستدلال، بين والحسِّيين الذين يحصِّلون معارفهم عن طريق التجربة، ناهيك بالعرفانيين الذين يبتنون معرفتهم الذوقيَّة على منهج الحدس والشهود. كل ذلك يغدو على نصاب التكامل والانسجام، حيث الكل يغتذي من الكل تحت رعاية عقلانية متعالية.
ثانيًا: خاصِّيَّة الفائقيَّة والمفارقة
فحوى هذه الخاصِّيَّة أنَّ للعقل في مقامه الامتداديِّ القدرةَ على توحيد العقلانيِّ والَّلاعقلانيِّ وفق جدليَّة التضادِّ والانسجام. وهذا يعود إلى إحاطته بالمناهج العقليَّة، لا على سبيل العبور الذي يليه الإلغاء والنفي، وإنَّما ليجعلها منازل ومحطات ضروريَّة بغية التعرُّف إلى الحقِّ المحتجب في عالم الخلق. والنتيجة التي تنتهي إليها هذه الجدليَّة التوحيديَّة، هي شهود الحقِّ المتجلِّي بالخلق. فالشهود هو إدراك حقائق المخلوقات في طور أعلى من أطوار العقل. من مفارقات هذا الطور الشهوديِّ أنَّه إذ يحتفظ بتساميه من أجل أن ينجزَ مهمَّة استكشاف الحقائق المحتجبة، لا ينفكُّ عن المراتب الدنيا التي تتعقَّل الموجودات كلًّا بحسب مقدارها ومدى سعتها. فالعقل الشهوديُّ هو الذي تُعرف به النماذج المطلوبة للحياة وفي مقدّمها نموذج التدبير السياسيّ. وهو ما يتجلَّى في عقل النبيِّ والوليِّ وسائر المصلحين من العرفاء. أمَّا الوحي فهو الذي ينبِّه العقل إلى وجوب اكتشاف مدركاته الوحيانيَّة. فلو تنبَّه بالإصغاء إلى نداء الوحي وَصَلَه ُالإلهامُ وأدرك ما لم يسطع إدراكه من قبل أن يتنبَّه. وعند هذه المنزلة يصبح العقل المسدَّد بالوحي عقلًا شهوديًّا ممتدًّا إلى ما بعد هوّيَّته الفيزيائيَّة. معنى هذا أنَّ العقل يمكن له أن يُدرِك إدراكًا حضوريًّا أيضًا، ذلك أنَّ العقل حاضر في مواطن الشهود الثلاثة الشهود الحسّيِّ والشهود العقلي والشهود القلبي. وله في كلِّ موطن إدراكاته المتناسبة معه. وعلى العموم، فإنَّ العقل حاضر في كلِّ ساحات الشهود، ويقوم بعمله هناك. فالعقل الشهوديُّ يستطيع ضمن الإدراك الشهوديِّ الحسّيِّ إدراك وجود الشي ووحدته في الخارج. وعلى هذا الأساس، لكي ندرك “العلّيَّة”، لا نحتاج إلى شيء زائد؛ إذ بمجرَّد رؤيتنا للمفتاح يتحرَّك بعد حركة يدنا؛ فإنَّ العقل يُدرك العلّيَّة، كونه يُدرك بنحو شهوديٍّ علاقة العلّيَّة بين اليد والمفتاح. بناءً على هذا، سوف تصبح الميتافيزيقا البعدية أمام منفسح معرفيّ يشهد فيه العقل على الموجودات شهوداً لا شية فيه. وبحسب القاعدة الفلسفيَّة القائلة “النفس في وحدتها كلُّ القوى”، فإن الشهود العقلي حاضر أيضًا في نفس موطن الحسِّ، وله إدراكاته الخاصَّة به هناك، ففي موطن الشهود الحسّيِّ نفسه توجد حقائق لا يمكن إدراكها إلَّا بشهود العقل.
[يد الله يزدان بناه – حاجة الفلسفة إلى الدين – مجلَّة “علم المبدأ”- العدد العاشر].
ثالثًا: خاصِّيَّة العقل الممتدِّ في المعرفة الشهوديَّة
لا يكتفي النظام المعرفيُّ العرفانيُّ ببيان القواعد العقليَّة والأسُس النظريَّة للمكاشفات القلبيَّة والمشاهدات الباطنيَّة، هو يعتني بدور آخر بالغ الأهميَّة، وهو تقرير هذه المكاشفات وإخراجها من كمونها في عالم الباطن إلى عالم الظهور، ومن الغيب إلى الواقع المشهود. وعندما يفارق العارف العقل المقيَّد بعالم الحواسِّ من أجل أن ينتقل إلى طور أعلى، سيكون بذلك قد جاوز ضيق العقل الأدنى متوجِّهاً نحو عالم عقليٍّ مُفارِق تنفسح فيه المدارك وتتلاحم الآفاق. والعقل الممتدُّ الذي به يُستأنف ما لا يتناهى من معارف وجوديَّة، هو نفسه ما يسمّيه العرفاء العقل القدسيّ. والأخير هو إيَّاه ما أخذت الفلسفة الأولى ولواحقها وسمَّته اصطلاحًا العقل المستفاد أو العقل الفعَّال. إلَّا أنَّ المهمَّة التي يتولَّاها العقل القدسيُّ هي توثيق ما لم يقدر عليه العقل الفلسفيُّ صبرًا وتدبُّرًا.
من العارفين من عدَّ الصلة بين العقل والقلب كالصلة بين العين والنفس. فكما أنَّه لولا العين لحرم الإنسان من نعمة الرؤية، كذلك لولا العقل لحرم القلب من البصيرة. فالعقل الذي يتمتَّع أيضًا بقابليَّة الاستدلال، يتمتَّع أساسًا بقابليَّة المشاهدة والكشف. إذ لولا العقل لما كان بمقدور القلب أن يشاهد أو أن يتحقَّق له الكشف. وبتعبير آخر، الفكر أو التفكير هو العمل الذي ينهض به العقل، وإذا ما عُدَّ العقل عين القلب، فلا بدَّ من أن يُعدَّ عمل العقل نوعًا من المشاهدة. فإذا استضاء العقل بنور القدس، واتَّحد العقل بالقلب، ورسخت البصيرة في القلب، وصار العقل يرى بوساطة القلب، تدفّقت المعارف والحقائق الإلهيَّة على قلب السالك، فيشاهدها عيانًا بوساطة قلبه وعقله معًا.
ما مرَّ من خصائص امتيازيَّة للعقل الممتدِّ، يجيز القول أنَّ العقل فعليَّة إدراك على الشيء قبضًا غير قابل للانفلات. فالذي يعقِل في هذه الحال، هو قلب العقل، ذاك الكائن المستتر الذي منه يتدفَّق الوعي بالوجود، وبه تُدرك الأشياء على حقيقتها. ومع هذا السموِّ يصير جوهرًا هاديًا ونفسًا واعية ، ذلك بأنَّ النفس في مراتب ترقِّيها تظهر ـ كما سبق
وأشرنا ـ على هيئة العقل الممتدّ، حيث تكون صفة هذا العقل مطابقة لكينونة النفس، على كمال ما ينبغي من تمام المشاكلة له. وذاك يعني أنَّ النفس في منزلة كونها قلب العقل هي المصدر الأول للمعرفة الفائقة.
* * *
وأنَّى كان الأمر والحال، فإنَّنا لن نفلح بميثاق العقل الممتدِّ لو داوَمْنا على الانشغال بما افترضه علينا منطق العقل الأدنى. فلهذا الأخير حدٌّ موصوفٌ أضناه التكرار والشرح. والعقل الأدنى بوصف كونه حالًّا في قضايا الدنيا وشؤونها، فقد أكسبته هذه القضايا والشؤون صبغتها حتى صار منها وصارت منه. يسوِّغها وتسوِّغُه تبعًا لداعيات المنافع. فالعقل الأدنى في مثل هذه الأحوال، ماكرٌ وذكيٌّ يتقن المخادعة. بل إنَّه عقلٌ زئبقيٌّ يتوارى إلى الظلِّ ويأنس إلى العتمة. وسواء عَرفَه من عَرَفهُ، أم جَهِلَه من جَهِلَهُ من الأقدمين والمحدثين، إلَّا أنَّه عقل موجبٌ للفتنة والضلال. وعلى غالب التقدير فإن التطواف في مرابعه سينتهي بصاحبه إلى الحسرة والخسران. لكن طورًا من التعقُّل يقع فوق طورالعين المدهوشة بسحر الحواسِّ ليس منه مناص. هنالك سيرى أنَّ فهم كلِّ شيء موقوفٌ على فهم ما به يكون هذا الشيء. وعليه، فإنَّ العقل “الما بعديَّ” الخارج للتوِّ من محنة الفراغ لا يذعن لانقسام الوجود وتشظِّيه. بل هو متحيِّز للتوحيد، ولذا ستجده حاثًّا خطاه بالانجذاب غير الكسول إلى مصادقة الجميل. فلو انعقد الميثاق زال التناقض الموهوم بين العقل والإيمان. وبفضل مصادقة الجميل يتقدَّم العقل “الما بعديُّ” بالنظر الحكيم إلى تلك الثنائيَّة الشاقَّة ولسان حاله يقول: العقل الذي ينفي الإيمان ويدمِّره، ينفي نفسه ويدمِّرها. والإيمان الذي يُعرِضُ عن العقل أو يزجره كان له المآل إيَّاه.. أي أنَّه يدمِّر نفسه مثلما يدمِّر الأصل الذي جاء منه.
[1]*– رئيس التحرير.