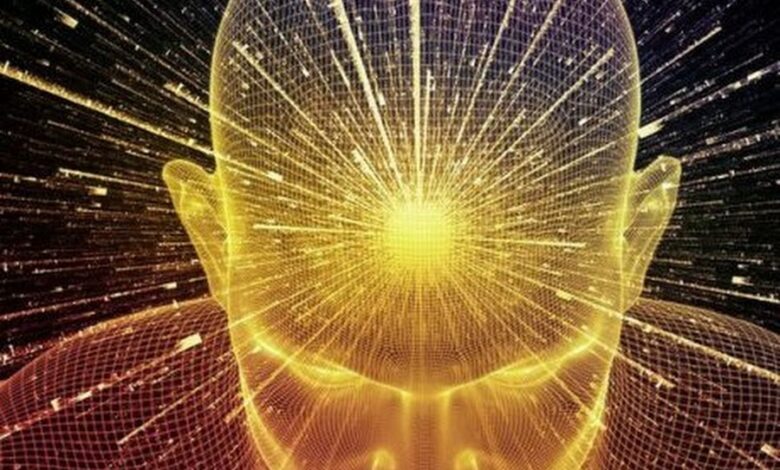
ميتافيزيقا السؤال المؤسِّس
ميتافيزيقا السُّؤال
دربة الاستفهام عن الوجود في زمانيَّته ولا زمانيَّته
د. محمود حيدر
مفكِّر وأستاذ محاضر في الفلسفة والإلهيَّات – لبنان.
ملخَّص إجماليّ
تستهدف هذه الدراسة التعرُّف على ماهيَّة السؤال في مسرى الاستفهام عن الظاهر والمحتجب في الوجود. وذلك يفترض الكشف عبر السؤال عن ضربين من الزمان الوجوديّ: أوَّلهما يسأل زمن الأشياء والماهيَّات، وثانيهما عن عالم فوق زمانيٍّ هو عالم الغيب المطلق. ولا ريب في أنَّ هذا الاختبار التأويليَّ ينطوي على مشقَّة ولطف في آن.. ذلك بأنَّه يضمُّ عناصر متداخلة لا تتوقَّف مفاعيلها على الاستفهام عن الشيء وشيئيَّته، أو على الإنسان بما هو كائن متفرِّد ينطق بالسؤال، ولا كذلك عن سرِّ الوجود المطلق.. وإنَّما أيضًا وأساسًا على السؤال نفسه بما هو سؤال. ويعني ذلك أنَّنا بإزاء مقول ميتافيزيقيٍّ يجاوز ما ذهبت إليه الأرسطيَّة في تعريف الفلسفة “بكونها عبارة عن أسئلة، الأصل فيها دهشة الإنسان بالظواهر التي تحيط به”.
لكنَّ السؤال الذي سنمضي إلى متاخمته هو على شأن آخر أكثر شمولًا وإحاطة. فهو إلى كونه سليل الدهشة في ظاهرها واستتارها، أي أنَّه يسأل عن الشيء وعن حقيقة الشيء، يسأل عمَّا يحتجب وراء هذه الحقيقة ويكون سببًا لتلك الحقيقة في الآن عينه. بهذه المنزلة من الاعتبار يصبح السؤال نفسه ظاهرة. بل الظاهرة الأكثر هولًا وإدهاشًا في اختبارات العقل الإنسانيّ.
مفردات مفتاحيَّة: الكينونة – مثنَّى السؤال والجواب – الوجود الَّلامتناهي – السَّرَيان الجوهريّ – الماهيَّة والهوّيَّة.
تمهيد
حين يُسأل عن ماهيَّة السؤال وأحواله لا يعود ثمَّة مسافة بين السائل وسؤاله، ولا بينه وبين الإجابة المحتملة. وعند ذاك يصير السائل والسؤال والموضوع المسؤول عنه كينونة واحدة. إلَّا أن هذه الكينونة تبقى غير محدَّدة وغير منجزة ما دامت لم تتلقَّ بعد جوابًا لتصبح محدَّدة. ولكي تحصِّل الجواب عمَّا يفصح عنها كماهيَّة وهوّيَّة ودور عليها أن تتطلَّع إلى ما يحتجب وراء الجدار، وأن تسلك دربة الوصول إلى العلم. هنالك فقط تتهيَّأ للتلقّي، ولما يتدفَّق عليها من معارف لا تتأتَّى إلَّا بسؤالٍ شغوف بالإجابة وواعٍ لبعدَيها المرئيِّ والمستتر.
يجدر القول هنا أنَّ الجواب في المنزلة الميتافيزيقيَّة سمْتُه الإقبال في الَّلحظة التي يسمع فيها نداء الاستفهام. لكن ليس أيَّ نوع من النداء، وإنَّما ذاك الساري في حركة جوهريَّة متمدِّدة في فضاء متعدِّد الأبعاد يضمُّ السائل والسؤال والشيء المسؤول عنه. ومتى عرفنا أنَّ الحركة في الجوهر هي حركة دفعيَّة تختزل الزمن، وتنقل الكينونة المثلَّثة الأضلاع من حال التبدُّد والزوال إلى مقام الثبات والديمومة، عرفنا نظير ذلك أنَّ الحركة العرَضيَّة التي تبدأ ثمَّ تتبدَّد، هي حركة تستهلك الزمن، ويستهلكها الزمن، وتكون النتيجة تبديد السؤال وتبديد جوابه على الأثر.
- في مثنَّى السؤال والجواب
السؤال حركة ممتدَّة من مجهول طلبًا إلى معلوم ما. وهو في المآل الأخير رغبة الفكر في الامتداد إلى ما لا يقف فيه عند حدّ. لهذا السبب، غالبًا ما يكون الجواب شقاءً للسؤال. حيث يكون الجواب فتنة للفكر يغويه إلى أسئلة لا نهاية لها. ذلك هو الوجه المحيِّر في كلِّ جواب. إلَّا أنَّ ذلك لا يعني أنَّ الجواب شقي في ذاته. إنَّه واثق من ذاته، ويتميَّز بنوع من السموّ. فالمجيب في النهاية هو أكثر سموًّا من السائل. ذلك بأن الجواب هو نضج السؤال في نهاية المطاف[1].
ما يعنينا في هذا المنفسح هو الاستفهام عن الوجود الذي “يوضع موضع سؤال”، في هذا المقام من الاستفهام يُسلَّط نور السؤال على كلِّ شيء، شأنَّه في ذلك شأن تلك النجوم التي يشتدُّ ضياؤها ويحتدُّ كي تنطفئ. فالقوَّة المضيئة التي تعلو بالوجود نحو الصدارة والتي يظهر الوجود عن طريقها بعد اختفاء وتحجُّب، هي في الوقت نفسه ما يهدِّد الوجود بالاختفاء. أمَّا السؤال فهو تلك الحركة التي يغيّر فيها الوجود مجراه فيظهر كإمكانيَّة مرهونة بدورة الزمان. ربما هذا هو بالضبط مصدر الصمت الذي يطبع الجمل الاستفهاميَّة. لكأنَّ الوجود، عندما يضع نفسه موضع سؤال، يبدو كأنَّه يتخلَّى عن صخب انبثاقه، ليكشف عن نفسه وينفتح، ويفتح الجملة على آفاق جديدة، بحيث تغدو الجملة بذلك الانفتاح فاقدة لمركزها الذاتيِّ الذي يصبح خارجًا عنها ومقيمًا في المحلِّ المحايد[2].
كلُّ سؤال عيش في الماقبل والمابعد في الآن عينه. فالسائل عن الماضي يضمر الَّلحظة التي هو فيها، والمقبل الذي سيحلُّ فيه. وعليه، يكون السؤال جامعًا لوحدات زمنيَّة متضادَّة: الماضي والحاضر والآتي. شأنَّه في هذا شأن المثنَّى في فقه الَّلغة. كلٌّ من طرفي المثنَّى يتمِّم نظيره وهو في غاية الرضى. وعليه فهو في الآن عينه “ما قبل وما بعد معًا”. ذلك بأنَّه متضمَّن في الموضعين ولا يغادرهما قطّ. فالسؤال قاطن في المعرفة وسليلها. وعليه، فهو ممتدٌّ بين الجهل والعلم، وحركته بينهما حركة امتداد جوهريّ. فلو حصل تقدُّم أو تأخُّر في حركة ظهور العلم من الجهل فهذا عائد إلى الشروط الفيزيائيَّة التي تحكم الوعي البشريَّ ضمن دائرة الزمان والمكان. أمَّا الحقيقة فهي تلك الكامنة في السريان الجوهريِّ الذي يتوقَّف ظهوره على التناسب والتطابق بين السؤال والجواب.
لكن السؤال ليس مجرَّد علاقة، وإنَّما هو سيرورة تضمُّ طرفيها وتوحِّد بينهما. العلاقة لا يعوَّل عليها في التناظر داخل الجنس الواحد. فالسؤال والجواب جنس واحد. والتقابل بينهما لا ينبني على التناقص وإنَّما على ضديَّة خلَّاقة تؤول إلى التكامل والانسجام والوحدة. السؤال هو أشبه بإجراء تلقيحيٍّ لوضعيَّة تتمتَّع بالاستعداد للولادة والانبثاق.
السؤال مفطور على المثنَّى. ذلك بأنَّ مبعثه البَدئيَّ مبنيٌّ على طرفين متلازمين لا انفصام لهما: الاستفهام وجوابه. ولأنَّه كذلك فهو محيط بزمنين ومحاطٌ بهما في نفس الآن: 1-زمانُه بما هو مفهوم كليٌّ يناظر الأنطولوجيا (علم الوجود). 2-وزمان الجواب الخاصّ به بوصفه مفهومًا جزئيًّا يتاخم الظواهر السارية في التاريخ. إنَّ هذه الخاصِّية التكوينيَّة للسؤال أكسبته صفة المثنَّى في حضوره المركَّب: الميتافيزيقيّ والتاريخيّ. ما يعني أنَّه في الآن عينه، ما قبل وما بعد، ومبتدأ وخبر، ومبدأ وغاية. مثال: السؤال قاطن في الجهل بالموجود، وهو سليله ولولاه ما ظهر. وهو أيضًا قاطن في العلم وهو سليله ما دام كلُّ علم بشيء يستدعي الاستفهام. هنا يصير السؤال زمانًا ممتدًّا بين الجهل والعلم. إلَّا أنَّ حركته الامتداديَّة هي امتداد وسريان جوهريّ. ولو حصل تقدُّم أو تأخُّر في حركة العلم بشيء ما من بعد الجهل به، فهذا عائد إلى الشروط الفيزيائيَّة الحاكمة على الوعي البشريِّ ضمن دائرة الزمان والمكان. أمَّا الحقيقة فهي السريان الجوهريَّ الذي يتحقَّق ظهوره بالتناسب والتطابق بين السؤال وجوابه.
لكن السؤال ليس مجرَّد علاقة بين مجهول ومعلوم، فماهيَّتُه الأصيلة في الواقع الخارجيِّ غير ماهيَّتها الاعتباريَّة في الذهن. من سمات مقولة العلاقة كما حدّدتها الميتافيزيقا أنَّها بسيطة لا تُدرَك إلَّا بالتركيب، فهي مولود بديهيٌّ لقوانين هذا العالم المتناقض والكثيف ولا تقوم إلَّا به. فالعلاقة لا تحدث إلَّا بين واقعين وأكثر. وإن لم توجد الحدود والوقائع فلا وجود لشيء اسمه علاقة. فالعلاقة ـ على ما تنظر الفلسفة الأولى ـ من أوهن مقولات الفكر، بل إنَّها الأكثر زوالًا وتبدُّلًا. ومع ذلك فهي موجودة مع كونها غير قائمة بذاتها. بها تظهر الأشياء متَّحدة من دون أن تختلط، ومتميّزة من دون أن تتفكَّك. وبها تنتظم الأشياء، وتتألَّف فكرة الكون. إنَّها تقتضي الوحدة والكثرة في آن. هي واحدة، وكثيرة بحكم خصيصة الأُلفة التي حظيت بها بين البساطة والتركيب. على صعيد الفكر تربط (العلاقة) بين مواضيع فكريَّة مختلفة وتجمعها في إدراك عقليٍّ واحد، تارة بسببيَّة، وأخرى بتشابه أو تضادّ، وثالثة بقرب أو بعد. وعلى صعيد الواقع فإنَّها تجمع بين أقسام كيان واقعيٍّ أو بين كائنات كاملة محافظة عليها في تعدُّدها. وهكذا يستحيل تقديم توصيف محدَّد للعلاقة، حيث لا وجود مستقلّ لها. إنَّها كالماهيَّة من وجهٍ ما، لا موجودة ولا معدومة إلَّا إذا عرض عليها الوجود لتكون به ويكون بها. لذلك سيقول عنها أرسطو، إنَّها واحدة من المقولات العشر، وهي عَرَضٌ يظهر لدى الكائن بمثابة اتِّجاه. أي أنَّها صوب آخر، تطلُّع، ميلٌ، مرجعٌ، ويقتضي دائمًا لظهوره وجود كائنين متقابلين على الأقلّ. صاحب العلاقة وقطبها الآخر، ثمَّ الاتصال بينهما[3].
2- المثنَّى كحاضن للسؤال والجواب
كلُّ جملة تجد تتمَّتِها واستمرارها في أخرى. إلَّا أنَّ السؤال لا يجد تتمَّته واستمراره في الجواب. إنَّه، على العكس من ذلك، ينتهي وينغلق بفضل الجواب. ليقيم السؤال نوعًا من العلاقة التي تتميَّز بالانفتاح والحركة الحرَّة. وما يحدِّده ردًّا واستجابة هو بالضبط ما يوقف مدَّ الحركة ويسدُّ أمامها الأبواب. يتلهَّف السؤال إلى الجواب وينتظره، لكنَّ الجواب لا يهدِّئ من روع السؤال. وحتى إن هو قضى عليه وأوقفه فإنَّه لا يقضي على الانتظار الذي هو سؤال السؤال. السؤال والجواب، بين هذين الطرفين مواجهة وعلاقة غريبة، من حيث إنَّ السؤال يتوخَّى من الجواب ما هو غريب عنه، كما يريد في الوقت نفسه أن يظلَّ قائمًا في الجواب كحركة يريد الجواب إيقافها ليخلد إلى الراحة. غير أنَّ على الجواب، عندما يجيب، أن يستعيد ماهيَّة السؤال التي لا يذيبها ما يجيب عنه.
السؤال بما هو سؤال لا محمول له من دون موضوع يحمله. فلا وجود له في الخارج بلا موضوعه. فعندما نطرح سؤالًا عن شيء ما لا يكون هذا السؤال مستقلًّا عن ذلك الشيء. وهنا تكمن خصوصيَّته كمفهوم لا نظير له بين المفاهيم.
أمَّا السؤال فلا يقوم على النفي، لأنَّه ليس نقيض الجواب بل ثمَّة تقابل الوقت والانتظار. وإنَّما سيرورة تناظر تضمُّ طرفيها وتوحِّد بينهما. السؤال والجواب من جنس واحد. والتقابل بينهما لا ينبني على التناقض وإنما على ضدِّيَّة خلّاقة تؤول إلى التكامل والانسجام والوحدة. ولذا فإنَّ فعاليَّة السؤال أشبه بإجراء تلقيحيٍّ لوضعيَّة طبيعيَّة أو فوق طبيعيَّة تتمتَّع بالاستعداد للولادة والانبثاق.
المثنَّى واحد وإن تركَّب من صورتين. ذلك بأنَّ كلًّا من هاتين الصورتين المؤلِّفتين للمثنَّى هي صفة من صفات واحديَّته. لذلك يكون السؤال وجوابه جوهر واحديَّة المثنَّى. ومزيَّة السؤال بوصف كونه مثنَّى أنَّه جوهر يحمل صفتين متلازمتين: الاستفهام والإجابة. وهاتان الصفتان موقعهما واحد في الزمان المطلق. متكثِّرٌ في الزمان الجزئيّ.
فقد يتميَّز شيئان متباينان أحدهما عن الآخر، إمَّا بتنوُّع صفات هذه الجواهر، أو بتنوُّع أعراض هذه الجواهر، فلو وجدت جواهر عدَّة متميّزة بعضها عن بعض لكان تميُّزها إمَّا بتنوُّع الصفات أو بتنوُّع الأعراض. وإذا كان تميُّزها بتنوُّع الصفات فحسب، فإنَّنا سنسلِّم إذًا بأنَّه لا يوجد غير جوهر واحد للصفة الواحدة. وإذا كان تميُّزهما بتنوُّع الأعراض، وبما أنَّ الجوهر متقدِّم بالطبع على أعراضه، فإنَّنا لا نستطيع، -إن نحن أبعدنا الأعراض واعتبرنا الجوهر في ذاته، أي من منظور الحقيقة – أن نتصوَّره متميّزًا عن جوهر آخر. بمعنى أنَّه لا يمكن أن يوجد في الطبيعة جوهران لهما صفة واحدة، أي أنَّهما يتَّفقان في شيء ما. وتبعًا لذلك فإنَّه لا يمكن لأحدهما أن يكون علَّة للآخر، بمعنى أنَّه لا يمكن لأحدهما أن ينتج من الآخر. وما يبرهن على هذه القضيَّة أنَّه لو أمكن للجوهر أن ينتج من شيء آخر لكانت معرفته متوقِّفة على معرفة علَّته، وبالتالي لما كان الجوهر جوهرًا.[4]
وعليه، لا يعمل السؤال وجوابه خارج المثنَّى.. ولا يرتضي لنفسه أن يكون انشقاق الواحد عن الإثنين، بحيث لو تآلف هذان الإثنان من بعد المكابدة في مشقَّة التناقض، أن يظهر كثالث يروح يستعيد استبداد الأنا بالغير ليصبح أولًا من جديد.
بهذه الصيرورة لا يُشتقُّ السؤال من نقيضين: الأنا السائلة والآخر المجيب. بل السؤال بوصفه إرادة استفهام هو ممَّا يُشتقُّ منه، لا من سواه، نظرًا لأصالته وفعاليَّاته التوليديَّة، يستطيع صاحب السؤال أن يتمثَّل حال سواه ويكونه، بشرط أن يعقد النيَّة على الخروج من كهف الثنائيَّة واحترابها. ففي هذا الكهف تحتدم الأنا مع كلِّ من يغايرها هويَّتها. وفي هذه الحال يستحيل كلٌّ منهما نقيضين متنافرين لا يلتقيان على كلمة سواء. بل قد يسعى كلٌّ منهما إلى تدمير نظيره، أو-في أحسن حال- ليقيم معه توازن هلع لا يلبث بعد هنيهة أن ينفجر لتصيب شظاياه الإثنين معًا. ولنا هنا على سبيل المناسبة أن نذكر شاهدًا من مختبرات الحداثة الغربيَّة:
كان نيتشه – وهو ينقد ثنائيَّة الخير والشرِّ في عقل الغرب- يتساءل عن الكيفيَّة التي يمكن لشيء ما أن يولد من نقيضه: الحقيقة من الضلال، إرادة الحقيقة من إرادة الخداع، الفعل الغيريّ من المصلحة الذاتيَّة. ونظر الحكيم النيّر الخالص من الشهوة… وإنّ تولُّدًا من هذا النوع ممتنع –كما يقول نيتشه-.. إذ يجب أن يكون للأشياء ذات القيمة الأسمى منبع آخر وخاصّ. وهذه القيمة لا يمكن أن تُشتقَّ من هذه الدنيا الفانية الغاوية المخادعة الوضيعة، أو من هذا الهرج والمرج من الأوهام والأهواء. إنَّ منبع هذه القيمة الأسمى يجب أن يكون هنالك في حضن الكون، في الَّلافاني في الإله المخفيِّ، في الشيء في ذاته، هناك، وليس في محل آخر”[5].
ولكن، من أين للعالم بسؤال ينقله من جحيم النفي والإقصاء إلى فردوس الفضيلة والاستقبال والرحمانيَّة؟
يمكن القول أنَّ نيتشه أكثر فلاسفة الحداثة ممَّن أسّسوا لسؤال ينفذ إلى الحدود القصوى لاستكناه حقائق العالم الخفيَّة. لقد رأى أنَّ إيمان الميتافيزيقيين الأصليَّ وفي كلِّ الأزمنة، هو الإيمان بأضداد القِيم. ثمَّ ليبيّن “أنَّ علينا أن نترقّب جنسًا جديدًا من الفلاسفة، من الذين لهم ذوق ما، وميلٌ ما، مغاير ومعاكس لأسلافهم.. ولنقل بكلِّ جدّ – كما يقول- : إنّي أرى بزوغ مثل هؤلاء الفلاسفة الجدد[6]“.
هذا الميل المعاكس الذي يريده نيتشه من نبوءته التي مرَّت معنا، هي بالضبط ما يقصده بـ”الإنسان الخلَّاق للفهم” الذي وجده في حكمة زرادشت. فسنرى مثلًا، أنَّ الواجب الأول في تأويليَّته يعني الانتصار على الذات. لذا كان يردِّد على الدوام أنَّ الإنسانيَّة التي يطمح كلُّ إنسان إلى تجاوزها هي إنسانيَّته بالذات بالمساءلة. ولقد كانت الخشية العظمى التي تسكنه هي الإضرار بالغير. أمَّا العدالة بهذا الاعتبار، فهي ليست مجرَّد مكافأة تمنُّ بها الأنا السائلة على سواها من أجل تمنحها الإجابة. العدالة عنده عطاءٌ مجانيٌّ تتجاوز ذاتها في سخاء بلا حدود طبقًا لما ورد في كتابه الأثير “هكذا تكلَّم زرادشت”: “أحب ذلك الشخص الذي يعطي دائمًا ولا يريد حفظ نفسه”.
السؤال الذي ينمو في واحديَّة المثنَّى يصير كلُّ شيء بالنسبة إليه قابلًا لسريان الزوجيَّة الخلَّاقة في الوجود. لقد صار الأمر بيّنًا لمن رأى نقيضه قائمًا في ذاته، وفي هذه الحال لا حاجة لأحدٍ من طرفي الزوجيَّة إلى البحث عن صاحبه في غير ذات زوجه، لأنَّ كلًّا من الزوجين النقيضين قائمٌ في ذات الآخر، وكلٌّ منهما يحسُّ بزوجه، ولولا رؤية كلٍّ من الباطن والظاهر قائمًا في الآخر لما استطاع الإنسان أن يتلاءم مع صروف الدهر، فيحيا النقيض في نقيضه، ليُعدَّ لكلِّ حال عدَّته مزوّدًا من غناه لفقره، ومن صحَّته لمرضه، ومن راحته لتعبه ومن شبابه لهرمه. وإذا كان الفردُ العاديُّ يحيا هذا التناقض فطرةً وسليقةً وطبعًا بحياته النقيضين معًا، فإنَّه على بصيرة من أمره، فكيف حياة أهل الغرام التي لا يعرفها إلَّا أصحابها، ولعلَّ السبب في غيابها عنَّا هو أنَّنا قد تجافينا عن فطرتنا، فلم نعش النقيض قائمًا في ذات نقيضه؟
ولهذا كان علمُنا بباطن الشيء يجعلنا نعلم ظاهره ضرورة وبداهة والعكس بالعكس[7]. ولنا في هذا مثال: فلو علمتَ أنَّ الحركة في كلٍّ من الزوجين النقيضين من كلِّ شيء، تنتهي وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، لوجدت أنَّ السبب في ذلك إنَّما هو من أجل أن تظلَّ مستمرَّة دائمًا وأبدًا. فالشيء المتحرِّك الذي تنتهي حركته في أحد الزوجين وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، إنَّما هي حركةٌ مستمرةٌ لا تتوقَّف، وفيها تتمثَّل الصلة بين الخالق والمخلوق،- وبين النظير ونظيره-، وذلك في صورة رحمته التي وسعت كلَّ شيء. وفي استمرار هذه الصلة المتبادلة على السواء والتعادل المتبادل ، يتجلَّى سرُّ هذا الوجود في صورة قيام النهاية في البداية والبداية في النهاية في كلِّ شيء[8]. فإذا نظرت مثلًا إلى معنى التزاوج الذي يتَّجه إلى الاتِّصال مستقلًّا عن معنى التجاوز الذي يتجه إلى تعدي الشيْ الذي تتجاوزه منفصلاً عنه، وجدت أنه ليس إلى تعرّف أيٍّ منهما من سبيل إلَّا من خلال الآخر.
إذن، يقوم المثنَّى على رابطة التماثل والانسجام والتكامل. وأمَّا الاثنينيَّة فتقوم على جدليَّة التناقض؛ حيث ينفي الحقُّ وجود الباطل؛ لذا يدخل الحقُّ والباطل في علاقة تناقض، أمَّا وجود الأبيض في تضادٍّ مع الأسود، والصلة بينهما صلة تضادّ، فالحالتان المتضادَّتان إذا تتالتا، أو اجتمعتا معًا في نفس المدرك كان شعوره بهما أتمَّ وأوضح، وهذا لا يَصدق على الإحساسات والإدراكات والصور العقليَّة فحسب بل يصدق أيضًا على جميع حالات الشعور كالَّلذة والألم والتعب والراحة.. فالحالات النفسيَّة المتضادَّة يوضح بعضها بعضًا، وبضدِّها تتميَّز الأشياء، وقانون التضادِّ أحد قوانين التداعي والتقابل[9].
والتقابل (opposition) (هو علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخر، أو علاقة بين متحرّكين يقتربان سوية من نقطة واحدة، أو يبتعدان عنها، وفي المنطق يأخذ التقابل وجهين أحدهما تقابل الحدود، والآخر هو تقابل القضايا. فالمتقابلان في تقابل الحدود هما الَّلذان لا يجتمعان في شيء واحد، في زمان واحد، ويمكن التمييز هنا بين أربعة أقسام، أو أنواع من التقابل:
1- تقابل السلب والإيجاب مثل الشعور والَّلاشعور.
2- تقابل المتضايفين مثل الأبوَّة والبنوَّة.
3- تقابل الضدَّين مثل السواد والبياض.
4- تقابل العدم والملكة مثل العمى والبصر.
أمَّا تقابل القضايا فيطلق على القضيَّتين الَّلتين تختلفان بالكمِّ، أو بالكيف أو بهما معًا، ويكون موضوعهما أو محمولهما واحدًا، ولهذا التقابل أربعة أقسام أيضًا[10].
ـ التداخل عند اختلاف القضيَّتين بالكم فقط.
ـ التضادُّ عند اختلافهما بالكيف فقط.
ـ التضادُّ الفرعي عند الاختلاف بالكيف فقط شرط أن تكون كلٌّ من القضيَّتين جزئيَّة.
ـ التناقض عند الاختلاف بالكمِّ والكيف معًا[11].
وهكذا لا ترضى طبيعة العقل البشريِّ بالفصل، فحين تقوم بعمليَّة التقابل الثنائيِّ تضع الطرف الأول في حال تعارض مع الطرف الثاني، ومع أطراف أخرى تشترك معه في الحال، أو الصفة… لكنَّ هذين الطرفين إذا نظرنا إليهما على أنَّهما طرفا عصا فثمَّة ما يربط بينهما، ويشكِّل موقعًا وسطًا هو ما يمكن أن نسمّيه حال شبه التضادّ، أو العلاقة بين طرفي الثنائيَّة، فـ لا يرضى الدماغ البشريُّ عن الانفصال الناجم عن إقامة مثل هذا التقابل القطبيِّ، فيبحث عن موقع وسط”.[12] فثمَّة منطقة وسطى بين السالب والموجب في الفكر الفلسفيِّ تربط بين الطرفين، ويستطيع الدماغ البشريُّ أن يلتقط المنطقة الوسطى بين طرفي الثنائيَّة، أو الجزء الأوسط الواقع بين حدَّيها. وقد مثَّل كلود ليفي شتراوس لهذه العمليَّة بالإشارات الضوئيَّة، فثمَّة إشارة وسط بين الأحمر والأخضر تتيح مسافة للذهن البشريِّ؛ ليتهيَّأ، والفعل البشريُّ هو الذي يختارها[13]. وعليه يشترط في الضدَّين أن يكونا من جنس واحد كالَّلذة / الألم “هما من الكيفيَّات النفسيَّة الأوليَّة، فليست الَّلذة خروجًا من الألم، ولا الألم خروجًا من الَّلذة، بل الَّلذة والألم كلاهما وجوديَّان، ولكلٍّ منهما شروط خاصَّة تدلُّ على أنَّهما إيجابيَّان”[14] والإيجاب / السلب “والإيجاب عند الفلاسفة هو إيقاع النسبة وإيجادها، وفي الجملة هو الحكم بوجود محمول لموضوع، وهو نقيض السلب، كما أن الإثبات هو نقيض النفي”[15].
وتشكل الأضداد ما يسمى بقانون وحدة الأضداد وصراعها، فكل شيء يحتوي على أضداد، ووحدة الأضداد نسبية، وصراعها مطلق، وهو قانون “مطلق للواقع، وفهمه بالعقل الإنساني يعبر عن ماهية الجدل المادي ولبّه.. وصراع الأضداد يعني أن التناقض داخل ماهية شيء ما يتم حلُّه بشكل دائم، ولما كان يُعاد تقديمه بشكل دائم فإنَّه يتسبَّب في تحويل القديم إلى جديد… وقد فسَّرت الماركسيَّة، وعرفت قانون وحدة الأضداد بأنَّه قانون المعرفة، وقانون العالم الموضوعيّ”[16].
أمَّا الضدّيَّة في المثنَّى فهي تعني وجود أمرين متضادَّين مرتبطين برباط واحد، وهو مبدأ يقوم عليها إيقاع الكون ونظامه، فالنور والظلمة في النهار والليل ثنائيَّة ضديَّة يجمعها اليوم، والفرح والحزن متضادَّان، ويختفي أحدهما وراء الآخر، وكذلك النجاح والفشل، والغنى والفقر، والعلم والجهل…. لكن العلاقة بين الثنائيَّات الضديَّة علاقة تضادّ؛ أي تواز بين طرفي الثنائيَّة، أمَّا علاقة التناقض فتقوم على النفي، فوجود طرف ينفي وجود الطرف الآخر[17].
- ميتافيزيقا الاستفهام
نقصد بكلامنا على “السؤال المؤسِّس”. ذات الذي يؤسَّسُ منه وعليه فهم الوجود كوجود بالذات، والتعرُّف على الموجود بما هو موجود. ما يعني ان حقيقة التأسيس في هذا السؤال مبنيَّة على تلازم وطيد بين الأنطولوجيِّ (علم الوجود) والفينومينولوجيِّ (علم ظواهر الوجود). أمَّا جلاء هذه الحقيقة فلا يتأتَّى من التشطير بين المرتبتين، وإنَّما من التجانس والانسجام بينهما، حيث يكون السؤال مطابقًا لكلِّ مرتبة وجوديَّة بقَدَرِها.
وما كنَّا لنتطلَّع إلى سؤال يؤسِّس ويفتح على بدءٍ جديد، إلا لإخفاق الميتافيزيقا في الإفلات من عالم الممكنات. فالأسئلة الناشئةَ من هذا العالم والمشدودةُ إليه هي أسئلة تتبدَّد تبعًا لتبدِّد موضوعاتها. أمَّا السؤال المؤسِّس فسمْتُه الأصالة والامتداد ومجاوزة الممكنات العارضة. ذلك رغم الاعتناء بها من جهة كونها ممرًّا ضروريًّا الى متاخمة المطلق. هو إذًا سؤال جوهريٌّ أصيل ولا يتبدَّد لأنَّه موصول بالَّلامتناهي. لأنَّه بالمطلق يكتسب السؤال المؤسِّس القدرة على التأسيس للمابعد. حيث لا يحد من تجدُّده وديمومته تعاقب الزمن الفيزيائيِّ مهما تنوَّعت موضوعاته وتكثَّرت أحداثه.
والسؤال المؤسِّس يرقب كلَّ سؤال يأتي من بعده. يعاينُه ويعتني به ويسدِّدُه. والأثر المترتِّب على المعاينة والاعتناء والتسديد لا يقتصر على نتائج المراقبة والفحص لجهة صوابها أو خطأِها، وإنَّما في معرفة صواب وخطأ السؤال نفسه. أي أنَّ المؤسِّس يعاين حصاد عمله في ما هو يعتني بكلِّ سؤال فرعيٍّ ويختبر جدواه. فلو جاءت النتيجة، على سبيل المثال، باطلة، ذلك يعني أن السؤال نفسه يحمل في داخله علَّة بطلانه. إنَّها طريقة عمل السؤال المؤسِّس التي تتوسَّل حكم الواقع لا حكم القيمة. تبعًا لهذه الطريقة لا أحكامُه متعلِّقة بخيريَّة مقاصد الفكرة أو حسن طويَّتها، وإنَّما بالظرف الزمانيِّ والمكانيِّ التي ولدت فيه. وهو ما تشير إليه القاعدة التالية: إنَّ حقَّانيَّة كلِّ استفهام تعود إلى التناسب بين لحظة صدوره والَّلحظة التي يستجاب له فيها. على سبيل المثال، لو أخذنا بفكرة ما لنصنع منها حدثًا تاريخيًّا، فإنَّ سريانها في الواقع من أجل أن تحقِّق غايتها لا يتوقَّف على مشروعيَّتها الأخلاقيَّة فحسب، وإنَّما أيضًا على تناسبها مع أوان ظهورها، أي على توفُّر الشروط الزمانيَّة والمكانيَّة المناسبة لماهيَّتها وأصلها. فالفكرة التي تظهر في غير أوانها لا تبطل فقط لأنَّ الظروف لم تكن ناضجة لولادتها الطبيعيَّة، وإنَّما لخلل في ذات الفكرة نفسها. فالسؤال المؤسِّس بصير بظروف الزمان والمكان، يستدلُّ ويدلُّ، يستهدي ويهدي، يدبِّر الفكرة ويرعاها بعقل صارم، ولا يهمُّه حُسن مظهرها وقوَّة جاذبيَّتها. والفكرة التي تستثير دهشة سائلها وحيرتِه، هي وليدة ظرف زمانيٍّ ومكانيٍّ محدَّد. لهذا السبب تروح تُفرغ كلَّ طاقتها ضمن هذين الظرفين ولا تتعدَّاهما. فإنَّما هي محكومة بوعي تاريخيٍّ معيَّن تستجيب له وتنتهي بانتهائه. وعليه، فإنَّ للأفكار بَدءًا وختامًا، ومبتدأ وخبرًا. وهي ككلِّ العوالم تولد وتعيش ثمَّ تشيخ وتؤول إلى الانتهاء. ولأنَّها متعلِّقة بزمان حدوثها وجغرافيَّته كان لكلِّ فكرة مكان تولد فيه وتنمو حتى تؤدّي الغاية من ولادتها.
والسؤال المؤسِّس محيط بمبتدأ الأفكار وخواتيمها. ومتبصِّرٌ في مسار زمن الكائن الإنسانيِّ ومآلاته. من أجل ذلك، كان له أن يحظى بمكانة أصيلة في علم الإلهيَّات وفي فلسفة التاريخ. وهذه المكانة متأتّية من توفُّره على تكوين ذاتيٍّ يمكِّنه من متاخمة الوجود بحاضريَّتيه المطلقة والنسبيَّة. ولذا فهو سؤال أصيل التناسب بين لحظة صدور الفكرة وزمن تحقُّقها في واقع محدَّد. على حين أنَّ تحويل الفكرة إلى حدث هو أمرٌ غير مرهون فحسب برغبة السائل والميقات الذي يحدِّده لتلقّي الجواب وإنَّما يعود إلى ما تقرِّره روح الزمن التي تحدِّد الوقت الأنسب لمثل هذا التحويل. فلكي يكتمل السؤال المؤسِّس وينجز ذاته سيكون على سائله أن يبذل جهدًا مضنيًا للعثور على ما يؤسِّس لآفاق الفكر وما يوقظ التاريخ من كسلِهِ ووهنه، وكذلك ما يحمل على التساؤل عمَّا يحتجب أو يتعذَّر فهمه.
العثور على استفهام يؤسِّس للآفاق فعل مبدع. فهو إمَّا أن يكون استئنافًا ليقظة بعد إخفاق، وإمَّا أنَّه بدءٌ مستحدث غير مسبوق بنظير. وفي كلا الحالين يحتاج الأمر إلى استراتيجيَّة مسدَّدة بجميل الصبر. فلا شيء يقوى على الزمن وما يكتظُّ به من أسئلة قهريَّة سواه. ولو شئنا أن نجعل الصبر منهجًا لأقمناه في فضاء يتعدَّى زمان الصابر ومسكنه. فبذلك يستطيع من اتَّخذ سيريَّة الصبر دُربةً له أن يتلقَّى الجواب من دون أن يستيئس، أو أن ينال منه ضيق الصدر. والصبر مقولة زمانيَّة لا يستطيع السؤال المؤسِّس أن يحظى بأهليَّة التأسيس إلَّا بتدبُّرها. ذلك بأنَّ جلاء كلِّ غامض أو مجهول، سواء في عالم المعقولات المجرَّدة أم في عالم الممكنات الحسّيَّة، يلزمه عزم دؤوب على احتواء الزمن. وعليه، فإنَّ شرط إنجاز السؤال المؤسِّس نفسه، هو في تمكُّنه من السيطرة على زمن الاستفهام عن الكينونة وما فيها. أمَّا لو تعجَّل السائل تحصيل الجواب على ما سأل بقي سؤاله ناقصًا. ففي هذه الحال لا يعود يتسنَّى للسائل أن يعقد ميثاقًا مع المجيب ليأتيه بالإجابة. والإجابة المأمولة تمكث هنالك في مكان ما من المقبل، فمتى آنت مدَّتها أقبلت نحو طالبها كأنَّما تجيء إليه من هيكل الكمال الأبديّ. السؤال الذي كمُلَت عناصره وصار أهلًا للتأسيس جوابُه كامن فيه من قبل أن يظهر إلى العلن. ولأنَّ العلاقة بين السؤال والجواب هي علاقة إيجاد وتبادل، فإنَّ مقوِّمات السؤال المتشكِّلة من ضرورات الَّلحظة ومن وعي السائل بها، هي ما تجعل كلَّ سؤال فرعيٍّ على عهد وثيق بالسؤال المؤسِّس. ولهذه العمليَّة التبادليَّة لها زمانها الوجوديُّ الخاصُّ؛ حيث يتعرَّف السائل على ما يسأل عنه بواسطة السؤال نفسه. أي بالسؤال الذي ينضج ويكتمل قوامه بصبر المتدبِّر على المطلوب.
كان الفيلسوف الألمانيُّ فرانز فون بادر Franz Von Baader (1756- 1841) (وهو أحد أهمِّ فلاسفة عصر المثاليَّة الألمانيَّة) يتحدَّث عن المبدأ الذي يؤسِّس ويؤسَّس منه وعليه. وقد قارب موضوعه الشائك على نحو فارق فيه معظم فلاسفة الحداثة من ديكارت مرورًا بكانط وصولًا إلى هيغل ومن تبعهم[18].
تبتدئ الفلسفة عند بادر بالسؤال عن الذي يؤسِّس بنية الكينونة والتفكير. ويقصد بذلك المبدأ الأساسيّ الذي يُحدث الكينونة ويؤيّدها ويرعاها. هذا المبدأ يجيء إثر النسيان الذي اقترفته الميتافيزيقا الأولى بحقِّ الوجود ثمَّ سرى بالوراثة إلى أزمنة الحداثة. وهو يذكّر بهذا المبدأ الذي يخلق ويؤسِّس ويدعم في الوقت نفسه. هو عنده أكثر من مجرَّد سبب أوَّل، أو محرّك أول كما وصفه أرسطو مثلًا. فعندما يكون الذي يُحدث ويؤيّد ويساعد مؤسِّسًا فبديهيٌّ أن يكون هو الذي يُحدث ويؤيّد ويساعد. فالمحدِث والمؤسّس الأول لا يمكن أن يُحدث ويؤسّس غيره من قبل أن يُحدث ويؤسّس نفسه أولًا. ومن خلال كونه مؤسِّسًا لذاته فقط، يمكن لذاتيّ التأسيس أن يؤسّس.
لقد رأى أنَّه لا يمكن لسببيَّة أُولى لا تكون مؤسَّسة بذاتها أن تكون سببيَّة أُولى. وأيُّ تفكير لا يكون تفكيرًا نابعًا من ذاته وواعيًا لذاته وللغير، لا يمكن أن يكون مؤسِّسًا ومُحدِثا للتفكير والوعي. فالسببيَّة الأولى سببيَّة أولى لأنَّ الإحداث يعني التأسيس بالذات، والتفكير بالذات والوعي بالذات. وإنَّ هذا الإحداث للذَّات وإنشاء الذات لا يمكن أن يحدث بأيِّ شكل في العالم المتناهي، وإنَّما في حياة الحقيقة الإلهيَّة الَّلامشروطة والأزليَّة والتي لا بداية لها[19].
فالمبدأ المؤسِّس بحقٍّ هو الذي يولِّد المعرفة وكلَّ ما يتعلَّقبها. ذلك بأنَّ المعرفة المطلقة والخالقيَّة المطلقة تتماهيان في المبدأ. أي مطابقة روح السؤال مع روح الاستجابة. وبذلك يكون المبدأ المؤسِّس للسؤال المؤسِّس مبدأ حقانيًّا، يتاخم الأبديَّة ويرعاها بقدر ما يفيض على الزمان الطبيعيِّ ويرعى أحقابه المتفاوتة في ضعفها وشدَّتها. لذلك فإنَّ من السمات الجوهريَّة للمبدأ المؤسِّس هو التنبيه إلى أن تماهي الذات والموضوع في العقل الواعي لذاته يفضي إلى إدراكهما معًا بحيث يدرك عندما يُحدِث. وعندما لا يكون وعي الذات تماهيًا أزليًّا بين الذات والموضوع لا يكون تماهياً حقيقياً؛ لأن التماهي بين ما يُحدِث وبين ما يُحدَث، والتماهي بين ذات وموضوع الوعي الذاتيِّ الذي لا ينشأ إلَّا في الزمن، ليس تماهيًا، بل هو تعاقب وإلغاء للفوارق. وهذه المعرفة الَّلاأوليَّة أو الثانويَّة هي معرفة ذاتيَّة لكلِّ عقلٍ متناهٍ. والعقل المتناهي لا يؤسِّس ولا يحدِث نفسه، ولا يُعرف إلَّا بكونه معروفًا من الروح المطلق الذي أحدثه. أمَّا النتيجة التي يتوصَّل إليها فون بادر فهي التنظير لنظريَّة معرفة تقوم على الوصل بين الموجود والواجد، وعلى رعاية المبدأ المؤسِّس للموجودات بحيث لا يغادرها قيد أنملة: وبناء على هذه النتيجة يصبح كلُّ تفكير ذاتيٍّ للموجود المحدود مفكَّر فيه، ويعرِف بمعرفته أنَّه مفكَّر فيه في الوقت نفسه. بذلك يكون بادر أول من أماط الِّلثام عن الخلل العرفيِّ في ذاتيَّة الكوجيتو الديكارتيِّ، على أساس أن “الأنا أفكر” (الكوجيتو) هي دائمًا في الوقت نفسه «أنا مفكّرٌ فيّ إذا أنا أفكٍّر (cogitor ergo cogito)[20].
- ماهيَّة السؤال المؤسِّس وجوابه
تظهر ماهيَّة السؤال المؤسِّس في التعرُّف على ثلاثة أركان: على السؤال نفسه، وعلى أحوال السائل، وعلى فعاليَّاته في المجالين الأنطولوجيِّ والتاريخيِّ. وما من ريب في أنَّ مهمَّة كهذه تنطوي على عناصر متداخلة لا تتوقَّف أبعادها على الاستفهام عن الشيء وشيئيَّته، أو على فرادة الإنسان بما هو كائن يسأل، ولا كذلك عن سرِّ الوجود المطلق.. وإنَّما أساسًا على السؤال بما هو سؤال. أي على جوهريَّته وحضوره كقيمة أصيلة في الحيوات الإنسانيَّة. ما يعني أنَّنا بإزاء مقولٍ أنطولوجيٍّ يضاعف ممَّا ذهبت إليه الفلسفة الأولى في تعريف الفلسفة “بكونها عبارة عن أسئلة، الأصل فيها دهشة الإنسان بالظواهر التي تحيط به”. لكنَّ السؤال، والسؤال المؤسِّس على وجه الخصوص، هو الظاهرة الأكثر هولًا وإدهاشًا في اختبارات العقل البشريِّ الواعي. حين يُسأل عن السؤال وأحواله لا يعود ثمَّة مسافة بين السائل وسؤاله، ولا بينه وبين الإجابة المحتملة. في لحظة بَدئه وانبثاقه يصير السائل والسؤال والموضوع المتعرَّف عليه كينونة واحدة. إلَّا أنَّ المؤسِّس بحكم طبيعته المؤسِّسة ينبري إلى الاعتناء بعالم الكثرة ليحدِّد لكلِّ فرد من أفرادها ماهيَّته وهوّيَّته والدور المناط به في الزمان والمكان المحدَّدين. لذا تبقى الكينونة غير محدَّدة وغير منجزة ما دامت لم تتلقَّ بعد جوابًا عمَّا تطلبه لتصبح محدَّدة. ولكي تحصِّل الكينونة الجواب عمَّا يفصح عنها كماهيَّة وهوّيَّة ودور عليها أن تتطلَّع إلى المقبل، وأن تنتقل إليه وتستوطنه لتعيشه بكثافته ولطائفه. فهناك تتهيَّأ للتلقّي. الجواب سمْتُه الإقبال في الَّلحظة التي يسمع فيها نداء السؤال. لكن ذلك السؤال الذي يسري ضمن حركة جوهريَّة مطابقة لروح الكينونة المتشكِّلة من ثلاثيَّة السائل والسؤال والشيء المسؤول عنه. ذلك بأنَّ الحركة في الجوهر هي حركة دفعيَّة تختزل الزمن وتنقل الكينونة المثلَّثة الأضلاع من حال التبدُّد والزوال إلى مقام الثبات والديمومة. وهي على خلاف الحركة الامتداديَّة الفيزيائيَّة التي تستهلك الزمن ويستهلكها، وتكون النتيجة تبديد السؤال وتبديد جوابه.
لقد اختبر العقل البشريُّ بالسؤال أول تمرين له في رحلة التعرُّف على مثلث الوجود: الله، الكون، الإنسان. وبه فُتِحَ بابُ التعرُّف على ما يستتر عن العين والعقل. فقد أقرَّ له العقلاء منذ الزمن الأول بهذه المزيَّة، حتى صار السؤال عندهم دُربةَ الفكر إلى فهم ما استغلق عليهم من حقائق. وما ذلك إلَّا لكون الاستفهام علامة دالَّة على سَرَيان العقل في الزمان الَّلامحدود، وبالتالي قدرة الإنسان على تقسيمه وترتيبه ونظمه ضمن مواقيت محدَّدة تناسب شرائط عيشه.
مؤدَّى ما نقصده، أن ما لا يؤسِّس لا يعوَّل عليه. وأن مقتضى التأسيس متاخمة منابت الأفهام والأفكار وتمييز صوابها من بطلانها، ثمَّ إعادة تأليفها تبعًا لتحوُّلات الأزمنة ومقتضياتها. ما يعني أنَّ السعي للعثور على مبدأ مؤسِّس هو فعلٌ زمانيٌّ ومكانيٌّ بقدر ما هو فعلٌ يجاوز الزمان والمكان. ومثل هذا الاختبار لا يقدر عليه في عالم الموجودات إلَّا الإنسان الذي جاهر بالسؤال، فيما سائر الموجودات تسأل عن حاجاتها بخفاء. لكن وفقًا لمبدأ التكامل فإنَّ جميع ما في العالم على تراتب موجوداته واختلافها في الاختبار يفعل فيه. الإنسان وما يحيط به من موجودات كلٌّ له نصيبه في التأسيس، وكلٌّ بحسب وضعيَّته الوجوديَّة. ذلك بأنَّ رسم حدود التمايز بين الإنسان والشيء لا يعني تغييب الشيء عن الحضور بوصفه عنصرًا جوهريًّا في تكوين هذا السؤال. فالكائنات كلُّها مطويَّة فيه ومتضمَّنة في غضونه، ولولاها لما كان للسؤال أن يُسأل، ولا كان له أن يكون سؤالًا يستدرج الإجابة.
حتى الاستفهام عن المطلق الذي يفترضه الذهن البشريُّ حين يتأمَّل عالم المعنى، لا ينفصل البتَّة عن عالم الممكنات. فعالم الإمكان ضروريٌّ في تظهير السؤال المؤسِّس والتعرُّف على إمكانيَّاته ووعوده. وما ذاك إلَّا لأنَّ الممكنات التي تمدُّ الحياة الإنسانيَّة بأسباب القدرة والديمومة هي التي تصنع للسؤال مواقيته ومكان حدوثه. لكن السؤال المؤسِّس رغم عنايته بعالم الإمكان يبقى متعلّقًا بمهمَّته الأصليَّة من خلال اعتنائه بالحقيقة المؤسِّسة للوجود. وعليه، لا يُنجز الاستفسار عن الشيء وشيئيَّته، ولا عن الموجود بما هو موجود، بمعزل عن هذه المهمَّة. فقد بذلت الميتافيزيقا مذ أبصرت النور في أرض الإغريق وإلى يومنا الحاضر ما لا حصر له من المكابدات إلَّا أنَّها غالبًا ما انتهت إلى الَّلايقين. لقد اختبرت النومين (الشيء في ذاته) والفينومين (الشيء كما يظهر) وكانت النتيجة أن نشأ حائلٌ حدَّ من جاذبيَّة العقل، وحال دون قدرته على تحرِّي غموض الوجود وغيبته.
- السؤال المؤسِّس ومراتبه الوجوديَّة
لا يفارق السؤال المؤسِّس بوصفه سؤالًا أنطولوجيًّا، الأسئلة الفرعيَّة التي تهتمُّ بعالم الموجودات. التأسيس بحسب الفيلسوف الفرنسيِّ جيل دولوز يعني التعيين. ثمَّ يسأل ليجيب: علامَ يقوم التعيين، وعلامَ يُمارَس؟ الأساس هو عمليَّة الُّلوغوس أو السبب الكافي. وبوصفه الأساس، فإنَّه يمتلك ثلاثةَ معانٍ:
الأساس في معناه الأول، هو الـ”عينه” أو المتطابق. يتمتَّع بالهوّيَّة الأسمى، المفترض أنَّها تنتمي إلى الأمثول، العين عينه. ما يكونه وما يمتلكه، يكونه ويمتلكه في الأول. ومَن هو الشجاع باستثناء الشجاعة، والفاضل باستثناء الفضيلة؟ ما يمتلكه الأساسُ للتأسيس، هو إذًا فقط ادّعاء الذين يأتون بَعد الذين يمتلكون.
المعنى الثاني في الأفضل. ما يطالب بأساس، ما يدعو إلى أساس، هو دومًا طموح، أي “صورة”: مثلًا، طموح أناس بأن يكونوا شجعانًا، وبأن يكونوا فاضلين – بإيجاز، بأن يمتلكوا جزءًا، بأن يشاركوا أي أن يمتلكوا في ما بعد). يميَّز إذًا الأساس بما هو ماهيَّة مثلانيَّة، المؤسَّس بما هو الطامح أو الطموح، وما يتناوله الطموح، أي الكيف الذي يمتلكه الأساس أولًا، والطامح إذا كان مؤسَّسًا سوف يمتلك ثانية. تجعل عمليَّةُ التأسيس الطامحَ متشابهًا مع الأساس، تعطيه من الداخل التشابهَ، وبهذا الشرط، تعطيه ما يجعله يشارك الكيفَ، الموضوع الذي يطمح إليه. يُسمَّى الطامحُ المتشابهُ مع عينه، تشابهًا؛ إلَّا أن هذا التشابه ليس تشابهًا خارجيًّا مع الموضوع، هو تشابه داخليٌّ مع الأساس ذاته[21](…) ما يجب تأسيسه، هو طموحٌ بالاستيلاء على الَّلامتناهي، على التأسيس الآن أن يعمل داخل التمثُّل، ليمدَّ حدودَه إلى الَّلامتناهي الصغر، كما إلى الَّلامتناهي الكبر. تعبّر هذه العمليَّةُ عن السبب الكافي. ليس هذا السببُ الكافي الهويَّةَ، ولكن وسيلة الإخضاع للـ “هو هو”، ولمتطلّبات التمثُّل الأخرى ما كان يفلت منها من الاختلاف في المعنى الأول.
تجتمع دلالتا الأساس، مع ذلك، في دلالة ثالثة. التأسيس هو – في الواقع – دومًا الخضوع، الانحناء – ترتيب نظام الفصول، السنوات والأيام. نجد أنَّ موضوع الطموح (الكيف، الاختلاف) وُضِع دائريًّا؛ تتميَّز أقواس الدائرة بقدر ما ينشئ الأساس في الصيرورة الكيفيَّة لركودات الدم ولحظات أشكال قطع تقع بين الحدَّيْن الأقصيَيْن للأكثر والأقل. يتوزَّع الطامحون حول دائرة متحرِّكة، يتلقَّى كلُّ واحد النصيبَ الذي يقابل جدارة حياته: تُشَبَّهُ حياةٌ ما هنا بحاضر دقيق يُبرِز طموحه بجزء من دائرة، “تدغم” هذا الجزء، وتتلقَّى منه خسارة أو ربحًا في نظام الأكثر والأقلّ بحسب تقدُّمه الخاصِّ به أو تراجعه في تراتبيَّة الصور (حاضر آخر، حياة أخرى تدغم جزءًا آخر). نرى في الأفلاطونيَّة كيف يشكِّل دورانُ الدائرة وتوزيعُ النصائب، الدورةَ والتناسخَ، الاختبارَ أو يانصيبَ الأساس. ولكن أيضًا عند هيغل، تقسم كلُّ البدايات الممكنة، كلُّ الحواضر في دائرة وحيدة غير متوقّفة لمبدأ يوسِّس، يضمُّها في مركزه كما يوزِّعها على محيطه. وعند لايبنتز، التماكن عينه هو دائرة التلاقي حيث تتوزَّع كلُّ وجهات النظر، كلُّ الحواضر التي تؤلِّف العالمَ. والتأسيس في هذا المعنى الثالث، هو تمثُّل الحاضر أي جعله يفاجئ ويمرُّ في التمثُّل (المتناهي أو الَّلامتناهي). يظهر الأساسُ إذًا، كما هي حال ذاكرة سحيقة أو ماضٍ محض ماضٍ، لم يكن قطُّ هو نفسه حاضرًا، ويجعل الحاضرَ يمضي، فتتعايش كلُّ الحواضر بالنسبة إليه في دائرة.
باختصار، السبب الكافي، الأساس هو مكوِّع بغرابة. ينزع من جهة، نحو ما يؤسِّسه، ومن الجهة الأخرى، ينعطف نحو ما فوق الأساس الذي يقاوم كلَّ الأشكال التي تفلت من التمثُّل.
التأسيسُ إذًا، على ما يبيِّن دولوز هو تعيين الَّلامتعيّن. ولكن هذه العمليَّة ليست بسيطة. عندما يمارَس “التعيينُ، فإنَّه لا يكتفي بإعطاء شكل أو بعدم تشكيل موادَّ تحت شرط المقولات. إنَّه شيء من العمق يصعد مجدَّدًا إلى السطح، يصعد إليه من غير أن يتَّخذ شكلًا، ويتسلَّل بالأحرى بين الأشكال، وجود بلا وجه مستقلّ ذاتيًّا، قاعدة مرتكز لاشكليَّة.
وعليه، فإنَّ ثمَّة جدليَّة اتِّصال وانفصال بين هذا السؤال ومراتبه الوجوديَّة. ولمَّا أن كان الوجود واحدًا متَّصلًا ومبنيًّا على التراتب، كذلك يكون الاستفهام عنه. أي أنَّه وجود واحد ذو مراتب. ولإنجاز الاستفهام وفق هذه الجدليَّة، وجدنا النظر إليه ضمن ثلاث مراتب: – سؤال فانٍ، سؤال باقٍ، وسؤال يتردَّد بين الفناء والبقاء. ولكلٍّ من هذه المنازل خصائصه المعرفيَّة ومقتضياته وظروفه الزمانيَّة والمكانيَّة وآثاره النفسيَّة والمعنويَّة. وفي ما يأتي نعرض إلى ماهيَّة وطبيعة كلِّ مرتبة:
أوَّلًا: السؤال الفاني: متعلِّق بماهيَّة وصفات الشيء ونشاطه كظاهرة في زمان ومكان محدَّدين، ولذلك فالسؤال عن الموجود الفاني هو سؤال فانٍ لأنَّه يحيا به ويزول بزواله. والطبيعة الفانية لهذا النوع من السؤال تعود إلى اختصاصه بدنيا الحواسِّ وتعلُّقه بالحاجات المباشرة للموجودات. فإذا سُدَّت لموجود ما حاجتُه كفَّ عن المطالبة. وما يكفُّ عن الطلب ينقضي أمره ويتبدَّد سؤاله. وحتى لو عاد المحتاج إلى السؤال عن حاجته كرَّة أخرى فلن يتعدَّى سؤاله عالم الفناء ما دام طلبُه منحصرًا بالأغراض الفانية.
إذًا، السؤال الذي يتعلَّق بالفاني ويجيء قبل أوانه لا أثر له، وهو غير قابل لأن يصير حدثًا أو فكرة. وما ذاك إلَّا لأنَّه بحكم ارتباطه بعوارض الممكنات آيلٌ إلى الفناء؛ وبالتالي فالاستفهام عنه غير موفور في الَّلحظة العجولة التي أعلن فيها. لذا، هو سؤال خارج الزمن الواقعيِّ ولا دوام له. وما لا دوام له في عالم الواقع معدوم الإجابة. أمَّا السؤال الذي يأتي بعد أوانه فسينتهي إلى النتيجة إيَّاها. فهو بحكم فوات وقته وانقضاء موضوعه يغدو عرضه للفناء، إمَّا لأنَّه يعيد تكرار الاستفهام عمَّا قد تحصَّل جوابُه من بعد أن تحوَّل إلى حدث، أو لأنَّه أُهمل وهُجر فلم تُدرك ماهيَّته أو يُعرف سرُّ ولادته المتأخِّرة.
لأجل ذلك كان من أبرز سمات السؤال الفاني وقوع صاحبه في الحَيْرة. وحيرته هنا ذات طبيعة سالبة وهي حَيْرة الكثرة من الناس. معها يكون الحائر متطيِّرًا ممَّا يكِّدره من أمور دنياه، فيتشابه عليه خيرُها وشرُّها، عاليها وسافلُها، ولا يجد لأمره حيالها من سبيل. وهذا الصنف من الحَيْرة ينتسب إلى ما نسمّيه بـ “الفراغ العجيب”. والممتَحنُ بهذا النوع من الفراغ محاطٌ بالقلق من كلِّ جانب. فهو أشبه بحاوية ضخمة من الظنون. سمتُه الَّلايقين وفقدان الثقة بالذات وبالغير. لا يواجه الحائر في السؤال الفاني أمرًا إلَّا أخَذَه العَجَب، فالفراغ العجيب علم ناقص، ولأنَّه كذلك فلن يسفر إلَّا عن حيرة مشوبة بالجهل. فإذا كان من أفعال العقل أنَّه يجمع ما تفرَّق في عالم الممكنات والمحسوسات، فالحائر في الفراغ يفرِّق ما كان شملُه مجموعًا. لهذا أمكن لنا القول أنَّ الحائر هاهنا يدور حول نفسه، ولا يملك أن يغادر دوَّامته قطّ. فإنَّ من طبائع الحيرة النازلة جمعها بين نقيضين: يقين ناقص وشكٍّ ناقص، والعائش فيها لا يقدر أن يجاوز نقصانه ويمضي إلى انشراح الصدر.
ثانيًا: السؤال المتردِّد بين الفناء والبقاء: صاحب هذا السؤال يسأل عن الأبديَّة ولا يعيشها. ولأنه يعرض عنها بالنظر والعمل داهَمَه النسيان. لذلك قد نجده يميل في أسئلته الى الشيء الفاني والفكرة الفانية بحكم انئخاذه بسحر الموجودات وتعلّقه بجاذبية الحس. وبسبب من منزلته التوسطية بين الفاني واللاّفاني ينحكم صاحب هذا السؤال بالتقلُّب والحَيْرة. وغالباً ما يشعر بأن يومَهُ كأمسِهِ وأمسَهُ كَغَدِه. وهكذا تتساوى أيامه في التكرار والتواتر ولا يقدر على أن يأتي بما يساعده على الانتقال الى ضفة الاستقرار وسداد الرأي. مع ذلك فإن حيرة الحائر بين الفناء والبقاء هي ذات طبيعة مختلفة عمن سبقه. ويترتب على هذا الاختلاف تمايزاً عن سواه في استقراء الوجود. فالحيرة الوسطى على الرغم من تطلعها الى الباقي والمطلق تبقى تدفع بصاحبها الى الفاني والنسبي. مع ذلك يستطيع الحائر فيها أن يجد له منفسحاً للتفكير بالسؤال المؤسِّس بما لديه من ذكاء وفطنة وسَعَةِ حيلة. في هذا المطرح يرنو الحائر الى مجاوزة نقصه شوقاً الى الانسجام والكمال. إلا أن عيشه في المنطقة الوسطى بين الفراغ والامتلاء يبقيه حائراً فلا يفلح بالصعود درجة الا إثر مكابدة…
ثالثاً: السؤال الباقي: هو سؤال يغتذي من الوصل الخلاَّق بين الله والكون والإنسان. ولو كان لنا أن نجعل له مقاماً لأقمناه في مقام “فوق ميتافيزيقي”. ولعل هذا المقام هو الأكثر قابلية لاستيلاد السؤال المؤسس ذلك بأنه مقام الجميع بين الأضواء، والوصل بين الوحدة والكثرة. ناهيك عن رعايته للتكامل والانسجام بين الغيب والواقع المشهود. في هذا المقام يكون السؤال حيَّاً، إلا أنه سؤال من ذلك النوع الذي لا ينتظر الاجابة على نحو ما يبديه الانسان من استفهامات في عالم الحس. فالإجابة ها هنا استجابة وإقبال ذلك بأنها متضمنة فيه ولو لم تظهر نتائجها في اللحظة التي تلي السؤال. فالإمكان تبيُّن ماهية السؤال الباقي في ما ذهب إليه التأويل العرفاني للزمن. فقد وصف عرفاء الصوفية أنفسهم بـ “أبناء الوقت”. وكلمة الأبناء تدل على جمع العارف بين أضلاع ثلاثة: الزمان والمكان وحضور الانسان فيهما. فمتى جاز المرء على الجمع بين الأضلاع ومعهم كان على شاكلتهم. وقتُه وقتهُم سمتُه سمتُهم، ومطرحُه مطرحُهم، ومآلُه مآلُهم. عندئذٍ يصير الزمن مقاماً للكائن لا يُعرَفُ الا فيه ولا يعرِفُ الوجود إلا من محرابه. والذي لم يبلغه بعد لا يقدر على المعرفة التي تمكنه من الكشف والمشاهدة. فلو لم يكن ابناً للوقت بهذا المعنى الخاص والمتعالي، يغدو مستحيلاً بالنسبة اليه لأنه غريب عن التماس ولا يملك عين البصيرة.
السؤال في المقام “فوق الميتافيزيقي” منفتح على اللامتناهي ومقيَّدٌ فيه في الآن عينه. فالسؤال عن الأزل، وبالتالي عن الله لا يسري في عالم المفاهيم الذي نشأ ونما في محراب الماهيات الفانية. أما السؤال عن الباقي والأزلي دائم فهو ما لا يمكن ان يُحمل على قول. لأن القول المحمول على شيء ما، هو قول محدد ومحدود بماهية ذاك الشيء. ولو شاء السائل أن يجيب على ماهية الأزلي بالوصف فلن يسعفه اللفظ. فالأزلي يتأبّى على كل لفظ. ولو تُلفَظ عنه فليس اللفظ بصائب حتى لو كان صادقاً في اللحظة التي يصدر فيها على لسان اللاَّفظ4.
لذلك سنرى ان السؤال عن الله هو من النوع الذي لا يُجهر به. لأنه ليس بعارض، وهو غير منحكم الى زمان ولا الى مكان. ثم ان السؤال عن الله لا يصح ان يندرج ضمن الاستفهام الفينومينولوجي عن الأشياء. ذلك استفهام عن اللاَّمتناهي والمحيط بكل شيء، لا بالسائل المحدد والمحدود والمحاط به. ولذا فالسؤال عن الله هو سؤال الذي لا تحاط ذاته بالفهم لأنه مطلق. والمطلق بحسب تعريف علماء اللغة هو ذكر الشيء باسمه حيث لا يُقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك!”. ولأنه مطلق ومحيط بالموجودات في زمانها ومكانها فلا مناص للموجودات من أن تأخذ من محيطها أصل موجوديتها. فالمحيط بالأشياء عطاء أزلي يمد كل شيء بما يحتاج إليه، والعطاء الأزلي لا ينتظر سؤال الشيء حتى يجيبه، بل من طبيعته الجود على الموجود ليكون موجوداً، سواء كان هذا الموجود صامتاً متلقياً كالموجودات الفيزيائية، أو ناطقاً ذا إرادة واختيار كالإنسان. الأزل إذاً، الفيض على الموجودات بمواقيت تناسب خصائصها الوجودية. ولذا فهو يجيب على الأسئلة التي تحتويها الأشياء سواء منها المضمرة في نفس الشيء أو تلك الظاهرة على شكل مناجاة واعية. والوجود الفياض هو الوحيد الذي يعلم سر أسئلتها ومتى واين وكيف تكون الإجابة. إجابة الأزلي على سؤال الشيء والانسان لا تتأخر ولا تتقدم، وانما صدور للسؤال والجواب في عين اللحظة. فالاشياء تحت عينه وعنايته، وفيضُه عليها لا ينقطع حتى لو تبدلت صورها المادية. أما علاقة الأزل بأزمنة الإنسان فهي علاقة مفارقة، فالإنسان شيء لا كالأشياء، ولذا فإن سؤاله ليس صامتاً وإنما ضوضاء تشغل الكينونة بنداءات لا تنقطع.
- سؤال الإنسان وأبديَّته
السؤال المتجاوز للمرئيِّ والمباشر والمحسوس هو ماهيَّة ذاتيَّة للإنسان، وهذه مزيَّتُه العظمى التي تجعله مُفارقًا للكائنات ومتَّصلًا بها في الآن عينه. هذا السؤال هو ما يجعل الإنسان إنسانًا، أي ككائن يعقل الكينونة ويستشعرها ويتولَّى مسؤولية رعايتها والعناية بها. وهذا هو معنى جامعيَّته لجهة أدائه مهمَّة كونيَّة مركَّبة ومتلازمة: أنطولوجيَّة وفينومينولوجيَّة. مع هذه الصفة الجامعيَّة للبعدين المذكورين في مهمَّته يرتفع التناقض بين المتناهي والَّلامتناهي، ويصير السؤال عنهما وفيهما سؤالًا واحدًا مع اختلاف زمانيَّة كلٍّ منهما، بينما تفترض الطبيعة المتناهية أسئلة تناسب تناهيها ومحدوديَّتها. وبالتالي فهي أسئلة قابلة للتبدُّد بمجرَّد حصول كلِّ سؤال على جوابه. لا يعود السؤال عن الموجود بما هو وحضور عينيٌّ في الكون صالحًا إلَّا بنسبة تعلُّقه بعلَّة وجوده. أي بوصفه وجودًا لا عدمًا. فالاستفهام عنه بما هو موجود واقعيٌّ ضروريٌّ لتغذية الاستفهام عن الَّلامتناهي، ذلك بأنَّه يشكِّل أحد مصادر التعرُّف على الوجود المحتجب عن الإدراك[22].
الوجود الَّلامتناهي يناظره، بما هو وجوده زمان لا متناهٍ. وهذا الزمان منقطع النظير لأنَّه جوهر مفارق مكتفٍ بذاته ويزوِّد غيره بالسيولة. كلُّ ما ليس منه يستمدُّ منه غذاء الحركة والحياة. ومثل هذا الاستمداد يجعله متَّصلًا بغيره ومنفصلًا عنه في الآن عينه. بين الاستمداد والإمداد يحضر الزمان المتعالي كامتداد جوهريٍّ طوليٍّ إلى عالم الممكنات. ولأنَّ مفهوم الحركة الجوهريَّة من مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود.
كلُّ الأشياء تسأل عن حاجتها بلغة لا نفهمها، ثمَّ تُلبَّى حاجتها بصمت، إلَّا الإنسان كان سؤاله فائضًا عن حاجته. فهو لا يكتفي بزمانه الذي خُصَّ به ككائن طبيعيٍّ، بل بسبب من صبغته التكوينيَّة قَدَرُه أن يمضي بعيدًا في مساءلة الأزل. وبذلك يجاوز زمانه الفيزيائيَّ، ويتطلَّع إلى المابعد. شغفه بالسؤال يحمله نحو مساءلة الأبديَّة. ويبقى يلحُّ بالسؤال سواء تحقَّق له التعرُّف عمَّا يسأل عنه، أم حين يوقن بتعذَّر الإجابة.
ليست الغاية من السؤال النظر إليه كذريعة لتحصيل العلم بالشيء. حدود الذريعة التي تنشأ لدى السائل إمَّا بدافع الفضول إلى التعرُّف على فكرة أو شيء ما، وإمَّا السؤال صيرورة لأنَّه يقصد التعرُّف. وهذا القصد يجعل الاستفهام عن الكلمة والشيء والحدث اسىتفهامًا كوجود وكظاهرة في الآن عينه.
ولكي يصبح السؤال مضاهيًا لحضور الشيء المستَفْهمِ عنه وَجَبَ التحرُّر من غَرَضِيَّة الاستجواب المنتهي عند حدود الَّلحظة. في هذه الحال يكفُّ السؤال عن الامتداد من أجل أن يتعرَّف على ما تخبّئه الَّلحظة التالية: لذا سنلاحظ أنَّ من أبرز السمات المميّزة للسؤال هي القهريَّة. أي أنَّه يقهر نفسه عندما تنتهي مهمَّته بالتعريف عن إدراك المحدَّد الفاني، ويقهره السائل حين يعرض عن التعرُّف على ما يجهله.. ومن سماته أيضًا وأساسًا أنَّه يحجب العقل عن مهمَّته الآيلة إلى إدراك الشيء في ذاته، وبالتالي إدراك المصدر الذي جاء منه ذلك الشيء.
سؤال الَّلحظة هو سؤال ناقص. ولأنَّه ناقص فهو قاصر عن أن يؤسِّس للمابعد. وكما مرَّ معنا، فإنَّ ما لا يؤسِّس لا يعوَّل عليه لا في الزمان ولا في المكان. إنَّه السؤال الذي يولد ويفنى في دائرة الَّلحظة إيَّاها. زد على هذا أنَّه كثيرًا ما يحمله اليأس على الإعراض عن مواكبة الأفكار والأحداث وعن التعامل مع الإمكانات التي يختزنها.
هذا الضرب من السؤال لا ينتمي إلى سلالة الأسئلة التي تتبدَّد حين تفرغ كلّ ما تحويه من سعة للأجوبة.
والسؤال عن ماهيَّته ومهمَّته وغايته هو سؤال ميتافيزيقيٌّ ببُعدَيه الفلسفيِّ والدينيّ.
والتساؤل في طور العلوم الإنسانيَّة هو أدنى مرتبة من السؤال، فالأول يتَّسم بالحيرة وعدم الحسم والتردُّد في الاحتمالات والتوقُّعات، أمَّا الثاني، أي السؤال، فله شخصيَّة صارمة صادمة لا تعرف الهوان والمراوحة.
السؤال ليس مجرَّد استفسار فائض عن حاجة السائل. كلُّ سؤال يطرح هو ترجمة لضرورة وجود الشيء أولًا، وإلحاح هذا الشيء على الكشف عن نفسه. عندما تسأل مثلًا عن السبب الذي حمل على عقد مؤتمر ما تحت عنوان الزمان، فمهما كانت الصيغة التي سيأتي من خلالها الجواب فإنَّ انعقاده يفضي إلى أنَّ الزمان نفسه هو الذي يلحُّ على كشف المجهول من ماهيَّته من خلال هذه القضيَّة المحدَّدة أو تلك. أما حصول الانعقاد في هذا الميقات بالذات فيعكس التزامن بين رغبة الشيء في الإشهار عن نفسه واستجابة لهذه الرغبة. لذا لا يكون السؤال سليمًا أو صائبًا إذا كان الشيء الذي يسأل عنه متردِّدًا في معناه ومقصده، نظرًا لتعدُّد العناصر المتضادَّة التي يختزنها. ولسوف تبقى الحيرة على سيرتها ما دامت تلك العناصر ممتنعة عن الانسجام. ففي هذه الحال قد يلجأ السائل إلى تفكيك السؤال المركَّب وتظهيره إلى بسائط وكلُّ بسيط يصبح سؤالًا عن شيء قائم بذاته.
السؤال بما هو حدث، يقع تحت النظر، ويستحثُّ الناظر على التعريف به. وهنا يأخذ مسراه التاريخيَّ والفينومينولوجيّ. أمَّا السؤال بما هو حضور أزليٌّ، فإنَّه يأخذ مسراه الأنطولوجيَّ المتعالي في الاستفهام عن معنى الشيء في ذاته كما ينبغي أن يعرف بكيفيَّة مطلقة الإلهيَّات.
- السؤال كحاصل للجهل بالشيء
كلُّ سؤال عن شيء هو عديل الجهل به. ومتى عرفت ذلك فقد أدركتَ سرَّ المثنَّى الذي ينطوي عليه كلُّ سؤال. والمثنَّى واحد بجناحين لا ينفصلان: جناح الجهل وجناح المعرفة. ولا يكتمل السؤالُ إلَّا بهما معًا؛ فلو لم يكن الجهل مكوِّنًا من مكوِّنات السؤال، لما كان للسائل أن يسأل عن أمر يريد التعرُّف عليه. ولو لم تكن المعرفة داخلة في أصل الاستفهام لانْعَطَفَ السؤالُ نحو العدم. الجهل إذًا، ضرورة وجوديَّة للمعرفة، وفي الآن الذي تولد فيه، تميل المعرفة صوب الجهل لتملأ خواءه، وتحيله بالسؤال الى علم ضاجِّ بالحياة.
ما كان للسؤال أن يوجد إلَّا متى قابَلَه جهلٌ بشيء. وما كنَّا لنسأل لولا أن غَدَوْنا في قلب الَّلحظة التي نُستدرجُ فيها لنقف حيارى أمام مجهول. ولأنَّ كلَّ مجهول هو مريب ومهول، فمن طبعه أن يحملنا على التساؤل عن سرِّه. أمَّا ذاك الذي نألفه، ويقع تحت سطوة الحواسّ، فالجهل به جهل نسبيّ، فلا تلبث أن تنقشع منزلته في الزمان والمكان والدور ولو بعد حين. وعند انكشاف المستتر من الشيء يمحو السائل جهله به. ومتى اتّفق له الأمر يمَّحي السؤال ويتبدَّد الجهل والسؤال معًا، ثمَّ ليظهر ذلك الشيء من بعد ذلك ناصعًا لاشِيَةَ فيه. الحاصل من هذا كلِّه أنَّ كلًّا من الجهل والسؤال يحصِّل معناه في مسرح الأضداد: السؤال يدلُّ على عدم العلم، والجواب يدلُّ على عدم الجهل.
في المحلِّ الذي يظهر فيه المجهول وهو على أتمِّ صورته، لا يعود ثمَّة حاجة إلى الاستفهام. وما ذاك إلَّا لأن الشيءَ المكتملَ الحضورَ يصبح معروفًا، والمعروف لا يعوزه السؤال. من هذا النحو لا يجيء الاستفسارُ عن شيٍء إلَّا متى كان هذا الشيء منحجبًا. فكلَّما توارى عن مجال الرؤية حنَّ إليه السؤال وانجذب إليه السائل. هكذا تبتدئ رحلة السؤال في حقول الجهل، ذلك من أجل أن ينتقل السائل إلى معرفة المجهول. ففي كنف هذه الَّلحظة بالذات يغدو كلُّ من يطلب الاستفهامَ عن شيء جاهلًا بذاك الشيء.
الجاهل الذي أدرك جهله، ثمَّ سدَّده بالسؤال، هو كَمَن دقَّ باب العلم طالبًا علياء المعرفة. وحين يسأل الجاهل عن علَّة جهله، ولماذا يجهل هذا الشيء أو ذاك، فقد وضع قدمه على دربة التعرُّف، وإذ يأتيه ما يستفهمُ عنه فقد أدَّى ما عليه من حقِّ الجهل عليه.
الجهل حدُّ العلم، والعلم سليل الجهل. وأمَّا السؤال فهو مزيج من جهل وعلم. حين يسأل المرء عن أمر يجهله، صار كالذي يقطع نصف المسافة إلى بلوغ العلم به.
مَزيَّة السؤال تكمن في حيازته على كيمياء التحويل. به تنتقل الموجودات من الكمون والخفاء إلى الظهور والإعلان. متى حلَّ التساؤل عن موجود ما، تحوَّل الجهل به إلى علمٍ بالقوَّة، كما تقول الحكمة. وعليه، فليس للسؤال من مقام إلَّا في محراب الجهل، وهنا على وجه الدقَّة يكمن سرُّه الأعظم…
لا مناص لمن يبتغي الحفر في أرض الجهل من شجاعة. فلا يبوح بجهله من جهل أمرًا وقاربه بالسؤال، إلَّا من كان شجاعًا. إذ ذاك يصير القادر على البوح من أهل المروءة ثمَّ يصَّاعد إلى ذروة الكبرياء.
إذا عَرَفتَ من تصغي إليه، عرفْتَ قَدْرًا ممَّا جاءك منه من مقاصد الكلام. وإذا جَهِلتَ المتكلِّمَ فقد غاب عنك ما يرسله إليك من معنى القول. فالذي انتهى إلى علمك منه أمران: أمرُه كمحدِّث وأمرُ حديثه. فقد عرَّفك المحدِّث باسمه وصفته وهوّيَّته لمَّا عرَّفك بنفسه، ثمَّ عرَّفك بحديثه عن قصده، لمَّا كشف لك ما عنده من معارف غابت عنك. فإذا أردت أن تعرف معنى الخطاب ومقصوده، وجب أن تعرف حقيقة من تستمع إليه. ثمَّ إنَّك لن تستطيع أن تتعرَّف إلى من تسمع منه الإجابة، إلَّا إذا تعرَّفْتَ إليه بلا مجادلة. دعه يُملِ عليك.. وما عليك إلَّا الإصغاء بلطف ورويَّة، فلن يكون لك هذا إلَّا بتساؤل المتهذِّب، وهو ما لا يتقنه إلا جاهلٌ عارفٌ بجهله.
المجادلة مفسدة التعرُّف. كلُّ فهم لأمرٍ مجهولٍ لا يأتي عن جدل، لأنَّ الجدل أداة تسلُّط لا أداة معرفة، والجدل وثن الغرور يبتدئ من جهل وينتهي إلى جهل.
الشيء زمانيٌّ محض. يظهر في ميقات وينتهي في ميقات، السؤال عنه مثله. كلُّ شيء يظهر في الزمان تتوجَّه نحوه علامة استفهام تطلب التعرُّف على ماهيَّته وطبيعة مهمَّته في دورة الوجود. وحين يموت يصبح لا شيء، فلا يعود ثمَّة جدوى من الاستفسار عنه. إذ من غير المعقول الاستفهام عن شيء غير موجود. وهذا معنى مرادنا من السؤال الفاني عن الشيء الموجود في الزمان المحض. فالشيء موجود محدَّد. بدايته معروفة وكذلك نهايته. وكلُّ معروف يدخل دخول اليقين في عقل العارف، وما لا يدخل لا يُسأل عنه ولا يُعرف. ذلك ما أثبته العلم بالاستدلال العقليِّ وبالتجربة معًا.
أمَّا الإنسان فهو كائن محدَّد وموصول بالَّلامحدد، زمانيّ ولا زمانيّ. وبالتالي فهو حادث وأزليّ. وبهذه الصفة التكوينيَّة، لا يمكن السؤال عن الإنسان أن يكون فانيًا وحسب، ولا أن يكون باقيًا فحسب. سؤال الإنسان مركَّب من زوجيَّة لا تنفصل البتَّة. وتستطيع أن تجمع بين السؤال الفاني والتساؤل الممتدِّ في عالم البقاء. ما يعني في هرمنيوطيقا الوجود الخاصّ به، أنَّ الإنسان ماهيَّة وهوّيَّة هو كائن زمانيٍّ وحاضر فيه وله مزية الامتداد إلى ما فوق الزمان. وهذا الامتداد المفارق للكائنات الفانية هو الذي يمنحه القدرة على مجاوزة شيئيَّته المحضة والاتصال بمعناه المتعالي. أمَّا السؤال عن مصدر هذه القدرة المركَّبة التي ميّزت الإنسان عن سائر الكائنات فهو جمعه بين ثلاثة أضلاع جعلته كائنًا ساعيًا إلى الفهم يسأل عن نفسه وعن الوجود الذي هو فيه: العقل، الأخلاق والحرّيَّة.
لا شيء في الكون إلَّا ويسأل عن حاجة ما تحقِّقُ له كفايته الذاتيَّة. الحجر والشجر والحيوان كلٌّ له سؤال على قدره. وسؤاله مجاب تبعًا لهندسة دقيقة مطابقة لطبيعته. وعندما تُلبَّى حاجته في إطار زمانه المحدَّد فلا تنجز التلبية إلَّا ضمن زمان لا محدود محيط بكلِّ الموجودات وسارٍ فيها في الآن عينه. ولذا، فإنَّ سؤال الموجود عمَّا ينقصه وتلبية هذا النقص هما سؤال وجواب متَّصلان بالزمان المطلق الذي لا انفصال فيه ولا تباين. وعليه، فلا حاجة للشيء أن يلحَّ بالسؤال لكي يأتيه الجواب الذي يناسب. ذلك يعني أنَّ سؤال الشيء عمَّا يتمِّمه فضلًا عن جوابه هما سؤال وجواب ينتميان إلى زمان مطلق وغير محدَّد حيث لا خيار ولا إرادة ذاتيَّة لهذا الشيء، وإنَّما فيضٌ أزليٌّ يعطي من وحداته الزمنيَّة بلا حساب ويوزِّعها على الأشياء كلٍّ بحسب شرط وجوده.
من زاوية نظر أخرى: السؤال الذي يأتي قبل أوانه، هو سؤال ناقص. ذلك بأنَّه سجين الوقت الذي طرح فيه أو لأجله. تنطبق هذه الفرضيَّة على الاستفهام الأنطولوجيِّ عن الوجود بما هو وجود، أي عن الوجود بذاته، وهو ما يُقال عنه الوجود الحقيقيّ. مثلما ينطبق كذلك على الاستفهام الفينومينولوجيِّ عن الموجود في الزمن الطبيعيّ. لكلٍّ من هذين الوجودين سُؤْلُه الخاص، ولحظته الزمانيَّة التي تفترض السؤال المناسب لكلٍّ منهما. إذًا، كلُّ استفهام عن فيزياء الطبيعة ينتمي إلى ما نسمّيه بالسؤال الفاني. فما دامت الطبيعة موضوعًا لمكابدات العقل البشريِّ وتحت سلطانه فكلُّ كشفٍ مستحدث يطوي السؤال الملازم له ليولد سؤال جديد… وهكذا دواليك. كلَّما تتبدَّل حركته أو تتغير مواضعه صحَّ عليه القول بنسبيَّة بقائه زمانًا ومكانًا ووجودًا. ولمَّا كان كلُّ نسبيٍّ في عالم الكون فانيًا فإنَّ كلَّ سؤال بصدده هو سؤال فانٍ ولو تعثَّر الجواب عليه، أو تأخَّر أوانُه أمدًا طويلًا. فقد أخذ الموجود الفاني بجريرته كلَّ ما يتعلَّق به.. والسؤال أول تعلُّقاته. السؤال الفاني له زمانه، لكنَّه زمان محدَّد بالَّلحظة التي سوف يُستفسر فيها عن ماهيَّة الشيء، وبالتالي فهو محدود بحدود الَّلحظة التي ينقشع فيها الجواب اليقين عن هذا الشيء. بيان ذلك: قد يكون الجواب عن شيء ما حاصلًا لدى شخص ما، مجهولًا عند شخصٍ آخر. فلئن كان السؤال عند الأول فانيًا بعد ظهور الإجابة فإنَّه يبقى حيًّا إلى وقت معلوم عند الآخر. إذ لا يلبث أن يتبدَّد ويفنى ولا يعود له اعتبار في الَّلحظة التي يدرك فيها هذا الآخر جوابه. وإذن، ففناء السؤال وبقاؤه في هذه الحال محكومان بزمان عابر، وعليه فإنَّهما فانيان معًا. هذه الفرضيَّة تعمُّ كلَّ الأشياء في العالم الطبيعيِّ، من الموجودات المجهريَّة المتناهية في الصغر، وصولًا إلى الأفلاك الَّلامتناهية في سعتها المكانيَّة والزمانيَّة.
قد يكون الاستفهام عن أيّهما سابق على الآخر السؤال أم الجواب، استفهامًا ساذجًا. لكن الاضطراب الحاصل الاستفهام عن شيء والإجابة عنه، يمنح ما تقدَّم المشروعيَّة المنطقيَّة. عندما يسأل سائلٌ عن شيء ما أو حدثٍ ما، أو مجهول ما، فإنَّ تصوُّرًا ما عن هذا الشيء قد حلَّ في ذهن السائل. وهذا الحلول سواء كان جزئيًّا أم إجماليًّا فذلك يعني أنَّ السائل تسلَّل من وراء ستارة الجهل ليجد له وصلًا مع الجواب المنتظر. بهذا التسلُّل الذي يمارسه السائل يقيم وصلًا في الآن عينه بين السؤال وجوابه. والفضل في هذا الوصل لا ينحصر بالسائل كما قد يُظنّ، وإنَّما للسؤال والجواب معًا، وبالمقدار نفسه الفضل في إنجاز هذا الوصل. وما ذاك إلَّا لأنَّ الجواب عمَّا هو الشيء متضمّن في السؤال عن هذا الشيء وموجود فيه. وما ذاك أيضًا لكون السائل والسؤال والجواب هي مراتب وجوديَّة تأتلف ضمن وحدة زمانيَّة ذات مرتبتين: مرتبة الجوهر حيث يتَّحد السؤال والسائل والمسؤول عنه اتِّحادًا ذاتيًّا أي أنَّ الثلاثة يؤلِّفون جوهرًا واحدًا هو المسألة. فالمسألة هي الأضلاع الثلاثة. كلُّ ضلع غير منفصل عن الجواب بل هو متضمّن فيه بقدر ما. أمَّا لماذا يُسأل عن الشيء في لحظة ما وفي مكان ما؟ فالجواب البديهيُّ هو أنَّ هذا الشيء لو لم يكن موجودًا في زمان محدَّد وفي مكان محدَّد لما جرى الاستفسار عنه. فالشيء ولو كان وجودًا ذهنيًّا هو وجود حقيقيٌّ بالقوة. فما لم يجب وجوده لا يوجد. هذا يعني أنَّ كلَّ موجود هو واجب توجبه.
السؤال والجواب والسائل ثلاثيَّة متَّصلة ومترابطة ولا يمكن فصل أيٍّ منها عن الآخر. والأصالة تعود للأحياز الثلاثة مجتمعة لا إلى أيٍّ منها حتى ولو تصوَّر البعض للوهلة الأولى أنَّه لولا السائل أي الإنسان لما صدر السؤال عن الشيء، ولا كان الجواب عنه متوقَّعًا. صحيح أنَّ الإنسان هو الفاعل الأصيل، إلَّا أنَّه لا يقدر على تحصيل فهم أمر ما بمعزل عن موجود ما يحمله على الفضول ويستدرجه ليتعرَّف إليه بالسؤال.
- الأشياء الصَّامتة في محضر السؤال المؤسِّس
كيف للأشياء أن تسأل، وكيف يُستجاب لها؟ لا يغيب مسعى الإجابة عن همِّ السؤال المؤسِّس مع أنَّ مثل هذا الاستفهام يستثير الاستغراب للوهلة الأولى.
الحضور العينيُّ استجابة حافزة للسؤال. ليس بالضرورة أن يصدر السؤال بالنطق كما هو الأمر عند الإنسان، فللاستجابة في عالم الأشياء الصامتة كما في عالم الحيوان إشارات وأصوات هي من ذات الأشياء وطبيعتها التكوينيَّة. الزهرة التي يصيبها العطش تطلق نداءها إلى الزارع بالذبول، والحصان الذي يتألَّم أو يجوع يسأل السائس أن يغيثه بمداواة دائمة، أو ما يسدُّ حاجته للإطعام. حتى الجمادات تهدي السائل أسئلتها بمحض تعيُّنها في الطبيعة، مثل البحار والأنهار والجبال والصحارى وما إلى ذلك.
لا يتلقَّى السؤال عن الشيء جواباته المناسبة إلَّا إذا جرى استدعاؤه من الشيء نفسه. نأتي بهذه الفَرَضيَّة قصد القول أنَّ الشيء أيًّا كان جنسه نوعه – سواء كان حجرًا أم شجرًا أو كائنًا حيًّا كالحيوان وعاقلًا كالإنسان – هو طالب سؤال. بمعنى أنَّه يسأل السائل عن ماهيَّته بوصفه كائنًا موجودًا في عالم الإمكان، وعلى السائل الذي هو الإنسان أن يعثر عليه إمَّا بالاستدلال، أو بالاستقرار، أو من خلال الحدس الباطنيِّ، وبذلك يكون كلُّ شيء في هذا العالم شريكًا في السؤال عن نفسه. لأول وهلة يظهر الإشكال عن امتناع غير الناطق عن السؤال، وأنَّ الشيء لا يتكلَّم ولا يحاور وهو صامت بذاته، فكيف له أن يسأل؟
من شرط السؤال إذا كان له أن يستجاب أن يأتلف السائل ضمن ثلاثيَّة السائل والسؤال والمسؤول عنه، أي أن يكون كلُّ ضلع من أضلاع المثلَّث الآنف الذكر متضمَّنًا في نظيره. فلو تمَّ التضمين على نحو ما هو مقدَّر له تحقَّق الطور الأول من التناسب، ليأتي الجواب كحصيلة له. والتناسب هنا يتأتَّى أوَّلًا من وعي السائل لسؤاله وللشيء المسؤول عنه، وثانيًا من كينونة الشيء كحضور يستدعي المساءلة. وهذا الوعي الذي يشكِّله الإنسان عن الموجود يصل بسبب التناسب إلى الدرجة التي يتحوَّل فيها الشيء إلى حاكٍ عن نفسه، بحيث يصبح شريكًا في السؤال وحافزًا على تظهير الجواب.
نحن إذًا، أمام هندسة تظهر خطوطها نتيجة فعاليَّة مشتركة يسهم فيها السائل والسؤال والشيء المستفهم عنه وكلٌّ بقدره، وهذه الهندسة ثلاثيَّة الأبعاد:
أوَّلًا: وعي السائل بزمان الشيء وتموضعه المكانيِّ، وتعيين النقطة المطلوب التعرُّف عليها في ما هو مستتر ومحجوب في ذلك الشيء.
ثانيًا: بناء السؤال استنادًا إلى العناصر التي يتشكَّل منها وعي السائل.
ثالثًا: أن يكون الشيء المستفهم عنه منجَزًا، أو منجِزًا. أي كحضور متحيِّز إمَّا كموجود طبيعيٍّ ينتمي إلى الأشياء المادّيَّة، أو كموجود متصوَّر ينتمي إلى عالم الذهن، أو كموجود عاقل وذي إرادة كالإنسان، الفرد أو الجماعة البشريَّة.
إذا توفَّرت مثل هذه الشروط فإنَّها تؤلِّف معًا المقدِّمة الضروريَّة لتكوين السؤال الصائب المفضي إلى الجواب الصائب. وإذا فُقدت فعاليَّة أيِّ ضلع من الأضلاع المكوِّنة للاستفهام، أي وعي السائل، وهيئة السؤال، ووجود الشيء المستفهم عنه كموجود حقيقيٍّ، فتنهار سائر الأضلاع وتفتقد قيمتها ليصبح الاستفهام ها هنا في أمر المحال. أمَّا إذا تكامل الجمع بين الأضلاع فقد تكامل السؤال وجوابه؛ بما يعني مشاركة كلٍّ من الأضلاع الثلاثة في إنجاز العمليَّة الاستفهاميَّة. أي أنَّ المحصِّل للجواب ليس فقط السائل مهما بلغ ذكاؤه وشفَّ حدسُه، وإنَّما أيضًا وأساسًا دعوة الشيء نفسه ليكون موضوعًا للاستفهام.
9- التساؤل دربة السؤال الأساس
يغتذي السؤال المؤسِّس ممَّا يتجاوز حدود السؤال الفاني وكذا السؤال المتردِّد بين الفناء والبقاء. ما يتيح له الفعليَّة والامتداد ليتاخم الحدود القصوى من الاستفهام. فالسؤال المؤسِّس المنبني ذاتيًّا على المجاوزة، هو سؤال مركَّب ويتشكَّل من عناصر متضافرة. فلا يكتفي بالاستفهام الأحاديِّ عن الشيء ليتلقَّى منه الإجابة، وإنَّما يمضي إلى محاكاته واستبطانه ومساءلته عن مغزى موجوديَّته وصولًا إلى الواجد الذي أخرجه إلى الوجود.
تفصح جوهريَّة السؤال عن إرادة التعرُّف على الشيء في الَّلحظة التي يستعدُّ فيها ذلك الشيء للإعلان عن نفسه. ففي هذه الآنيَّة الطفيفة يتَّخذ السؤال مكانته ويكتسب صفته الوجوديَّة. في هذه الَّلحظة تتوثَّب همَّة السائل من أجل التعرُّف على ماهيَّة ذلك الشيء وهويَّته. لكن هذا التوثُّب ما كان ليظهر بالسؤال لولا أنَّ الشيء نفسه استمال جزءًا من نفس السائل ومن زمانه ومكانه أيضًا. هنا يجري الكلام على نحو دقيق حول مكانة السؤال في الأفق الميتافيزيقيِّ. إذ عندما يصدر السؤال ولا غاية له إلَّا معرفة الشيء في ذاته، ولماذا صدر في هذه الآونة أو تلك بالذات، فذلك يدلُّ على مكانته الأصيلة في التفكير الميتافيزيقيّ. بل أبعد من هذا نقول إنَّه عنصر التناظر الأول مع واقعة الاحتجاب الوجوديِّ وغموضه. يجري ذلك، سواء تعلَّق الأمر باحتجاب الوجود نفسه كمقولة أنطولوجية أم باحتجاب الموجود كمقولة فينومينولوجيَّة. ما ينبغي أن يُستعاد اليوم هو إدراك الماهيَّة الأنطولوجيَّة للسؤال كمبدأ ضروريٍّ للتفلسف المعاصر. بنحو أكثر تحديدًا السؤال عن السؤال نفسه، ذاك الذي بسبب من غيبته أو تغييبه انحدر التفلسف إلى دنيا الماهيَّات الفانية وغفل عن مهمَّته الأصليَّة في تحرّي الوجود بما هو وجود.
ينبغي القول هنا أنَّه إذا فُهِمَ السؤالُ بوصفه استفهامًا عن ظاهر الشيء ونشأته الأصليَّة، فالتساؤل هو الحيرة في فهم ما يحتجب عن الإدراك في حقيقة ذلك الشيء. هو قصدٌ معرفيٌّ صبورٌ يؤلِّفه الفكر ويألفه. ومن وجه إضافيٍّ هو محفوظٌ في النفس العاقلة تلتجئ إليه حين تتقطَّع بها السبل حين يكابد الفكر أسئلة لا يقدر على صوغها بناء على استحالة الجواب اليقينيِّ عليها، فإنَّه يلتجئ إلى التساؤل علَّه يفلح استفهامات استعصى أمرُها على الفهم. ربما لهذا السبب وصفه هايدغر بأنَّه تقوى الفكر.
التساؤل إذًا، هو الَّلحظة التي ينعطف فيها السائل نحو طور آخر من التعرُّف على الموجود. ونستطيع القول أنَّ التساؤل ضربٌ من المَيْلِ إلى تحصيل جواب محتمل عن المختفي. ومع هذا المَيْل يحلُّ المتسائل في منطقة غامضة، حيث يتوارى الشيء المراد التعرُّف عليه، ويغيب عن النظر المباشر؛ بعدئذٍ لا يبقى أمام المتسائل إلَّا أن يستغيث بالعقل الصبور، حتى تقترب لحظة الانفراج. وجهد المتسائل بالصبر والتبصُّر فعلٌ منفردٌ بذاته يُعرض من خلالها عن مخاطبة الخارج ويرجع إلى مساءلة الداخل. يجري ذلك على نحوٍ هو أشبه بانعطاف يجاوز الزمن المألوف لـ “الأنا السائلة” حيث ينتقل الفكر من طور الجهر بموضوعه إلى التأمُّل الهادي إلى مكنونه. بذلك يغدو الشيء المرصود للتعرُّف مدار المعاينة الذاتيَّة لإدراك ما ينطوي عليه من أسرار.
في محراب التساؤل نجدنا في منفسح من التفكُّر يتقدَّم على السؤال ذي البعد الواحد، ويجاوزه ليفتح على آفاق تفتح على فهم تجلِّيات الخلق وتجدُّده. وعندها يتَّخذ التساؤل منحىً مفارقًا للأسئلة المنحصرة في المكان المحدود والزمانيِّ الفاني.
- السؤال بما هو لغة جاذبة
كان كتاب هايدغر “الوجود والزمان” (1927( (Sein und Zeit)، (1962)، Being and Time في القليل منه وصفًا فلسفيًّا، وفي أكثره مبحث في ما قبل الوجود (Pre-Ontological Inquiry). غير أنَّه بسبب من الطبيعة الظرفيَّة التي اتَّسم بها الكتاب المشار إليه، لم يكن يحاول الإجابة عن السؤال، بل تحريكه (Stir) كما يطيب له أن يعبِّر. لقد رمى إلى تهيئة سياق لذلك السؤال ليتحقَّق له وجود. ذاك أنَّ عمليَّة التفكير بحقٍّ في السؤال، ومعاناة السؤال معاناة وجوديَّة إنَّما هي عمليَّةٌ تُفكِّك تاريخ الأنطولوجيا، وتاريخ الكيفيَّة التي تمَّ بها تفسير الوجود بها تفسيرًا تقليديًّا.[23]
يذهب هايدغر إلى الحدِّ الذي يرى فيه الى السؤال كلغة جاذبة لما يمكث وراء مستطاع العقل المنشغل بالأشياء الحالة في الزمان والمكان. وكان يرى أيضًا أنَّ الوجود كمثل الزمان ليس له وجود قائم خارج أي شيء، وخصوصًا خارج المكان، حيث يكون السؤال. وبحسب تأويليَّته لا يظهر السؤال إلَّا في السؤال، بمعنى أنَّه لا يظهر إلَّا في صورة علاقات يجري تشكيلها في الُّلغة والشعر والفكر. والوجود ليس إجابة لأيِّ شيء، لأنَّه ليس كيانًا (Entity)، أو شيئًا، أو تصوُّرًا، أو فكرة تكون قابلة للإدراك، ولكنَّه مزيد من الشكِّ، وافتقاد الحضور، وقلق يشير إلى العدميَّة المطلقة؛ وهو واقع دائمًا خارج سيطرة الفهم.
ويتجنَّب هايدغر الحقائق الفلسفيَّة التي يقتصر دورها على مجرَّد إضفاء الغموض على هذه التجربة الواقعة في ما قبل الأنطولوجيا، ويحاول أن يمارس التفكير في غياب سوالف التصوُّرات (Preconception)، وفي غياب الحقائق السامية السرمديَّة. وهكذا يتحوَّل فكره شيئًا فشيئًا إلى الُّلغة كلَّما تدرَّج المقال في الإفصاح عن محتواه، وهو لا ينفكُّ يثير سؤال الوجود، لا لشيء إلَّا ليرى شبه إجابة تختفي في لحظة اقترابه من التوصُّل إلى صياغة محكمة للسؤال نفسه. وهذان الأمران يصبحان متَّصلين اتصال معاندة، ومتنافيين أيضًا تنافي المعاندة، من أجل هذا وبسببه يسعى لممارسة التأمُّل من خلال الخطاب الواقع في إطار سؤاله الذي يطرحه هو نفسه، بحيث يصبح السؤال الذي ليس له جواب، هو السؤال الوحيد الذي يقوم أساسًا بدور المرشد لتفكيره لاحقًا[24].
لقد ناقش هايدغر في “الوجود والزمان” قضايا أساسيَّة للميتافيزيقا الغربيَّة. أرقاها فكرة الإنسان بوصفه موجودًا يثير أسئلة عن الوجود. إلَّا أنَّه ما لبث أن مال إلى همٍّ أبعد غورًا بعد أن تخلَّى عن فكرته الخاصَّة حول أهميَّة الذات بوصفها كائنًا عارفًا، إلى أهميَّة الُّلغة بما هي القوَّة التي تفكِّك الذات. وهكذا يصبح الإنسان، بمصطلحيَّة هايدغر، هو موضوع الُّلغة (The Subject of Language). وبحسب الكيفيَّة التي شرع بها يتأمَّل الموجود، فهذا الموجود يختفي في الُّلغة: أي أنَّ الخطاب في كتاب: الوجود والزمان يشير إلى انتهاك حدود النصِّ الأدبيِّ نفسه.
لقد تقدَّم هايدغر بخطواته نحو النقطة التي يرجِّحها فوكو، وهو ما يمثِّل خاصيَّة مميّزة لضرب معيَّن من ضروب الفكر في القرن العشرين، رأى أنَّ الأَوْلى هو العدول عن القول بأنَّ شخصًا ما يتكلَّم، إلى القول بأنَّ الُّلغة نفسها تتكلَّم، وأنَّ الإنسان ينصت. وإذا كان مثل هذا الإنصات ممكنًا، فما الذي يمكن للمرء أن يسمعه؟ هو يذهب إلى أنَّنا يقينًا لا نسمع كلَّ شيء، وذلك لأنَّ ثمَّة شيئًا جوهريًّا بالنسبة إلى طبيعة الُّلغة لا يمكن أن يُسمع أو يُقرأ؛ شيئًا يُحتَبس حين تتكلَّم الُّلغة. إن الكلمات لا يقتصر عملها على الكشف عمَّا يجري هناك، إذ إنَّ “الُّلغة هي بيت الوجود”، ولكنَّها أيضًا تُسِرُّ فلا تبوح. وحين ندعها تتكلَّم عن نفسها، فالذي يتكشَّف هو شيء ما يعبِّر عن طبيعتها: إنَّ الكلمات لا تكشف عمَّا هو موجود وعمَّا ليس موجودًا في آن (was es gibt und gleichwohl nicht ist)[25].
مع الفيلسوف الألمانيِّ مارتن هايدغر سوف تنعطف مهمَّة الميتافيزيقا نحو ضفَّة معاكسة يستعاد فيها ما يسمّيه “السؤال الأساس”، ليكون الشاهد على فلسفة آن لها أن تسلك السبيل إلى الصواب.
ما يميّز السؤال الأساس بالنسبة إليه هو أنَّه “ما إن نسأله بالفعل، حتَّى يجعل من الميتافيزيقا مشكلة، ممَّا يؤدّي إلى تحويل الفلسفة بكاملها[26].” السؤال الأساس، ليس إذًا السؤال المؤسِّس فقط، ليس معناه معنى ما بُنِيَ عليه فقط، لا يبقى فقط في داخل الميتافيزيقا وتطوُّرها. نعم، هو أساسٌ حصلَت منه انطلاقة أعطت الميتافيزيقا وما ارتكز عليها، ولكنّه أيضاً أصل أوّل حمل إمكانيات فكريَة لم تأخذها الميتافيزيقا، في توجُّهها الصارم، على عاتقها. لهذا السؤال هنا ميزتان علينا التشديد عليهما، هما: أوّلًا سؤال يخصُّ الميتافيزيقا بأسرها، وثانيًا سؤال ما إن نتعرَّف إليه فنسأله مجدَّدًا حتّى تتحوَّل الفلسفة، بل وقد تختفي الميتافيزيقا في طيَّات تساؤلاتها الجديدة، فيكون السؤال الأساس التحضير لفكرٍ آخَر، أكثر أوّليَّة وأصالة[27].
السؤال بالمعنى الذي أراد هايدغر تظهيره هو استفهام فلسفيٌّ بامتياز، بل هو أهمُّ إجراءات الفلسفة في مسعاها إلى الاستفسار عن أعمق الحاجات الطارئة الملازمة لوجود الإنسان”[28]. السؤال “يخصُّ الكائن ككائن: هو يهدُف إلى كينونة الكائن… سؤال الميتافيزيقا الأساس ليس “ما هو الكائن ككائن؟”، بل “ما هي الكينونة ككينونة؟” باختصار: سؤال الميتافيزيقا الأساس هو الّذي يسأل عن جوهر وعمق جوهر ما يجعل الكائن يكون ككائن، مهما يكن الكائن ومهما تكن طريقة وجوده.[29]” هذا السؤال لم تسأله الميتافيزيقا منذ بدايتها، أو جاوبت عنه من دون أن تسأل عمَّا يحمل جوابها من تساؤل هو في صلب الكينونة، فكان جوابها انحجابًا أكبر للسؤال الأساس[30].
من هنا بالطبع الحاجة إلى تكرار وإعادة السؤال، بدءًا من الاتّجاه الّذي أخذته الـ Leitfrage (السؤال الموجِّه/المرشِد)، وذلك بشكلٍ يبيِّن لأوّل مرَّة ما هو مخفيٌّ في باطنها: “الإمكانيَّة الوحيدة المتبقّية هي إعادة السؤال الموجِّه التقليديِّ – ما هو الكائن؟ – ولكن شرط أن يقود السؤال إلى التساؤل الكامن والمخفيِّ فيه، لكي يتبلور ويحصل السؤال العينيُّ عن الجوهر والعمق الّذي يتجلّى فيه جوهر الكينونة[31].” يقول هايدغر، في الفترة ذاتها: “… الإشكال الموجِّه للفلسفة القديمة هو السؤال، ما هو الكائن؟، وهذا السؤال الموجِّه، يمكننا أن نحوِّله إذا ما فرضنا عليه في البداية الشكل الأوّليِّ للسؤال الأساس: ما هي الكينونة؟“. هذا التحوُّل يصبح لاحقًا وثبة نوعيَّة عنده، ولكن نبقى هنا في ما حصل قبل الكينونة والزمان ومكَّن كتابته[32]: التحوُّل هو في التركيز على الكينونة بدلًا من الذي يحصل عندها هو مركزيٌّ وضروريٌّ لقيام فكرٍ جديد.
ما يحصل بالفعل في هذا التحوُّل هو تجلٍّ، ذلك التجلّي الّذي أراده هايدغر في بداية المحاضرة: “البدء بالفعل من بداية هذا المنطق. وعندها، ما يميّزه يقفز أمام أعيننا بشكلٍ يمكننا قراءته بوضوح[33].” وهو يسأل: “ما هو جوهر الكينونة…؟ ما هو العمق الّذي يمكن لهذا الفهم أن يقوم عليه؟” والجواب واضح الآن، متجلٍّ: هذا العمق “هو الزمان[34]“.
لمَّا كانت الحَيْرة على ثلاثة منازل، نازلة ووسطى وصاعدة، فالأخيرة هي حَيْرة الذين اختبروا المنزلين السابقين، وقرَّروا أنَّ معرفة الموجود لا تصحُّ من دون معرفة الواجد. ومثل هذه المعرفة تتخطَّى عالم المفاهيم المستنتج من أعراض الماهيَّات الفانية. وإنَّما تبدأ رحلتها على خطٍّ معاكس مع رحلة العقل الراعي لمظاهر الوجود. أي أنَّها تمضي من التعقيد إلى التبسيط، ومن الكثرة الفانية إلى الوحدة الباقية، وبالتالي من الموجود إلى الموجِد. وفقًا لهذه السيريَّة لا تُنجز إلَّا في صورة جمع الأضداد. لهذا عرَّفها الحكماء بأنَّها تأثير شهود جمع الأضداد على ذهن العارف ونفسه وعقله. وهي أمر طبيعيٌّ عند أولئك الذين تتطلَّع أعينهم إلى ما وراء الأشياء وفي أعماق الطبيعة. ربما لهذا الاعتبار كانت الحَيْرة في تعريف الشيخ الأكبر ابن عربي نوعًا من الضلالة المطلوبة التي تُوصِلُ الإنسانَ إلى موضع يرى فيه أنَّ الحيلة الوحيدة لقطع الطريق هي تلك التي يريه الله إيَّاها.
[1] – M.Blanchot, L’entretien infini, Gallimard, pp. 13-16.
[2] – ipID, pp. 17.
[3] – (الموسوعة الفلسفيَّة ـ معهد الإنماء العربي ـ إشراف: معن زيادة، بيروت- 1984. راجع مصطلح علاقة).
[4] – باروخ سبينوزا – علم الأخلاق – ترجمة: جلال الدين سعيد – المنظَّمة العربيَّة للترجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العربيَّة – بيروت – 2009 – ص 35.
[5]– فريديريك نيتشه – ما وراء الخير والشر – ترجمة جيزيللا فالور حجار، إشراف: موسى وهبه – إصدار دار الجديد – بيروت 1995 – ( ص 18).
[6]– المصدر نفسه – ص (20).
[7] – محمد عنبر – مقدِّمة لديوان العارف بالله العلَّامة الشيخ أحمد محمد حيدر “النغم القدسي” – دار الشمال – طرابلس – لبنان – 1997 – ص(18).
[8] – المصدر نفسه – ص (20).
[10] – سمر الديوب – الثنائيَّات الضديَّة – بحث في المصطلح ودلالاته – المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّة – بيروت – 2018 – ص 18.
[11]ـ المرجع السابق، ص 318- 319.
[12]ـ إدموند ليتش: 2002، كلود ليفي شتراوس دراسة فكريَّة، ترجمة: د. ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص 24.
[13]ـ المرجع السابق، ص 25.
[14]ـ المعجم الفلسفي، ص126.
[15]ـ المرجع السابق، ص 179.
[16]ـ الموسوعة الفلسفيَّة، ص373.
[17]ـ سمر الديوب – مصدر سبق ذكره – ص 21.
[18] – Franz von Baader، Schelling، Paderborn 7115; Emmanuel Tourpe, L’Audace théosophique de Baader: premiers pas dans la philosophie religieuse de Franz von Baader (5671- 5485), Paris 7115.
–[19] See. Franz von Baader، Über das Verhältnis des Wissens zum Glauben، in SW I، p 185; Vorlesungen über spekulative Dogmatik (abbr. VD)، in: SW، Vol. VIII، 115; Erläuterungen zu sämtlichen Schriften von Louis Claude de Saint-Martin (abbr. E)، in SW، Vol. XII، p. 714، 178-171 and others.
[20] – IPID, P. 179.
[21] – جيل دولوز – الاختلاف والتكرار – ترجمة: وفاء شعبان – المنظَّمة العربيَّة للترجمة – بيروت – 2009 – ص 500.
4 – ابن فارس- الصاحبي في فقه الُّلغة – المكتبة السلفيَّة – القاهرة – 1328هـ- ص 164.
[22] – مهدي قوام صفري – كيف يمكن قيام ميتافيزيقا – ترجمة: حيدر نجف – المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيَّة – سلسلة الدراسات الغربيَّة 2017- ص 308.
– [23] أدوين غينتسلر – في نظريَّات الترجمة – اتِّجاهات معاصرة – ترجمة: سعيد عبد العزيز مصلوح – مراجعة محمد بدوي – المنظَّمة العربيَّة للترجمة – بيروت – 2007 – ص 363.
[24] – المصدر نفسه.
[25] – غينتسلر – المصدر نفسه – ص 365.
[26]– GA, Bd. 80, p. 282 : “… wenn sie wirklich gestellt wird, die Metaphysik zum Problem werden läßt, d.h. die Philosophie im Ganzen verwandelt.”
[27] – رالف درويش – فصليَّة “الاستغراب” العدد الرابع عشر – شتاء 2019.
[28]– GA, Bd. 80, p. 281 : “… innerste Not der Existenz des Menschen.”
[29]– GA, Bd. 80, p. 303, 304 : “… gefragt ist nach dem Seienden als Seienden, nach dem Sein des Seienden… Die Grundfrage der Metaphysik lautet nicht : Was ist das Seiende als solches ?, sondern : Was ist das Sein als solches ?, kurz : Die Grundfrage der Metaphysik ist die nach Wesen und Wesensgrund dessen, was das Seiende, was und wie immer es sein mag, als Seiendes sein läßt.”
[30] – رالف درويش – مصدر سابق.
[31]– GA, Bd. 80, p. 317 : “Es bleibt nur die Wiederholung der überlieferten Leitfrage : Was ist das Seiende ?, aber so, daß sich dieses Fragen auf den ihr verborgenen zugrundeliegenden Grund zurückbringt, d.h. so, daß die konkrete Frage nach dem Wesen und Wesensgrund des Seins zur Ausarbeitung und wirklichem Geschehen gelangt. »
[32]– راجعOtto Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers (Pfullingen : Neske, 1963), p. 161.
[33]– GA, Bd. 80, p. 284 : “… wirklich mit dem Anfang dieser Logik beginnen. Dabei springt uns schon hinreichend deutlich ihre Eigentümlichkeit in die Augen.”
[34]– GA, Bd. 80, p. 317 : “Was ist das Wesen des Seins… ? Auf dem Grunde wovon ist dieses Seinsverständnis möglich ? Auf dem Grunde der Zeit.”





