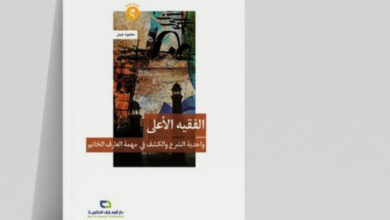إيمان “ما بعد العلمانية”..
إيمان “ما بعد العلمانية”..
محمود حيدر
مرَّ تاريخ كامل استحلَّت فيه عبارةُ “إزالة السحر عن العالم” (désenchantement) عقلَ الحداثة الغربية برمته. كان الدين على وجه الحصر هو المقصود من العبارة التي تحولت مع تقادم الزمن إلى ما يشبه الأيقونة الإيديولوجية.
لم يكد القرن العشرون يطوي سجله المكتظَّ بالأفكار والأحداث والحروب الكبرى، حتى قَفَل الغرب عائداً إلى أسئلة بَدئية طواها سحر الحداثة وضجيجها. من أظهر تلك الأسئلة، ما عكسته مناخات الجدل المستحدث في ما أسموه “رجوع الدينيّ”. وما كان القصدُ من “رجوع الدينيِّ” هنا، إلا الإعراب عما يسفر عنه سؤال الدين من أثرٍ مبين في ثقافة الغرب المثقلة بعَلمانيتها الصمَّاء. لم يفارق الدين أرض الحداثة سحابة القرون الخمسة من عمرها المديد. كذلك لم يغادر الدينيُّ هواجس الغرب وتعقُّلاته، لا في حداثته الأولى، ولا في أطواره ما بعد حداثية. كأنما قدرٌ قضى أن يظلّ الدين باعث الحراك في الفلسفة والفكر والثقافة والاجتماع.. حتى لقد بدا أشبه بمرآة صقيلةٍ يَظهر على صفحتها الملساء حُسنُ الحداثة المزعوم. فالدين ـ على ما يبين فلاسفة التنويرـ لم يكُف عن كونه وظيفة أبدية للروح الإنساني. لهذا راحوا يُنبِّهون إلى ضرورة ألاَّ تتنازل الفلسفة يوماً عن حقّها في بحث المشكلات الدينية الأساسية وحلِّها.
كان فيلسوف الدين الروسي نيقولا برديائيف يرى أن لليقظات الفلسفية دائماً مصدراً دينيّاً. ولقد نال من كلامه هذا الكثير من النعوت المذمومة ممن جايَلَهم من علماء الماركسية وفلاسفتها. لكنه رغم سَيْلِ الانتقادات التي انهمرت عليه، ظل على قناعته بأن جهلاً مطبقاً ضرب العقل الأوروبي حيال الدين. كان برديائيف يدعو على الدوام إلى التبصر بالإيمان الديني بما هو حالة فوق تاريخية لا يستطيع العقل العلماني أن يقاربها بيسر. بل انه سيمضي في مطارح كثيرة من مساجلاته إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد أعرب عن اعتقاده بأن الفلسفة الحديثة عموماً، والألمانية خصوصاً، هي أشد مسيحية في جوهرها من فلسفة العصر الوسيط. حيث نفذت المسيحية ـ برأيه ـ إلى ماهية الفكر نفسه ابتداءً من فجر عصور الحداثة.
* * * * *
“رجوع الديني”، هو بلا ريب، عنوان إشكالي سيكون له آثاره البيِّنة على المفاهيم والأفكار والقيم التي تجتاح المجتمعات الغربية اليوم. من بين تلك الآثار ما ينبري إلى تداوله جمعٌ من فلاسفة ومفكري الغرب سعياً للعثور على منظور معرفي يُنهي الاختصام المديد بين الدين والعلمنة. والذي تسالَمَ عليه الجمعُ في ما عرف بنظرية “ما بعد العلمانية”، هو أحد أكثر النوافذ المقترحة حساسية في هذا الاتجاه. ما يعزز آمال القائلين بهذه النظرية أن أوروبا الغنية بالميراثين العلماني والديني قادرة على إبداع صيغة تناظر تجمع الميراثين معاً بعد فِرقة طال أمدها. ربما هذا هو السبب الذي لأجله ذهب بعض منظِّري “ما بعد العلمانية” ـ ومنهم الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ـ إلى وجوب تخصيص إطار مرجعي يحضن أهل الديانات وأتباع العلمنة سواء بسواء بغية العيش المتناغم في أوروبا تعددية.
شغف التساؤل حول صيرورة الاحتدام الديني العلماني ومآلاته، لم يتوقف عند هذا المفرق.. كان ثمة منحى آخر تترجمه الملتقيات الحميمة بين اللاَّهوت والفلسفة. واللقاء المثير الذي جمع قبل بضعة أعوام البابا بينيدكتوس السادس عشر إلى الفيلسوف هابرماس، شكَّل في العمق أحد أبرز منعطفات التحاور الخلاّق بين الإيمان الديني والعلمنة في أوروبا. ومع أن اللقاء لم يسفر يومئذٍ عما يمكن اعتباره ميثاقاً أوليّاً للمصالحة بين التفكير اللاهوتي والتفكير العلماني، إلا أنه أطلق جدلاً قد لا ينتهي إلى مستقر في الأمد المنظور.
اللقاء الفريد بين الرجلين، ظَهَّرَ المسلَّمات التي ينبغي الأخذ بها لتحصين كرامة الإنسان في زمن بلغت فيه اختبارات الحداثة حدَّ التهافت. وجد هابرماس في العقل العملي لـ”الفكر ما بعد الميتافيزيقي العلماني” نافذة نجاة.. بينما وجده البابا بنيديكتوس في الإنسان كمخلوق إلهي. يومها اعترف هابرماس باستعداد الفلسفة التعلُّم من الدين. كان لسان حاله يقول: ما دام العقل لم يستطع القضاء على الوحي في فضاء علماني، فليهتم الفيلسوف بالإيمان عوض الاستمرار في الحرب معه. ثم أصرَّ على ضرورة أن توليَ الدولة المشرِّعة للقوانين كل الثقافات والتمثُّلات الدينية عنايتها، وأن تعترفَ لها بفضاء خاص في إطار ما سماه بالوعي “ما بعد العلمانيّ” للمجتمع. أما إجمالي ما ذهب إليه البابا فهو دعوته إلى تحصين الحضارة الغربية المعاصرة عبر خمس ركائز: التعاون بين العقل والإيمان ـ مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الإنسان ـ فكرة الحق الطبيعي كحق عقلي ـ التعدد الثقافي كفضاء لارتباط العقل والإيمان ـ العقل والإيمان مدعوان لتنظيف وإشفاء بعضهما البعض…
لو كان لنا من عبرةٍ تُستخلَصُ مما أبداه الرجلان، لقلنا إن ما حصل هو أشبه بإعلان ينبئ عن انصرام تاريخ غربي كامل من الجدل المزمن حول “بِدعة” الاختصام بين الوحي والعقل.
* * * * *
ما بعد العلمانية إذاً، تجربة مستجدة في التفكير الغربي بشقيه العلماني واللاهوتي. تجربةٌ تتغيَّا وضع حدّ للاحتراب المديد بين خطّين متعاكسين: إما الإيمان المطلق بقوانين اللاّهوت وسلطاته المعرفية، وإما الإيمان بمطلق العقل المحض، وما يقرره من أحكام لادينية لفهم العالم.
لئن دلَّ كلّ ذلك على شيء، فعلى تحول غير مسبوق في التفكير “الما بعد حداثي” بجناحيه الديني والدنيوي. مثلما يشير إلى وجود منفسحات معرفية ذات وزن داخل البيئة الغربية، كانت ولا تزال ترى بهدوء إلى موقعية الإيمان الحاسمة في وجدان الأفراد والحضارات. لقد أسفرت هذه المنفسحات عن أمرٍ ذي دلالة جوهرية في التحول المشار إليه: أن ليس ثمة من تضادٍّ بين الإيمان في طبيعته الحقيقية، والعقل في طبيعته الحقيقية. وأن ليس ثمة صراع جوهري بين الإيمان بالوحي والوظيفة الإدراكية للعقل. ومتى فُهِمَ ذلك على النحو الأتمّ، ظهرت الصراعات السابقة بين الإيمان والعلم في ضوءٍ مختلف تماماً. فالصراع في حقيقته لم يكن بين الإيمان والعلم، بل بين إيمانٍ وعلمٍ لا يعي كل منهما بعده الحقيقي. من قبيل المثال غير الحصري: لم يكن الصراع الشهير بين نظرية التطور الداروينية، ولاهوت بعض الطوائف المسيحية صراعاً بين العلم والإيمان، بل صراعاً بين علمٍ يجرد إيمان الإنسان من إنسانيته، وإيمان حوّله لاهوت السلطة إلى أيديولوجيا، ومن ثَمَّ إلى حرب مفتوحة على العقل.
لقد سرى سؤال الدين في الغرب مسرى خطبة الحداثة من مبتدَئِها إلى خبرها. فلو عاينَّا قليلاً منها، لاسيما الفلسفي والسوسيولوجي، لعثرنا بيسر على أصلها الديني. كما لو كان من أمر الحداثة حين أرادت تظهير غايتها الكبرى، أن تتخذ لنفسها صفةَ متعالية. ربما هذا هو السبب الذي نُظِرَ فيه إلى الحداثة وما بعدها، كظاهرة ميتافيزيقيّة رغم دنيويتها الصارمة. فالحداثة من قبل أن تشرَع سيوفها شرَعت أسئلتَها. وهي أول ما سألت، ساءَلَت الكنيسة المسيحية كخصيم لها بلا هوادة. لكنها حين مضت في السؤال لتمنح نفسها بعض اليقين، هبطت إلى عمق الزمان الديني. لم تفعل الحداثة ما فعلت إلا عن أمر متأصِّل في ذاتها. فقد “استفرغت” ما يعربُ عن سيرتها الضاجّة بالكامن الديني. وغالباً ما انصرفت إلى المسيحية لحاجتها إلى متعالٍ يضفي على أزمنتها فضائل القدسيِّ ومزاياه… أو.. ربما لأنها بحثت عن اعتلائها الأرضي فلم تجده إلا في فضاء الدين. لذا كان عليها ان تهيمن على معنى المسيحية لتقوم مقامه، أو لترتدي بواسطته لبوس الفضيلة. لهذا الداعي ـ على غالب الظن ـ تناهى لنا كيف بدت أسئلة الحداثة وأفعالها محمولة على أجنحة الميتافيزيقا.
منشأ المفارقة أن سؤال الحداثة، جاءنا بالأصل من حقول المسيحية الواسعة؛ فإنه بهذه الدلالة وليدها الشرعي. بل أن سيرة الحداثة مع المسيحية كانت أشبه بديانة خرجت من ديانة عاصرتها، ثم سبقتها، ثم من بعد أن ارتوت من عداوتها لها عادت لتحاورها ولو على كيدٍ مُضْمرٍ.
حين تصدّت الفلسفة المعاصرة لتجيب على السؤال الصعب حول المآل الذي يمكن أن يسفر عنه اللقاء الحذر بين الإيمان الديني والعلمنة، لم تستطع الفصل بين خصمين انحكم إليهما الغرب جيلاً إثر جيل. مع ذلك لم تستيئس الفلسفة من متاخمة الفضاءات القصوى لأسئلة الدين. فمن خصائص التفلسف ـ على حدِّ درايتنا ـ أن كل سؤال يولد نتيجة علاقة بين ضدَّين، وأن عناصره تتشكل من هذين الضدَّين معاً. وأن كل سؤال يحيط دائماً بمجمل إشكالية الفضاء الذي منه جاء، ويكون في كل مرّة هو هذا المجمل نفسه. وعلى هذا النحو لا يُمكن لأي سؤال ميتافيزيقي أن يُطرح، ـ كما يُبيّن مارتن هايدغر ـ من دون أن يكون السائل نفسه، ـ مُتَضمَّنا ـ في السؤال، أي عالقاً في هذا السؤال.
* * * * *
لقد حطَّت المنازعةُ بين الحداثة والكنيسة على أرض الفصل بين “دنيوية العلمنة” وجوهر المسيحية. لم تتوقف “العلمانية الحادة” لمّا نازعت الكنيسة مقامها، على احتكار قيم السياسة والاجتماع ووضع نظريات الدولة. فإذا بها، تمضي إلى نهاية الرحلة لتنقلب على الكنيسة، وتُطيح لاهوتها السياسي، وتحكم على ادعائه الحقيقة بالبطلان. بل إنها ستذهب مسافة أبعد في المواجهة، لتفتح باب المساءلة، مجمل ما أنجزته الفلسفة الحديثة في صعيديها القيمي والأخلاقي. مثال لا حصر: تحوّلت مقولة الواجب عند كانط إلى مجرد طاعة مطلقة لنظام الدولة / الأمة و”أميرها الحديث”. ذاك الذي نزع من الحداثة أخلاقها حين استفرغها من جوهرها المسيحي، ثم واصل “ضراوته” حتى أوشك ألاّ يبقي من الكنيسة سوى حجارتها الصمّاء.
كانط نفسه لم توفِّره سيوف الحداثة. فقد جاء شغفه بالتفكير النقدي ليفتح على ممارسة فلسفية لا تُبقي منجزات التنوير في منأى من النقد. كانت غاية “ناقد العقل الخالص”، موقوفة على سعيه إلى حفظ الأنوار العقلية بالأخلاق العملية. وكذلك على رؤيته بأن الإنسان كائنٌ عاقلٌ، وبما أنه عاقلٌ فهو كائنٌ أخلاقيٌّ، وبما أنه أخلاقي فهو كائن ديِّنٌ.
لما انتصرت الحداثة على اللاّهوت، وابتنت علمانيتها الحادة بعقل بارد، راحت تنظر إلى الكنيسة بوصفها نابض إرجاع للزمن، وإلى المؤمنين بوصفهم كائنات أسطورية تُغرِقُ العالمَ بالظلمات. لكن يبدو أن تلك النظرة طفقت تتهيَّأ لمنقلب آخر.. صحيح أن الحداثة انتصرت على اللاّهوت، لكنها لم تستيقظ من نوام انتصارها بعد.. كان الفرنسيون يقولون أن جمهوريتهم لم تنتصر إلا بدحر الكنيسة.. لكنهم لم يلبثوا حتى أدركوا أن هذا النصر كان أشبه بانتصار فرنسا على نصفها الآخر.
ثمة من شبَّه مآلات ما بعد الحداثة بتلك الصورة المنسوبة إلى جاهلية القرون الوسطى. وقد عنى بها تلك الجاهلية المستأنفة، والتي تأتينا هذه المرّة برداءٍ تكنولوجيّ “ما بعد حداثيّ”. وهذا بالضبط ما قصده اللاهوتي الألماني ديتريش بونهوفر حين صبَّ جام نقده على حداثةٍ باتت مهووسة بعالمٍ صار عبداً لأهوائه وأشيائه. حداثة تحول فيها سيّدُ الآلة إلى عبدٍ لها، وانتهى تحرر الجماهير إلى رعب المقصلة. والقومية انتهت إلى الحرب.. وتفتَّحت مع الحداثة أبواب العدمية”.
* * * * *
لزمن ليس ببعيد كان ثمة تساؤل عما إذا كان الغرب سيتحول إلى مجتمع بلا دين.. تساؤل مرير ملأ تاريخ الكنيسة الكاثوليكية المعاصرة، من البابا بولس السادس في الستينيات، إلى يوحنا بولس الثاني في الثمانينيات والتسعينيات، وصولاً إلى البابا المستقيل بنديكت السادس عشر فالبابا الحالي فرانسيس.
الصورة الراهنة للتساؤل المذكور تظهر في أكثر لحظاتها غشاوة. لم يعد العقل الذي ابتنت عليه الحداثة منجزاتها العظمى على امتداد قرون متصلة، قادراً وبأدواته المعرفية المألوفة، على مواجهة عالم ممتلئ بالضجر والخشية واللاّيقين. وما عادت العلمنة التي “قدَّست” مسالكها ونعوتها وأسماءَها قادرة على مواصلة مشروعها التاريخي عبر استئناف عداوتها للإيمان الدينيّ.
أما حين انتهت ما بعد الحداثة إلى الحديث عن الإنسان الأخير وعن موته، فإنها لم تكن لتفعل ذلك إلا لتكشف عن جاذبٍ إلى معنى ما فوق ميتافيزيقي.. بل ربما عن رغبة كامنة بيومٍ تستعاد فيه الإنسانيّة على نشأة الجمع بين أفق الألوهة وأفق الأنسنة على نصاب واحد.